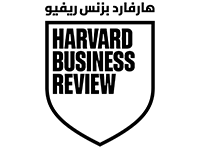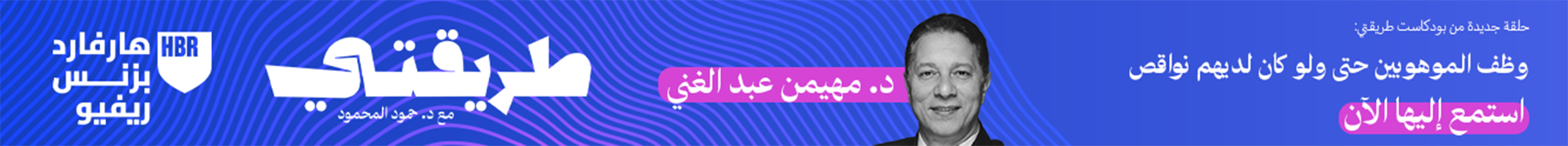ظهر أول الأعمال الخاصة باستراتيجية الشركة في نهاية الخمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين، ومن أهم الأعمال التي ميّزت تلك الفترة نجد أعمال شاندلر وكتابه "الاستراتيجية والهيكل (التنظيمي)" عام 1962، الذي عرّف فيه الاستراتيجية بأنها: "تحديد الغايات والأهداف الأساسية البعيدة المدى، ثم اختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذه الغايات". بعدها أسهمت أعمال مايكل بورتر خلال الثمانينيات في بروز الإدارة الاستراتيجية وتطورها، وهي الإدارة التي تنشأ من تفاعل 4 عناصر معاً: الهيكل التنظيمي، وعملية اتخاذ القرار، وهوية الشركة، والاستراتيجية المتبعة.
فيما يلي 7 من أهم المصطلحات المستخدمة في مجال الإدارة الاستراتيجية ومعناها:
1. رسالة الشركة (Mission Statement)
بيان مختصر يوضح كيفية تحقيق الغاية الأساسية التي أُنشئت من أجلها الشركة. تسهم رسالة الشركة في توجيه أهدافها، ويجب أن تكون متوافقة مع قيَمها ومبادئها وتوقعات المساهمين. فمثلاً، تصوغ الشركات التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة رسالتها بحيث تتضمن الإشارة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الهدر، مثل رسالة شركة تيسلا (Tesla): "رسالتنا هي تسريع التحوّل العالمي إلى الطاقة المستدامة". يكفي الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية حتى نتمكن من صياغة رسالة الشركة، وتتمحور هذه الأسئلة حول كيفية خلق القيمة، وطبيعة المنتجات، والميزة التنافسية التي تميّزنا عن باقي المنافسين، أي أنها تعكس ملامح الاستراتيجية التنافسية.
2. رؤية الشركة (Vision Statement)
بيان مختصر للوضعية المستقبلية التي تريد الشركة الوصول إليها. تساعد الرؤية على توجيه أنشطة الشركة وتحديد الأهداف الرئيسية العامة، لذلك لا يتم تعديل الرؤية خلال فترة حياة الشركة إلا نادراً وضمن نطاق محدود. وتتميز الرؤية بمجموعة من الخصائص أهمها: سهلة الفهم والتذكر، وتبعث على التحدي، وذات هدف محدد، ومتجهة نحو المستقبل، وذات طابع جذاب وملهم ويتميز بالإيجابية والتحفيز. من أمثلة رؤية الشركات نذكر رؤية إيكيا "خلق حياة يومية أفضل للكثير من الأفراد"، ورؤية أمازون "أن نصبح أكثر شركات الأرض تركيزاً على العميل، بحيث يمكنه أن يجد ويكتشف أي شيء قد يرغب في اقتنائه عبر الإنترنت".
3. غاية الشركة (Purpose Statement)
بيان مختصر يوضح الغاية الأساسية (الغرض) التي أُنشئت من أجلها الشركة، والدافع وراء مزاولة نشاط محدد، وعادة ما تتضمن الأبعاد الرئيسية الآتية:
- السبب وراء الاعتقاد أن الشركة تستطيع إحداث فرق.
- فئة الناس التي تنوي الشركة التأثير فيها.
- كيفية خلق هذا الأثر، أي ملامح الاستراتيجية.
- الواقع الجديد الذي ينتج بعد تحقيق الشركة لأهدافها، وهو عنصر مرتبط برؤية الشركة.
يخضع بيان الغاية لخصائص كتابة رسالة الشركة مثل الوضوح والبساطة والاختصار. ومن أمثلة الغايات المحررة بأسلوب متميز:
شركة ساوث ويست إيرلاينز: "نسعى لإيصال الناس بما هو مهم في حياتهم من خلال رحلات جوية ودودة وموثوقة ومنخفضة التكلفة" (To connect People to what's important in their lives through friendly, reliable, and low-cost air travel). تشبه غاية الشركة إلى حد كبير رسالة الشركة، إذ في كثير من الأحيان يُستعمل أحدهما للتعبير عن الآخر، لكن الاختلاف النظري الموجود هو أن الغاية توضح الغرض (أو الهدف البعيد المدى) الذي أُنشئت من أجله الشركة، في المقابل توضح الرسالة كيفية تحقيق هذا الغرض.
4. الكفاءة الأساسية (Core Competency)
تُسمى أحياناً "القدرة الأساسية"، وهي من المصادر المستدامة للمزايا التنافسية، إذ تتضمن الجمع بين المعرفة والقدرات التكنولوجية التي تتيح للشركة بناء ميزة تنافسية. الكفاءة الرئيسية (أو الأساسية) هي مورد قيّم يمكن أن تحوز عليه الشركة، ويتضمن الأنشطة والعمليات والموارد التي تميّز الشركة عن الشركات الأخرى المنافسة. هناك 3 ميزات رئيسية للكفاءات الأساسية هي:
- يجب أن يوفر النشاط قيمة أو فوائد فائقة للمستهلك.
- لا يمكن تقليد الكفاءة الأساسية بسهولة من المنافسين.
- يجب أن تكون الكفاءة نادرة ولا يمكن إيجادها عند المنافسين.
5. الاستراتيجية التنافسية (Competitive Strategy)
تُسمى أيضاً "استراتيجية الأعمال" (Business Strategy)، وهي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة على مستوى "ميدان نشاط استراتيجي" محدد (Strategic Business Unit. SBU)، وتهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية تمكّنها من مواجهة المنافسة في هذا الميدان المحدد. بصفة عامة، هناك 3 مقاربات رئيسية تُبنى عليها الاستراتيجية التنافسية هي:
- المقاربة الأولى: المقاربة الكلاسيكية، وتتمحور حول التموقع وكيفية مواجهة المنافسة القائمة في ميدان محدد، وتُعتبر أعمال مايكل بورتر من أهم مميّزات هذه المقاربة إذ يقول: "جوهر الاستراتيجية هو خيار تنفيذ الأنشطة بطريقة مميزة عن المنافسين"، وبناءً على هذا التصور، اقترح بورتر 3 استراتيجيات تنافسية.
- المقاربة الثانية: مقاربة الموارد والكفاءات (RBV)، ويُنظر وفقها للشركة على أنها محفظة للموارد والكفاءات المولّدة للميزة التنافسية (عكس المقاربة الكلاسيكية التي تعتبر الشركة محفظة أعمال ومنتجات)، وتُعتبر أعمال الباحث بارني (Barney) في بداية التسعينيات من أهم المساهمات التي أثْرت هذه المقاربة. عادة ما تكون دورة حياة المنتجات وجيزة، أما الموارد والكفاءات، فتتسم بالاستقرار والتطور البطيء، وهو ما يعطي ميزة على المدى البعيد. لذلك تنتج الشركات التي تتبع هذه المقاربة منتجات جديدة باستمرار ما يمكّنها من اختراق أسواق جديدة، ومنتجات شركة هوندا اليابانية خير مثال على ذلك.
- المقاربة الثالثة: مقاربة الانقطاع (Rupture)، وتتمحور حول خلق سوق جديدة تكون فيها المنافسة معدومة أو شبه معدومة، وذلك عن طريق ابتكار طرق جديدة في خلق القيمة تمكّن من استهداف فئات جديدة في السوق غير مستهدفة بعد. من أهم المساهمين في هذه المقاربة هامل وبراهالاد وكتابهما "نافس للمستقبل"، ثم كيم وموبورن وكتابهما الشهير "استراتيجية المحيط الأزرق"، ومن أمثلة الشركات التي تبنّت هذه الاستراتيجية نذكر سيرك دو سولاي الكندي وإيكيا السويدية.
6. الاستراتيجية الكلية (Corporate Strategy)
هي الاستراتيجية التي تتمحور أساساً حول تسيير حافظة أعمال الشركة، إذ تُعنى بتحديد التوجهات العامة للاستثمار، وتطوير وحدات العمل الاستراتيجية الحالية (النشاطات)، أو الخروج من بعض منها، وكذلك كيفية تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخيارات واستغلال الروابط التي تنشأ بين مختلف النشاطات. ترتبط الاستراتيجية الكلية ارتباطاً وثيقاً برسالة الشركة وتوقعات المساهمين. تُصاغ الاستراتيجية الكلية بناءً على الإجابة عن 4 أسئلة رئيسة هي:
- ما هو النشاط الرئيس للشركة؟
- ما هو معدل نمو كل نشاط وربحيته؟
- ما هي الموارد الواجب تخصيصها لكل نشاط؟ وما هو النشاط الذي يحتاج إلى الاستثمار؟ وما هو النشاط الذي يجب التخلي عنه أو بيعه؟
- كيف نستغل الروابط التي تنشأ بين مختلف النشاطات بهدف خلق القيمة للشركة ككل؟
7. استراتيجيات النمو (Growth Strategies)
هي الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات عندما تتخذ قرار التوسع، سواء كان هذا التوسع في مجال نشاطها الحالي، أو عبر مجالات نشاط (أو صناعات) أخرى. يمكن حصر استراتيجيات النمو في 3 أصناف كالآتي:
- النمو الداخلي: هو النمو الذي تعتمد فيه الشركة على مواردها الخاصة، دون اللجوء إلى مساعدات الشركات الأخرى، ومن أدواته توظيف مختصين أو خبراء أو موظفين جدد، والحصول على تمويل بنكي إضافي، والاعتماد على الابتكارات التي يكون مصدرها الشركة نفسها. من إيجابيات هذا النمو عدم الحاجة إلى موارد مالية ضخمة، والحفاظ على ثقافة الشركة وهويتها؛ ومن سلبياته البطء في التنفيذ إذ إنه لا يلائم الفرص التي تظهر لفترة زمنية محددة.
- النمو الخارجي: هو النمو الذي تعتمد فيه الشركة على مصدر خارجي، ويكون هذا المصدر عادة شركة أخرى، سواء كانت تنتمي إلى الصناعة نفسها أو إلى صناعة أخرى، ويُعتمد فيه على عمليات الاندماج والاستحواذ. من إيجابياته أنه لا يتطلب فترة زمنية طويلة؛ ومن سلبياته أنه يتطلب أموالاً معتبرة ويكون محفوفاً بالمخاطر مثل الصدمات الثقافية.
- النمو المختلط: هو النمو الذي يعتمد على مزيج من النمو الداخلي والنمو الخارجي، ويعتمد أساساً على التحالفات الاستراتيجية.
تُعد هذه المفاهيم السبعة أساساً لفهم الاستراتيجية وتطبيقها بفعالية، إذ تساعد الشركات على تحديد رؤيتها ورسالتها، وبناء ميزتها التنافسية، واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.