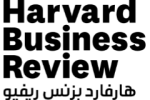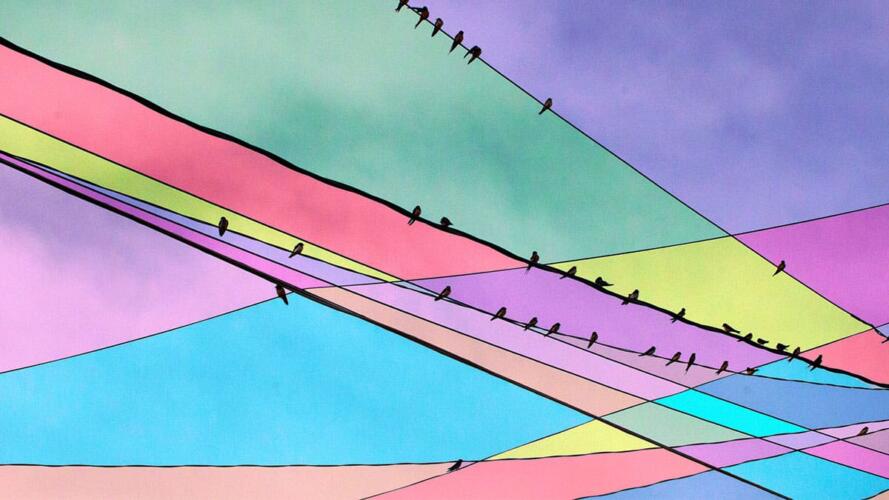
كان من المنطقي أن تُنشئ شركة كبرى متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مركزاً للابتكار في أحد مكاتبها بالولايات المتحدة، يتحلى موظفوه بحس ريادة الأعمال والالتزام والحماسة للعمل، وكانوا نتيجة لذلك يطورون بسرعة أفكاراً جديدة خاصة بمنتجات التعامل مع العملاء. فأرادت الشركة أن تنقل أفضل الممارسات عبر الثقافات وتستنسخ هذا النجاح في أماكن أخرى كالهند والصين. عقد قادة من الولايات المتحدة على مدى أسبوع ورشات مخصصة لتعريف عمال فرعي الشركة في الصين والهند على الممارسات الأميركية المتطورة، المتمثلة في دورات التطوير السريع والتصميم الموجه للمستخدم والتعاون مع الآخرين في مواقع المكاتب المفتوحة. كما زود القادة أيضاً موظفي الفرعين بتعليمات مفصلة عن كيفية تطبيق هذه الممارسات. بل إنهم أرسلوا أحد الموظفين الأميركيين للعمل في فرع الهند لمدة عام.
لكن هذا الجهد لم يحقق النتائج التي كانوا يتوقعونها، وضاعت بعض عناصر هذه التصورات المهمة في عملية النقل.
مثل هؤلاء القادة، الذين يعملون في هذه الشركة، يفترضون غالباً أنه إذا نجحت ممارسة ما في مكان معين، فإنها ستنجح في مكان آخر، ويرغبون في جني فوائد تقاسم ممارسات مشتركة عبر أماكن مختلفة. لكن هذه الممارسات لا تنجح دائماً. ويعرف الكثيرون منا بداهةً أن أفضل الممارسات يتم تطويرها لمكان وزمان معينين، ولا تنتقل بالضرورة جيداً بين الثقافات. إنها شبيهة بالحذاء الذي لا يلائمك دائماً. فقد تنتعل حذاء وقد يبدو جميلاً، لكنه يمكن أن يسبب لك بثوراً إذا لم يكن قياسه مضبوطاً. هذا ما يحدث أيضاً للممارسات التي لا تتلاءم كثيراً مع سياق ثقافي آخر. ولا يعني هذا أن العمال في البلدان الأخرى، مثل الصين والهند المذكورتين في المثال السابق، لا يحسنون صنعاً. فهم ليسوا سبب البثور. ويكشف بحثي بعض النتائج المهمة حول كيفية وسبب الانتقال الناجح أو الفاشل للممارسات من ثقافة إلى أخرى.
فقد شاركت في ثلاث دراسات تظهر سبب فشل بعض الممارسات، وتبين ما يتعين أن يفعله القادة لتجنب هدر المال وإضاعة الوقت وإحباط الموظفين.
أجريت الدراسة الأولى في شركة التكنولوجيا الفائقة المذكورة أعلاه. لقد قمت، رفقة كل من سارة فارلاندر وبوبي توماسون وبراندي بيرس وهيذر ألتمان، بملاحظة ما حدث بعد تقاسم ممارسات الابتكار مع الطرفين الصيني والهندي. وما شاهدناه وما كنت رأيته يحدث في أماكن أخرى هو أنه على الرغم من أن هؤلاء الموظفين كانوا جميعاً جزء من الشركة ذاتها، بل وينجزون نوعية العمل ذاته، فإنه لم يتم تأويل الممارسات أو تطبيقها بالطريقة نفسها عبر السياقات الثقافية المختلفة.
لقد فهم موظفو الشركة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أن مبدأ دورات التطوير الأقصر شبيه بثقافة شركة ناشئة يتمتع فيها الموظفون باستقلالية أكبر وبمجال للتجربة. ولهذا رحب هؤلاء الموظفون بالفرصة لزيادة حظوظهم ورأوا الفشل تطويراً للتعلم والابتكار. أما في الصين فقد ساوى الموظفون بين السرعة والكفاءة. وأخبرونا أن جدول المواعيد المكثف زاد من تركيزهم، ودفعهم ليكونوا أكثر إدراكاً للوظائف التي يضيفونها للمنتج. أما في الهند فقد كان للموظفين تأويل آخر. لقد نظروا إلى الدورات الأقصر كطريقة لملاءمة عملياتهم ومهاراتهم مع مع مهارات مطوري البرمجيات في العالم، الذين يؤمن هؤلاء الموظفون الهنود بأنهم ينتقلون بدورهم إلى دورات أكثر سرعة، كما أثنوا على هذا الانتقال كوسيلة للدفع نحو المزيد من الارتباط بالعملاء مبكراً في عملية الإنتاج.
لم يكن أي من التأويلين خاطئاً بالطبع، لكن نتج عنهما تطبيقان متباينان. فعلى سبيل المثال قادت عملية تصنيع عدسات الكفاءة في الصين إلى تبني ممارسة لا تنسجم مع أهداف مركز الابتكار التي تنص على الرشاقة والتكرار. لقد قبلوا أجل 90 يوماً، ووضعوا جداول مواعيد مكثفة، وقللوا الوظائف، وحثوا أنفسهم على العمل بمزيد من الفعالية. ولذلك، فعلى الرغم من تطبيق دورات التطوير السريعة كما تم تحديدها، فإنها لم تحدث أثراً ملحوظاً في الابتكار.
وحدث أمر مماثل مع مبدأ التصميم الموجه للمستخدِم. كان يُنظر في الولايات المتحدة إلى هذه الممارسة كامتداد لثقافة الإنتاج الموجه للعملاء، وهي التي ينخرط فيها العملاء أكثر في عمليات التطوير. لكن في الصين كان يُنظر إلى الحديث مع العملاء كإلزام للطرفين، أي مطورو البرمجيات والعملاء، الذين اعتُبروا غير مهتمين ولا علاقة لهم بتحديد متطلبات المنتج. وبالنظر إلى تركيز فرع الصين تاريخياً على تطوير البرمجيات الفائقة، فقد اعتُبر دمج مدخلات منتظمة من العملاء مخالفاً للممارسة الهندسية الجيدة، ولذلك لم يتبنى مطورو البرمجيات هذا النهج. وبالمقابل رحب مطورو البرمجيات في الهند بمبدأ التصميم الموجه للمستخدم كامتداد لممارساتهم القائمة على إشراك شبكاتهم المجتمعية والشخصية في دمج المدخلات خلال عمليات التطوير.
أما العنصر الثالث الذي جاء به مركز الابتكار فهو الحيز المكتبي المفتوح. لقد آمن المدراء في الولايات المتحدة أن فضاءات العمل المفتوحة والمرنة عززت التعاون مع الآخرين والابتكار، وتم إنشاء المركز على بعد مسافة من المقر الرئيس وهو ما اعتبره الموظفون الأميركيون أمراً محرراً. كان تصميم الحيز المكتبي المفتوح غير معتاد إلى حد ما في الصين، وكان مطورو البرمجيات هناك مرتبكين لأنه يُنتظر منهم أن يكونوا أكثر تعاوناً. فواصلوا بدلاً من ذلك اتباع أعراف العمل الخاصة بهم باطمئنان في مكاتبهم، مع تفاعل محدود إلا في فترة الاجتماعات وفي أثناء الغذاء. كما اعتبروا الانفصال عن المقر الرئيس نوعاً من العزل. ولذلك قضى العديد من الموظفين القسط الأكبر من أوقاتهم في الرجوع إلى المقر الرئيسي حيث شعروا بأنهم جزء من المشروع. وفي النهاية أغلق هذا المركز ليتمكن الموظفون من العودة إلى المقر الرئيس.
ولم يكن الموظفون في فرع الهند بدورهم مؤيدين للانفصال عن المقر الرئيس، وأحسوا بالقلق من فقدان ارتباطهم بالمكونات الأخرى للمؤسسة. كما لاحظنا أيضاً أن الموظفين الهنود كانوا غير مرتاحين في الفضاءات الواسعة المفتوحة، وعدَلوا عن استخدام قاعات الاجتماعات كفضاءات للمشاريع التي يتعاونون فيها بشكل مكثف. وكان الموظفون الهنود قادرين على تنفيذ جوهر تعليمات الفضاء المفتوح، على الرغم من أن ذلك لم يكن مخططاً له من طرف الشركة. لكن هذا التباين في التطبيق اعتُبر فشلاً في نظر القيادة الأميركية.
قد يبدو للوهلة الأولى أن مطوري البرمجيات في الصين يقاومون هذه الممارسات. لكن العكس هو الصحيح، فقد كانوا متحمسين ومتحفزين جداً، لكنهم بمجرد أن عملوا على إدماج هذه الممارسات في أنشطتهم المحلية واجهوا عوائق ولم يجدوا توجيهاً لتجاوزها. وعلى عكس فرع الهند، فإن مطوري البرمجيات في الصين لم تكن لهم أي صلة تساعدهم في عملية التكيف، فضاعت هذه الممارسات في عملية النقل.
بينما تنتقل الكثير من الممارسات دون أي تغيير، يتطلب بعضها نوعاً من التكييف. وتتعرض الممارسات، في غياب التكييف، إما إلى الرفض، وإما إلى تبنيها بشكل رسمي فقط، وهما أمران لا يحققان الفوائد المرجوة. فعندما فهم الموظفون الغرض من هذه الممارسات، حسب هذه الدراسة، وأعطيت لهم الحرية والدعم لتأويلها وتكييفها حسب سياقهم الثقافي الخاص، فإنهم كانوا أكثر قرباً من تنفيذ روحها.
وفي دراسة مشابهة حاورتُ وراقبتُ، أنا وكاترين كرامتون، أعضاء تسع فرق مختصة في تطوير البرمجيات، تمثل كل واحدة منها فرعين إما من الولايات المتحدة والهند، أو من الولايات المتحدة وألمانيا، أو من ألمانيا والهند. ولاحظنا في هذه المجموعات أن ممارسات الإدارة التي نجحت في ألمانيا والولايات المتحدة لم تنجح في الهند. فعلى سبيل المثال خلقت عمليات التقييم والمكافآت، التي تحفز مطوري البرمجيات في الولايات المتحدة وألمانيا، استياء في الهند، بل وأدت بالموظفين إلى البحث عن وظائف بديلة. ففي ألمانيا والولايات المتحدة مثلاً حظي الموظفون بحد أدنى من الإشراف الإداري، وأعجبتهم مسألة الاستقلالية. بينما كان مطورو البرمجيات في الهند أصغر سناً، ومتعطشين للمزيد من التواصل والتفاعل مع آراء المدراء. وفي بعض الحالات غادر هؤلاء إلى شركات أخرى لأن مدراءها يتميزون بنشاط إشراف أكبر.
وقوبلت التراتبية المسطحة الشائعة في ألمانيا والولايات المتحدة بخيبة أمل في الهند، حيث أتاحت التراتبية الحادة مزيدا من الفرص للتقدم السريع. وتطلّع الموظفون في الهند إلى الترقيات المنتظمة، كمؤشر ملموس على تقدم مسارهم المهني. وتكيف فرع الهند من خلال تناوب مطوري البرمجيات على مناصب قيادة أو تنسيق المشاريع، مما خلق الشعور بالمسؤولية ومؤشرات تقدم المسار المهني التي كان يبحث عنها هؤلاء. وساعدت هذه الممارسات على التخفيف من شعور الاستياء.
وفي دراسة ثالثة، قمنا أنا وستيف بارلي وزكريا رودجرز، باختبار استعمال تكنولوجيات التعاون بين الموظفين في فروع إحدى الشركات في اليابان والمكسيك والولايات المتحدة. وكما توقعنا، فقد لاحظنا اختلافات في كيفية توظيف الموظفين لتقنيات التعاون على الرغم من أنهم يعملون جميعاً لصالح الشركة نفسها، ويقومون بالنوعية نفسها من العمل، ويتوفرون على الأنظمة ذاتها. فوجدنا في المكسيك مثلاً أن تنقل الموظفين إلى مقرات العمل كان متوقعاً بشكل أقل، ولذا كان العمل من المنزل أكثر شيوعاً. ونتيجة لذلك تم تبني التقنيات التي تدعم الاتصال عن بعد بحماس أكبر مما تم في اليابان، حيث تفرض التقاليد أن يتم العمل داخل المكتب. كما لاحظنا أيضاً اختلافات في اختيارات تقنيات التعاون. على سبيل المثال تم استعمال شبكة “جابر” (Jabber) بكثافة في المكسيك والولايات المتحدة أكثر من اليابان، وعندما استُعملت في اليابان فقد تم ذلك بطريقة شكلية، بتوظيف عبارات التحية الرسمية مثلاً. واعتمد الموظفون في اليابان أكثر على أنظمة الحضور عن بعد، بينما كان موظفو المكسيك والولايات المتحدة يميلون أكثر إلى استخدام الحلول المكتبية السمعية أو السمعية البصرية للاجتماعات مع متعاونين وعملاء بعيدين.
كما كنت قد لاحظت في أماكن أخرى اختلافات في كيفية اعتماد تقنيات التعاون مع الآخرين مثل أنظمة إدارة المعرفة. هذه الأنظمة موجهة لتشجيع الموظفين على تقاسم معرفتهم وخبرتهم مع الآخرين. وتمثل في الثقافة الغربية في كثير من الأحيان أنظمةَ تحفيز تكافئ الموظفين ب”علامات” وجوائز. وتفترض هذه الأنظمة ضمنياً أن الأفراد العاملين ربما يتحكمون في معرفتهم. وفي الثقافات الجماعية والهرمية أكثر، قد لا يعتبر الأفراد أنفسهم متمتعين بسلطة تقاسم المعرفة. وبدلاً من ذلك يمارس الفريق أو المدير هذا الحق في تقاسم المعرفة. وبناء على ذلك، فإننا نميل إلى رؤية انخفاض ملحوظ في استعمال أنظمة إدارة المعرفة كلما انتقلت من الغرب إلى الشرق.
فما الذي يمكن فعله إذا كان نقل أفضل الممارسات عبر الحدود الثقافية صعباً، وأحياناً لا ينجح؟ إليكم بعض الإجراءات التي لاحظت أنها نجحت في بعض المؤسسات التي درسناها.
ركز على الغاية من الممارسة، وليس على السلوكات في حد ذاتها
عندما يركز القادة على الأهداف ويستهدفون نتائج الممارسات، فإن ذلك يخلق مجالاً أمام الموظفين لتكييف الممارسة مع السياق الثقافي بموازاة مع تحقيق الغاية الأساسية. وهذا ما حدث عندما استخدم مركز الابتكار في الهند غرف المشاريع في المكاتب المفتوحة. كان الموظفون يتعاونون فيما بينهم، وإن لم يكن ذلك بالطريقة التي خطط لها قادة الولايات المتحدة. وعندما يشجع القادة بنشاط عملية التكيف فإنهم يتيحون للموظفين تحقيق الهدف بالطريقة المثلى للشركة. ويتطلب هذا طبعاً من القادة أن يكونوا جد واضحين بخصوص الغاية من الممارسات الجديدة، وطرح الأسئلة حول ما يمكنه أن ينجح في مكان معين بدلاً من تقديم تعليمات التطبيق المفصلة. وقد يكون من الصعب طبعاً تمييز الحالات التي يتم فيها رفض الممارسات بسبب عدم تلاؤمها مع السياق الثقافي عن الحالات التي يقاوم فيها الموظفون عملية التغيير. ويمكن للروابط أن تساعد في هذا الأمر.
وجود رابط ثقافي يساعد في نقل الممارسات
إنه أحد الأشخاص الذين فهموا جيداً الممارسة، ويمكن أن يعمل على التأكد من تكييفها بطريقة تحافظ على روحها الأصيلة. هذا الشخص له خبرة في تلقي السياق الثقافي، ومن ثمة يعرف جوانب الممارسة التي قد لا تكون مناسبة. وقد لاحظنا أن عملية التكييف بمساعدة الروابط تنحو إلى أن تكون تكرارية، حيث قد يحاول الفرع المستقبل للممارسات الجديدة اختبارها، والتعرف على طرق التطبيق التي تجعلها غير ملائمة، ثم تجربة الممارسات التي تتناسب جيداً مع السياق الثقافي مع الحفاظ أيضاً على الغاية من الممارسة.
اجتهد لملاءمة الممارسة وليس لاستنساخها
عندما تكون فرق العمل موزعة عبرالعالم لكنها تتعاون عن قرب، متيحة لكل فرع تكييف الممارسة مع سياقه الثقافي الخاص فإن ذلك يمكن أن يخلق الارتباك ويضعف التنسيق. ففي الحالة الموضحة أعلاه مثلاً، التي قامت فيها الشركة بتدوير مناصب قيادة المشاريع وتنسيقها في الهند لتحسيس مطوري البرمجيات بالتقدم في مسارهم المهني، حدث تضارب في الأدوار عبر مختلف مقرات الشركة. كما اشتكى الموظفون في فروع أخرى من أنهم لا يعرفون إلى من سيلجؤون، مشيرين أيضاً إلى جهلهم لمستوى الخبرة الذي يجب أن يمتلكه صاحب منصب معين. وعندما يكون التعاون دولياً فإن حدوث بعض الاختلافات عبر الفروع أمر لا مفر منها. ويتمثل التحدي القائم هنا في إيجاد ممارسات ملائمة لكل السياقات الثقافية. ويمكن أن يساعد التجريب -والمرونة- في تحديد الممارسات التي تنجح في مختلف المواقع.
دعم التجريب
يتطلب الأمر في الغالب عدة محاولات لإيجاد تكييف يناسب السياق الثقافي ويحقق الغاية الأصلية للممارسة. وفيما يتعلق على سبيل المثال بحالة الموظفين الهنود المنشغلين بتقدم مسارهم المهني، كررت الشركة محاولات التكييف عدة مرات للتوصل إلى الممارسات التي نجحت بالنسبة لكل من الموظفين الهنود والشركة بأكملها. ويعتبر التقبل والاستعداد للتكيف في كلا الفرعين أمراً أساسياً لنجاح العملية.
ويلعب القادة دوراً حيوياً في ابتكار الحلول البديلة، وهو ما أسميه أنا وكاترين كرامتون “الوقوف في الفجوة”، أي امتصاص الضغوطات وتصفيتها بصفة شخصية خلال عملية التكيف. تجعل الممارسات المشتركة التعاون العالمي سهلاً جداً. ويمكنها أن تكون مصدراً للمزايا التنافسية. لكن بحثنا يظهر أن القادة الحكماء يركزون على الغاية من الممارسة، وليس على خصائصها، ويشجعون التكيف والتجريب لضمان تحقيق الممارسة للفوائد المرجوة. ومن المرجح أن تجد الشركات، التي تنجز ذلك كما يجب، موظفيها أكثر فعالية وسعادة في العمل. وختاماً فإن منح الموظفين المجال للتجريب بهذه الطريقة، يسمح لهم بالتوصل إلى ابتكارات جديدة يمكن تقاسمها في أماكن أخرى.
تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .