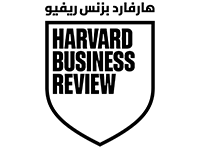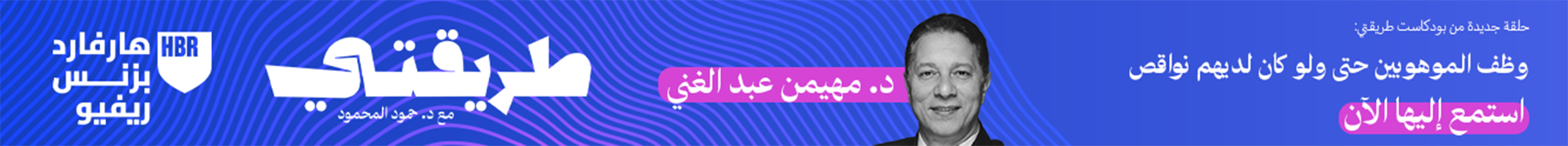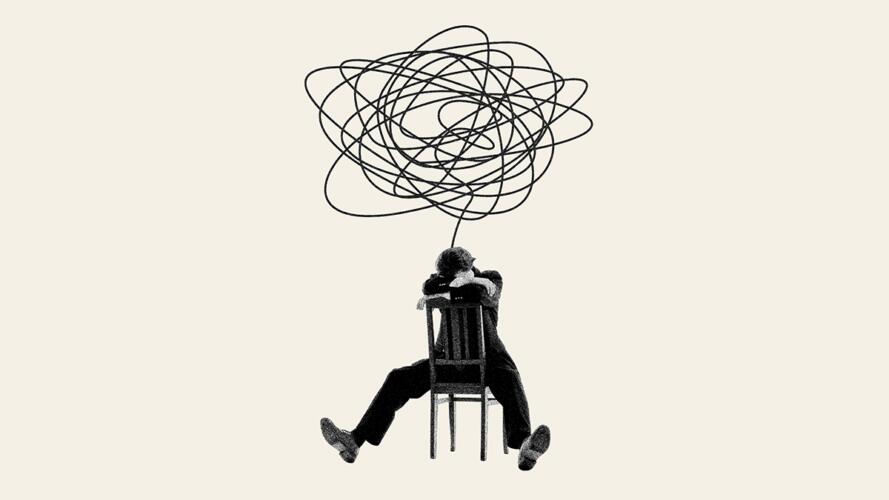ظلت الشركات طيلة عقود من الزمن تتعامل مع التوتر في مكان العمل بوصفه شأناً فردياً يتولاه قسم الموارد البشرية، غالباً من خلال برامج الرفاهية أو ورش العمل المخصصة لإدارة التوتر، بدلاً من النظر إليه باعتباره خطراً ممنهجاً يمس جوهر الأعمال ويستدعي إشرافاً مباشراً من القيادة التنفيذية. ولا تزال نتائج هذا التصور القديم تظهر حتى الآن، لا بسبب غياب الوعي، بل لأن شركات كثيرة ما زالت تعتبر التوتر مسألة ثانوية خارجة عن صلب استراتيجياتها.
أثبتت دراسة استقصائية أجرتها شركة ديلويت أن 94% من أصحاب المناصب التنفيذية العليا يتفقون على أهمية التحلي بصفات القيادة الواعية بالجوانب الصحية. ومع ذلك، اعترف 68% منهم بأنهم لا يتخذون الإجراءات الكافية لحماية صحة الموظفين وأصحاب المصلحة، ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الوعي بالمشكلة وتطبيق الحلول. وفي الوقت نفسه، أثبتت بيانات شركة آفلاك الأميركية أن 54% من الموظفين في عام 2024 شعروا بأن الشركة التي يعملون بها تهتم بصحتهم النفسية، مقارنة بنسبة 48% في عام 2023. لكن 38% من الموظفين أفادوا بارتفاع مستويات التوتر في العمل، مقارنة بنسبة 33% في عام 2023، ما يشير إلى أن الاستثمارات الحالية لا تعالج احتياجات الموظفين المتعلقة بالتوتر على نحو فعال.
لماذا لا تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها؟ نرى أن أحد الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات التوتر، على الرغم من الاستثمارات المبذولة، يكمن في محدودية قدرة الشركات على قياس المشكلة وتحويلها إلى مؤشرات كمية واضحة. ومثلما تبذل الشركات جهداً منظماً لقياس المخاطر المالية والتشغيلية والمرتبطة بالسمعة، نرى أن عليها أيضاً قياس التوتر وإدارته بوصفه خطراً يمس جوهر أعمالها.
نقدم هنا "مقياس مخاطر التوتر"، وهو إطار عمل جديد يساعد المؤسسات على تقييم المخاطر التجارية الناتجة عن التوتر وتتبعها، كما نعرض استراتيجيات عملية لتعزيز القدرة على الصمود من خلال القياس المنهجي والتحمل الجماعي للمسؤولية بين الفرق المتعددة التخصصات والمبادرات التطويرية الموجهة.
كلفة التوتر على أداء المؤسسات
في دراستنا الأخيرة التي شملت 1,005 موظفين بدوام كامل في قطاعات تتصف بارتفاع حدة الضغوط الوظيفية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وجدنا أن ارتفاع مستويات التوتر يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بنحو 5.3 مليون دولار سنوياً لكل 1,000 موظف في الشركة الواحدة. وكشفت نتائج تحليلاتنا أيضاً أن كلفة التوتر على الشركات تتجلى في 3 محاور أساسية: ضبط التكاليف وتخفيف المخاطر والحفاظ على الأداء المستدام.
ضبط التكاليف
تشير بياناتنا إلى أن الموظفين الذين يعانون ارتفاع مستويات التوتر يتقدمون بمطالبات تأمين صحي أكثر من نظرائهم الذين ينعمون بانخفاض مستويات التوتر بمقدار 2.5 مرة، ما يشكل عبئاً مالياً مباشراً على الشركات التي تدفع تكلفة هذه المطالبات من ميزانيتها مباشرة، دون الاستعانة بطرف ثالث. وقد أشار تقرير "مخاطر الأفراد 2024" الصادر عن شركة ميرسر إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين الصحي يمثل الخطر التجاري الأول على مستوى العالم، ما يعزز الحاجة الملحة لمعالجة هذه التكلفة المتصاعدة؛ فمن عام 2020 حتى عام 2024، ارتفعت أقساط التأمين لكل موظف في الولايات المتحدة بنسبة 28%، بمتوسط زيادة سنوية قدره 6.5%.
تخفيف المخاطر
بالإضافة إلى ذلك، أفاد 12% من الموظفين المشاركين في دراستنا بأنهم ارتكبوا أخطاء أو تأخروا عن المواعيد النهائية أو خالفوا الإجراءات النظامية على نحو قد يعرض المؤسسة لمخاطر الإخلال بالامتثال التنظيمي، وكان احتمال وقوع هذه السلوكيات أعلى بمقدار 11 مرة لدى الموظفين الذين يعانون ارتفاع مستويات التوتر. وقد تكون العقوبات المالية الناجمة عن عدم الامتثال بالغة الضرر، لكن الخسارة الحقيقية تكمن في فقدان ثقة أصحاب المصلحة والضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركة نتيجة الإخفاقات المرتبطة بالتوتر.
الحفاظ على الأداء المستدام
أثبتت بياناتنا أن التوتر المزمن يستنزف إنتاجية القوى العاملة؛ فالموظف الذي يعاني ارتفاع مستويات التوتر يأخذ إجازات مرضية أكثر من نظرائه منخفضي التوتر بمقدار 8 مرات، ويتراجع مستوى تفاعله الوظيفي بمعدل يفوقهم بمقدار 4 مرات. وعند احتساب الكلفة الإجمالية للتغيب عن العمل والحضور غير المثمر (أي الحضور الجسدي دون فعالية) ومعدلات الدوران الوظيفي، نجد أن كل موظف يعاني ارتفاع مستويات التوتر يتسبب بخسارة سنوية في الإنتاجية بنحو 12,000 دولار، في المتوسط، وهو عبء خفي لكن أثره ملموس على ربحية المؤسسة.
يشكل دوران الموظفين المرتبط بالتوتر الجانب الأكبر من التكاليف، بنحو 3.5 مليون دولار سنوياً، وذلك بناء على فرضية مفادها أن ثلث الموظفين الذين ينوون الاستقالة ينفذون قرارهم خلال عام واحد، وأن كلفة الدوران الوظيفي لاستبدال موظف واحد تعادل راتبه السنوي كاملاً على الأقل. وتقدر كلفة الحضور غير المثمر بنحو مليون دولار سنوياً، استناداً إلى معيار شركة غالوب الذي يقدر أن خسارة الإنتاجية الناجمة عن ضعف التفاعل الوظيفي تعادل 18% من الراتب. وأخيراً، تقدر كلفة التغيب عن العمل المرتبط بالتوتر بنحو 778,000 دولار سنوياً، نتيجة الإجازات المرضية الإضافية التي يأخذها الموظفون الذين يعانون ارتفاع مستويات التوتر، وعددها 6 أيام، إذا احتسبنا أن سنة العمل تتألف من 260 يوماً.
أداة لتحديد حجم المخاطر الناجمة عن التوتر وتخفيف حدتها
تتمثل الخطوة الأولى، وربما الأهم، في إدارة مخاطر التوتر في القدرة على قياس التوتر بدقة داخل مؤسستك نفسها؛ إذ يخبرنا قادة كثيرون بأنهم ينظرون إلى التوتر على أنه أمر شخصي أو ذاتي يصعب قياسه كمياً. وغالباً ما تكتفي الأدوات التقليدية، مثل الدراسات الاستقصائية حول مستويات تفاعل الموظفين أو الاستطلاعات الدورية القصيرة، برصد لمحات سريعة من المشاعر السائدة، ونادراً ما تربط التوتر بالنتائج التي تهم المسؤولين التنفيذيين في المقام الأول، مثل الإنتاجية وضبط التكاليف والتعرض للمخاطر.
يقدم مقياس مخاطر التوتر الذي طورناه منهجية مختلفة. وقد ظهر هذا المقياس بوصفه أداة تحليلية ضمن إطار دراستنا البحثية، وهو يوفر تقييماً منظماً ومتدرجاً لمستويات التوتر بين الموظفين، ما يتيح للقادة قياس فعالية مبادراتهم التطويرية بدقة؛ فعندما تشير البيانات إلى أن شريحة كبيرة من الموظفين دخلت مناطق التوتر المرتفع المرتبطة بمخاطر ملموسة، يتيح هذا التقييم إطلاق استراتيجيات دقيقة وموجهة لمعالجة جذور التوتر قبل أن تتحول إلى أزمات.
كيفية البدء
يمكن للشركات أن تبدأ بتقييم مخاطر التوتر داخلياً من خلال طرح سؤال بسيط على الموظف، مثل: "كم مرة تشعر بالتوتر أو القلق أو الإرهاق في أثناء العمل؟" وذلك مرة كل 6 أشهر إلى 12 شهراً، مع مطالبة الموظف باختيار إحدى الإجابات التالية: "أبداً" أو "نادراً" أو "أحياناً" أو "كثيراً" أو "دائماً". تتيح هذه البيانات للقادة تصنيف الموظفين إلى 3 مجموعات حسب مستوى التوتر: منخفض ومتوسط ومرتفع. وينبغي التعامل مع هذه البيانات وفق أعلى معايير الخصوصية، وهو ما سنتناوله لاحقاً بمزيد من التفصيل.
- منطقة التوتر المنخفض: يتميز الموظفون في هذه الفئة بانخفاض مستويات التوتر وتدني معدلات المخاطر. يختار هؤلاء الموظفون إجابات مثل "نادراً" أو "أبداً" عند سؤالهم عن شعورهم بالتوتر. ويعملون في بيئة مستقرة تسمح لهم بالحفاظ على أداء مستدام مع تعرض تشغيلـي محدود للمخاطر. وتشير نتائج أبحاثنا إلى أن هذه المجموعة تسجل معدلات أقل من الإجازات المرضية ومطالبات التأمين الصحي وتظهر قدرة أكبر على التعاون مع الزملاء. وتتمتع المؤسسات التي تضم نسبة مرتفعة من هذه الفئة بفرق أكثر قدرة على التركيز والتحلي بالمرونة والتفاعل. وفي أبحاثنا، شكل أفراد هذه الفئة 14% من مجموع الموظفين الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية (قد تختلف هذه النسبة من شركة لأخرى، لكننا نقدمها باعتبارها نقطة مرجعية أولية لتوزيع مستويات التوتر في المؤسسات).
- منطقة التوتر المتوسط: يرتفع التوتر بين أفراد هذه الفئة من حين لآخر، لكنه لا يصل إلى مستويات حرجة. وترتفع بها المخاطر، لكنها تظل قابلة للإدارة. يشير الموظفون في هذه المجموعة إلى شعورهم بالتوتر "أحياناً". وعلى الرغم من أنهم يظهرون غالباً بمظهر الموظفين المنتجين، فإن استمرار التوتر المعتدل دون فترات استشفاء كافية يمكن أن يضعف تركيزهم ويقوض قدرتهم على الإبداع ويبدد فرص العمل الجماعي. وقد تتحول هذه الفئة بمرور الوقت إلى مصدر خفي لمخاطر الأداء التي تتجلى في تزايد احتمالات الانفصال النفسي عن العمل وتوتر العلاقات وظهور متاعب صحية. وتشير بياناتنا إلى أن هذه المجموعة تشكل نحو 41% من القوى العاملة.
- منطقة التوتر المرتفع: يتسم التوتر في هذه الفئة بالاستمرارية أو بالحدة الكافية لجعل تأثيره مزمناً على الموظفين، ما يزيد احتمالات وقوع المخاطر. يشير الموظفون في هذه المجموعة إلى شعورهم بالتوتر "كثيراً" أو "دائماً". وتمثل هذه المجموعة منطقة أزمة تتراكم فيها التكاليف وتزداد فيها مواطن الضعف التشغيلية؛ إذ يأخذ الموظفون في هذه الفئة إجازات مرضية بمعدل يزيد 8 مرات على نظرائهم منخفضي التوتر، وتزيد احتمالات تفكيرهم في مغادرة العمل بمقدار 3.7 مرات، كما تزيد احتمالات انفصالهم النفسي عن العمل بمقدار 4 مرات، وغالباً ما يرتكبون أخطاء تتعلق بالامتثال التنظيمي بمعدل يفوق نظراءهم 11 مرة، ويقدمون عدداً أكبر من مطالبات التأمين الصحي بمقدار 2.5 مرات، ويبلغون عن وقوع عدد أكبر من النزاعات الشخصية مع زملائهم بمقدار 7 مرات. وتشير بياناتنا إلى أن هذه الفئة تشمل نحو 45% من إجمالي الموظفين.
بعد أن تتعرف الشركة إلى توزيع مستويات التوتر داخل قوتها العاملة، يمكنها تحليل مدى ارتباط هذه المناطق بالمؤشرات التشغيلية التي تتابعها فعلياً، مثل الإيرادات وحالات عدم الامتثال ورضا العملاء. ويتطلب هذا مقارنة الأنماط لمعرفة إذا ما كانت ثمة أقسام معينة تجمع بين ارتفاع مستويات التوتر وزيادة الأخطاء أو تراجع تقييمات العملاء، مقارنة بالأقسام أو الفرق التي تشهد مستويات توتر أقل. يهدف هذا التحليل إلى تحديد إذا ما كان التوتر المرتفع يتركز في قطاعات ترتبط بنتائج تجارية محورية وإذا ما كان هذا التوتر المرتفع يقترن بزيادة في المخاطر أو تراجع في مستوى الأداء.
أخيراً، كي تستفيد الشركات من هذه الرؤى عملياً، يمكنها تحديد العوامل الأساسية التي تمثل مؤشراً على التوتر. ويمكن تقييم هذه العوامل من خلال طرح أسئلة على الموظف، مثل: "إلى أي مدى تبدو أعباء العمل والمواعيد النهائية قابلة للإدارة؟" أو "هل تشعر بالأمان النفسي عند التعبير عن المخاوف أو طلب المساعدة؟" تسهم هذه الرؤى الإضافية في تمكين المؤسسات من تصميم مبادرات تطويرية هيكلية موجهة لمعالجة العوامل الحاسمة التي تنبئ بمخاطر التوتر في بيئة العمل.
على سبيل المثال، استخدم أحد عملائنا من الشركات المتعددة الجنسيات إطار "مقياس مخاطر التوتر" لقياس العلاقة بين مستويات التوتر والقدرة على الصمود في مختلف جوانب المؤسسة، بعد تقسيم النتائج حسب الأقسام والمناطق الجغرافية. وبعد تنفيذ الدراسة الاستقصائية الأولى لقياس مستويات التوتر، أجروا لاحقاً دراسة استقصائية تضمنت أسئلة مثل: "ما مدى ثقتك بقدرتك على إدارة التوتر بفعالية؟"، وذلك لتقييم مستوى مرونة الموظفين في مواجهة التوتر.
يساعد تحليل القدرة على الصمود في الكشف عن قدرة الموظف على التعافي والاستمرار في الأداء تحت الضغط، ما يوفر مؤشراً استشرافياً للمخاطر وجاهزية المؤسسة، لا سيما في الأدوار القيادية. وقد اكتشفت الشركة أن المدراء يواجهون مستويات أعلى من التوتر المدرك مقارنة بغيرهم، لكنهم في الوقت ذاته أظهروا مستويات أعلى من الصمود، ما يسلط الضوء على أهمية تزويد القادة المستقبليين بمهارات التعامل مع التوتر والقدرة على الصمود.
كشفت الدراسة الاستقصائية أيضاً عن مناطق خطر على مستوى الشركة بأكملها، مثل الجلوس فترات طويلة وتراجع الإنتاجية وانخفاض الثقة في القدرة على التعامل مع التوتر. وقد استعرض الفريق القيادي هذه النتائج خلال اجتماعاته وأسفرت عن مبادرات تطويرية استراتيجية شملت تخصيص فترات راحة محددة لتشجيع الموظفين على الحركة وتدشين حملة لتشجيعهم على ممارسة العادات الصحية. حققت هذه المبادرات معدلات تفاعل أعلى بكثير مقارنة بمحاولات سابقة لتعزيز الرفاه؛ إذ تبين أن 54% من المبادرات ساعدت على تقليل التوتر فوراً.
استناداً إلى هذه الرؤى، شاركنا في تصميم برنامج لترسيخ العادات السلوكية، مع مراعاة تصميمه بحيث يتناسب مع احتياجات كل منطقة وكل قسم. ولتشجيع المشاركة المنتظمة، أنشأنا لوحة مركزية للتصنيف تحتفي بكل مرة يختار فيها أحد الموظفين الحضور والمشاركة في هذه البرامج المخصصة لتخفيف التوتر.
دمج التوتر رسمياً ضمن إدارة المخاطر
لإدارة التوتر على نحو فعال بوصفه التزاماً مؤسسياً ملموساً، لا بد من إشراك الأطراف المعنية جميعاً في تحمل المسؤولية؛ فدمج التوتر ضمن أطر إدارة المخاطر الرسمية يضمن إجراء تقييمات دورية وإعداد تقارير منتظمة وطرح المسألة للنقاش على مستوى القيادة ومجالس الإدارة. ونؤكد من واقع خبرتنا أن أكثر المؤسسات فعالية هي التي توحد جهود القيادات من أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية وإدارة المخاطر لتقاسم مسؤولية الحد من مخاطر التوتر، ما يسهم في كسر الحواجز التقليدية بين الفرق وحماية القوى العاملة وتمكينها وتحفيزها.
حين تلتقي الخبرة البشرية التي يقدمها قسم الموارد البشرية مع أدوات التحليل المنهجي، تستطيع المؤسسات تطوير أساليب متقدمة لرصد المؤشرات المبكرة، مثل أنماط التغيب عن العمل وتذبذب مستوى الأداء، وغيرها من المؤشرات المبكرة على تراجع التفاعل الوظيفي. ويؤدي إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون إلى إدراج التوتر ضمن جدول مراجعات المخاطر التي تناقشها القيادة، إلى جانب المخاطر المالية والتشغيلية.
على سبيل المثال، عملت إحدى شركات المحاماة التجارية العالمية على دمج قضايا الصحة النفسية والتوتر ضمن إطارها العام لإدارة المخاطر، بما يتماشى مع توصيات المعيار الدولي آيزو 45003 المعني بالصحة النفسية المهنية وإدارة الاحتراق الوظيفي في أماكن العمل، وذلك لمعالجة المخاطر النفسية والاجتماعية الناجمة عن ضعف الصحة النفسية. وقد طورت الشركة مؤشرات استباقية وتتبعية بالاستعانة ببيانات من شركات التأمين والوساطة، وربطت هذه المؤشرات بمقاييس الأداء والتكلفة. أتاح لها هذا الربط إظهار العائد على الاستثمار في مبادراتها التطويرية الحالية المتعلقة بالرفاه الوظيفي. وأسهم هذا النهج في اتخاذ إجراءات أدق تستند إلى الأدلة وعزز مفهوم الأمان النفسي وأرسى أسس حجج مؤسسية متكاملة تعزز استمرارية الاستثمار في الصحة النفسية.
ملاحظة بشأن الخصوصية: نؤمن بضرورة جمع بيانات التوتر دائماً دون الكشف عن الهوية، إلى جانب عرض نتائجها مجتمعة، أي على مستوى الفريق أو القسم، مثلاً، لا على المستوى الفردي. وينبغي أن تتسم أي جهود للقياس بالشفافية الكاملة، مع إبلاغ الموظفين بوضوح بالوضع الراهن وكيفية استخدام البيانات والفائدة التي ستعود عليهم من ذلك.
والأهم من ذلك، نؤمن بأن هذا العمل يجب أن يركز على إحداث التغيير على مستوى النظام، لا على إلقاء اللوم على الأفراد؛ فالغرض من أداة مثل "مقياس مخاطر التوتر" لا يتمثل في مراقبة الموظفين، بل في تمكين القادة من رؤية الجوانب التي تحتاج إلى تغييرات هيكلية، بحيث يمكن معالجة الأسباب الجذرية للتوتر بطرق تحسن الصحة والأداء في آن واحد.
لم يعد بوسع المؤسسات أن تكتفي برد الفعل على الأحداث عند وقوعها؛ بل بات من الضروري أن تعمل على بناء القدرة على الصمود وترسيخها بوصفها قدرة طويلة الأجل، وذلك من خلال دعم الأفراد وتصميم بنية تنظيمية تساند هذه القدرة.
القدرة على الصمود ليست برنامجاً منفصلاً، بل هي منظومة مدمجة في أسلوب القيادة والتشغيل والنمو داخل المؤسسات. ويتطلب بناؤها التزاماً مشتركاً؛ فالموظف بحاجة إلى دعم يساعده على اكتساب عادات صحية مستدامة، في حين يجب على المؤسسات أن تتحمل مسؤولية تشكيل بيئات تقلل التوتر وتضمن الأمان النفسي للجميع.
نؤمن بأن على المؤسسات استخدام البيانات المتعلقة بالتوتر الوظيفي بانتظام لإعادة تقييم السياسات والممارسات والأعراف الثقافية، إذا كانت ترغب في منع تحول التوتر إلى مشكلة مزمنة ومكلفة. وبدمج القدرة على الصمود في النسيج المؤسسي، يستطيع القادة، برأينا، أن يقللوا احتمالات الاضطراب ويحموا صحة القوى العاملة ويحققوا ميزة تنافسية طويلة الأمد.