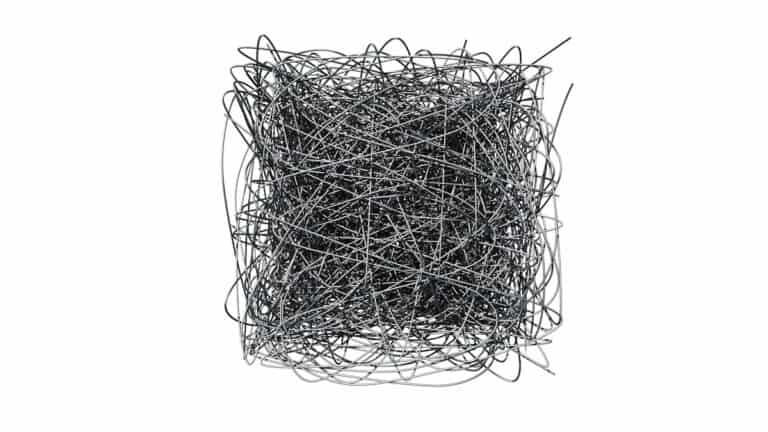حين يجري الحديث عن التفكير التّصميمي، نلاحظ أنّ هذا النوع من التفكير قد بدأ يفقد بريقه، فبعد أن كان يُعتبر - سابقاً – مجموعة من أدوات الابتكار، وكانت الشّركات والجامعات تتبناه بحماسة ودون نقد يُذكَر، بوصفه نهجاً لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة، بدأ التشكيك به يتسرب إلى صفحات المجلات الاقتصادية والمنشورات التعليمية.
هناك انتقادات عديدة توجّه إلى التفكير التّصميمي: فهو غير معرف تعريفاً كافياً، وتعتمد دواعي استخدامه على الحكايات أكثر ممّا تعتمد على البيانات، وهو لا يعدو أن يكون مجموعة مبادئ منطقية أساسية أعيد تجميعها وتسويقها مقابل رسوم استشارية مرتفعة. وفي حين تدفقت بعض مبادئ التفكير التصميمي هذه إلى عالم السياسة، وأعيد طرح مبادرات التغيير الاجتماعي على أنها ابتكار اجتماعي، بدأ القلق والاستياء من المنهج يظهر في مجال السياسة العامة.
ومع ذلك، فقد أغفل معظم النّقّادالمشكلة الأساسية في التفكير التصميمي، وهي أنه - في جوهره - استراتيجية قديمة للحفاظ على الوضع الراهن والدفاع عنه. ويعطي التفكير التصميمي الامتيازات المصممة من قبل الأشخاص الذين تخدمهم، وبذلك فإنه يحدّ من المشاركة في عملية التصميم، وهذا بدوره يحدّ من نطاق الأفكار المبتكرة حقاً، ويزيد من صعوبة معالجة التحديات التي تتميز بدرجة عالية من الغموض، كتغيرات المناخ، حيث يشكّل العمل بالطريقة المعتادة وصفة توصلنا حتماً إلى الكوارث.
تسمية جديدة لأسلوب قديم
لكي نفهم سبب اعتبار التفكير التصميمي محافظاً في جوهره، من الضروري أن ننظر إلى ما سبقه من المناهج. فعلى الرغم من الترويج له بوصفه منهجاً ابتكارياً، تماماً كالحلول التي يعد بإنتاجها، إلا أنه يحمل شبهاً كبيراً بنموذج أقدم لمعالجة المشكلات اشتُهِر في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بسبب أهمية الحلول التي كان من المفترض أن ينتجها. وسمّي ذلك النموذج القديم "النهج المنطقي التجريبي" لحلّ المشكلات"، وقد كان نسخة مبسطة ومعممة من النموذج العلمي، بصورة مماثلة لكون التفكير التصميمي نسخة منَمّطة - أو شديدة التبسيط كما يقول البعض- عن المناهج التي يستخدمها المصممون. وقد تمّ تبني هذا النموذج بحماسة أيضاً من قبل المديرين وصنّاع السياسات، حيث كانوا يستندون إليه من أجل إعادة تشكيل وصياغة الإجراءات في الشركات والحكومات.
إن أوجه التشابه بين الخطوات في الطريقتين شديدة إلى درجة أنّ التفكير التصميمي يبدو كأنه تقليد للنموذج القديم. إذ إنّ منهج حلّ المشكلات المنطقي التجريبي بُني حول سلسلة مراحل تزيدنا كلٌّ منها قرباً من التعرف على الحلّ. وبالمثل يوصف التفكير التصميمي - عموماً - بأنه مكون من أنماط أو أنساق، هي عبارة عن مرتكزات في عملية التصميم، ويعكس كلّ نمط منها وجهاً مختلفاً من أوجه التكفير التصميمي.
يبدأ حلّ المشكلات المنطقي التجريبي من الافتراض بأنّ البحث عن حلّ يبدأ بالاعتماد على البيانات المتاحة عن المشكلة. ويختلف التفكير التصميمي اختلافاً بسيطاً عن النموذج الأصلي، إذ يقترح - بدلاً من ذلك - أنّ على المصممة نفسها توليد المعلومات بشأن المشكلة اعتماداً على خبراتها التي شكّلتها عن طريق التواصل التعاطفي الذي تبنيه مع الأشخاص المتأثرين بالتصميم.
عند هذه النقطة تنتهي الاختلافات الإجرائية بين المنهجين. أما الخطوة التالية في كلًّ منهما فتدعى "التعريف" أو التحديد، وهي تعريف المشكلة أو التحدي الّذي يواجهه التصميم. ويتحرك كلا المنهجين بعدها نحو تطوير نظرية حول كيفية حلّ المشكلة أو التحدي التصميمي. وتسمى هذه الخطوة في التفكير المنطقي التجريبي "مرحلة الفرضية" بينما تسمى في التفكير التصميمي "مرحلة تشكيل الفكرة". وبعد ذلك ينصح كلا المنهجين بتجريب الحلّ المقترح، وهي تسمى في المنهج القديم (المنطقي التجريبي) مرحلة التطبيق، بينما يحضّ المنهج الأحدث (التفكير التصميمي) أتباعه على "إنشاء نماذج أولية". وعلى الرغم من تماثل المنهجين، يتطلب الأخير وضع المزيد من الملاحظات اللاحقة. أمّا الخطوة الأخيرة في المنهجين فهي تقييم فعالية التجربة. وتسمى هذه الخطوة في التفكير المنطقي التجريبي "مرحلة التقييم" فيما يطلق عليها في التفكير التصميمي "صيغة الاختبار"، وتؤدي هذه الخطوة في المنهجين إلى تفعيل الجانب التكراري لهما في حلّ المشكلات، مع تشجيع مطبقيه على استخدام المعلومات التي يستخلصونها من هذه المرحلة من أجل العودة إلى المراحل السابقة وتحسين الفرضيات أو الحلول، أو كليهما.
حماية الأقوياء
يحدد كلّ من المنهجين حلّ المشكلات ضمنياً- على أنه حكر على الأقوياء، وخصوصاً عندما يتعلق التصميم بغايات اجتماعية. إذ يحولان الإمكانات اليومية لحلّ المشكلات إلى ممارسة نادرة تنحصر - فقط - في أولئك الّذين يتبعون منهجية متخصصة بوعي ذاتي. وفي الواقع، يتّسم حلّ المشكلات دوماً بالفوضية، ويتم تشكيل معظم الحلول وفق أجندات سياسية وقيود على الموارد. وليس بالضرورة أن تكون الحلول الرابحة هي الأفضل، بل هي عموماً الحلول التي يفضلها الأقوياء أو على الأقل تفضلها الأكثرية. ويقدم كلا المنهجين (التفكير المنطقي التجريبي والتفكير التصميمي) غطاء لهذه المتغيرات السياسية. ويجعلان عملية عميقة البنى الاجتماعية والاقتصادية تبدو كأنّها مجرد عملية تقنية أو جمالية.
كانت هناك منذ وقت طويل دعوات لجعل عملية حلّ المشكلات والتصميم أكثر انفتاحاً وديمقراطية. ولطالما كانت التجارب المتعلقة بتصميم السياسات القائمة على المشاركة، بدءاً من إعداد الميزانيات التشاركية وصولاً إلى الاستشارات العامة حول السياسات (التي تتراوح بين أنظمة تقسيم المناطق وإصلاحات ذات طابع ديمقراطي)- لطالما كانت تلك التجارب - تسير جنباً إلى جنب مع تصميم سياسات أكثر تقييداً للممارسات. وبالمثل، سعى المصممون والمبتكرون الاجتماعيون إلى الحصول على آراء وملاحظات تقييمية من السكان المستهدفين، حتى أنهم سعوا إلى الحصول على الأفكار المبتكرة التي يولدها المستخدمون الذين طوروا المنتجات عن طريق العمل معهم كهواة. ومع ذلك، وحتى في هذه العمليات الأكثر انفتاحاً، فإنّ المصمم أو صانع السياسات هو من يقرر في النهاية الأفكار والتفضيلات التي يتم تضمينها في الحلّ.
من الاختلافات بين التفكير التصميمي والمنهج المنطقي التجريبي في حلّ المشكلات، هو أن الأول يشير إلى الغموض ويحتفي به بوصفه تمهيداً لأيّ حلّ تصميمي مبتكر، وهذا أمر جيد في بعض الأحيان، إلا أنه يجدد تأكيد الدور المتميز للمصممة، من خلال وضعها كشريان حيوي لا بدّ أن تعبر من خلاله أولاً جميع المفاهيم الضمنية التي تدخل لاحقاً في التصميم النهائي. فالمصممة هي الأداة التي تحول الغموض الفوضوي إلى خطوط نظيفة لحلّ أنيق. ونظرا لأنّ المدخلات التي تقدمها المصممة في عملية التصميم ليست بحاجة إلى توضيح، فإنها تتحرر إلى حدّ ما من متطلبات شرح وتفسير الأساس المنطقي لخيارات تصميمها والدفاع عنها.
يضاف إلى ذلك، أنه بسبب قيام المصممة ذاتها بتوليد المفاهيم الضمنية التي تستخدمها عن طريق التواصل التعاطفي مع المستخدمين المحتملين، أي أسلوب "التعاطف - ومهما كانت احتياجات مستخدمي المنتجات والمجتمعات التي تتصورها – فإنّ هذه الاحتياجات تنعكس من خلال الخبرة والتجربة الشخصية للمصممة وأولوياتها الخاصة. وكما تقرّ أيّة عالمة إثنوغرافية (في الأجناس البشرية) تستحق التقدير، فإنّ الاعتبارات الذاتية غير الموضوعية هنا أمر حتمي، وهذا ما يفسّر تشديد النظم والتخصصات التي تعتمد على التفاعل العاطفي في جمع البيانات، على أهمية الانتباه إلى هوية الباحث وتحديد موقعه (أو وضعه) السياسي. ولكن التفكير التصميمي لا يولي انتباهاً شديداً للموقع السياسي. ويشير هذا الإهمال إلى أنّ المصمم، بوصفه حالماً صاحب رؤية خلّاقة، يترفع عن نزاعات التحيز والمناطق العمياء التي تفتقر إلى الفهم والتمييز، والضغوط السياسية أيضاً.
الحفاظ على الوضع الراهن
تكمن مشكلة تمييز دور المصمم وتفضيله ، أو حتى دائرة صغيرة من المصممين - على هذا النحو - في أنه يضيق احتمالات الابتكار بصورة جذرية. وتنبع قيمة الغموض من مجموعة المعاني التي يصادم بعضها بعضاً في الوقت الذي تكون المشكلة فيه غير محددة بعد، وكذلك من فرص العلاقات الجديدة التي تثيرها هذه التصادمات. يحتفي مفكرو التفكير التصميمي بهذه العلاقات، وخصوصاً تلك التي تتسع لتشمل وجهات نظر وتخصصات وأقسام شديدة الاختلاف، ويعتبر هؤلاء أن هذا النوع من التبرير الاستنتاجي القائم على التخمين والحدس والملاحظة أساساً للإبداع والابتكار .
وعندما يتصرف المصمم كحارس مرمى للمعاني التي تتضمنها عملية التصميم، يصبح احتمال إيجاد العلاقات محدوداً، ليس فقط فيما يعتبره المصمم ويراه مهماً، بل - أيضاً – في العلاقات التي يمكن له أن يتخيلها. أمّا إذا كان فضاء التصميم مفتوحاً باتساع أمام المعاني التي يرى المستخدمون وأوساط المجتمع أنها هامة، فمن المؤكد أننا سنقرأ عدداً أقلّ من القصص عن تدخلات التصميم الفاشلة، من أمثلة مضخات الماء التي صُمِّمت بشكل غريب وتُركَت يأكلها الصدأ لأنها غير صالحة للاستخدام، وأنظمة التوزيع المبتكرة لشبكات الوقاية من البعوض التي تحول دون حصول معظم الناس عليها، والتشوهات التي تتسبب بها الأحذية التي يوزعها الأغنياء على الفقراء كعروض تسويقية. وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
إنّ الأبعاد السياسية للتفكير التصميمي تمثل مشكلة بحدّ ذاتها، ولكن المنهج نفسه غير مناسب إطلاقاً لمعالجة مشكلات في المجالات ذات التغير السريع، أو التي تتصف بالكثير من الغموض وعدم اليقين. وذلك أنه بمجرد إتمام التصميم فإنّ المجال الّذي يتيحه المنهج لمواجهة الغموض والبدائل الجديدة يتم إغلاقه، وأحد هذه المجالات هو التغير المناخي، إذ تتغير البيئة الطبيعية بسرعة مدهشة، وبطرق تبدو غير مسبوقة في التاريخ البشري، وغير قابلة للتنبؤ بها، حيث يُظهر كلّ اكتشاف علمي جديد مدى تمادينا في الاستخفاف بتعقيد الأنظمة الفاعلة، وما تحمله التغيرات الوشيكة التي قد تعني نهاية وجودنا فعلاً. ومع ذلك فإنّ أساليب التفكير التصميمي التي ترافق تبنيها مع الكثير من الضجيج للتعامل مع التحديات، قدمت حلولاً شكلية جامدة. وقد أتاح لنا التفكير التصميمي الاحتفاء بحلول تقليدية على أنها ابتكارات باهرة، ثمّ مواصلة أعمالنا كالمعتاد.
غير ملائم لحالات الغموض
بعد أن تسبب إعصار ساندي بخسائر تزيد على 60 مليار دولار أميركي في منطقة نيويورك، أطلقت إدارة أوباما عملية لإعادة البناء من خلال مسابقة التصميم "Rebuild by Design" من أجل إيجاد حلول جديدة لإعادة البناء، تساعد على إصلاح البنية التحتية، وحماية المنطقة من العواصف الشرسة التي أنبأتنا بها عاصفة ساندي وأفضل العلوم المناخية. ميزت المسابقة نفسها باستخدامها "حلّ المشكلات القائم على التصميم التعاوني من أجل مساعدة المجتمعات والمدن على بناء القدرة على الصمود." وهي عملية يمكن أن تتيح للمناطق المدنية "التغلب على العوائق الطارئة والتنظيمية القائمة، وذلك عن طريق غرس التعاون بين المصممين والباحثين وأفراد المجتمع ومسؤولي الحكومة والخبراء المتخصصين". وكما هو متوقع، تم اختيار 10 فرق من مصممين دوليين للمشاركة في المسابقة، وعقدت هذه الفرق عدة جلسات استشارية جماعية، حيث استخلص المصممون المعلومات عن أكثر ما يهم السكان في عملية إعادة التأهيل. ودمجت فرق التصميم هذه المعلومات مع البيانات بشأن الأضرار المادية والنواحي الاقتصادية للمنطقة في عدة دورات متكررة من التصميم، وأنتجت 6 تصميمات حصلت على مكافآت مالية من أجل تنفيذها.
كانت حصة الأسد من العرض البالغ قرابة مليار دولار في المسابقة من نصيب نظام "بيغ يو" (the Big U)، وهو اقتراح لإنشاء جدار مجزأ بطول عشرة أميال، مكون من سواتر ردمية مزينة بمناظر طبيعية، وبوابات متحركة من أجل حماية النصف الأدنى من مدينة مانهاتن والعقارات الثمينة جداً هناك. وسمي هذا الجدار اليوم "جدار دراي لاين Dryline" أي الخط الجاف، ومن المتوقع أن يكلف حتى إنهائه بين مليار وثلاثة مليارات دولار أمريكي، وأن يكون قادراً على حماية المدينة من العواصف العنيفة بحجم إعصار ساندي، ولكنه لن يتمكن من حمايتها من عواصف أكبر من ذلك. تشير التوقعات الحالية لارتفاع سطح البحر بفعل قوة العواصف إلى أنّ الجدار سيتمكن من حماية المدينة من العواصف حتى عام 2050 فقط، وقد يتحول بعد ذلك إلى ما يشبه حواف حوض استحمام يحتجز مياه الفيضان داخل المدينة. وسيستمر خلال العقود الثلاثة القادمة بناء العقارات العالية القيمة خلف الحماية الظاهرية للجدار، ممّا يزيد المخاطر التي ستواجه المدينة عندما تُخترق هذه العوازل بصورة حتمية في نهاية المطاف. ستكون أولى مراحل بناء جدار دراي لاين في الجانب الشرقي الأدنى من مدينة مانهاتن، بجوار خطّ أحد آخر مجمعات البيوت السكنية ذات الكلفة المقبولة في الجزيرة، وهناك مخاوف من أن الردم المزين سيضيف حديقة عامة جديدة إلى المنطقة، مما يعني أن السكان الذين شارك الكثير منهم بحسن نية في المشاورات الجماعية المكررة، سيتم تشريدهم من أحيائهم بسبب موجة ليست من المياه بل هي موجة من الترف والتحسين.
وباختيار اقتراح يو بيغ (جدار درايلاين)، أكدت مسابقة "إعادة البناء بواسطة التصميم Rebuild by Design" مجدداً الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً ومادياً. فقد أثمر التفكير التصميمي جداراً هو جزء عادي - رغم أنه مكلف - من البنية التحتية التي ستمنع المياه من اجتياح المدينة لفترة من الزمن وستسمح للسكان بالادعاء أنّ البحر سيبقى في حوضه رغم جميع التوقعات التي تقول إنه سيفيض ويغمر جزءاً كبيراً من مدينة مانهاتن. وخلف الأسوار ستبقى الحياة في المدينة كعادتها، مع استمرار قيمة العقارات بالارتفاع، واستمرار أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من السكان في معاناة تهجيرهم من قلب مانهاتن المكلف إلى الأطراف الخارجية لمدينة نيويورك.
بديل مفتوح جوهرياً
ولحسن الحظ، أنتجت مسابقة "إعادة البناء بواسطة التصميم" - أيضاً - حلاً ربما يصبح وسيلة ابتكار أساسية وبديلاً عن التفكير التصميمي. وهو مقترح الحواجز المائية الحية الذي يتضمن إنشاء "عقد" من الجزر الصغيرة على طول الشاطئ الجنوبي لجزيرة ستاتن (Staten Island)، وهي إحدى المناطق التي عانت أسوأ الانجرافات التي سببتها عاصفة ساندي الهائلة. والحواجز المائية عموماً هي أنقاض تكدس في أكوام بهدف إبطاء حركة الأمواج المندفعة نحو الشاطئ بقوة، ولكنّ هذا العرض الذي مُنِح تمويلاً أولياً متواضعاً نسبياً، يقترح استخدام هذه الحواجز من أجل إعادة إحياء البيئات البحرية وتحويلها إلى حواضن لكل أنواع الحياة، بما فيها النباتات والحيوانات والبشر. حيث يتم بناء هذه الحواجز باستخدام صناديق اسمنتية تؤمن المساكن للمحار والفقمات والأسماك والطحالب والأجناس الأخرى من الأحياء البحرية. كما تؤمن منصة مادية ورمزية للنشاطات التعليمية والاقتصادية المتعلقة بالنظام البيئي. ويولي المشروع من خلال المدارس العائمة أهمية لاحتياجات الجيل القادم، ويضع حواجز الأمواج كجزء من الإرث البيئي يستطيع جيل الشباب اليافعين المطالبة به وتشكيله. ويفترض هذا المقترح أن طريقة مواجهة التغيرات البيئية لا تكون بإقامة المتاريس والتحصن ضدها، بل باحتضان التغيير الذي تمثله، وإعادة تصور الكارثة على أنها فرصة لإنشاء مستقبل بيئي جديد.
إن كلّاً من عملية التصميم والحلّ نفسه مفتوحان بصورة جوهرية. إذ يستمر سكان المنطقة بالمشاركة في عملية التصميم، ليس بوصفهم مصدراً لمعلومات المصممين بل بصفتهم مصممين أساسيين بأنفسهم، فهم يساعدون في صياغة العناصر المادية للحل ّ إلى جانب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي يدعمونها. تعمّد المقترح عدم تحديد المحطات المائية التي يصورها التصميم على شكل قلادة قائمة على اليابسة في المساحات التي تتبع قوس الحواجز المائية، ليتيح للسكان تحديد أشكالها ووظائفها. لم يكوّن المشروع رأياً بشأن المحطات بعد، وهو يتوقع أن تكون استخداماتها في المراكز المختلفة متسعة النطاق، كحاضنة للأعمال التجارية، ومنارة، ومخبر لدراسة الحياة البرية، ومحطة لقوارب الكاياك، ومكان للتأمل. كما يفترض لأشكال الحياة غير البشرية أن تمارس دوراً فاعلاً في العملية من خلال التوضع في الحواجز المائية، وإعادة تشكيل عناصر الإسكان المادية التي يؤمنها المشروع وتوسيعها، وحتى جذب أنواع جديدة من الكائنات إلى المنطقة، مع الوعد بتوفر الغذاء الوفير وربما المياه الأكثر إنعاشاً. ويتعمد مشروع الحواجز المائية الحية - من خلال إبقاء عملية التصميم مفتوحة - تجنب وضع الخاتمة المغلقة التي تتميز بها حلول التفكير التصميمي المكتملة. كما يتضمن المشروع احتمال وجوب إعادة ابتكار الحواجز المائية مع ارتفاع منسوب مياه البحر حولها . وهو يحمي الأفكار الوليدة، بنفس الطريقة التي يحمي فيها الصغار والشباب تقريباً، وذلك من خلال توفير مساحة محمية للأعمال التعاونية الجارية مع ما تولده التغيرات المناخية من غموض وتقلبات.
توفر هذه النافذة الكوة التي يتيحها مشروع الحواجز المائية الحيّة بديلاً للخاتمة المغلقة "النهاية المغلقة" البنية المغلقة التي يتضمنها منهج التفكير التصميمي في أساسه. فهي تُظهِر عملية تصميم يُنحّى فيها المصمم جانباً، ولا يكون التصميم فيها مسيرة صارمة خطوة بخطوة عبر سلسلة مراحل، بل مساحة يمكن للناس أن يجتمعوا فيها ويفسّروا الطرق التي تتحدى فيها الظروف المتغيرة جميع المعاني والأنماط والعلاقات التي اعتُبرت لفترة طويلة من المسلّمات. يمكن أن تكون عملية التأويل هذه غير قابلة للتنبؤ بها، ويصعب التعامل معها أحياناً من ناحيتي الشكل والمدة، وقد يتعذّر وضع خطة لها، وغالباً ما تكون غير مرئية إلا من خلال التأمل في الماضي. ولكنّ حالة الفوضى الأولية هذه هي تحديداً ما تجعل عملية التفسير أو التأويل خلاقة ، فالمعلومات التي يجدها الناس مصادفة أو تتجمع مع بعضها بصورة سريعة توفر قاعدة للحلول المبتكرة، بالإضافة إلى أنها تتيح المجال لعملية إعادة تصور كاملة لما يمكن اعتباره حلاً يمكن البدء به.
لقد أطلقتُ على هذا المنهج في مواضع أخرى تسمية "المشاركة التفسيرية"، ووصفته بأنه عملية تفسير تعاونية واسعة النطاق يقوم المشاركون فيها بإعادة النظر في المفاهيم التي يملكونها عن أنفسهم والآخرين، وكذلك حول العالم المتغير الذي يعيشون فيه. وتمثل التزاماً نحو عملية ليس لها بداية ولا نهاية واضحتين، وهدفها غير المحدد بوضوح ليس أكثر من وضع تصوّر وتوضيح لطرق جديدة لمواجهة التغيرات التي لا تزال غامضة وغير قابلة للقياس.
لا تخلو المشاركة التفسيرية من ضغوط القلق والتّوتر، كما أنّ السياسات التي تشكل خيارات التصميم تتأرجح بين المشاركين في حالة من الأخذ والرّد ، وتواجه - غالباً - تحديات شرسة. ولكن هذا النوع من المشاركة يقدم إمكانية للابتكار الجوهري، وذلك لأنّ الحلول التي يأتي بها غالباً ما تكون على درجة عالية من الإبداع، إضافة إلى أنها تميل إلى الانفتاح وتتقبل التعديلات التدريجية. يتسع هذا الانفتاح ويحتضن المشاركة التفسيرية لأنه يرحب بالأشخاص المتأثرين بالحلّ الذي يدخل في عملية التصميم التفسيري الجارية، ويدعوهم لإجراء تعديلات على الحلّ كي يكون قادراً على تلبية حاجتهم بصورة أفضل في أيّ وقت.
إنّ هذه الحلول المفتوحة والمتغيرة باستمرار، والتي تدعمها المشاركة التفسيرية، تمثل فرصة للتخلص من المناهج التقليدية فيحلّ المشكلات، مثل الحلّ المنطقي التجريبي أو التفكير التصميمي. وتسمح لنا هذه الحلول المنفتحة بالتفاعل مع التغيير بدلاً من وضع أنفسنا في مواجهته.
وبالنسبة للشركات والمبتكرين الاجتماعيين والجهات السياسية الفاعلة، قد يبدو اقتراح تبني عملية مشاركة تفسيرية فوضوية وشاملة - ناهيك عن الحلول المفتوحة التي تدعم بتصميمها الإبداع التشاركي - أمراً غير قابل للتطبيق أو تبذيراً مفرطاًولكنْ ، كما قد يكتشف سكان نيويورك، ربما في وقت أقرب من المتوقع، فإن المتاريس التي تنتجها الخطوات الواضحة المحدّدة في التفكير التصميمي لا تتناسب مع التغيّرات التي لا يمكننا حتى الآن تخيلها أو فهمها بصورة كاملة.