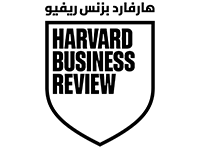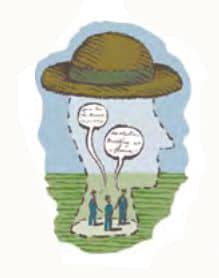إن التمتع بالذكاء والمهارات أمرٌ هامّ، لكن الذكاء العاطفي شرطٌ لا غنى عنه بالنسبة للقيادة. فما هي سمات القائد الحقيقي؟
لا بدّ أن جميع رجال وسيدات الأعمال، قد سبق لهم أن سمعوا بقصّة مدير تنفيذي يتمتّع بذكاء خارق ومهارات عالية، وعندما رُقّي إلى منصب قيادي فشل في أداء مهمّته. ويعرفون بالتأكيد قصّة مدير آخر يتمتّع بقدرات فكرية ومهارات تقنية متينة، ليست فذّة أو استثنائية، رُقّي إلى منصب مشابه فانطلق محلّقاً في آفاق رحبة.
مثل تلك القصص تعزّز الاعتقاد الواسع الانتشار بأن العثور على الأشخاص الذين يمتلكون "الخلطة المناسبة" من الصفات والملكات والمؤهلات هو أقرب إلى الفن منه إلى العلم. أوليست الأساليب الشخصية للقادة الرائعين متباينة؟ فبعض القادّة هادئون وتحليليون؛ بينما يعتلي آخرون المنابر ليصدحوا منها بخطبهم الرنانة. وعلى قاعدة لكل مقام مقال، فإن الأوضاع المختلفة، تستدعي أنماطاً مختلفة من القيادة. فمعظم عمليات الدمج في الشركات تحتاج إلى مفاوض حسّاس يدير الدفة، بينما تتطلّب عمليات التغيير سلطة أشدّ مضاءً وحزماً.
بيد أنني اكتشفت أن أكثر القادة فعّالية وتأثيراً متشابهون في تمتعهم بمَلَكة على جانب كبير من الأهمية: فجميعهم يمتلكون مستوى رفيعاً ممّا بات يُعرف باسم "الذكاء العاطفي" (وهو يُعرف أيضاً باللغة العربية باسم "الذكاء الوجداني"). وهذا لا يعني أن حاصل الذكاء، (الذي يعرّف بالإنكليزية باسم (IQ))، أو المهارات التقنية لا دور لها؛ إنها مهمّة جداً بالتأكيد؛ لنقل إنها عتبة الدخول إلى مناصب الإدراة التنفيذية، لكنها شرط لازم وغير كافٍ لشغل هذه المناصب. إن الأبحاث التي أجريتُها، فضلاً عن مجموعة أخرى من الدراسات الحديثة، تظهر بكلّ وضوح أن الذكاء العاطفي هو الضالّة المنشودة. فمن دون هذا الذكاء، يمكن للشخص أن يكون حاصلاً على أفضل تدريب على وجه البسيطة، وأن يمتلك ذهناً تحليلياً ثاقباً، وجعبةً ملآى بالأفكار الذكية، ويفشل، مع ذلك، في أن يكون قائداً فذاً.
فكرة المقالة باختصار
ما الذي يميّز القادة العظام عن القادة الجيّدين فقط؟ ليس ما يمّيزهم هو حاصل الذكاء (IQ) أو المهارات التقنية، حسبما يقول دانييل غولمان، بل "الذكاء العاطفي": وهو عبارة عن مجموعة من المهارات التي تُمكّن أفضل القادة من جعل أداء مرؤوسيهم يصل إلى أقصى حدّ ممكن. فعندما كان كبار المدراء في إحدى الشركات يمتلكون قدراً كبيراً وكافياً من الذكاء العاطفي، فإن أرباح أقسامهم فاقت الأهداف السنوية بنسبة 20%. وتشتمل مهارات الذكاء العاطفي على:
الوعي الذاتي – معرفة المرء لنقاط قوّته، ونقاط ضعفه، ودوافعه، وقيمه، والأثر الذي يتركه على الآخرين.
ضبط الذات – التحكّم بالنزوات والدوافع والأمزجة الهدّامة أو إعادة توجيهها.
الحافز – الاحتفاء بالإنجاز لغرض الإنجاز.
التعاطف – فهم التركيبة العاطفية للآخرين.
المهارة الاجتماعية – بناء الألفة والمودّة مع الآخرين من أجل توجيههم في الاتجاه المرغوب.
يولد الواحد منّا ولديه مستويات معيّنة من الذكاء العاطفي. غير أننا قادرون على تعزيز هذه القدرات من خلال المثابرة، والممارسة، واستطلاع آراء الزملاء أو المرشدين والموجّهين.
ما الذي يقدمه الذكاء العاطفي لسمات القائد الحقيقي؟
خلال العام الماضي، ركّزت أنا وزملائي على الآلية التي يعمل الذكاء العاطفي بموجبها في مكان العمل. وقد درسنا العلاقة بين الذكاء العاطفي والأداء الفعّال، ولاسيما لدى القادة. ولاحظنا كيف يتبدّى الذكاء العاطفي خلال أداء المرء لعمله. إذن كيف بوسعك أن تعرف إذا كان شخص ما يمتلك ذكاءً عاطفياً حادّاً أم لا؟ وكيف تستطيع أن تميّز الذكاء العاطفي الموجود لديك أنت؟ سنحاول في الصفحات التالية أن نستكشف الإجابات عن هذه الأسئلة، متطرّقين إلى كل مكوّن من مكوّنات الذكاء العاطفي وهي: الوعي الذاتي، وضبط الذات، والدافع، والتعاطف، والمهارة الاجتماعية؛ شارحين كل واحد منها على حدة.
 تقويم الذكاء العاطفي
تقويم الذكاء العاطفي
تُوظّف معظم الشركات الكبيرة هذه الأيام اختصاصيين نفسيين مُدرَّبين ليعملوا على تطوير ما يُسمّى "نماذج الكفاءة" التي تساعد هذه الشركات في تحديد الأشخاص المرجّح أن يسطع نجمهم في سماء المناصب القيادية العليا، وفي تدريبهم ومساعدتهم على التقدم. كما يقوم هؤلاء الاختصاصيون النفسيون بتطوير نماذج مماثلة من أجل المناصب الأدنى مرتبة. وفي السنوات القليلة الماضية، قمت شخصياً بتحليل النماذج المستخدمة في 188 شركة، ومعظمها شركات ضخمة وعالمية مثل لوسنت تكنولوجيز (Lucent Technologies)، والخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، وبنك كريدي سويس (Credit Suisse).
لقد كان هدفي من القيام بهذه المهمّة هو أن أحدّد ما هي القدرات الشخصية التي أسهمت في تحقيق أداء متميّز للغاية ضمن هذه المؤسسات، وما مقدار هذا الإسهام. وقد صنّفت القدرات ضمن ثلاث فئات هي: المهارات التقنية البحتة مثل المحاسبة والتخطيط التجاري؛ والقدرات الفكرية مثل التفكير التحليلي؛ والمهارات التي تدل على ذكاء عاطفي، مثل القدرة على العمل مع الآخرين، والفعالية في قيادة عملية التغيير.
اقرأ أيضاً: تعرف على سمات القائد العالمي الفعال
ولتصميم بعض نماذج الكفاءة هذه، طلبَ الاختصاصيون النفسيون من المدراء في الشركات تحديد القدرات التي يجب أن يتمتّع بها أبرز القادة النموذجيين في المؤسسة. ولصياغة نماذج أخرى، استعمل الاختصاصيون النفسيون معايير موضوعية مثل ربحية القسم، لتمييز المدراء ذوي الأداء الممتاز في المناصب العليا ضمن مؤسساتهم عن أقرانهم العاديين. وخضع هؤلاء الأفراد لمقابلات واختبارات شاملة، وأجريت مقارنة بين قدراتهم. وأسفرت هذه العملية عن وضع قوائم بالسمات التي تُميَّزُ القادة الفعّالين. وتراوح طول القائمة ما بين 7-15 عنصراً، حيث شملت بنوداً مثل "أخذ زمام المبادرة" و"الرؤية الاستراتيجية".
وعندما حلّلتُ هذه البيانات، توصّلتُ إلى نتائج مثيرة. فمن المؤكّد بأن العقل الذكي كان أحد المحرّكات الأساسية للأداء المُتميّز؛ كما أن المهارات الفكرية مثل "التفكير الشامل"، و"الرؤية البعيدة المدى" كانت ذات أهمية خاصّة. ولكن عندما حسبت المعدّل الخاص بالمهارات التقنية، وحاصل الذكاء، والذكاء العاطفي، بوصفها العناصر المكوّنة للأداء المُتميّز، تبيّن لي بأن أهمية الذكاء العاطفي بالنسبة لأداء الوظائف في جميع المستويات، كانت ضعف أهمية العناصر الأخرى.
وعلاوةً على ما سبق، أظهر تحليلي أن أهمية الذكاء العاطفي كانت تتزايد كلّما ارتقينا إلى المستويات الأعلى في الشركة، حيث لا يعود للفروق بين المهارات التقنية أهمية تذكر. أي بعبارة أخرى، كلّما علت مرتبة الشخص الذي اعتُبِرُ ممتاز الأداء، ازداد دور ذكائه العاطفي في زيادة فعاليته. وعندما قارنت بين الموظفين ذوي الأداء الممتاز والموظفين ذوي الأداء العادي في المناصب القيادية العليا، وجدت أن 90 % من الفرق في بياناتهم كان ناجماً عن عوامل مرتبطة بالذكاء العاطفي لا بالقدرات الفكرية.
وقد أثبت باحثون آخرون بأن الذكاء العاطفي لا يميّز القادة المتفوّقين فحسب، بل يرتبط بالأداء القوي أيضاً. ويمكن اعتبار النتائج التي توصّل إليها الراحل ديفيد ماكليلاند (David McClelland)، الباحث المشهور في السلوك البشري والسلوك المؤسسي، من الأمثلة الجيّدة على ذلك. ففي دراسة له عام 1996، شملت شركة عالمية للأغذية والمشروبات، وجد ماكليلاند أن المدراء الذين يمتلكون مستوى مرتفعاً من قدرات الذكاء العاطفي، قد حققت أقسامهم أرباحاً فاقت الأهداف السنوية بنسبة 20%. أمّا رؤساء الأقسام الذين ليس لديهم القدر الكافي من القدرات فقد كان أداؤهم أقل من أهدافهم السنوية بالنسبة ذاتها تقريباً. والملفت في النتائج التي توصّل إليها ماكليلاند، هي أنها كانت متشابهة بين أقسام الشركة في كل من أميركا، وآسيا، وأوروبا.
المدراء التنفيذيون لا يمنحون الوعي الذاتي حق قدره عندما يبحثون عن القادة المحتملين لشغل المناصب العليا.
باختصار، لقد بدأت الأرقام تحكي لنا قصة مقنعة عن وجود رابط بين نجاح الشركة ومستوى الذكاء العاطفي لدى قادتها. وبنفس القدر من الأهمية تشير الأبحاث إلى أن الناس قادرون على تطوير ذكائهم العاطفي، فيما لو اتّبعوا المنهجية الصحيحة (راجع الجدول الجانبي الذي يحمل عنوان: "هل يمكن تعلّم الذكاء العاطفي؟").
الوعي الذاتي
إن الوعي الذاتي هو المكوّن الأول للذكاء العاطفي – وهذا أمر منطقي عندما نتذكّر النصيحة التي قدّمتها قبل آلاف السنين العرّافة والكاهنة في معبد دلفي في الأساطير اليونانية: "اعرف نفسك". فالوعي الذاتي يعني امتلاك المرء فهماً عميقاً لمشاعره، ونقاط قوّته وضعفه، واحتياجاته، وبواعثه، ودوافعه. فالأشخاص الذين يمتلكون وعياً ذاتياً قوياً ليسوا مُفرطين في الانتقاد، ولا في الآمال غير الواقعية، وإنما هم أشخاص صادقون وأمينون، مع أنفسهم ومع الآخرين.
يدرك الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية من الوعي الذاتي كيف تؤثّر مشاعرهم عليهم، وعلى الآخرين، وعلى أدائهم في العمل. وبالتالي فإن الشخص الذي يعي ذاته ويعرف أن المُهل الزمنية الضيّقة تظهر أسوأ ما لديه، يحاول تخطيط وقته بعناية، وإنجاز أعماله قبل المهلة المحددة. كما أن الشخص الذي يتمتّع بقدر كبير من الوعي الذاتي سيكون بوسعه التعامل مع زبون متطلّب؛ فهو سيدرك تأثير الزبون على مزاجه، وبأنه السبب العميق للإحباط الذي يشعر به. وقد يفسّر الأمر قائلاً: "طلباته السخيفة تشتّت انتباهنا عن العمل الحقيقي الذي ينبغي إنجازه"؛ لا بل سيمضي خطوة أبعد ويحوّل غضبه إلى شيء بنّاء.
اقرأ أيضاً: كيف تغدو قائداً أكثر شمولاً؟
ويمتدّ الوعي الذاتي لدى المرء ليشمل فهمَه لقيمه وأهدافه. فشخص يمتلك وعياً ذاتياً كبيراً يعلم أي طريق سيسلك، وسبب اختياره لهذا الطريق. لذلك سيكون قادراً، مثلاً، على رفض عرض عمل قد يكون مغرياً من الناحية المالية لكنه لا يتناسب مع مبادئه أو أهدافه على المدى البعيد. أمّا الشخص الذي يفتقر إلى الوعي الذاتي، فإنه عرضة لاتخاذ قرارات قد تسبب له اضطراباً داخلياً عندما يتناسى أهدافه ويدوس على قيمه. فقد يقول شخص من هذا النوع لنفسه بعد عامين من شغله لوظيفته: "لقد وقّعت العقد لأن العرض المالي كان مُغْرياً، لكن هذا العمل لا يعني لي شيئاً وأنا أشعر بالسأم دائماً" إن القرارات التي يتّخذها من يمتلكون وعياً ذاتياً تتناغم مع قيمهم؛ لذلك يجدون أن عملهم يمدّهم بالطاقة والنشاط.
كيف تستفيد عملياً من المقالة؟
ولكن كيف يمكن للمرء أن يدرك الوعي الذاتي؟ إنه يتجلّى أولاً وقبل كل شيء، بشكل صراحة وقدرة على تقويم الذات بواقعية. فالأشخاص الذين يمتلكون مستوى مرتفعاً من الوعي الذاتي قادرون على التحدّث بدقة وانفتاح عن عواطفهم، وعن تأثير هذه العواطف على عملهم، ولكن ليس من الضروري أن يتكلم المرء باستفاضة، أو أن يأخذ الحديث شكل الاعتراف. فعلى سبيل المثال، أبدت مديرة أعرفها، تشكّكها في مدى نجاح خدمة جديدة كانت شركتها، وهي سلسلة متاجر كبرى، تعتزم إطلاقها. وتقوم هذه الخدمة على تقديم المساعدة الشخصية للمتسوّقين أثناء تجوّلهم في المتجر. وقد قدّمت لمديرها وفريقها تفسيراً لسلوكها دون أن يحثها أحد على ذلك قائلة: "يصعب عليّ دعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة. فقد كنت أرغب بأن أكون الشخص الذي يدير المشروع، لكن لم يتمّ اختياري لذلك. اصبروا علي قليلاً ريثما أتعامل مع الأمر". وقد تأكد المدير بالفعل من مشاعرها؛ وما مضى أسبوع إلا وغدت من الداعمين للمشروع بشكل كامل.
كيف تقوّي ذكاءك العاطفي؟
حاول أن تلجأ إلى الممارسة العملية لمهارات الذكاء العاطفي، واستفد من آراء الآخرين لكي تعزّز مهاراتك في هذا المجال.
مثال: عَلِمَت إحدى المديرات التنفيذيات من الآخرين بأنها تفتقر إلى التعاطف، ولاسيما القدرة على الإصغاء. لذلك أرادت حل هذه المشكلة، فطلبت من أحد الموجهين أن يخبرها عندما تبدو عليها علامات ضعف الإصغاء. ثم حاولت تمثيل بعض المقاطع الدرامية لتتدرّب على تقديم إجابات أفضل؛ كأن تتوقف عن مقاطعة الآخرين مثلاً. كما بدأت أيضاً بمراقبة المدراء التنفيذيين البارعين في مهارات الإصغاء وحاولت تقليد سلوكهم.
غالباً ما يتبدّى هذا النوع من معرفة الذات خلال عملية التوظيف. اطلب، مثلاً، من شخص مرشّح لشغل وظيفة معيّنة أن يصف مرّةً انجرف فيها وراء مشاعره وأقدم على أمر ندم عليه فيما بعد. المرشّحون ذوو الوعي الذاتي المرتفع سيكونون صريحين في الإقرار بالفشل – وسيروون قصصهم غالباً والابتسامة تعلو وجوههم. فإحدى أبرز السمّات المُميّزة للوعي الذاتي هي امتلاك المرء حس الفكاهة في نقد نفسه.
كما أن الوعي الذاتي هو أمر يُمكن اكتشافه خلال عمليات مراجعة الأداء الوظيفي. فالناس الذين يتمتّعون بالوعي الذاتي المرتفع يدركون نقاط قوّتهم وقصورهم ويرتاحون للحديث عنها، وغالباً ما يُبدون تعطّشاً للنقد البنّاء. أمّا من يمتلكون وعياً ذاتياً منخفضاً، في المقابل، فإنهم يفسّرون الرسالة التي توجّه إليهم بوجوب تحسين وضعهم على أنها تهديد أو دلالة على الفشل.
إن الأشخاص الذين يمتلكون وعياً ذاتياً يتميزون أيضاً بثقتهم بأنفسهم. فهم يدركون قدراتهم تمام الإدراك، ومن المستبعد أن يعرّضوا أنفسهم للفشل، مثلاً، من خلال تجاوز المهلة المحدّدة لإنجاز المهام الموكلة إليهم. كما أنهم يعلمون أيضاً متى يطلبون المساعدة، ومجازفاتهم في العمل محسوبة بدقة؛ فهم لن يقبلوا تحدّيات يدركون عدم قدرتهم على مواجهتها بمفردهم. وهم يعوّلون على نقاط القوة لديهم.
ولنأخذ، على سبيل المثال، تصرّف موظفة في الإدارة المتوسطة دُعيت لحضور اجتماع لكبار المدراء التنفيذيين في شركتها، يهدف إلى دراسة استراتيجية تلك الشركة. فرغم أنها كانت أصغر الحاضرين سنّاً، إلا أنها لم تجلس في الاجتماع بهدوء، تستمع بصمت الخائفين. كانت متيقّنة من وضوح منطقها، وبراعتها في عرض أفكارها بأسلوب مقنع، وقد قدّمت مجموعة من الاقتراحات الوجيهة بخصوص استراتيجية الشركة. ولكن وعيها الذاتي منعها، في الوقت نفسه، من اقتحام مجالات كانت تعلم أنها ضعيفة فيها.
هل يمكن تعلم الذكاء العاطفي؟
خاض البشر ولعصور طويلة نقاشاً محوره السؤال التالي: هل يولد القائد قائداً أم أنّه يُصنع؟ كما خاضوا أيضاً نقاشاً مشابهاً حول الذكاء العاطفي. فهل يُولد الناس وهم يتمتّعون بمستويات معيّنة من التعاطف، مثلاً، أم أنهم يكتسبون التعاطف نتيجة لتجاربهم في الحياة؟ الإجابة هي مزيج من الاثنين معاً. فالبحث العلمي يشير بقوّة إلى أن هناك عاملاً وراثياً يقف جزئياً وراء الذكاء العاطفي. كما تشير الأبحاث السيكولوجية والتطوّرية إلى أن التربية هي الأخرى لها دورها. قد لا نعلم حجم الدور الذي يؤدّيه كل عامل من هذه العوامل، بيد أن الأبحاث والتجارب العملية تشير بوضوح إلى أن الذكاء العاطفي هو أمر يُمكن تعلّمه.
هناك حقيقة مؤكّدة: الذكاء العاطفي يتزايد مع التقدّم في العمر. وثمّة كلمة تقليدية قديمة لوصف هذه الظاهرة هي: "النضوج". وحتى بعد النضوج، فإن بعض الناس يظلون بحاجة إلى تدريب لتعزيز ذكائهم العاطفي. ولكن، للأسف، فإن الكثير من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء مهارات القيادة – ومن ضمنها الذكاء العاطفي – هي بمثابة هدر للوقت والمال. والمشكلة بسيطة: إنها تركّز على الجزء الخاطئ من الدماغ.
يُولد الذكاء العاطفي إلى حدِّ كبير في النواقل العصبية لجزء من الدماغ يُسمّى "الجهاز الحوفي أو الطرفي" وهو الذي يتحكّم بالمشاعر والدوافع والبواعث والنزوات. وتشير الأبحاث إلى أن أفضل طريقة يتعلّم بها الجهاز الحوفي هي من خلال التحفيز، والممارسة المديدة، والتغذية الراجعة (آراء الآخرين). ولنقارن بين هذا النوع من التعلّم، والتعلّم الحاصل في الجزء من الدماغ المُسمّى "القشرة الحديثة" والتي تتحكّم بالقدرات التحليلية والتقنية، وتستوعب المفاهيم والمنطق. وهي الجزء من الدماغ الذي يحاول تعلّم كيفية استعمال الكمبيوتر أو إجراء عملية مبيعات من خلال قراءة كتاب. ومن غير المفاجئ – ولكن من الخطأ- أن يكون هذا الجزء من الدماغ هو الذي تستهدفه معظم برامج التدريب الهادفة إلى تعزيز الذكاء العاطفي. وتشير الأبحاث التي أجريتُها مع "رابطة أبحاث الذكاء العاطفي في المؤسسات" إلى أنّه عندما تتبنّى هذه البرامج منهجية تستند إلى "القشرة الحديثة"، فقد تؤثر تأثيراً سلبياً حتى على الأداء الوظيفي للناس.
ولكي تعزّز المؤسسات الذكاء العاطفي لدى موظفيها، يتعيّن عليها أن تعيد تركيز تدريبها ليشمل "الجهاز الحوفي" في الدماغ. ويجب أن تساعد الناس على خرق العادات القديمة واكتساب عادات جديدة. وهذا الأمر لا يستغرق وقتاً أطول من الوقت الذي تستغرقه برامج التدريب التقليدية فحسب، وإنما يتطلّب منهجية مُعدّلة بحسب وضع كل شخص وحالته.
تخيّلوا مثلاً مديرة تنفيذية يعتقد زملاؤها أنها غير قادرة على التعاطف، وهذا العيب يظهر من خلال عدم قدرتها على الإصغاء؛ فهي تقاطع الناس ولا تعير اهتماماً كبيراً لما يقولونه. ولكي تحلّ هذه المديرة المشكلة، فإنها بحاجة إلى أن تشعر بالدافع إلى التغيير، وهي بعد ذلك بحاجة إلى تدريب وإلى تلقّي آراء الآخرين في الشركة بأدائها. ويُمكنها الاستعانة بزميل أو مرشد ليخبرها متى يلاحظ أنها تفشل في الإصغاء. وبعد ذلك يتعيّن عليها أن تعيد تمثيل الحادثة مع التدرّب على إبداء استجابة أفضل؛ بمعنى أن تُظهر قدرتها على استيعاب ما يقوله الآخرون. ويمكن توجيه هذه المديرة إلى ضرورة مراقبة مدراء تنفيذيين معيّنين يجيدون الإصغاء، وتقليدهم.
وإذا ما اقترنت هذه العملية بقدر من المثابرة والصبر فإنها قد تقود إلى نتائج دائمة. فأنا أعرف واحداً من محللي وول ستريت سعى إلى تحسين ذكائه العاطفي، وتحديداً قدرته على قراءة ردود أفعال الناس وفهم وجهات نظرهم. فقبل أن يشرع هذا المدير التنفيذي في مسعاه ذلك، كان مرؤوسوه يشعرون بالذعر من العمل معه، لا بل كان البعض يذهب إلى حد إخفاء الأخبار السيئة عنه. وقد صُدِمَ بالطبع عندما وُوجِه بهذه الحقائق في النهاية. وعندما ذهب إلى البيت وأخبر أفراد عائلته بما حصل، فوجئ أكثر أنهم هم أيضاً أكّدوا له ما كان قد سمعه في مكان العمل. فعندما كانت آراؤهم حول أي موضوع لا تتوافق مع رأيه، فإنهم هم أيضاً كانوا يشعرون بالخوف منه.
هذا الأمر دفعه إلى الاستعانة بخدمات أحد المرشدين لكي يساعده في العمل على زيادة ذكائه العاطفي من خلال الممارسة، والتدريب، وطلب آراء الآخرين بأدائه. وفي خطوة أولى، ذهب في إجازة إلى بلد أجنبي لم يكن يتقن لغة أهله. وأثناء وجوده هناك، راقب ردود أفعاله الشخصية تجاه الأوضاع غير المألوفة ومدى انفتاحه على الأشخاص الغرباء عنه. وعندما عاد إلى بلاده، وتحت تأثير الذل الذي شعر به خلال هذا الأسبوع الذي قضاه في الخارج، طلب من المرشد أن يرافقه كظله خلال أجزاء من النهار، عدّة مرّات في الأسبوع، ليراقبه ويرى كيف سيُعاملُ الناس بطريقة جديدة أو مختلفة ويعطيه رأيه في ذلك. وفي الوقت ذاته، تعمّد اختيار نقاشاته مع زملائه في العمل كفرصة تسمح له بالتدرب على ممارسة "الإصغاء" إلى الأفكار المختلفة عن أفكاره. وأخيراً، قام هذا المدير التنفيذي بتصوير نفسه بالفيديو أثناء الاجتماعات وطلب من الذين يعملون معه، والذين يعملون تحت إمرته، أن يعطوه رأيهم بقدرته على تفهم مشاعر الآخرين. استغرق الأمر بضعة أشهر، غير أن الذكاء العاطفي لهذا المدير التنفيذي ارتفع في نهاية المطاف، وقد انعكس هذا التحسّن على أدائه الإجمالي في العمل.
من المهم أن نشدّد على أن بناء المرء لذكائه العاطفي لا يمكن أن يحصل – ولن يحصل – دون وجود رغبة صادقة، ودون بذل جهد متواصل. فحضور ندوة قصيرة لن يعود على المرء بالنفع الكبير، كما أنه لن يعثر على دليل إرشادي مختصر يعلّمه كيف يصبح أذكى عاطفياً. فتعلّم التعاطف – أي أن يحاول المرء جعل التعاطف استجابته الطبيعية التي يبديها للآخرين – هو أمر أصعب بكثير من تعلّم بعض التحليلات الإحصائية المعقّدة. لكنه أمر ممكن التحقيق. يقول الشاعر رالف والدو إمرسون "لولا الحماس، لما كان أي شيء عظيم ليتحقق البتّة." فإذا كان هدفك هو أن تصبح قائداً حقيقياً، فإن هذه الكلمات يجب أن تكون المنارة التي تهتدي بها وأنت تسعى إلى الارتقاء بذكائك العاطفي نحو الأعلى.
على الرغم من القيمة الكبيرة لوجود أشخاص يمتلكون وعياً ذاتياً في مكان العمل، إلا أن أبحاثي تشير إلى أن المدراء التنفيذيين لا يمنحون الوعي الذاتي قيمته الحقيقية عندما يبحثون عن القادة المحتملين لشغل المناصب العليا. كما أن العديد من المدراء التنفيذيين يخطئون في التمييز بين الصراحة في التعبير عن المشاعر وبين الضعف، ويفشلون في إبداء الاحترام المُستحقّ للموظفين الذين يقرّون علناً بنقاط ضعفهم؛ فهؤلاء الناس يُستبعدون دون تردد باعتبارهم "غير صارمين بما يكفي" لقيادة الآخرين.
لكن العكس هو الصحيح. ففي المقام الأول، عادة ما يُعجب الناس بالصراحة ويحترمونها. بالإضافة إلى أن القادة كثيراً ما يطلب منهم إصدار قرارات تتطلّب تقويماً صريحاً للقدرات، سواء لقدراتهم الذاتية أو لقدرات الآخرين. كأن يتعيّن عليهم الإجابة عن الأسئلة التالية: هل لدينا الخبرات الإدارية المطلوبة للاستحواذ على شركة منافسة؟ هل بوسعنا إطلاق منتج جديد في غضون ستة أشهر؟ وبالتالي فإن من يقوّمون أنفسهم تقويماً صريحاً – أي الناس الذين يمتلكون وعياً ذاتياً – جاهزون لفعل الشيء ذاته مع مؤسساتهم التي يديرونها.
ضبط الذات
تُعتبر الدوافع البيولوجية المحرّكَ الأساسي لعواطفنا. ونحن لا نستطيع التخلّص منها، لكننا قادرون على فعل الكثير للتحكّم بها. وبالتالي فإن ضبط الذات يشبه حديث المرء الدائم مع نفسه. وهو، من بين مكوّنات الذكاء العاطفي، الذي يحرّرنا من أسر مشاعرنا. فالناس الذين يمارسون هذه المناجاة الذاتية تنتابهم نفس الأمزجة السيئة والنوبات العاطفية التي تنتاب سائر الناس الآخرين، لكنهم يبرعون في إيجاد طريقة للتحكّم بها، لا بل والتنفيس عنها بطرق مفيدة.
تعالوا نتخيّل معاً مديراً تنفيذياً شهد لتوّه فريقاً من موظفيه يقدّم تحليلاً رديئاً أمام مجلس الإدارة. قد يشعر هذا المدير التنفيذي في اللحظات العصيبة التالية برغبة جامحة في الضرب بقبضته على الطاولة، أو في رفس الكرسي الذي أمامه. وقد يشعر أنه يريد القفز من مكانه والصراخ في وجوه أعضاء الفريق. أو قد يحافظ على صمت مطبق، محدّقاً في عيون الجميع قبل أن ينتصب واقفاً.
لكنّه لو كان يتمتّع بموهبة ضبط الذات، لاختار منهجاً مختلفاً. فهو سينتقي كلماته بعناية، مقرّاً بضعف أداء الفريق دون الاندفاع إلى أحكام متسرّعة. ومن ثم سيتمهّل قليلاً ليدرس أسباب هذا الفشل؛ هل هي شخصية وناجمة عن ضعف الجهود المبذولة؟ هل هناك عوامل أوصلت إلى هذه النتيجة؟ وماذا كان دوره هو شخصياً في هذه الكارثة؟ بعد دراسة متأنية لهذه الأسئلة، يجمع المدير أعضاء الفريق، ويضع أمامهم عواقب الحادثة، ويخبرهم بمشاعره تجاهها. وبعد ذلك يعرض تحليله للمشكلة مع حل مدروس بشكل جيد لها.
فلماذا يُعتبر ضبط الذات مهمّاً بالنسبة للقادة؟ أولاً، إن الأشخاص الذين يتحكّمون بمشاعرهم ودوافعهم – أي الناس العاقلون الحصيفون – قادرون على خلق بيئة قائمة على الثقة والإنصاف. وفي مثل هذه البيئة، نجد بأن الاقتتال والألاعيب الشخصية تنخفض انخفاضاً حادّاً، بينما تكون الإنتاجية مرتفعة، وهذا ما يجعل الأشخاص الموهوبين يندفعون نحو المؤسسة وليس هناك ما يغريهم بالمغادرة. وضبط الذات له تأثير يسري من القمّة إلى القاعدة ضمن المؤسسة. فلا أحد يُريد أن يُقال عنه أرعن وحاد الطباع في الوقت الذي تمتدح فيه المديرة لتناولها الأمور بأسلوب هادئ. وكلّما كانت الأمزجة السيئة أقل حضوراً في قمّة الهرم كلّما كانت هذه الأمزجة أقل حضوراً في أرجاء المؤسسة.
ثانياً، يُعتبر ضبط الذات أمراً هامّاً لأسباب تتعلق بالتنافسية. فالجميع يعرف أن قطاع الأعمال اليوم يكتنفه الغموض والتغيّر. كما أن الشركات تشهد الكثير من عمليات الاندماج والانهيار الدورية. وما تحدثه التكنولوجيا من تحوّلات سريعة في العمل يصيب المرء بالدوار. لذلك يكون الأشخاص الذين يعرفون كيف يجيدون التعامل مع عواطفهم قادرين على ركوب موجة التغيير بنجاح. وعندما يُعلن برنامج جديد، لا يُصابون بالذعر بل يكون باستطاعتهم تأجيل إطلاق الأحكام، والاجتهاد في استقصاء المعلومات، والإصغاء إلى المدراء التنفيذيين وهم يشرحون البرنامج الجديد. ومع مضي المبادرة قُدماً، يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على مواكبتها.
لا بل في بعض الأحيان، ينتقل هؤلاء الأشخاص إلى الطليعة. ولنأخذ المثال التالي عن مديرة كانت تعمل في شركة صناعية كبيرة. فقد كانت هذه المديرة، حالها حال زملائها الآخرين، تستخدم برنامجاً معيناً للحاسوب منذ خمس سنوات. وكان البرنامج هو الذي يحدّد طريقة هذه المديرة في جمع البيانات وصياغة التقارير، كما كان يحدّد نظرتها إلى استراتيجية الشركة. وذات يوم أعلن كبار المدراء التنفيذيين عن عزمهم تركيب برنامج جديد سيُحدث تحوّلاً جذرياً في طريقة جمع المعلومات وتقويمها ضمن المؤسسة. وفي الوقت الذي أبدى العديد من الموظفين تذمّرهم الشديد، واشتكوا بمرارة من الإرباك الذي سيتسبّب به هذا التغيير، حاولت تلك المديرة تأمّل الأسباب الداعية إلى طرح البرنامج الجديد، واقتنعت بقدرته على تحسين الأداء مستقبلاً.
لذلك حضرت الدورات التدريبية بشغف كبير، في الوقت الذي رفض عدد من زملائها حضور تلك الدورات، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ترقيتها لتصبح المديرة المسؤولة عن عدد من الأقسام، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى براعتها الكبيرة في استعمال التكنولوجيا الجديدة.
أودّ هنا أن أوكّد مجدّداً على أهمية ضبط الذات بالنسبة للقيادة، وأن أُثبت أنها تعزّز من استقامة الشخص، وهذه ليست فضيلة شخصية فحسب، وإنما نقطة قوّة للمؤسسة أيضاً. فالعديد من المشاكل والأمور السيئة التي تشهدها الشركات ناجمة عن السلوك المتهوّر للبعض. فقلما يخطّط الناس للمبالغة في الأرباح، أو إخفاء حسابات المصاريف، أو استغلال الأموال العامّة، أو إساءة استعمال السلطة لمآرب شخصية. بل إن هناك فرصة تعرض نفسها فيتلقفها الأشخاص الذين لا يستطيعون التحكّم بأهوائهم ويقولون لها نعم.
وفي المقابل، دعونا نأخذ مثالاً عن سلوك أحد المدراء التنفيذيين في شركة كبيرة للأغذية. فقد كان هذا المدير صادقاً تماماً في مفاوضاته مع الموزّعين المحليين، حيث كان يعرض عليهم دورياً، وبالتفصيل المملّ، هيكلية التكلفة لديه، لكي يسمح للموزّعين بتكوين فكرة واقعية عن عملية التسعير في الشركة. لكن هذه المنهجية التي اتبعها كانت تحدّ كثيراً من قدرته على المساومة. وكان في بعض الأحيان يشعر برغبة جامحة في زيادة الأرباح من خلال إخفاء بعض المعلومات المتعلّقة بتكاليف الشركة، غير أنه كان يقاوم هذا الشعور لأنه كان يعتقد أن المنطق على المدى البعيد يقتضي عدم الرضوخ إليه. وقد أثمر هذا الضبط الذاتي للعواطف عن نتائج إيجابية للغاية تمثّلت في إقامة علاقات قويّة مع الموزّعين أفادت الشركة أكثر من أي مكاسب مالية قصيرة الأجل كان يمكن أن تحققها.
وبالتالي، فإن ضبط العواطف الذاتية يتبدّى من خلال علامات يمكن رؤيتها بسهولة: ازدهار يسمح بالتأمّل والتدبّر والتمعّن؛ وارتياح تجاه الغموض والتغيير؛ واستقامة – أي قدرة على صدّ الاندفاعات العاطفية.
وكما هي الحال مع الوعي الذاتي، فإن ضبط الذات لا يحظى هو الآخر بالتقدير الذي يستحقّه. فالناس الذين يستطيعون التحكّم بعواطفهم يُنظر إليهم أحياناً بوصفهم متبلّدي المشاعر، بينما تُعتبر استجاباتهم المحسوبة ضرباً من قلّة الحماس. وهناك اعتقاد غالب بأن الأشخاص ذوي الطباع النارية هم قادة "كلاسيكيون" – فنوبات الغضب التي تنتابهم ليست إلا علامة مُميزة للكاريزما والسلطة. ولكن عندما يصل هؤلاء الناس إلى القمّة، فإن تهوّرهم ينقلب ضدّهم. وفي جميع ما أجريته من أبحاث لم يتبيّن لي قط أن الإفراط في إظهار الانفعالات السلبية كان عاملاً يؤدي إلى نجاح القيادة.
الحافز
إذا كان هناك من سمة موجودة لدى جميع القادة الناجحين تقريباً فهي الدافع أو الحافز. فهم مدفوعون لتحقيق الإنجازات التي تفوق كافة التوقعات، سواء كانت توقعاتهم الذاتية أو توقعات الآخرين. والكلمة الأساسية هنا هي الإنجاز. هناك الكثير من الأشخاص الذين تحفّزهم العوامل الخارجية مثل الراتب العالي، أو المكانة الرفيعة المكتسبة من امتلاك لقب مثير للإعجاب، أو من العمل لدى شركة مرموقة. وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين لديهم إمكانيات قيادية يشعرون بدافع داخلي نابع من رغبة دفينة بالإنجاز لغرض الإنجاز.
فإذا كنتم تبحثون عن قادة، فكيف تعرفون الأشخاص الذين يدفعهم حب تحقيق الإنجاز لا المكافآت الخارجية؟ إن العلامة الأولى هي شغفهم بالعمل بحد ذاته؛ فأولئك الأشخاص يسعون وراء التحدّيات الخلاقة، ويعشقون التعلّم، ويفخرون كثيراً بالأعمال المنُجزة على أكمل وجه. كما أنهم لا يكلّون ولا يملّون من العمل على تحسين أدائهم، ولديهم طاقة لا تنضب. وغالباً ما يبدو الأشخاص الذي يمتلكون مثل تلك الطاقة ضجرين ومتململين من بقاء الوضع على ما هو عليه، كما أنهم يدأبون على طرح أسئلتهم عن سبب تنفيذ الأشياء بهذه الطريقة لا بغيرها؛ وهم توّاقون لاستكشاف أساليب جديدة في عملهم.
وكمثال على ذلك، كان أحد المدراء في شركة لمواد التجميل يشعر بالإحباط جرّاء اضطراره للانتظار مدّة أسبوعين لكي يحصل على نتائج المبيعات من موظفيه الميدانيين. وتوصّل أخيراً إلى نظام هاتفي مؤتمت يصدر إشارة عند الساعة الخامسة من مساء كل يوم منبّهاً مندوبي المبيعات التابعين له. وكانت هناك رسالة صوتية مؤتمتة تطلب من أولئك الموظفين إدخال الأرقام التي يجب أن تقدّم إلى المدير – عدد الاتصالات التي أجروها وحجم مبيعاتهم في ذلك اليوم. وقد أسهم النظام، بهذه الطريقة، في تقليل زمن الحصول على نتائج المبيعات من أسابيع إلى ساعات.
تُظهرُ هذه القصّة سمتين إضافيتين مشتركتين تميّزان الأشخاص المدفوعين نحو الإنجاز بحافز داخلي. فهم يحاولون، على الدوام، رفع مستوى المعايير المقبولة للأداء، ويحبّون معرفة الأرقام والنتائج. ودعونا نأخذ مستوى الأداء المقبول أولاً. فخلال عمليات مراجعة الأداء، قد يطلب الأشخاص الذين يمتلكون مستوى عالياً من الدافع الداخلي من رؤسائهم أن يوسّعوا مهامهم. إن أي موظف يجمع ما بين الوعي الذاتي والدافع الداخلي سيدرك بالطبع حدوده، لكنّه لن يقبل بأي أهداف يبدو تحقيقها سهلاً جداً.
ونرى أيضاً أن الأشخاص الذين يدفعهم الحافز الداخلي نحو الأداء الأفضل يحتاجون إلى طريقة لتتبّع ما يحرزونه من تقدّم - تقدّمهم، أو تقدم فريقهم، أو شركتهم. وفي الوقت الذي نجد فيه الأشخاص ذوي الدافع الضعيف للإنجاز يتصرّفون بضبابية تجاه النتائج، نرى من يملكون دافعاً قوياً للإنجاز يلاحقون النتائج بدقّة من خلال تتبّع بعض المقاييس الدقيقة مثل الربحية أو الحصة السوقية. وأنا أعرف أحد مدراء الصناديق المالية الذي يبدأ نهاره وينهيه على شبكة الإنترنت، محاولاً أن يقيس أداء سهم صندوقه مقابل أربعة مقاييس مستعملة في ذلك القطاع.
وما يثير الانتباه هو أن الأشخاص ذوي الدافع الداخلي العالي يظلون متفائلين حتى لو لم تكن الأرقام في صالحهم. ففي تلك الحالات، يتضافر ضبط الذات لديهم مع الدافع نحو الإنجاز ليتغلّبا معاً على الإحباط والاكتئاب اللذين يأتيان بعد نكسة أو فشل. ولنأخذ مثالاً آخر عن مديرة للمحافظ المالية تعمل في شركة استثمارات كبيرة. فبعد عدّة سنوات من النجاح، سجّل صندوقها خسائر على مدار ثلاثة فصول متتالية، ممّا دفع ثلاثة من كبريات المؤسسات الاستثمارية إلى سحب أموالها من الصندوق ووضعها في صناديق أخرى.
بعض المدراء التنفيذيين كانوا سينحون باللائمة في هذا الهبوط في أداء الشركة على الظروف الواقعة خارج نطاق سيطرتهم، بينما سيرى آخرون في النكسة برهاناً على الفشل الشخصي. بيد أن مديرة المحافظ المالية هذه تحديداً، رأت الفرصة سانحة لإثبات قدرتها على قلب الأمور رأساً على عقب. وبعد عامين، عندما رُقِّيت إلى منصب رفيع جداً في الشركة، قالت في وصف تجربتها: "إنها أفضل شيء حصل معي؛ لقد تعلّمت منها الكثير".
وبالنسبة للمدراء التنفيذيين الذين يحاولون أن يعثروا بين موظفيهم على الأشخاص الذين يمتلكون مستويات عالية من الحافز نحو الإنجاز، هناك دليل أخير يمكنهم البحث عنه ألا وهو مدى التزام الشخص تجاه المؤسسة. فعندما يحبّ الناس وظيفتهم بسبب العمل الذي يقومون به في حدّ ذاته، فإنهم غالباً يشعرون بالالتزام تجاه المؤسسات التي تجعل ذلك العمل ممكناً. فالموظفون الملتزمون سيبقون على الأرجح ضمن مؤسستهم حتى لو كانت شركات التوظيف تطاردهم ملوّحةً لهم بالمبالغ المالية الكبيرة.
ليس من الصعب على المرء أن يفهم كيف ولماذا يُترجم الدافع نحو الإنجاز على شكل قيادة قوية. فإذا ما فرضت على نفسك معايير عالية للأداء، فإنك ستفعل الشيء ذاته مع المؤسسة عندما تكون في موقع يسمح لك بذلك. كما أنّ الدافع إلى المضي أبعد من الأهداف الموضوعة، والاهتمام بمراقبة الأرقام والنتائج يمكن أن يصبحا صفتين تنتقل عدواهما إلى الآخرين. وغالباً ما يكون بوسع القادة الذي يتمتّعون بهذه الخصال بناء فريق من المدراء حولهم يتحلّى بالصفات ذاتها. وبطبيعة الحال فإن التفاؤل والالتزام تجاه المؤسسة هما عنصران أساسيان بالنسبة للقيادة – ولكم أن تتخيّلوا فقط كيف يمكنكم أن تقودوا شركة من دونهما.
التعاطف
إن التعاطف، من بين جميع أبعاد الذكاء العاطفي، هو الأسهل تمييزاً. لعله سبق لنا جميعاً أن شعرنا يوماً بتعاطف أحد الأصدقاء، أو الأساتذة الحساسين، معنا؛ كما أننا جميعاً صعقنا من غياب هذا التعاطف لدى مدرّب أو مدير عديم الإحساس. ولكن عندما يتعلّق الأمر بالشركات والعمل، نادراً ما نسمع بأن الناس يحظون بالمديح، ناهيك عن المكافأة، جرّاء شعورهم بالتعاطف مع الآخرين. فكلمة التعاطف، بحدّ ذاتها، تبدو غريبة عن قاموس الشركات، كما وتبدو خارج السياق ضمن الواقع القاسي للسوق.
لكن التعاطف لا يعني شعاراً من قبيل "إذا كنتَ أنت بخير، فأنا بخير". فبالنسبة للقائد، لا يعني التعاطف مجرّد تقمّص مشاعر الآخرين، ومحاولة إرضاء الجميع؛ فذلك سيكون كابوساً مريعاً، وسيجعل إنجاز العمل ضرباً من المستحيل. بل إنّ التعاطف يعني أخذ مشاعر الموظف، إلى جانب عوامل أخرى، بعين الاعتبار في معرض اتخاذ القرارات الذكية.
دعوني أعطيكم مثالاً عملياً عن التعاطف. هل لكم أن تتخيّلوا ما الذي حصل عندما اندمجت شركتان عملاقتان للوساطة ضمن شركة واحدة، ممّا يعني بأن بعض المناصب الوظيفية قد باتت مكرّرة في كل الأقسام التابعة لهاتين الشركتين؟ جَمَع مدير أحد الأقسام موظفيه وألقى على مسامعهم خطاباً باعثاً على الاكتئاب مشدّداً فيه على عدد الأشخاص الذين سيُفصلون من عملهم قريباً، بينما ألقى مدير قسم آخر على موظفيه خطاباً مختلفاً، عبّر فيه بصراحة عن قلقه وحيرته، ووعد بإطلاع الجميع على آخر التطوّرات والمستجّدات، ومعاملتهم بإنصاف.
لقد كان الفرق بين هذين المديرين يكمن في التعاطف. فالمدير الأول كان قلقاً على مصيره الشخصي إلى درجة لم يكن معها قادراً على مراعاة مشاعر زملائه الذين هدّهم القلق. أمّا المدير الثاني فقد شعر بحدسه ما الذي كان يعتمل في صدور الناس، وحاول تهدئة مخاوفهم من خلال الكلمات التي استعملها. فهل كان من المفاجئ أن ينهار القسم التابع للمدير الأول بما أن العديد من الأشخاص الذين ضعفت معنوياتهم، ولاسيما الموهوبين منهم، قد تركوا الشركة؟ وفي المقابل، ظل المدير الثاني قائداً قوياً، ولم يتزحزح موظفوه من أماكنهم، وبقي قسمه محافظاً على إنتاجيته كسابق عهده.
يكتسب التعاطف بوصفه أحد مكوّنات القيادة أهمية خاصة هذه الأيام لثلاثة أسباب على الأٌقل: تزايد حاجة الشركات إلى فرق العمل؛ والخطى المتسارعة للعولمة؛ وتنامي الحاجة إلى الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين.
لنستعرض هنا التحدّيات التي تنطوي عليها عملية قيادة فريق عمل. فكما يشهد أي شخص كان يوماً عضواً في فريق، فإن هذه الفرق تشبه مراجل تغلي بالمشاعر المتأججة. وغالباً ما يُطلب منهم التوصّل إلى توافق في الآراء – وهي مهمّة يصعُب تحقيقها بين شخصين اثنين، فما بالكم إذا كان العدد أكبر بكثير. وحتى في المجموعات التي لا يزيد عدد أعضائها على أربعة أو خمسة أشخاص، فإن التحالفات تتشكّل وتبدأ الأجندات الخاصّة بالتصارع. وبالتالي يجب أن يكون قائد الفريق قادراً على أن يتفهّم وجهات نظر جميع الجالسين إلى المائدة.
وهذا تماماً ما كانت مديرة التسويق في شركة كبيرة لتقنية المعلومات قد تمكّنت من فعله عُندما أوكلت إليها مهمّة قيادة فريق يُعاني من المشاكل.
كان الفريق يمرّ بحالة مضطربة؛ فكاهله ينوء بعبء العمل، وقد فشل فشلاً ذريعاً في إنجاز المهام المطلوبة ضمن المهل الزمنية المحددة؛ وكان التوتّر على أشدّه بين الأعضاء. ولم يكن تعديل من هنا أو هناك في الإجراءات كافياً للمّ شمل الفريق وتحويله إلى جزء فعّال من الشركة.
لذلك اتّخذت المديرة عدداً من الخطوات، ومنها عقد سلسلة من الاجتماعات مع كل عضو في المجموعة على انفراد، أعطت فيها نفسها الوقت الكافي لسماع ما الذي يحبطهم، وكيف يقيّمون زملاءهم، وما إذا كانوا يشعرون بأنهم مهملون أو تمّ تجاهلهم. وقامت بعد ذلك بتوجيه أعضاء الفريق نحو الاجتماع معاً. لقد شجّعت الناس على الحديث بصراحة حول إحباطاتهم، وساعدتهم على طرح شكاواهم البنّاءة خلال الاجتماعات. باختصار، سمحت لها حالة التعاطف التي تبنّتها بأن تفهم التركيبة العاطفية للفريق. ولم تقتصر النتيجة المُحققة على تزايد التعاون بين أعضاء الفريق، بل أضافت إليه عملاً جديداً: إذ بات الفريق يلبّي، بناء على تجربته، طلبات المساعدة لمجموعة واسعة من الزبائن الداخليين.
تُعتبر العولمة سبباً آخر لتنامي أهمية التعاطف بالنسبة لقادة قطاع الأعمال. فالحوار الذي يدور بين أفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة يمكن أن يفضي بسهولة إلى حالات من سوء الفهم. وهنا يبرز التعاطف بوصفه الترياق والدواء. فالناس الذين أوتوا هذه الخصلة قادرون على التقاط الإشارات الخفية الموجودة في لغة الجسد؛ وهم قادرون على القراءة بين سطور الكلام الذي يسمعونه من الآخرين؛ ولديهم فوق ذلك تفهّم عميق لوجود الاختلافات الثقافية والعرقية ولأهميتها.
ودعونا هنا نأخذ مثالاً آخر عن أحد المستشارين الأميركيين الذي كان فريقه قد تقدّم لتوّه بعرض لتنفيذ أحد المشاريع لصالح زبون ياباني محتمل. كان هذا الفريق معتاداً خلال تعاملاته مع الأمريكيين على تلقّي وابل من الأسئلة بعد تقديم عرض كهذا، لكن في هذه المرة ساد في الغرفة صمت مطبق. وبما أن بعض أعضاء الفريق فسّروا هذا الصمت بوصفه علامة على عدم الرضى، فقد بدأوا بحزم حقائبهم استعداداً للمغادرة. لكن كبير الاستشاريين أومأ إليهم بالانتظار والتريّث. ورغم أنه لم يكن مطلعاً بالتحديد على تفاصيل الثقافة اليابانية، فقد قرأ وجه الزبون وإيماءاته ولم يستشعر أي رفض، بل على العكس من ذلك. كان لديه إحساس بأن الزبون مهتمّ بالعرض ويدرسه دراسة عميقة. وكان إحساسه صائباً: فعندما تكلّم الزبون أخيراً، إنما فعل ذلك إيذاناً بقبول تسليم المهمّة إلى هذا الفريق الاستشاري.
أخيراً، فإن للتعاطف دوراً كبيراً في الاحتفاظ بالأشخاص الموهوبين، ولاسيما في ظل اقتصاد المعرفة السائد اليوم. لقد كان التعاطف دوماً ضرورياُ للقادة من أجل تطويرالموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم. لكن المخاطر باتت اليوم أعلى. فعندما يغادر الموظفون الجيدون الشركة، فإنهم يأخذون معهم معارفها وخبرتها.
وهنا يأتي دور التدريب والتوجيه. فقد ثبت مراراً وتكراراً بأن جميع عمليات التدريب والتوجيه تؤتي أكلها، ليس فقط على شكل تحسّن في الأداء، وإنما أيضاً من خلال تزايد الرضى الوظيفي وتناقص تنقّل الموظّفين. لكنّ ما يدفع تلك العمليات إلى تحقيق أفضل النتائج هو طبيعة العلاقة. فالمدرّبون والموجّهون البارعون يعرفون كيف يسيّرون الموظفين الذين يقدمون لهم المساعدة. فهم يدركون كيف يوصلون إليهم الآراء والملاحظات المتعلقة بأدائهم، أي كيف يزودونهم بالتغذية الراجعة الفعالة؛ كما أنهم يعلمون متى يجب أن يضغطوا عليهم لتحسين أدائهم، ومتى يحجمون عن ذلك. ومن خلال الطريقة التي يتّبعونها مع "تلاميذهم"، إذا جاز التعبير، فإنهم يبرهنون، عملياً، على التعاطف.
ورغم أن الأمر قد يبدو فيه شيء من التكرار لفكرة سبق وأن ذكرتها، إلا أنني أعيد القول بأن التعاطف لا يحظى بالكثير من الاحترام في قطاع الأعمال. إذ يتساءل الناس كيف يمكن للقادة اتخاذ قرارات صعبة إذا "شعروا" بجميع الأشخاص الذين سيتأثرون من قرارهم. لكنّ القادة الذين يمتلكون خصلة التعاطف يفعلون عملياً أكثر بكثير من مجرّد التعاطف مع من حولهم: إنهم يستفيدون من معارفهم من أجل تحسين شركاتهم بطرق حاذقة لكنها هامّة.
المهارة الاجتماعية
إن المكوّنات الثلاثة الأولى للذكاء العاطفي هي مهارات تتعلّق بإدارة الذات. أمّا الاثنتان الأخيرتان، وهما التعاطف والمهارة الاجتماعية، فتتعلّقان بقدرة الشخص على إدارة علاقاته مع الآخرين. إن المهارة الاجتماعية، كأحد مكوّنات الذكاء العاطفي، ليست بالبساطة التي قد تبدو عليها. وهي تتجاوز مجرّد إبداء المودّة، رغم أنّ الأشخاص الذين يتمتّعون بمستويات عالية من المهارة الاجتماعية نادراً ما يكونون شريرين. إن المهارة الاجتماعية، بالأحرى، هي عبارة عن ودّ هادف له غرض محدّد وهو دفع الناس إلى السير في الاتجاه الذي ترغب فيه، سواء تعلّق الأمر بالاتفاق على استراتيجية تسويقية جديدة، أو إثارة الحماس بخصوص مُنتج جديد.
يميل الناس الذين يتمتّعون بالمهارة الاجتماعية عادة إلى امتلاك دائرة واسعة من المعارف، وهم موهوبون في العثور على قواسم مشتركة تجمعهم بأناس من جميع المشارب والخلفيات. إنها موهبة بناء الألفة والمودّة. ولا يعني هذا بأنهم يختلطون بالناس باستمرار؛ وإنما يعني بأنهم يعملون وفق الافتراض القائل بأن لا شيء هامّاً يُنجز من تلقاء نفسه. فأولئك الناس لديهم شبكة موجودة يلجؤون إليها حين يأتي الوقت المناسب لاتخاذ الخطوات العملية.
تُعتبر المهارة الاجتماعية تتويجاً للأبعاد الأخرى للذكاء العاطفي. فالناس أميل إلى إدارة علاقاتهم بفعالية كبيرة عندما يكونون قادرين على فهم عواطفهم الذاتية والتحكّم بها، وبوسعهم التعاطف مع مشاعر الآخرين. وحتى الحافز، المذكور أعلاه، يسهم في زيادة المهارة الاجتماعية. ولنتذكّر بأن الناس المدفوعين إلى الإنجاز من تلقاء أنفسهم ميّالون بطبعهم إلى التفاؤل، حتى لو واجهتهم النكسات أو حالات الفشل. وعندما يكون هؤلاء الأشخاص مستبشرين، فإن "ألقهم" يشعّ على المحادثات واللقاءات الاجتماعية الأخرى. وهم يحظون بشعبية واسعة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي.
وبما أن المهارة الاجتماعية هي نتاج الأبعاد الأخرى للذكاء العاطفي، فإنها قابلة للتمييز في مكان العمل بطرق عديدة ستبدو الآن مألوفة. فالأشخاص الذي يتمتّعون بالمهارة الاجتماعية، على سبيل المثال، يجيدون إدارة الفرق – وهذه هي الترجمة العملية لخصلة التعاطف الموجودة لديهم. كما أنهم يمتازون بقدرة رهيبة على الإقناع – وهذا تجسيد للوعي الذاتي، وضبط الذات، والتعاطف، مجتمعةً. وبما أن الأشخاص البارعين في الإقناع قد أوتوا هذه المهارات، فإنهم يعرفون متى يستجدون الآخرين عاطفياً، مثلاً، ومتى تكون مخاطبة العقل أجدى. كما أن الدافع، ولاسيما عندما يكون ظاهراً علناً، يجعل هؤلاء الناس متعاونين إلى أقصى حد: فشغفهم يمتدّ إلى الآخرين، وهم يمتلكون دافعاً قوياً يقودهم نحو إيجاد الحلول.
لكن المهارات الاجتماعية قد تتبدّى أحياناً بطرق لا تتبدّى بها المكوّنات الأخرى للذكاء العاطفي. فمثلاً، قد يبدو الماهرون اجتماعياً أحياناً وكأنهم لا يعملون رغم وجودهم في مكان العمل. إذ يظهرون وكأنهم يمضون الوقت في الدردشة والثرثرة، فتراهم في أروقة الشركة يتجاذبون أطراف الحديث بتراخٍ مع زملائهم، أو حتى يمازحون أشخاصاً لا تربطهم بهم علاقة وظيفية "حقيقية". لكن الأشخاص المتمتعين بالمهارة الاجتماعية يعتقدون بأن من غير المنطقي أن يحدَّد نطاق علاقاتهم قسرياً. فهم يعملون على بناء روابط واسعة لأنهم يعلمون أنهم، في مثل هذه الأوقات المتغيرة، قد يحتاجون يوماً إلى طلب المساعدة من أشخاص بدأوا بالتعرّف عليهم اليوم.
اقرأ أيضاً: 6 مهارات أساسية يجب على كل قائد تملكها وممارستها
دعونا هنا نأخذ مثالاً عن مدير تنفيذي يعمل في قسم الاستراتيجيات في شركة عالمية لتصنيع أجهزة الحاسوب. في العام 1993، أصبح هذا المديرعلى قناعة تامة بأن مستقبل الشركة مرتبط بالإنترنت. وخلال العام التالي وجد من يشاركه قناعته تلك وأفكاره، فاستخدم مهارته الاجتماعية لتكوين مجتمع افتراضي ضم أشخاصاً من جميع المستويات والأقسام. ومن ثم استعان بهذا الفريق الذي بات حقيقياً لإنشاء موقع للشركة على الإنترنت، ليكون بذلك واحداً من أوائل المواقع التي أسستها شركة كبرى على الشبكة العنكبوتية. كما أنه، وبمبادرة شخصية منه، ودون أي موازنة أو تفويض رسمي، سجّل اسم الشركة لحضور مؤتمر سنوي لقطاع الإنترنت. وبعد أن اتصل بحلفائه وأقنع مختلف الأقسام بالتبرّع بالمال، تمكّن من حشد أكثر من 50 شخصاً، يتبعون اثني عشر قسماً في الشركة، كي يمثّلوها في المؤتمر.
تنبهت الإدارة للأمر: فخلال عام من ذلك المؤتمر، شكّل الفريق التابع لهذا المدير التنفيذي أساس القسم الأول للإنترنت في الشركة، وكُلِّفَ هو رسمياً برئاسته. ولكي يستطيع الوصول إلى هذا كله، تجاهل الحدود التقليدية في الشركة، وأقام علاقات مع أشخاص في كل زاوية منها، وحرص على الحفاظ عليها.
فهل تُعتبر المهارة الاجتماعية واحدة من القدرات القيادية الأساسية في معظم الشركات؟ الإجابة هي نعم، ولاسيما إذا ما قورنت بالمكوّنات الأخرى للذكاء الاجتماعي. يبدو أن الناس يعرفون بالبداهة أن القادة بحاجة إلى إدارة العلاقات بفعالية؛ فليس هناك قائد يعيش في جزيرة منعزلة. إن مهمّة القائد في النهاية، هي إنجاز العمل اعتماداً على أشخاص آخرين، والمهارة الاجتماعية هي التي تجعل ذلك ممكناً. والقائد الذي لا يستطيع التعبير عن تعاطفه قد لا يكون لديه كذلك أي تعاطف أصلاً. كما أن الحافز الموجود لدى القائد سيكون عديم الجدوى إذا لم يكن قادراً على إيصال شغفه وحماسه إلى مؤسسته. والمهارة الاجتماعية تسمح للقادة بأن يضعوا ذكاءهم العاطفي موضع التطبيق.
سيكون من الحماقة الزعم بأن اختبار حاصل الذكاء، والقدرات التقنية، ليست من المكوّنات الأساسية للقيادة القوية. لكن "الوصفة" لن تكتمل دون الذكاء العاطفي. ففي السابق كان الاعتقاد السائد أنه "من الجميل أن يتمتّع" قادة قطاع الأعمال بالذكاء العاطفي. لكننا بتنا اليوم نعلم بأن الأداء الجيّد "يقتضي أن يتمتّع" القادة بهذه الصفات.
ولحسن الحظ فإن الذكاء العاطفي هو أمر يمكن للمرء أن يتعلّمه. ليست العملية سهلةً بالتأكيد، وهي تستغرق وقتاً ليس بالقصير، والأهم من ذلك كله أنها تحتاج إلى الالتزام من أجل صياغة سمات القائد الحقيقي. لكن المكاسب المتحققة من امتلاك ذكاء عاطفي متطوّرِ، بالنسبة للفرد والمؤسسة على حدّ سواء، تجعل هذا الجهد يستحق العناء.
اقرأ أيضاً: كيف تصبح قائد بشكل فعلي؟