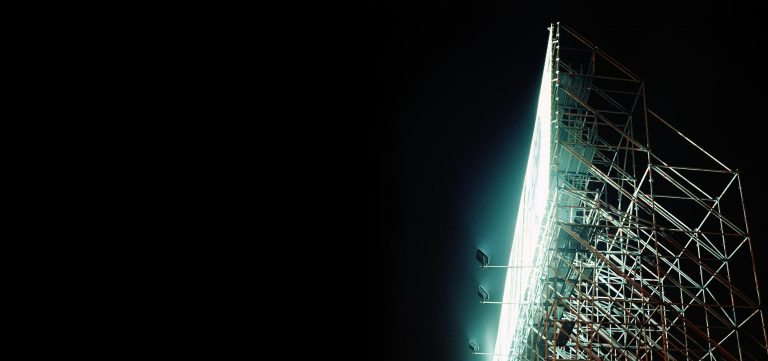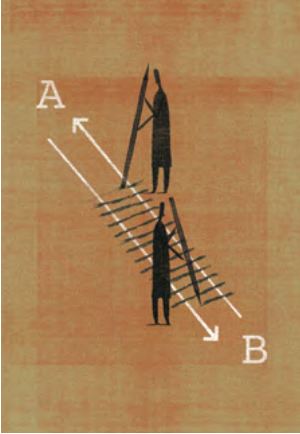يتوقّف النموُ المستدام على مدى اتّساع التعريف الذي تعتمده لقطاعك الذي تعمل فيه – ومدى العناية التي تبذلها في قياس احتياجات زبائنك. فماذا عن قصر النظر التسويقي في الشركات؟
كل قطاع صناعي رئيسي كان يوماً ما صناعة متنامية. لكن بعضاً من هذه الصناعات، التي تركب الآن موجة النمو الحماسي هي عملياً على وشك الاضمحلال. وهناك صناعات أخرى كان يُعتقد بأنها صناعات متنامية مرموقة قد توقّفت عملياً عن النمو. وفي جميع الحالات، لا يعود السبب في تعرّض هذا النمو للخطر، أو في تباطئه، أو توقفه، إلى أن السوق قد وصل إلى حد الإشباع، وإنما يعود إلى الفشل في الإدارة. ولكن للأسف غالباً ما تقع الشركات في فخ قصر النظر التسويقي أثناء العمل.
الأهداف التي تقود الشركة إلى حتفها
إن الفشل يكمن في القمّة. والمدراء التنفيذيون المسؤولون عن هذا الفشل، في الحصيلة، هم المدراء الذين يتعاملون مع أهداف وسياسات عريضة. وبالتالي:
- لم تتوقّف السكك الحديدية عن النمو لأن الحاجة إلى نقل الركّاب والبضائع قد تراجعت؛ فهذه الحاجة قد ازدادت بالتأكيد. ولا يعاني قطاع السكك الحديدية اليوم من متاعب لأن تلك الحاجة قد لبّتها وسائل آخرى (كالسيارات والشاحنات والطائرات وحتى الهواتف)، بل لأن تلك الحاجة لم تلبِّها السكك الحديدية ذاتها. فهي قد تركت الوسائل الأخرى تسحب البساط من تحت أقدامها وتستقطب زبائنها، لأنها اعتبرت أنها تعمل في قطاع السكك الحديدية لا في قطاع النقل. والسبب الذي جعلها تعرّف قطاعها تعريفاً خاطئاً هو أنها كانت تركّز على السكك الحديدية بدلاً من التركيز على النقل؛ تركّز على المُنتَج بدلاً من التركيز على الزبون.
- أمّا هوليوود فبالكاد نجت من استيلاء التلفزيون بالكامل عليها. والواقع أن جميع شركات الأفلام العريقة قد مرّت بعملية إعادة تنظيم جذرية، بينما اختفى بعضها بكل بساطة عن المشهد تماماً. لكن هذه الشركات لم تقع في الورطة من جرّاء غزو التلفزيون، وإنما بسبب قصر نظرها هي. فكما هو الحال تماماً بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، قد أعطت هوليوود تعريفاً غير صحيح للقطاع الذي تعمل فيه. فهي كانت تعتقد بأنها تعمل في مجال الأفلام، في حين أنها كانت في الحقيقة تعمل في مجال الترفيه. وقد عنت "الأفلام" مُنتجاً محدّداً ومحدوداً، مما ولّد قناعة حمقاء جعلت المُنتجين، ومنذ البداية، ينظرون إلى التلفزيون على أنه تهديد. ولذلك ازدرت هوليوود التلفزيون ورفضته، في وقت كان يجب أن ترّحب فيه بهذا الاختراع بوصفه فرصة لتوسيع قطاع الترفيه.
أمّا اليوم، فإن التلفزيون هو قطاع عمل أكبر بكثير من قطاع الأفلام القديم المعرَّف تعريفاً ضيّقاً. ولو قُدِّرَ لهوليوود أن تركّز على الزبائن (وتقدّم لهم الترفيه)، عوضاً عن تركيزها على المُنتج (أي صنع الأفلام)، فهل كانت لتتعرّض لهذه المحنة المالية التي عصفت بها؟ أشكّ في ذلك. لكن من أنقذ هوليوود في نهاية المطاف وجعل الحياة تدبّ في أوصالها من جديد؟ إنهم موجة الكتّاب والمنتجين والمخرجين الشباب الذين تسبّبت نجاحاتهم السابقة في التلفزيون في تقويض شركات الأفلام القديمة وهزّ عروش أساطين السينما العمالقة.
فكرة المقالة بإيجاز
"ما هو القطاع الذي تعملون فيه حقاً؟" قد يبدو هذا السؤال بسيطاً للغاية – لكنه السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعاً على أنفسنا قبل أن يبدأ الطلب على منتجات شركتنا وخدماتها بالاضمحلال.
لقد أخفق قطاع السكك الحديدية في طرح السؤال ذاته – وتوقّف عن النمو. لماذا؟ ليس لأن الناس لم يعودوا بحاجة إلى النقل. وليس لأن الابتكارات الأخرى (كالسيارات والطائرات) لبّت احتياجات النقل. وإنما توقّف قطاع السكك الحديدية عن النمو لأن السكك الحديدية لم تتحرّك لتلبّي تلك الاحتياجات. فالمدراء التنفيذيون في هذا القطاع اعتقدوا مخطئين بأنهم كانوا يعملون في قطاع السكك الحديدية، وليس في قطاع النقل. وقد نظروا إلى أنفسهم على أنهم يقدّمون مُنتَجاً وليس على أنهم يخدمون الزبائن. وثمّة عدد كبير جدّاً من الصناعات التي ترتكب الخطأ ذاته، معرّضةً نفسها بذلك إلى الاندثار.
فكيف تضمنون استمرار النمو في شركتكم؟ ركّزوا على احتياجات الزبائن وليس على بيع المنتجات. فعملاقة الصناعات الكيماوية شركة "دوبان" (DuPont) ظل تراقب بشكل وثيق الهموم الملحّة التي تشغل بال زبائنها، وسخّرت معارفها التقنية لتقديم طيف دائم التزايد من المنتجات التي وافقت أذواق المستهلكين، وأسهمت في التوسّع الدائم لسوقها. ولو كانت دوبان قد بحثت فقط عن المزيد من الاستعمالات لدرّة اختراعاتها، أي النايلون، لما كانت قائمة حتى يومنا هذا ربما.
كيف تستفيد عملياً من الفكرة؟
نحن نعرّض شركتنا لخطر الاضمحلال والاندثار عندما نقبل أياً من الخرافات التالية:
الخرافة الأولى
التنامي الدائم في أعداد السكّان وتزايد ثرائهم سيضمن نموّنا. عندما تكون الأسواق آخذة بالاتساع، نفترض غالباً بأننا لسنا مضطرين إلى تشغيل خيالنا وتفكيرنا بخصوص القطاع الذي نعمل فيه. بل عوضاً عن ذلك نحاول التفوّق على منافسينا من خلال تحسين ما نقوم به أصلاً. فماذا تكون النتيجة؟ نزيد كفاءة عملية تصنيع منتجاتنا، عوضاً عن تعزيز القيمة التي تقدّمها هذه المنتجات إلى الزبائن.
الخرافة الثانية
ليس هناك من بديل منافس للمُنتج الرئيسي الذي يصنعه قطاعنا. اعتقاد شركاتنا بأن منتجاتنا ليس لها منافس، هو اعتقاد يجعلها عرضة للتهديد من الابتكارات المذهلة التي تأتي من خارج قطاعاتنا – وهي غالباً ما تصدر عن شركات أصغر حجماً وأحدث عهداً تركّز على تلبية احتياجات الزبائن وليس على المنتجات ذاتها.
الخرافة الثالثة
نحن قادرون على حماية أنفسنا من خلال اللجوء إلى الإنتاج بالجملة وبكميات هائلة. قليلون منّا فقط قادرون على مقاومة إغراء تزايد الأرباح المحتمل نتيجة التراجع الحاد الحاصل في تكاليف إنتاج الوحدات. لكن التركيز على الإنتاج بالجملة وبكميات هائلة يعني التركيز على احتياجات شركتنا – في وقت يجب أن نركّز فيها على احتياجات الزبائن.
الخرافة الرابعة
الأبحاث التكنولوجية والتطوير ستضمن نموّنا. عندما تقود أعمال البحث والتطوير إلى صنع منتجات متقدّمة جداً تشكّل خرقاً لما هو سائد من المنتجات حالياً، فإننا قد ننجذب نحو تنظيم شركاتنا لتتمحور حول التكنولوجيا وليس حول الزبائن. عوضاً عن ذلك يجب أن يظل تركيزنا منصبّاً على تلبية احتياجات الزبائن.
وثمّة أمثلة أخرى أقل وضوحاً عن قطاعات وصناعات كانت، ولاتزال، تعرّض مستقبلها للخطر من خلال تعريفها للغاية من وجودها تعريفاً خاطئاً. وسأناقش بعضاً منها بالتفصيل لاحقاً، وسأحلّل أنواع السياسات التي جعلت هذه القطاعات تواجه المتاعب. أما الآن فقد يكون من المفيد تبيان ما الذي يمكن لإدارة تركّز على الزبائن بشكل كامل أن تفعله لتحافظ على نمو قطاعها المتنامي، حتى بعد أن تكون الفرص الواضحة قد استُنفدت. وثمّة مثالان موجودان منذ فترة طويلة، وهما النايلون والزجاج – وتحديداً شركتا دوبوت دي نيمور آند كومباني (E.I. du Pont de Nemours and Company) وكورنينغ غلاس وركس (Corning Glass Works)
كلا الشركتين تمتلكان كفاءات تقنية هائلة، كما أن تركيزهما على المُنتج أمر لا مجال للشك فيه. لكن ذلك وحده لا يفسّر سرّ نجاحهما. فهل ثمة من كان، وبكل فخر، أكثر تركيزاً على المُنتج واهتماماً به من شركات النسيج في منطقة نيو إنغلاند التي تعرّضت مع ذلك إلى مجزرة شاملة؟ إن نجاح شركتي دوبان وكورنينغ لا يعود أساساً إلى تركيزهما على المُنتَج والأبحاث، وإنما لأنهما ركّزتا أيضاً وبعمق على الزبون. إنه التيقظ الدائم الذي لا يفوّت أية فرصة لتطبيق المعرفة والخبرة التقنية في ابتكارات ترضي الزبون، وهذا ما يفسر هذا الإنتاج الاستثنائي من البضاعة الجديدة الناجحة. ولولا تلك العين الثاقبة النظرة، الباحثة دوماً عن رضى الزبون، لما وُفقتا في تصنيع المنتجات الصحيحة، ولتحوّلت أساليب البيع لديهما إلى أساليب عقيمة، عديمة الجدوى.
إن صناعة الألمنيوم بدورها هي من الصناعات التي لا تزال تشهد نموّاً بفضل جهود شركتين أنشئتا في زمن الحرب وحاولتا بتأنٍ وتصميم ابتكار استخدامات جديدة ترضي احتياجات الزبائن. فلولا شركة كايزر للألمنيوم والكيماويات (Kaiser Aluminum & Chemical Corporation) وشركة راينولدز ميتال كومباني (Reynolds Metals Company)، لكان الطلب الإجمالي اليوم أقل بأشواط كثيرة.
الخطأ في التحليل. قد يذهب البعض إلى القول بأن من الحماقة مقارنة السكك الحديدية مع الألمنيوم، أو مقارنة الأفلام مع الزجاج. أليس الألمنيوم والزجاج من المواد المتعدّدة الاستعمالات إلى درجة تجعل هاتين الصناعتين أمام فرص أكثر للنمو مقارنة مع السكك الحديدية والأفلام؟ لكن هذه النظرة ترتكب ذات الخطأ الذي تحدّثتُ عنه قبل قليل. فهي تعرّف قطاعاً أو مُنتَجاً أو مجموعة من الخبرات تعريفاً شديد الضيق بما يضمن هرمه قبل الأوان. فعندما نذكر "السكك الحديدية" يجب أن نتأكّد بأننا نقصد "النقل". وكناقل فإن السكك الحديدية لازال أمامها فرصة كبيرة لتحقيق نمو ضخم. وعملها بهذا المعنى لا يقتصر على النقل بحدّ ذاته (وإن كنت شخصياً أعتقد بأن النقل السككي هو واسطة نقل ذات إمكانيات أكبر بكثير ممّا يُعتقد عموماً).
لا يعوز السككَ الحديديةَ وجودُ الفرص، بل شيء من الخيال الخصب والجرأة في مجال الإدارة، فهما اللذان أضفيا العظمة، ذات يوم، على هذا القطاع. إذ حتى شخص لا خبرة لديه مثل جاك بارزون (Jacques Barzun) كان قادراً على رؤية ما تفتقر إليه عندما قال: "يعتصر الألم قلبي وأنا أرى أكثر مؤسسات القرن الماضي تقدّماً وتطوّراً من الناحيتين المادّية والاجتماعية تتداعى وتفقد سمعتها، ويضيع اعتبارها جرّاء غياب الخيال الواسع الذي شيّدها وارتقى بها يوماً. فما نفتقر إليه هو وجود الإرادة لدى الشركات بالبقاء على قيد الحياة وإرضاء عامّة الناس من خلال حس الابتكار والمهارة١".
كيف تخدع الشركات ذاتها. يمتلك الناس ذاكرة قصيرة. فعلى سبيل المثال، يمجّد الناس اليوم، وبكل ثقة، قطاعي الكيماويات والإلكترونيات، هذين التوأمين اللذين ينموان بسرعة هائلة، ويصعب على هؤلاء الناس أن يتصوروا إمكان حدوث خطب لهذين القطاعين. كما يصعب عليهم ربما تصوّر كيف أمكن لرجل أعمال عاقل جدّاً أن يكون بهذا القصر في النظر مثل مليونير بوسطن الشهير الذي حكم في مطلع القرن العشرين على وَرَثَتِهِ، ودون قصد منه، بالفقر بعد أن أوصى باستثمار كل ثروته إلى الأبد وحصرياً في الأوراق المالية والأسهم الخاصّة بشركات الترام الكهربائي. إن العبارة التي ضمّنها في وصيته "سيظل هناك طلب دائم على النقل الكفوء في المدن"، لا تمنح العزاء لورثته الذين يكسبون قوتهم من خلال ملء خزانات السيارات بالبنزين في محطات الوقود.
ومع ذلك، وفي استبيان عادي أجريته شخصياً على مجموعة من المدراء التنفيذيين الأذكياء، أجمع نصفهم تقريباً على أن ورثتهم لن يتأذوا على الأغلب فيما لو ربط هؤلاء المدراء ثرواتهم إلى الأبد بقطاع الإلكترونيات. وعندما واجهتهم بمثال عربات الترام في شوارع بوسطن، اعترضوا جميعاً وبصوت واحد قائلين "الوضع هنا مختلف". لكن هل هو مختلف حقّاً؟ أليس الوضع الأساسي في الحالتين متطابقاً؟
في الحقيقة ليس هناك شيء اسمه "صناعة متنامية" باعتقادي. وإنما هناك فقط شركات منظّمة ومُدارة بطريقة تسمح لها بخلق فرص النمو والاستفادة منها. أمّا الصناعات التي تفترض بأنها تركب مصعداً كهربائياً للنمو سينقلها إلى الأعلى فهي في طريقها إلى حالة الركود. ويُظهِرُ تاريخ كل صناعة "متنامية"، ماتت أو في طور الاحتضار، مرورَها بدورة من خداع الذات تشمل توسّعاً هائلاً وتقهقراً لم يتم اكتشافه. وثمّة أربعة شروط تضمن عادة حدوث هذا النوع من خداع الذات:
1- الاعتقاد بأنّ النمو مضمون طالما أن هناك سكّاناً تتزايد أعدادهم ويزدادون ثراءً.
2- الاعتقاد بأنه ليس هناك من بديل منافس للمُنتج الرئيسي الذي تُنتجه هذه الصناعة.
3- الإيمان المفرط بالإنتاج بالجملة وبالمزايا المتحققة من تراجع تكاليف الوحدة المُنتَجة مع تنامي كميات الإنتاج.
4- الاهتمام الزائد بأحد المنتجات المعتمدة اعتماداً كاملاً على التجارب العلمية المضبوطة بدقّة، وعلى التحسين، وتخفيض تكاليف التصنيع.
سوف أستعرض الآن كل شرط من هذه الشروط بشيء من التفصيل. ولكي أعرض وجهة نظري بأكبر قدر ممكن من الوضوح فإنني سأشرح هذه النقاط من خلال الإشارة إلى ثلاثة قطاعات هي: النفط والسيارات والإلكترونيات. وسوف أركّز على النفط تحديداً لأن هذه الصناعة تمتد على فترة أطول، بالإضافة إلى أنها قد شهدت تقلّبات أكبر. ولا تحظى هذه الصناعات الثلاث بسمعة ممتازة في أوساط عامّة الناس، فضلاً عن تمتعها بثقة كبار المستثمرين فحسب، وإنما باتت إداراتها أيضاً معروفة بأفكارها التقدّمية في مجالات عدة مثل الضبط المالي، والأبحاث التي تُجرى على المنتجات، والتدريب الإداري. فإذا ما أمكن للاندثار أن يزحف ويصل حتى إلى هذه الصناعات، فإنه يمكن أن يطال أي صناعة أخرى.
خرافة السكّان
إن الاعتقاد بأن الأرباح مضمونة نتيجة تنامي أعداد السكّان وزيادة اليسر والترف هو اعتقاد أثير على قلب كل صناعة. وهو يبعد عنها شبح الخوف من المستقبل الموجود لدى جميع الناس. فإذا كان المستهلكون يتضاعفون ويشترون المزيد من منتجاتكم وخدماتكم، فإنكم ستكونون قادرين على مواجهة المستقبل بقدر أكبر من راحة البال والطمأنينة ممّا لو كانت السوق تشهد انكماشاً في حجمها. فالسوق الآخذة بالاتساع تمنع شركات التصنيع من التفكير المجهد أو من إطلاق العنان لخيالها. فإذا كان التفكير هو الاستجابة الذهنية لوجود مشكلة، فإن غياب المشكلة يقود إلى غياب التفكير. وإذا كان مُنتجك أمام سوق آخذة بالاتساع التلقائي، فإنك لن تفكّر كثيراً في كيفية توسعتها.
واحد من أكثر هذه الأمثلة لفتاً للانتباه نجده في صناعة البترول. ولعلّها واحدة من أقدم صناعاتنا المتنامية، وهي تمتلك سجلاً حافلاً تُحسد عليه. ورغم وجود بعض المخاوف الراهنة التي تحيط بمعدّل نموّها، إلا أن هذه الصناعة تميل عادة إلى التفاؤل.
لكنني مؤمن بإمكانية إثبات أنها تمرّ بتحوّل جوهري وإن كان نمطياً. فهي ليست من الصناعات التي لم تعد متنامية فحسب، بل هي ربما في طور الانحدار والتراجع مقارنة مع القطاعات الأخرى. ورغم أن هناك جهلاً واسع النطاق بهذه الحقيقة، إلا أنه من الممكن تخيّل أن قطاع النفط سيتحسّر يوماً ما على أمجاده الغابرة، تماماً كما يفعل قطاع السكك الحديدية اليوم. وعلى الرغم من الأعمال الرائدة التي اضطلع قطاع النفط بها في تطوير وتطبيق طريقة "القيمة الحالية" عند تقويم الاستثمارات، وفي مجال العلاقات بين الموظفين، وفي العمل مع دول العالم النامية، إلا أن هذا القطاع هو مثال مُثير للقلق يبيّن كيف أن التراخي والرضى عن الذات، والتشبّث بالرأي الخاطئ، هي أمورٌ يمكن أن تحوّل الفرصة إلى ما يُشبه الكارثة.
ثمّة صفة تميّز هذا القطاع وغيرَه من القطاعات التي كانت تؤمن بقوّة بالفوائد المرجوّة من تزايد أعداد السكّان، ولاسيما عندما كانت تمتلك مُنتجاً شائعاً لا يبدو أن هناك بديلاً منافساً له، وتتمثّل في أن كل شركة من الشركات عملت على التفوّق على منافسيها من خلال تحسين الأشياء التي تقوم بها أصلاً. وهذا أمر منطقي بطبيعة الحال إذا افترض المرء بأن المبيعات لا ترتبط إلا بسكّان هذه البلاد، لأن الزبون ليس بوسعه أن يقارن بين المنتجات إلا على أساس الصفات المُميّزة لكل مُنتَج. لكنني شخصياً أعتقد أن من المهم الإشارة إلى أن قطاع النفط، ومنذ إرسال جون د. روكفلر لمصابيح زيت الكاز (الكيروسين) إلى الصين مجاناً، لم يُقدِم على أي خطوة بهذا التميّز حقاً لخلق الطلب على مُنتجاته. لا بل إن هذه الشركات قد أخفقت حتى في تحسين منتجاتها. وحتى أعظم تحسين وحيد – ألا وهو تطوير رباعي إثيل الرصاص – جاء من خارج القطاع، وتحديداً من جنرال موتورز ودوبان (DuPont). أمّا الإسهامات الكبيرة لقطاع النفط فتقتصر على تكنولوجيا استكشاف النفط، وإنتاجه، وتكريره.
البحث عن المتاعب. بعبارة أخرى، يمكن القول بأن قطاع النفط قد ركّز جهوده على تحسين كفاءة استخراج منتجه وتصنيعه، وليس على تحسين المنتج العام أو تسويقه. وعلاوة على ما سبق، فإنه ظلّ يعرّف مُنتجه الرئيسي بأضيق تعريف ممكن – فيُقال بنزين وليس طاقة، أو وقود أو نقل. وقد ساعد موقفه هذا في ضمان أن:
- تأتي التحسينات الكبيرة على جودة البنزين غالباً من خارج قطاع النفط. كما أن تطوير الوقود البديل الفخم يأتي من خارج أروقة صناعة النفط، كما سنبيّن لاحقاً.
- تأتي الابتكارات الرئيسية في تسويق وقود السيارات من شركات النفط الصغيرة الجديدة غير المنشغلة أساساً بالإنتاج أو التكرير. وهذه هي الشركات التي كانت مسؤولة عن الاتساع المتسارع لمحطات الوقود التي تضمّ مضخّات عديدة، والتي نجحت في التركيز على توفير مساحة فسيحة ونظيفة ضمن المحطّة، وعلى تقديم خدمة سريعة وكفوءة للزبائن الراغبين بملء سياراتهم بالوقود، مع تزويدهم ببنزين ذي جودة عالية وبأسعار زهيدة.
وبالتالي فإن قطاع النفط يبحث عن المتاعب التي تتسبّب بها الجهات الخارجية. وعاجلاً أو آجلاً، وفي بلاد تعجّ بالمستثمرين وروّاد الأعمال المتعطّشين، فإن التهديد قادم لا محالة. لا بل سيزداد احتمال تحقّق هذا الأمر عندما ننتقل إلى مناقشة الاعتقاد الخطير التالي الموجود لدى العديد من الإدارات. وبما أن الاعتقاد الثاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتقاد الأول، ولغرض الاستمرار، فإنني سأواصل الشرح مستعملاً المثال ذاته.
فكرة عدم إمكانية الاستغناء عن المُنتج. تحمل صناعة البترول اعتقاداً شبه يقيني بأنه ليس هناك بديل منافس لمُنتجها الأساسي أي البنزين، أو بأنه حتى لو وُجِدَ هذا البديل فإنه سيظل واحداً من المشتقات النفطية، مثل وقود الديزل أو كيروسين الطائرات.
يقوم هذا الافتراض على الكثير من التفكير الرغبوي التلقائي، أي على رغبة دفينة لدى قطاع النفط بأن يكون هذا هو الحال بينما الواقع في مكان آخر. وتكمن المشكلة في أن معظم شركات التكرير تمتلك كميات ضخمة من احتياطيات النفط الخام. وهذه الكميات لن تكون لها قيمة إلا في حال وجود سوق للمنتجات التي يمكن تحويل النفط إليها. ومن هنا يأتي الاعتقاد الراسخ باستمرار التفوّق التنافسي لوقود السيارات المشتق من النفط الخام.
تظل هذه الفكرة قائمة على الرغم من جميع البراهين التاريخية التي تدحضها. فالبراهين لا تُظهر بأن النفط لم يكن يوماً مُنتَجاً متفوّقاً بالنسبة لأي غرض لفترة طويلة من الزمن فحسب، وإنما تبيّن أيضاً بأن قطاع النفط لم يكن يوماً صناعة متنامية حقاً، بل كان عبارة عن سلسلة متتابعة من الشركات المختلفة التي مرّت بالدورات التاريخية المعتادة من النمو، والنضوج، والاندثار. أمّا بقاء هذه الصناعة على قيد الحياة عموماً فيعود إلى نجاتها المتكرّرة، وبأعجوبة، من الاندثار الكامل، ونجاتها غير المتوقعة بجلدها في اللحظة الأخيرة من الكارثة المحققة التي تشبه الكوارث التي رأيناها في فيلم ذي بيرلز أوف باولين (The Perils of Pauline).
الكوارث التي ألمّت بالبترول. ولكي أوضح قصدي، سوف أستعرض الأحداث الرئيسية فقط. أولاً، كان النفط الخام إلى حدّ كبير عبارة عن دواء حاصل على براءة اختراع. ولكن حتى قبل أن تختفي هذه الموضة، كان الطلب عليه قد اتّسع كثيراً جرّاء استعمال النفط في مصابيح زيت الكاز (الكيروسين). وهذا الاحتمال بإنارة مصابيح العالم مستقبلاً هو ما أدى إلى ازدياد الاعتقاد بذلك النمو الهائل الموعود. وكانت هذه الاحتمالات المستقبلية مشابهة للاحتمالات الموجودة لدى هذا القطاع اليوم بخصوص تنامي استعمال البنزين في أجزاء أخرى من العالم. فهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يقتني كل إنسان في الدول النامية سيّارته الخاصّة.
وفي زمن مصابيح الكيروسين، كانت شركات النفط تتنافس فيما بينها وضد مصابيح الغاز من خلال تحسين الإنارة التي يوفّرها مصباح الكيروسين. وفجأة حصل المستحيل. فقد اخترع إديسون مصباحاً لم يكن يعتمد أبداً على النفط الخام. ولولا تنامي استعمال الكيروسين في المدافئ المنزلية، لكان المصباح الكهربائي المتوهّج قد أجهز تماماً على النفط كصناعة متنامية في ذلك الزمان. ولمَا كان النفط مفيداً إلا لتشحيم محاور العجلات.
ومن ثمّ عادت الكارثة والخلاص منها ليضربا من جديد. فقد شهد العالم حصول اختراعين عظيمين، لا علاقة لأي منهما بقطاع النفط: فالتطوير الناجح لأنظمة التدفئة المركزية المنزلية التي تعمل على احتراق الفحم جعل المدافئ المنزلية تندثر وفي الوقت الذي كان فيه هذا القطاع يترنّح، جاءته أقوى دفعة إلى الأمام يمكن أن يحصل عليها عبر محرّك الاحتراق الداخلي الذي اخترعه أناس من قطاعات أخرى أيضاً. وبعد ذلك، وعندما بدأ التوسّع الهائل في استعمال البنزين يتراجع ويستقرّ أخيراً في عشرينيات القرن، جاء الخلاص بأعجوبة على يدي جهاز التدفئة المركزية الذي يعمل على النفط. ومرّة أخرى، إذن فقد أتّى حبل الإنقاذ من اختراعات طوّرها أناس في قطاعات أخرى. وعندما ضعفت السوق، جاء تزايد الطلب على وقود الطائرات خلال زمن الحرب ليلقي بطوق النجاة. وعقب الحرب، أدّى توسّع الطيران المدني، وتشغيل قطارات السكك الحديدية على الديزل، والتنامي الهائل في الطلب على السيارات والشاحنات، إلى المحافظة على النمو المرتفع في هذا القطاع.
وفي هذه الأثناء، واجهت أنظمة التدفئة المركزية – التي كانت إمكانية ازدهارها المستقبلي قد أعلنت للتو – منافسة شرسة من الغاز الطبيعي. صحيح أن شركات النفط نفسها هي من كان يمتلك الغاز الذي بات الآن ينافس نفطها، إلا أن هذه الشركات لم تكن هي من أطلق ثورة الغاز الطبيعي، ولم تحقق حتى يومنا هذا تلك الأرباح العظيمة من ملكيتها للغاز. وإنما كانت ثورة الغاز قد انطلقت على أيدي شركات نقل الغاز الحديثة العهد التي سوّقت للمنتج باندفاع كبير. وقد أطلقت صناعة جديدة رائعة، أولاً خلافاً لنصيحة شركات النفط، وثانياً في مواجهة مقاومة رهيبة منها.
وبالنظر إلى المنطق الإجمالي لهذا الوضع، نجد بأن شركات النفط هي من كان يجب أن يُطلق ثورة الغاز. فهي لم تمتلك الغاز فحسب، بل كانت الوحيدة التي تعرف كيف تتعامل معه، وتستخرجه، وتستعمله، وكانت الوحيدة التي تمتلك الخبرة في أنابيب الغاز ونقله. كما أنها كانت تفهم مشاكل التدفئة. ولكن بما أن شركات النفط كانت تعلم جزئياً بأن الغاز الطبيعي سينافس مبيعاتها من وقود التدفئة، فقد هزئت بالآفاق المستقبلية للغاز. لكن الثورة كانت قد انطلقت أخيراً على أيدي المدراء التنفيذيين لشركات أنابيب النفط الذين كانوا غير قادرين على إقناع شركاتهم باقتحام قطاع الغاز، فتركوا مؤسساتهم وأنشؤوا شركات في غاية النجاح لنقل الغاز. وحتى بعد أن اتّضح نجاحهم لشركات النفط التي تألمت لذلك، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرّك ساكناً للدخول في مجال نقل الغاز. وهكذا انتقلت مليارات الدولارات التي يدرّها هذا القطاع، والتي كان من المُفترض أن تذهب إلى جيوبها، إلى جيوب الآخرين. وتماماً كما كان الحال في الماضي، فإن ما أعمى بصيرة هذا القطاع هو انشغاله الضيّق بمُنتج محدّد وقيمة احتياطياته التي يملكها، من غير أن يولي اهتماماً كافياً للاحتياجات الأساسية لزبائنه ولخياراتهم المفضّلة.
لم تشهد سنوات ما بعد الحرب أي تغيّر. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، شعر قطاع النفط بالكثير من الأمل تجاه مستقبله نتيجة للزيادة السريعة في الطلب على منتجاته التقليدية. وفي العام 1950، توقّعت معظم الشركات بأن تكون معدّلات التوسّع السنوية بحدود 6% حتى عام 1975 على الأقل. ورغم أن نسبة احتياطيات النفط الخام إلى الطلب في العالم الحر كانت بحدود 20 إلى 1، في وقت كانت فيه النسبة 10 إلى 1 تعتبر عادة نسبة عمل معقولة في الولايات المتّحدة، إلا أن الطلب المزدهر جعل مستكشفي النفط يندفعون بحثاً عن المزيد دون إيلاء الاعتبار الكافي لما وعد به المستقبل حقاً. وفي عام 1952، "وصلوا" إلى الشرق الأوسط؛ وقد ارتفعت نسبة احتياطيات النفط الخام إلى الطلب إلى عنان السماء وبلغت 42 إلى 1. وإذا تواصلت الإضافات الإجمالية إلى الاحتياطيات بالمعدّل الوسطي المسجّل خلال السنوات الخمس الماضية، (37 مليار برميل سنوياً)، فإن نسبة الاحتياطيات بحلول العام 1970 ستبلغ 45 إلى 1. وقد أسهمت هذه الوفرة في النفط في إضعاف أسعار الخام والمنتجات في جميع أنحاء العالم.
يمجد الناس اليوم، وبكل ثقة، قطاعي الكيماويات والإلكترونيات، هذين التوأمين اللذين ينموان بسرعة هائلة، ويصعب على هؤلاء الناس أن يتصوروا إمكان حدوث خطب لهذين القطاعين.
مستقبل يكتنفه الغموض. لا تجد الإدارة عزاءً كبيراً اليوم في التوسّع المتسارع لقطاع البتروكيماويات، وهو أيضاً فكرة أخرى لاستعمال النفط لم تنشأ في الشركات الرائدة. فالحجم الإجمالي لإنتاج البتروكيماويات في الولايات المتّحدة يعادل 2% تقريباً من الطلب على جميع المنتجات البترولية. ورغم أن نسبة النمو المتوقعة حالياً في صناعة البتروكيماويات هي 10% سنوياً، إلا أن ذلك لن يوازن الضغوط الأخرى على نمو استهلاك النفط الخام. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من تعدّد المنتجات البتروكيماوية وتناميها، إلا أن من المهمّ أن نتذكّر بأن هناك مصادر غير نفطية للمواد الخام الأساسية، كالفحم. كما أن الكثير من البلاستيك يمكن إنتاجه بكميات قليلة نسبياً من النفط. إن الحد الأدنى المطلق المطلوب لضمان كفاءة تشغيل أي مصفاة هو أن تكرّر 50 ألف برميل من النفط يومياً. أمّا المعمل الكيماوي الذي ينتج 5 آلاف برميل يومياً فهو يعتبر معملاً ضخماً.
لم يكن النفط يوماً صناعة تسجّل تنامياً قوياً متواصلاً، وإنما شهدت تطوّراً متقطّعاً ومرحلياً، كما أن هذه الصناعة كانت دائماً تجد خلاصها بأعجوبة عن طريق ابتكارات وتطوّرات لم تكن من صنع يدها. ويعود السبب في عدم نموّها السلس والمضطرد إلى أنها في كلّ مرّة كانت تعتقد فيها بأنها تمتلك مُنتجاً متفوّقاً عصيّاً على المنافسة من منتجات أخرى بديلة، كان يتّضح بأن هذا المنتج ليس متفوّقاً على غيره، لا بل هو عرضة للاندثار الكامل والمريع. وحتى الآن، نجا البنزين (المُستخدم كوقود للسيارات في أي حال) من هذا المصير. ولكن كما سنرى لاحقاً، فإنه هو الآخر قد يكون في طريقه إلى الزوال.
كل ما أحاول قوله هنا يهدف إلى الإثبات بأنه ليس هناك من ضمانة تحول دون اندثار أي مُنْتَج. فإذا لم تتسبّب الأبحاث التي تقوم بها الشركة ذاتها في اندثار المُنْتَج، فإن أبحاث شركة أخرى ستتسبب في ذلك. وما لم تكن الصناعة محظوظة، كما هو النفط حتى الآن، فإنها يمكن أن تغرق في بحر من الأرقام الحمراء – تماماً كما حصل مع قطاع السكك الحديدية، وكما جرى مع مصنّعي السياط المستعملة في توجيه الخيول التي تجرّ العربات، ومع سلاسل محلات البقالة الصغيرة، ومع كبريات شركات الأفلام، وتماماً كما حصل مع العديد من الصناعات الأخرى أيضاً.
لكي تكون أي شركة محظوظة فإن الطريقة الفضلى تكمن في أن تصنع حظّها بيدها. وهذا يتطلّب معرفة العوامل التي تقود إلى النجاح في قطاع معيّن. وأحد ألدّ أعداء هذه المعرفة هو الإنتاج الشامل للوحدات المتشابهة وبالجملة.
الضغوط الإنتاجية
تبدو الصناعات التي تقوم على الإنتاج بالجملة (أي إنتاج كميات كبيرة متطابقة من مُنتج معيّن) وكأنها واقعة تحت تأثير دافع قوي يُجبرها على الإنتاج بطاقتها القصوى. كما تجد معظم هذه الشركات نفسها أضعف من أن تقاوم الإغراء الذي يمثّله التراجع الحاد في تكاليف إنتاج الوحدات مع ارتفاع الكميات المُنتَجة، ولا سيما أن احتمالات تحقيق الأرباح نتيجة لذلك تبدو مذهلة. لذلك تنصبّ كل الجهود على الإنتاج. وتكون النتيجة هي إهمال التسويق.
لكن جون كينيث غالبريث يخلص إلى أن العكس تماماً هو الذي يحصل. فالإنتاج يكون استثنائياً في ضخامته إلى حدّ أن كل الجهود تنصبّ على محاولة تصريفه. وهو يقول بأن هذا ما يفسّر انتشار الإعلانات الغنائية، واللوحات الإعلانية في مختلف أرجاء المناطق الريفية، وغير ذلك من الممارسات التي تتّسم بقدر كبير من الهدر والقباحة. وهنا يضع غالبرياث إصبعه على الجرح، لكن النقطة الاستراتيجية تفوته. فالإنتاج بالجملة يقود بالفعل إلى ضغوط هائلة من أجل "تصريف" المُنتج. لكن التركيز عادة ينصبّ على البيع وليس على التسويق. فالتسويق، وهو عملية أعقد وأكثر تفصيلاً من البيع، يكون نصيبه التجاهل.
إن الفرق بين التسويق والبيع هو أكثر من مجرّد اختلاف لغوي في معاني الكلمات. فالبيع يركّز على حاجات البائع، بينما يركّز التسويق على حاجات الشاري. والبيع يحصر همّه في التفكير بحاجة البائع إلى تحويل المنتج إلى أموال نقدية، بينما ينهمك التسويق في الاهتمام بكيفية تلبية احتياجات الزبون عن طريق المُنتج وكل الأشياء المرتبطة بخلق المنتج، وتسليمه، وأخيراً استهلاكه.
في بعض الصناعات، بلغت الإغراءات التي يحملها الإنتاج بالجملة حدّاً كبيراً من القوّة جعل كبار المدراء يقولون لأقسام المبيعات عملياً: "تخلّصوا أنتم من الإنتاج، ونحن سنتولّى أمر الأرباح". وفي المقابل، تحاول الشركة التي تركّز على التسويق بحق أن تخلق منتجات وسلعاً ذات قيمة مرضية تجعل المستهلكين يرغبون في الحصول عليها. فما تعرض الشركة بيعه لا يشمل مجرّد مُنْتَجِ عادي أو خدمة عادية، وإنما كذلك كيف جرى توفيرهما للزبون، وبأي شكل، ومتى، وضمن أي ظروف، وبأي شروط تجارية. والأهم من ذلك، أن ما تعرض بيعه لا يتقرّر من البائع وإنما من الشاري. فالبائع يستقرئ احتياجات الشاري بحيث يصبح المُنْتَج هو إحدى نتائج جهود عملية التسويق، وليس العكس.
ديترويت تتأخّر في اللحاق بالركب. قد يبدو هذا وكأنه قاعدة أولية في العمل، لكن ذلك لا يمنع من أن هذه القاعدة تُخرق على نطاق واسع. بل إنها بالتأكيد تُخرق أكثر ممّا تُحترم. ولنأخذ على سبيل المثال صناعة السيارات.
ففي هذا القطاع يُعتبر الإنتاج بالجملة هو الأشهر، والأكثر عظمة وتبجيلاً، وله أكبر الأثر على المجتمع برمّته. وقد رهن هذا القطاع ثروته بالاشتراطات الكثيرة التي يتطلّبها التغيير السنوي في الطراز، وهي سياسة تجعل التركيز على الزبائن ضرورة ملحّة جداً. وبناءً عليه، تنفق شركات السيارات ملايين الدولارات سنوياً على الأبحاث الخاصة بالمستهلكين. لكن تسجيل السيارات الصغيرة الجديدة لهذا الحجم من المبيعات وخلال السنة الأولى من طرحها في السوق، يشير إلى أن الأبحاث الهائلة التي تقوم بها شركات ديترويت للسيارات قد فشلت منذ زمن بعيد في الكشف عمّا يريده الزبائن حقّاً. فشركات ديترويت للسيارات لم تقتنع بأن الناس يريدون الحصول على أي شيء مختلف عمّا كانوا يحصلون عليه سابقاً، إلا بعد أن خسرت ملايين الزبائن لصالح مصنّعي السيارات الصغيرة الآخرين.
يظهر تاريخ كل صناعة "متنامية"، ماتت أو في طور الاحتار، مرورها بدورة من خداع الذات تشمل توسعاً هائلاً وتقهقراً لم يتم اكتشافه.
فكيف قُدِّرَ لهذا التأخّر الذي لا يُصدّق في فهم رغبات المستهلكين أن يستمرّ لهذه الفترة الطويلة؟ ولماذا لم تكشف الأبحاث عن الخيارات المفضّلة للمستهلكين قبل أن تكشف قرارات الشراء الفعلية لهؤلاء المستهلكين عن الحقائق؟ أليس هذا هو الغرض من إجراء أبحاث المستهلكين – أي معرفة ما الذي سيحصل قبل وقوعه فعلاً؟ الإجابة هي أن ديترويت لم تجرِ أي أبحاث فعلياً لتعرف حاجات المستهلكين. وإنما أجرت أبحاثاً فقط على خياراتهم المفضّلة من بين الأشياء التي كانت قد قرّرت سلفاً تقديمها لهم. والسبب هو أن ديترويت تصبّ تركيزها أساساً على المُنتج وليس على الزبون. بقدر ما تدرك ديترويت بأن لدى الزبائن احتياجات يتعيّن على الجهات الصانعة تلبيتها، تتصرّف عادة كما لو أن المهمّة يمكن إنجازها بالكامل من خلال إدخال تغييرات على المُنتجات. وفي بعض الأحيان، يُولى الاهتمام إلى الجانب المالي أيضاً، لكن ذلك يتمّ من أجل البيع أكثر ممّا يتمّ من أجل تمكين الزبون من الشراء.
بالنسبة لتلبية الاحتياجات الأخرى للزبون، فليس هناك ما يكفي من الأشياء التي تجري ليُكتب عنها. فالمجالات التي تتضمّن أكبر قدر من الاحتياجات غير الملبّاة تحظى بالتجاهل، أو في أحسن الحالات، بقدر لا يُذكر من الاهتمام. وهي تخصّ مراكز البيع ومسائل إصلاح السيارات وصيانتها. تنظر ديترويت إلى هذه المجالات الإشكالية بوصفها ذات أهمية ثانوية. وهذا أمر يمكننا تفهّمه بما أن عمليات البيع وخدمات الصيانة في هذا القطاع غير مملوكة ولا مُدارة من قبل الشركات الصانعة، وليست خاضعة لسيطرتها. فبعد الانتهاء من إنتاج السيّارة، تصبح الأمور في يد وكيل السيارات الذي يفتقر إلى الخبرة. ومن الأمثلة التي تُظهِرُ بجلاء ابتعاد أو انفصال شركات ديترويت عن زبائنها حقيقةُ أنه على الرغم من انطواء خدمات صيانة السيارات على فرص هائلة لتحفيز المبيعات وزيادة الأرباح، إلا أن 57 وكالة فقط، من أصل 7,000 وكالة تبيع سيّارات شيفروليه، تقدّم خدمات الإصلاح والصيانة الليلية.
يعبّر السائقون مراراً وتكراراً عن عدم رضاهم عن خدمات الصيانة، وعن خشيتهم من شراء سيارات بموجب آليات البيع السائدة حالياً. فحالات القلق والتوتر والمشاكل التي يواجهونها خلال عمليات شراء السيارة وصيانتها باتت اليوم ربما أكثر حدّة وانتشاراً ممّا كانت عليه قبل سنوات عديدة. ومع ذلك يبدو بأن شركات السيارات لا تصغي إلى زبائنها الغاضبين ولا تستقي مؤشراتها منهم. وإذا ما أصغت إليهم، فإنها لا تراهم إلا من منظار انهماكها الذاتي بالإنتاج. وهي لا تزال تنظر إلى الجهد التسويقي بوصفه من التبعات الضرورية للمُنتَج، وليس العكس، كما يُفترض أن يكون. وهذا الأمر هو من تركة الإنتاج بالجملة ونظرته الضيّقة القائلة بأن الأرباح تتأّتى بصورة أساسية من الإنتاج بالطاقة القصوى وبتكلفة منخفضة.
ما الذي وضعه هنري فورد في المقام الأوّل؟ من الواضح بأن إغراء تحقيق الأرباح من الإنتاج بالجملة له مكانته المحفوظة في الخطط الإدارية والاستراتيجية لأي شركة، لكنه يجب أن يأتي دائماً بعد التفكير العميق بالزبون. فهذا واحد من أهم الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من السلوك المتناقض لهنري فورد. فإلى حدّ معيّن يمكن القول بأن هنري فورد كان أكثر المسوّقين عبقرية وحماقة في الوقت ذاته في التاريخ الأميركي. كان أحمقَ لأنه رفض أن يقدّم إلى الزبون أي شيء آخر سوى سيّارة سوداء. وكان عبقرياً لأنه صمّم نظام إنتاج يناسب احتياجات السوق. ونحن نحتفي به عادة للسبب الخطأ: أي لعبقريته في الإنتاج. بيد أن عبقرته الحقيقية تكمن في التسويق. ونحن نعتقد بأنه كان قادراً على تخفيض سعر البيع وبالتالي بيع ملايين السيارات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 500 دولار أميركي لأن اختراعه لخط التجميع كان قد قلّل التكلفة. لكنه في الواقع ابتدع خط التجميع لأنه استنتج بأنه قادر على بيع ملايين السيارات بقيمة 500 دولار أميركي. وبالتالي فإن الإنتاج بالجملة كان نتيجة لأسعاره المنخفضة وليس السبب فيها.
لقد شدّد فورد على وجهة نظره مراراً وتكراراً، لكن مدراء الشركات الذين يركّزون على الإنتاج يرفضون الإصغاء إلى الدرس العظيم الذي قدّمه لنا. وإليكم فيما يلي فلسفة عمله التي لخّصها لنا بإيجاز بليغ:
"تقوم سياستنا على تخفيض السعر، وتوسيع العمليات، وتحسين المُنتج. وسوف تلاحظون بأن تخفيض السعر يأتي في المقام الأول. فنحن لم نعتبر يوماً بأن أية تكاليف ثابتة. وبالتالي، فإننا نخفّض السعر أولاً إلى الحد الذي نعتقد بأننا سنحقق عنده المزيد من المبيعات. ومن ثمّ نمضي قدماً ونحاول تحقيق الأسعار. ونحن لا نهتم لشأن التكاليف. فالسعر الجديد يُجبر التكاليف على الهبوط. والطريقة الأكثر شيوعاً تتمثّل في أخذ التكاليف ومن ثم تقرير السعر؛ ورغم أن هذه الطريقة قد تكون علمية بالمعنى الضيّق للكلمة، إلا أنها ليست عملية بالمعنى الواسع لها، فما الفائدة من معرفة التكلفة إذا كانت تخبرك بأنك لن تستطيع تصنيع سلعتك بسعر يمكنك أن تبيعه به؟ ودعوني أقدّم لكم إثباتاً آخر أوضح. صحيح أن المرء قد يتمكّن من حساب التكلفة، وبالتأكيد كل تكاليفنا محسوبة بعناية ودقّة، لكن لا أحد يعلم ماذا يجب أن تكون التكلفة. وهناك طريقة تساعدنا في اكتشاف ذلك. فنحن نقول سعراً معيّناً منخفضاً جدّاً بحيث يضطر الجميع في المكان إلى التفكير في كيفية تحقيق أرفع درجات الكفاءة. والسعر المنخفض يجعل الجميع ينقّبون عن الأرباح تنقيباً. ويساعدنا استعمال هذه الطريقة الإجبارية في تحقيق اكتشافات أكثر بخصوص عمليات التصنيع والبيع، ممّا لو استعملنا أي طريقة استقصائية سهلة أخرى".
الإفراط في التركيز الضيّق على المنتج وحده. يعتبر إغراء تحقيق الأرباح من الإنتاج بالجملة، جرّاء انخفاض تكاليف إنتاج الوحدات، أخطر شكل من أشكال خداع الذات الذي يمكن أن يصيب شركة ما، ولاسيما الشركة "النامية"، وخاصّة أن التزايد المضمون والواضح في الطلب في هذه الحالة يجعل الشركة أميل إلى عدم إيلاء الاهتمام المناسب للتسويق والزبائن.
فماذا تكون النتيجة المعتادة لهذا الانشغال الضيّق بما يُسمى المسائل الملموسة والمحسوسة؟ عوضاً عن أن ينمو القطاع نجده ينحدر. وهذا يعني عادة بأن المُنتَج يفشل في التكيّف مع الأنماط المتغيّرة دائماً لاحتياجات المستهلكين وأذواقهم، أو مع المؤسسات والممارسات التسويقية الجديدة والمعدّلة، أو مع التطوّرات التي تطال المنتجات الأخرى في القطاعات المنافسة أو المُكمّلة. فالقطاع يفرط في التركيز بشدّة على مُنْتَجه الخاص به إلى حدّ لا يعود معه يرى كيف أن منتجه في طريقه إلى الاندثار.
دعونا نأخذ المثال الكلاسيكي لصناعة السياط التي تستعمل في توجيه الخيول التي تجرّ العربات. لا تحسين على هذا المُنتَج ومهما كان كبيراً كان سينقذ هذه الصناعة من حكم الإعدام الذي نزل بها. ولكن لو كانت الصناعة قد عرّفت عن نفسها بأنها تعمل في مجال النقل وليس في مجال صناعة سياط الخيول، فلربما كانت قد ظلت على قيد الحياة. ولكانت قد فعلت ما يحتاج إليه البقاء دائماً – أي التغيّر. فحتى لو اكتفت بالتعريف عن نفسها بأنها قطاع معني بتقديم محفّز إلى مصدر للطاقة، فلربما كانت قد بقيت على قيد الحياة من خلال تصنيع الأحزمة الخاصّة بالمراوح أو أجهزة تنقية الهواء، مثلاً.
وثمّة مثال آخر قد يصبح يوماً ما مثالاً أكثر كلاسيكية حتى، وهو هذه المرّة أيضاً من قطاع النفط. فبما أن هذا القطاع كان قد أفسح في المجال أمام الآخرين كي يقتنصوا منه فرصاً رائعة (ومن ضمنها الغاز الطبيعي، كما شرحت سابقاً؛ ووقود الصواريخ، وزيوت محرّكات الطائرات)، فإن المرء يتخيّل بأن القطاع سيتّخذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار الأمر مجدّداً. لكن ليس هذا هو الحال. فنحن نشهد الآن فرصاً استثنائية ومذهلة لإدخال تطويرات جديدة على أنظمة الوقود ولاسيما تلك المُصمّمة لتشغيل السيارات. والأمر لا يقتصر تَرَكّز أعمال التطوير هذه في شركات تقع خارج صناعة البترول، وإنما نجد أيضاً بأن قطاع البترول وبطريقة شبه منهجية يتجاهلها، مكتفياً بالأمان والرضى الذين يشعر بهما جرّاء نعمة النفط. لكننا هنا ومن جديد أيضاً أمام قصّة مشابهة لقصّة مصباح الكيروسين في مقابل المصباح الكهربائي المتوهّج. فالنفط يحاول تطوير الوقود الأحفوري (الهيدروكربوني) عوضاً عن تطوير أي وقود يناسب احتياجات مستعمليه، سواء أكان مصنوعاً بطرق مختلفة وبمواد مختلفة عن النفط، أم لا.
وفيما يلي بعض الأشياء التي تعمل الشركات غير النفطية عليها حالياً:
- أحرزت أكثر من اثنتي عشرة شركة من هذه الشركات تقدّماً ملموساً خلال عملها على تطوير نماذج للأنظمة الطاقية. وعندما يكتمل بناء هذه الأنظمة، فإنها ستحلّ مكان محرّك الاحتراق الداخلي وتقضي على الحاجة إلى البنزين. والصفة الأهم التي ستميّز كل نظام من هذه الأنظمة هو أنها ستقضي على الحاجة إلى التوقف المتكرّر والمزعج لإعادة التزوّد بالوقود وهو أمر يستنزف الكثير من الوقت. ومعظم هذه الأنظمة المُزمعة هي خلايا وقودية مصمّمة لتوليد الطاقة الكهربائية مباشرة من المواد الكيماوية دون احتراق. ومعظمها يستعمل عناصر كيماوية غير مشتقّة من النفط، هي عموماً هيدروجين وأوكسجين.
- نجحت مجموعة أخرى من الشركات في تطوير نماذج لبطاريات تخزين كهربائية (مدّخرات) مصمّمة لتزويد السيارات بالكهرباء. وإحدى هذه الشركات هي شركة لصنع الطائرات تعمل ضمن مشاريع مشتركة مع عدد من مؤسسات الكهرباء، التي تأمل باستعمال قدراتها في توليد الكهرباء خارج ساعات الذروة لتوفير الكهرباء خلال الليل من أجل إعادة شحن هذه البطاريات. وثمّة شركة أخرى، هي عبارة عن شركة إلكترونيات متوسطّة الحجم، تستعمل أيضاً منهجية البطاريات، استناداً إلى خبرتها الواسعة في مجال البطاريات الصغيرة والتي اكتسبتها من خلال عملها على المُعينات السمعية (أي الأجهزة المساعدة على السمع). وهي حالياً في طور التعاون مع شركة لصناعة السيارات. كما أن التحسينات الحاصلة مؤخراً، والناجمة عن الحاجة إلى أجهزة تخزين طاقة متناهية الصغر وذات طاقة عالية تستعمل في الصواريخ، ستجعل البطارية الصغيرة نسبياً والقادرة على تحمّل أعباء عالية أو ارتفاعات كبيرة في التيّار في متناول يدنا قريباً. وتَعِدُنا تطبيقات وبطاريات ثنائي الجرمانيوم التي تستعمل الصفائح وتقنيات النيكل كادميوم بإحداث ثورة في مصادرنا الطاقية.
- تحظى أنظمة تحويل الطاقة الشمسية باهتمام متزايد. وقد تجرّأ مؤخراً أحد المدراء التنفيذيين في قطاع السيارات في ديترويت، والمعروف بحذره الشديد، على القول بأن السيارات التي تعمل على الطاقة الشمسية قد تصبح شائعة بحلول العام 1980.
أمّا بالنسبة لشركات النفط، فإنها "تراقب التطوّرات الحاصلة" إلى حدٍّ ما، كما أخبرني أحد مدراء الأبحاث. والبعض من هذه الشركات يُجري أبحاثه الخاصّة على الخلايا الوقودية، وإن كانت هذه الأبحاث تقتصر بشكل شبه دائم على تطوير خلايا تعمل على الكيماويات الهيدروكربونية. بيد أن أيّا منها ليس متحمّساً لإجراء الأبحاث على الخلايا الوقودية، أو البطاريات، أو معامل الطاقة الشمسية. كما أن أيّاً منها لا ينفق على هذه المجالات الهامّة للغاية ولو النذر اليسير ممّا ينفقه عادة على الأشياء المعتادة وغير المميّزة مثل تقليل الرواسب في غرفة الاحتراق ضمن محرّكات البنزين. وقد أخذت إحدى شركات البترول المتكاملة الرئيسية زمام المبادرة مؤخراً لدراسة الخلايا الوقودية وخلصت إلى أنه: "على الرغم من أن الشركات تنشط في العمل على هذه الخلايا ممّا يشير إلى اعتقادها بنجاحها في نهاية المطاف، إلى أن التوقيت المُنْتَظر لأثرها وحجم هذا الأثر لازالا أبعد من أن يستدعيا اعترافاً بها في توقعاتنا".
ومن الطبيعي أن يطرح المرء السؤال التالي: «لماذا يتعيّن على شركات النفط أن تعمل بطريقة مختلفة؟ ألن تؤدّي الخلايا الوقودية الكيماوية، أو البطاريات، أو الطاقة الشمسية إلى قتل خطوط الإنتاج الحالية في هذه الشركات؟ والإجابة هي نعم سوف تقتل خطوط الإنتاج الحالية، وهذا بالضبط هو السبب الذي يجب أن يدفع شركات النفط إلى تطوير وحدات الطاقة هذه قبل أن يقوم منافسوها بهذه المهمّة، بحيث لا تصبح شركات دون وجود قطاع تنشط فيه.
وقد تكون الإدارة أقدر على فعل ما هو مطلوب منها للمحافظة على ذاتها إذا نظرت إلى نفسها على أنها تنشط في مجال الطاقة. لكن ذلك حتى لن يكون كافياً إذا أصرّت على حصر نفسها في نطاق ضيّق من خلال التركيز على مُنْتَجِها فقط. وهي يجب أن تنظر إلى نفسها على أنها تهتم بتلبية احتياجات الزبائن، وليس بالعثور على النفط أو تكريره أو حتى بيعه. وحالما تعتبر بصدق بأن عملها يتمثّل في تلبية احتياجات الناس في مجال النقل، فلا شيء سيكون قادراً على منعها من أن تخلق نموّها الذي سيدرّ عليها أرباحاً طائلة.
التدمير الخلاق. بما أن الأقوال أسهل من الأفعال، قد يكون من المناسب أن أشير إلى عواقب هذا النوع من التفكير وما يقود إليه. دعونا ننطلق من البداية: أي من الزبون. يمكننا أن نثبت بوضوح أن السائقين يمقتون تجربة شراء البنزين وما يرافقها من إزعاج وتأخير. لكن الناس لا يشترون البنزين فعلياً. فهم لا يستطيعون رؤيته، أو تذوّقه، أو الشعور به، أو تقديره، أو حتى اختباره عملياً. فما يشترونه فعلياً هو الحق في مواصلة قيادة سياراتهم. ومحطة الوقود بالنسبة لهم تشبه جابي الضرائب الذي يضطر الناس إلى دفع رسم دوري إليه كثمن لاستعمال سياراتهم. وهذا الأمر يحوّل محطة الوقود عملياً إلى مؤسسة لا تحظى بالشعبية. ولا يمكن أبداً تحويلها إلى مؤسسة شعبية أو ممتعة، وإنما يمكن فقط تقليل عدم شعبيتها وكراهيتها.
إن التقليل من عدم شعبيتها بالكامل يعني التخلّص منها. فلا أحد يحب جابي الضرائب، حتى لو كان شخصاً ودوداً وبشوشاً. ولا أحد يحب أن يقطع رحلته ليشتري منتجاً وهمياً، ولا حتى من رجل شديد الوسامة مثل إله الجمال أدونيس أو امرأة شديدة الفتنة مثل إلهة الجمال فينوس. وبالتالي، فإن الشركات التي تعمل على إنجاز بدائل غريبة للوقود تلغي الحاجة إلى إعادة التزوّد الدورية بالوقود، تتّجه مباشرة إلى أحضان السائقين المزعوجين الذين فتحوا أذرعتهم على وسعها لاستقبالها واحتضانها. إنهم يركبون موجة الحتمية؛ لا لأنهم يصنعون شيئاً متفوّقاً من الناحية التكنولوجية أو أكثر تعقيداً، ولكن لأنهم يلبّون حاجة قوية لدى الزبائن. كما أنهم يقضون على الروائح الكريهة وتلوّث الهواء.
وعندما تدرك شركات البترول منطق إرضاء الزبون الذي يمكن أن يكون موجوداً في أنظمة الطاقة الأخرى، ستكتشف بأن لا خيار أمامها سوى العمل على إنتاج وقود فعال ويدوم طويلاً (أوعلى طريقة لتزويد السائقين بالوقود الحالي دون إزعاجهم)، تماماً كما لم يكن هناك من خيار أمام سلاسل متاجر الأغذية الصغيرة سوى الدخول في مجال السوبرماركت، وتماماً كما لم يكن أمام شركات الصِمَام المُفرَّغ (Vacuum tube) سوى صنع أنصاف النواقل. إذن يتعيّن على شركات النفط، وخدمة لمصلحتها الذاتية، أن تدمّر أصولها التي تدرّ عليها أرباحاً طائلة. فالتمنّيات لن تستطيع أن تنقذها من ضرورة الانخراط في هذا النوع من «التدمير الخلاق".
لقد عبّرت عن هذه الحاجة بأقوى العبارات لأنني أعتقد أن الإدارة بحاجة إلى أن تبذل جهوداً هائلة كي تنأى بنفسها عن الطرق التقليدية التي تتّبعها. فلازال من اليسير جدّاً في هذا الزمان على أي قطاع أو شركة أن يدع الوفر الذي يحققه في عمليات الإنتاج بالجملة يهيمن على غاياته في العمل، وأن يعمل وفق رؤية خطرة بسبب إفراطها في الانحياز إلى المُنتَج. باختصار، إذا تركت الإدارة نفسها عرضة للتيّار كي يجرفها، فإنها ستنجرف حتماً باتجاه النظر إلى نفسها على أنها تنتج السلع والخدمات، وليس على أنها تعمل على إرضاء الزبائن. ربما قد لا تنحدر إلى الدرك الذي يجعلها تقول لمندوبي المبيعات: «تخلّصوا أنتم من الإنتاج، ونحن سنتولّى أمر الأرباح"، لكنها، ودون أن تعلم ذلك، ربما تمارس هذه الصيغة بحذافيرها، وهي في طريقها إلى الأفول لتلقى حتفها في النهاية. لقد كان القدر التاريخي للصناعات النامية واحدة تلو الأخرى هو الانغماس إلى حدّ الانتحار في التركيز المفرط والضيّق على المُنتج.
مخاطر الأبحاث والتطوير
ثمّة خطر كبير آخر يتهدّد استمرار النمو في أي شركة، وهو ينشأ عندما تكون الإدارة العليا مفتونة بالكامل باحتمالات تحقيق الأرباح نتيجة لأعمال البحث التقني والتطوير. ولكي أوضح قصدي، فإنني سأنتقل أولاً للحديث عن قطاع جديد هو صناعة الإلكترونيات، ومن ثمّ أعود مجدّداً إلى شركات النفط. وآمل من خلال المقارنة بين مثال حديث وآخر مألوف، أن أسلّط الضوء على سعة انتشار هذه الطريقة الخطرة في التفكير ومدى مكرها.
التسويق لا يحصل على مكانته المُستحقة. في حالة الإلكترونيات، يمكن القول بأن أكبر خطر يتهدّد الشركات الجديدة المرموقة في هذا المجال لا يتعلّق بعدم إيلائها البحث والتطوير القدر الكافي من الاهتمام، وإنما بإيلائهما اهتماماً زائداً عن اللزوم. كما أن الحقيقة المتمثّلة في كون شركات الإلكترونيات الأسرع نمواً مدينة في تفوّقها هذا إلى تركيزها الكبير على الأبحاث التقنية، هي حقيقة تقع خارج نطاق بحثنا بالكامل.
فقد قفزت تلك الشركات إلى عرش الثراء بعد صعودها المفاجئ إلى القمّة جرّاء حالة من التقبّل العام القوي وغير المعتاد للأفكار التقنية الجديدة. كما أن نجاحها كان مشفوعاً بسوق مضمونة عملياً من المساعدات العسكرية والطلبيات العسكرية والتي سبقت في حالات كثيرة وجود منشآت لتصنيع المنتجات. وبعبارة أخرى، فإن توسّعها كان خالياً بالكامل تقريباً من أي جهد تسويقي.
وبالتالي فإنها تحقّق نمواً ضمن شروط وظروف تقترب اقتراباً خطيراً من حدّ التوهّم بأن منتجاً متفوّقاً سيبيع نفسه بنفسه. وبما أن الإدارة قد أنشأت شركة ناجحة من خلال صنع منتج متفوّق، فمن غير المفاجئ أن تستمر هذه الإدارة في التركيز على المنتج عوضاً عن الناس الذين سيستهلكونه. وهي تعتنق الفلسفة القائلة بأن تواصل النمو هو مسألة استمرار في عملية الابتكار والتحسين في المُنتَج.
وهناك عدد من العوامل الأخرى التي تعزّز هذا الاعتقاد وتمدّه بأسباب البقاء:
- بما أن المنتجات الإلكترونية تتّسم بالتعقيد الشديد، فإن الإدارة العليا تزدحم بالمهندسين والعلماء. وهذا الأمر يخلق حالة من الانحياز الانتقائي لصالح الأبحاث والإنتاج على حساب التسويق. والمؤسسة تميل إلى أن تنظر إلى نفسها بوصفها مؤسسة تصنع الأشياء وليس مؤسسة تلبّي احتياجات الزبائن. ويجري التعامل مع التسويق على أنه أحد النشاطات الثانوية أو الجانبية أو على أنه "شيء آخر" يجب إنجازه بعد استكمال الوظيفة الحيوية المتمثّلة بخلق المنتج وإنتاجه.
- وإلى جانب الانحياز لصالح الأبحاث الجارية على المُنْتَج، وعلى تطويره، وعلى عملية إنتاجه، فإن هناك انحيازاً آخر يُضاف إليه لصالح التعامل مع متغيّرات يمكن التحكّم بها. فالمهندسون والعلماء يشعرون بأنهم في ملعبهم المفضّل عندما يتعاملون مع أشياء ملموسة مثل الآلات، وأنابيب الاختبار، وخطوط الإنتاج، وحتى الميزانيات. أمّا المفاهيم المجرّدة التي يكنّون لها بعض المودّة فهي الأمور القابلة للاختبار أو التلاعب بها في المختبر، وإذا لم تكن قابلة للاختبار، فيجب أن تكون ذات وظيفة معيّنة مثل بديهيات الهندسة الإقليدية. باختصار، تميل إدارات هذه الشركات الجديدة التي تسجّل نمواً ملفتاً إلى تفضيل النشاطات التجارية القابلة للدراسة الحذرة، والتجريب، والضبط، والأكثر ارتباطاً بالوقائع العملية للمختبر والمتجر والكتب.
لكن الوقائع العملية للسوق لا تنال نصيبها من الاهتمام. فالمستهلكون يتّسمون بأنهم غير قابلين للتنبّؤ، وهم متنوّعون، ومتقلّبو المزاج، وأغبياء، ويتمتّعون بقصر النظر، وعنيدون، ومثيرون للمتاعب عموماً. ليس هذا ما يقوله المدراء المهندسون بحقهم، لكن هذا ما يؤمنون به في أعماق وعيهم. وهذا ما يفسّر تركيزهم على ما يعلمونه وما يستطيعون التحكّم به، وتحديداً أبحاث المنتجات، وهندستها، وإنتاجها. ويكتسب التشديد على الإنتاج جاذبية خاصّة عندما يكون من الممكن صنع المُنتج بتكاليف إنتاج متناقصة لكل وحدة. فليس هناك من طريقة أكثر جاذبية لكسب المال من تشغيل المعمل بطاقته الإنتاجية القصوى.
يمكن القول بأن هذا التوجّه القوي نحو التركيز على الجوانب العلمية والهندسية والإنتاجية الموجود لدى الإدارات العليا في العديد من شركات الإلكترونيات ينجح إلى حدّ ما هذه الأيام، لأن هذه الشركات تحاول اختراق حدود جديدة خلقت فيها القوّات المسلّحة أسواقاً شبه مضمونة. كما أن هذه الشركات تجد نفسها في موقع رائع فهي مضطرة لملء الأسواق، وليس إيجادها، وهي ليست مضطرة إلى اكتشاف احتياجات الزبون ورغباته، وإنما تجد الزبون نفسه يتطوّع بالقدوم إليها مقدّماً مطالبه المحدّدة التي تخصّ المُنتجات الجديدة. فلو أن فريقاً من الاستشاريين كان قد كُلِّفَ تحديداً بمهمّة تصميم وضع تجاري محسوب بدقّة لمنع ظهور وتطوّر وجهة نظر تسويقية تركّز على الزبون، لما كان هذا الفريق ليتمكّن من خلق ظروف أفضل من الظروف التي وصفتها لتويّ.
معاملة ابن الجارية. يُعتبر قطاع النفط مثالاً مذهلاً يبيّن كيف يمكن للعلم والتكنولوجيا والإنتاج بالجملة أن يحرفوا مجموعة كاملة من الشركات عن مهمّتها الرئيسية. فتركيز شركات النفط هذه ينصبّ وإلى الأبد على استجرار المعلومات التي تُساعدها في تحسين ما تقوم به الآن، إلى حدّ أنها لا تدرس المستهلك على الإطلاق (وهو أمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد). فهي تحاول استكشاف المزيد من الإعلانات المُقنِعة، والمزيد من الحملات الترويجية الفعّالة في أقسام المبيعات، وما هي الحصص السوقية للشركات المختلفة، وما الذي يحبّه الناس أو لا يحبّونه في وكالات محطات الوقود وشركات النفط، وهكذا دواليك. فلا أحد يبدو مهتمّاً بالسبر العميق للاحتياجات الإنسانية الأساسية التي يعمل هذا القطاع ربما على تلبيتها، بقدر اهتمامه بسبر المواصفات الأساسية للمواد الخام التي تنتجها الشركات في مسعى منها لإرضاء الزبائن.
ونادراً ما تُطرح الأسئلة الأساسية المتعلّقة بالزبائن والأسواق. فهذه المسائل تحظى بمعاملة تشبه معاملة ابن الجارية. والجميع يقرّون بوجودها، وبضرورة الاهتمام بها، لكنهم لا يعتبرون بأنها تستحق الكثير من التفكير أو الاهتمام الحقيقيين. وليس هناك من شركة نفط تشعر بالإثارة تجاه زبائنها الذين يعيشون في محيط منطقة عملها بقدر الإثارة التي تحسّ بها تجاه النفط الموجود في الصحراء الإفريقية. ولا شيء يمكنه أن يوضح مدى إهمال التسويق أفضل من كيفية التطرّق إلى هذا الموضوع في صحافة قطاع النفط.
فالعدد الصادر من "المجلة الفصلية لمعهد البترول الأميركي" (American Petroleum Institute Quarterly) عام 1959، احتفاءً بالذكرى المئوية لاكتشاف النفط في تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا (Titusville, Pennsylvania) تضمّن 21 مقالة تستعرض عظمة هذا القطاع. وقد تطرّقت مقالة واحدة من هذه المقالات فقط إلى الإنجازات المتحققة في مجال التسويق، ولم تكن سوى سجل مصوّر يُظهر كيف تغيّر شكل الهندسة المعمارية في محطّات الوقود. كما احتوى العدد أيضاً على قسم خاص "بالآفاق الجديدة"، والذي خُصِّص لتبيان الدور الرائع الذي سيلعبه النفط في مستقبل أمريكا. وكانت كل إشارة ترد في المقالة تنضح بالتفاؤل ولم تحتوِ أي إشارة، ولو ضمنية، إلى احتمال مواجهة النفط لمنافسة شرسة. بل وحتى الإشارة إلى الطاقة النووية جاءت في معرض تعداد الفضائل التي يمكن أن يقدّمها النفط إلى الطاقة النووية ليساعدها على النجاح. ولم تكن هناك أي خشية من أن يتعرّض ازدهار هذا القطاع للخطر، أو أي تلميح إلى أن واحداً من تلك "الآفاق الجديدة" قد يشمل طرقاً جديدة أفضل لتخديم زبائن النفط الحاليين.
لكن أوضح وأقوى مثال على هذه المعاملة التي يحظى بها التسويق، والشبيهة بمعاملة ابن الجارية، نراه في سلسلة أخرى خاصّة من المقالات القصيرة حول "الإمكانيات الثورية للإلكترونيات". وتحت هذا العنوان، ظهرت قائمة المقالات في فهرس المحتويات:
"بحثاً عن النفط"
"في عمليات الإنتاج"
"في عمليات التكرير"
"في عمليات الأنابيب"
والملفت في الأمر أن كل مجال من المجالات الوظيفية الرئيسية في هذا القطاع مذكور، باستثناء التسويق. لماذا؟ إمّا لأن هناك اعتقاداً بأن قطاع الإلكترونيات لا ينطوي على أي إمكانيات ثورية في مجال تسويق البترول (وهذا خطأ صريح)، أو لأن محرّري المقالات نسوا مناقشة التسويق (وهو الأرجح ممّا يظهر معاملة ابن الجارية التي يتلقاها التسويق).
كما أن الترتيب الذي ترد فيه المجالات الوظيفية الأربعة يفضح مدى غربة قطاع النفط عن المستهلك. فهذه الصناعة تعرّف نفسها ضمنياً على أنها تبدأ بالبحث عن النفط وتنتهي بتوزيعه من المصافي. لكن في حقيقة الأمر، يبدو بالنسبة لي بأن هذه الصناعة تبدأ بحاجة المستهلك إلى منتجاتها. ومن هذا الموقع الأساسي ينتقل التعريف عائداً باضطراد إلى الوراء نحو مجالات تقل أهميتها بالتدريج حتى يصل أخيراً ويستقر عند البحث عن النفط.
البداية والنهاية. تُعتبرُ النظرة التي ترى بأن أي صناعة هي عملية لإرضاء الزبائن، وليست عملية لإنتاج السلع، نظرةً في غاية الحيوية يتعيّن على جميع رجال الأعمال استيعابها. فأي صناعة تبدأ مع الزبون واحتياجاته، وليس مع براءة اختراع، أو مادّة خام، أو امتلاك مهارة في البيع. وبالتالي فإن الصناعة وبعد أن تتعرّف على احتياجات الزبون، تأخذ بالتطوّر إلى الخلف، بحيث تنشغل أولاً بتوفير الرضى الفعلي للزبائن. ومن ثم تنتقل خطوة إضافية إلى الوراء لخلق الأشياء التي تحق ق جزئياً هذا الرضى لدى الزبائن. أمّا كيف تُصنَّع هذه المواد فهو أمر لا يعني الزبون لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لا يمكن اعتبار الطريقة المحدّدة المستعملة في التصنيع أو العمليات أو أي شيء آخر تمثّل جانباً حيوياً في عملية التصنيع. أخيراً، تنتقل الصناعة خطوة إضافية أخرى إلى الوراء لتوْجِدَ المواد الخام الضرورية لصنع منتجاتها.
وتكمن المفارقة في بعض الصناعات التي تصبّ جلّ اهتمامها على البحث التقني والتطوير، في أن العلماء الذين يشغلون المناصب التنفيذية العليا ليسوا علميين على الإطلاق عندما يتعلّق الأمر بتعريف الحاجات والغايات الإجمالية لشركاتهم. فهم يخرقون أول قاعدتين من قواعد المنهج العلمي، ألا وهما: إدراكهم لمشاكل الشركة وتعريف هذه المشاكل، ومن ثم وضع فرضيات قابلة للقياس بخصوص حلها. وهم لا يتمتّعون بالعملية إلا عندما يتعلّق الأمر بالأشياء السهلة والمريحة مثل التجارب المخبرية والتجارب التي تجري على المُنتج.
لا يَعتَبِرُ هؤلاء المدراء بأن الزبون (وتلبية احتياجاته العميقة) هو "المشكلة" – ليس لأن لديهم أي اعتقاد راسخ بعدم وجود هكذا مشكلة، وإنما لأن الحياة التي قضتها هذه الإدارات في المؤسسات قد عوّدتها على النظر في الاتجاه المعاكس. فالتسويق يحظى بمعاملة تشبه معاملة ابن الجارية.
أنا لا أقصد بأنهم يتجاهلون البيع. فهم أبعد ما يكونون عن ذلك. وإنما أعيد القول بأن البيع يختلف عن التسويق. وكما سبق وأشرت، فإن البيع يهتم بالخدع والتقنيات التي تجعل الناس يستبدلون نقودهم بمنتجك. والبيع لا يهتم بالقيم التي تشكّل جوهر عملية التبادل هذه. وهو لا ينظر إلى مجمل العملية التجارية على أنها تتكوّن من جهود متكاملة بإحكام لاكتشاف حاجات الزبائن، وخلقها، وتحفزيها وتلبيتها، بينما نجد التسويق من جهة أخرى يمتلك هذه النظرة دوماً وفي كل الأحوال. فالزبون في نظر البيع هو شخص ما "موجود في هذا العالم"، يمكن، وباستعمال قدر مناسب من الدهاء، سحب المال السائب من جيبه.
لا بل يمكن القول فعلياً بأن البيع ذاته لا يحظى بالكثير من الاهتمام في بعض الشركات ذات الذهنيات التي تركّز على التكنولوجيا فقط. فبما أن هناك سوقاً شبه مضمونة لبضائعها الجديدة المتدفقة، فإنها لا تعرف فعلياً ما الذي تعنيه السوق الحقيقية. فالأمر يبدو وكأن هذه الشركات تعيش في اقتصاد موجّه، لا تحتاج فيه سوى إلى نقل بضائعها من المصنع إلى متاجر التجزئة. وتركيزها الناجح على المنتجات يقنعها عادة بسلامة الطريق الذي تسير عليه، وهي تُخفق في رؤية الغيوم التي تتلبّد في سماء السوق.
قبل أقل من 75 عاماً، كان قطاع السكك الحديدية الأميركي يحظى بولاء قوي لدى الدهاة من محللي وول ستريت. فالملوك الأوروبيون كانوا قاد استثمروا في هذا القطاع استثمارات هائلة. وقد ساد الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه جمع بضعة آلاف من الدولارات ليستثمرها في أسهم السكك الحديدية ستحلّ عليه بركة الثروة الأبدية. فلم يكن هناك أي شكل آخر للنقل بوسعه أن ينافس السكك الحديدية في سرعتها، ومرونتها، وديمومتها، واقتصادها، وإمكانيات نموّها المستقبلية.
وقد عبّر جاك بارزون عن هذا الأمر قائلاً: "مع حلول بداية القرن، باتت السكك الحديدية مؤسسة، وصورة تعبّر عن الإنسان، وتقليداً، وسجل شرف، ووحياً يُلهم الشعراء، وحاضنة أحلام الطفولة، وأجمل الألعاب، وأبدع الآلات التي– إلى جانب عربات دفن الموتى – تميّز الحقب الأساسية في حياة الإنسان".
وحتى بعد دخول السيارات، والشاحنات، والطائرات، ظل ملوك السكك الحديدية واثقين بأنفسهم ثقة راسخة لا تتزعزع. ولو أنك أخبرتهم قبل 60 عاماً بأنه بعد 30 عاماً سيصبحون مفلسين، و"على الحديدة" كما يقال بالعاميّة، وسيستجدون الدعم من الحكومة، لاتهموك بالجنون المطلق. فهذا المستقبل لم يكن، ببساطة، وارداً في حسبانهم على الإطلاق. لا بل إن الأمر لم يكن موضوعاً قابلاً للنقاش أصلاً، أو سؤالاً جائز الطرح، أو مسألة يمكن لأي إنسان عاقل أن يفكر في وضع تخمينات بشأنها. لكن الكثير من المفاهيم "المجنونة" باتت الآن مقبولة كأمر واقع ومنها، على سبيل المثال، فكرة وجود أنابيب معدنية يبلغ وزنها 100 طن تتحرّك بسلاسة في الهواء على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، محمّلة بمئة مواطن بكامل قواهم العقلية يحتسون المشروبات، موجهة إلى السكك الحديدية، دون رحمة، ضربة قاصمة.
فما هي الأشياء المحدّدة التي يتعيّن على الشركات الأخرى فعلها لتحاشي هذا المصير؟ ما الذي يستوجب التركيز على الزبائن فعله وما الذي يعنيه؟ لقد أجابت بعض الأمثلة والتحاليل السابقة جزئياً عن هذين السؤالين. وسيحتاج الأمر إلى مقالة أخرى لتبيّن بالتفصيل ما هي الأمور المطلوبة في صناعات محدّدة بعينها. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون واضحاً بأن بناء شركة فعّالة تركّز على الزبائن يحتاج إلى أكثر من مجرّد نوايا حسنة أو خدع ترويجية؛ إنه يستدعي وجود مسائل جوهرية مثل مؤسسة تتمتّع بالحس الإنساني والقيادة. ولكن في الوقت الحاضر، دعوني أقترح ما يبدو على أنه بعض الاشتراطات العامّة:
الشعور الدفين بالعظمة. يتعيّن على الشركة وبكل وضوح أن تفعل ما يحتاجه البقاء. أي يجب عليها أن تتكيّف مع متطلّبات السوق، ويجب أن تقوم بذلك عاجلاً وليس آجلاً. لكن السعي إلى مجرّد البقاء ليس إلا طموحاً مقبولاً على مضض. فأي إنسان قادر على البقاء بطريقة أو أخرى، حتى المشرّدين الذين لا يجدون الطعام والمأوى. لكن التحدّي يكمن في كيفية البقاء بنبل وشهامة، والإحساس بالنبض المتنامي للتفوّق التجاري: ليس فقط تذوّق حلاوة النجاح، وإنما امتلاك ذاك الشعور الدفين بعظمة ريادة الأعمال.
ليس هناك من مؤسسة قادرة على الوصول إلى العظمة دون قائد قوي يمضي قدماً مدفوعاً بإرادة النجاح. والقائد يجب أن يتحلّى برؤية ثاقبة، أي رؤية قادرة على أن تحشد وراءه أتباعاً كثراً توّاقين لتجسيد هذه الرؤية. وفي قطاع الأعمال، الأتباع هم الزبائن.
ولكي تتمكّن أي مؤسسة من صنع هؤلاء الزبائن، ينبغي أن يُنظر إلى هذه المؤسسة بأكملها على أنها كيان ينتج الزبائن ويلبيّ احتياجاتهم. ويتعيّن على الإدارة ألا تنظر إلى نفسها بوصفها جهة تنتج المنتجات وإنما بوصفها مؤسّسة تلبي القيمة التي ستسهم في خلق الزبائن. يجب على الإدارة تعميم هذه الفكرة (وكل ما تعنيه وتستدعيه) في كل ركن وزاوية في أنحاء المؤسسة. وهذا التذكير يجب أن يكون مستمرّاً وعلى قدم وساق وبطريقة تحفّز الناس وتشحذ هممهم. وإلا فإن الشركة ستتحوّل إلى سلسلة من الأقسام والأجزاء المنفصلة التي لا يجمعها جامع ولا يوحّدها هدف أو غاية تقودها في الاتجاه المطلوب.
باختصار، ينبغي على المؤسسة أن تتعلّم كيف تنظر إلى نفسها لا بوصفها مُنْتِجَاً للسلع أو الخدمات، وإنما بوصفها تشتري الزبائن، وتقوم بالأشياء التي ستجعل الناس يريدون المتاجرة معها. وهناك مسؤولية لا مفرّ منها تقع على عاتق الرئيس التنفيذي الذي يتعيّن عليه خلق هذه البيئة، وهذا الموقف، وهذا الطموح، ووجهة النظر هذه. والرئيس التنفيذي يجب أن يُحدِّد أسلوب الشركة، واتجاهها، وأهدافها. وهذا يقتضي منه أن يعرف بدقّة إلى أين يريد المضي، وأن يعرف بدقة إلى أين يريد المضي، مع ضمان أن تكون المؤسسة بأكملها مدركة لهذا الاتجاه ومتحمسة له. هذا هو الشرط الأساسي للقيادة لأنه ما لم يعرف القائد إلى أين هو ماضٍ، فأي طريق ستقوده إلى هناك.
وفي نهاية الحديث عن قصر النظر التسويقي لدى الشركات، إذا كان أي طريق مقبولاً، فلم لا يمتشق الرئيس التنفيذي حقيبة العمل ويذهب ليصيد السمك؟ وإذا كانت المؤسسة لا تعلم إلى أين هي ذاهبة أو لا يهمّها الأمر، فإنها ليست مضطرة إلى الإعلان عن تلك الحقيقة عبر رئيس صوري يكون في الواجهة. فالجميع سيلحظون ذلك عاجلاً وليس آجلاً.