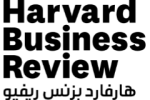لطالما مثّل ستيف جوبز حالة استثنائية في مجال الإدارة، وكان أسلوب قيادته محطّ إعجاب أو انتقاد في الوقت نفسه، لكنه دون أن يكون موضوع تقليد بالتأكيد، إذ لم يتلاءم أسلوبه مع أطر العمل المرجعية وظل هناك دائماً فرق بين الإدارة التقليدية وإدارة ستيف جوبز.
والسبب الذي جعل نظريات الإدارة التقليدية تنظر إلى أسلوب جوبز باعتباره حالة استثنائية هو أنه كان يعمل في مجال غامض بالنسبة إلى الإدارة، أي مجال إضفاء المعنى سواء على رغبات العملاء أو عمل الموظفين.
فوضعهم جوبز في مركز أهدافه، لكن ذلك لم يعنِ قطّ أنه أعطى للمستخدمين ما يريدونه، ولا أنه أنشأ مؤسسة ذات هيكل إداري مسطح يسودها المرح، وتتدفق فيها الأفكار من الأسفل إلى الأعلى. ولم يكن نهج شركة آبل في مجال الابتكار موجهاً قطّ بما يريده المستخدمون. كما أنها لم تكن تصغي إليهم بقدر ما كانت تطرح عليهم بعض المقترحات. وما تزال القصص المروية عن تجربة قيادة جوبز تتحدث عن نهجه الإداري الرأسي والتنازلي الذي تغلب عليه الصرامة، إذ كان جوبز مثلاً بطل إطلاق المنتجات الجديدة وليس فريقه.
ويقدّر أسلوب “الإدارة بالمعنى” الطابع الإنساني للموظفين وأبعادهم العقلانية والثقافية والعاطفية، وأنهم يقدّرون الشخص الذي يعطي لعملهم معنى يتبنونه. ونحن نعلم أن العملاء لا يشترون منتج آبل لمجرد أنه مفيد أو وظيفي، بل إنهم يميلون إلى التغاضي عن بعض القيود التقنية التي تفرضها هذه العلامة التجارية مقابل ذلك التصميم الرائع وتلك الهوية التي تميز منتجاتها. ولم يكن التصميم بالنسبة إلى جوبز مسألة جمالية فقط، بل كانت غايته خلق معانٍ جديدة لتجربة المستخدمين.
كان جوبز مدفوعاً دائماً بالبحث عن منتجات تقدم المزيد من المعنى لتجربة العملاء. وقد كانت شركة آبل رائدة حقيقية في مجال ابتكار منتجات ذات معنى، فجهاز آي ماك جي 3 (iMac G3) الصادر سنة 1988 بمواده ذات الألوان الشفافة المستوحاة من المنتجات المنزلية الحديثة غيّر معنى أجهزة الكومبيوتر وحوّلها من أجهزة مكتبية إلى أجهزة منزلية. أما أجهزة آيبود (iPod) وتطبيق آي تيونز (iTunes) وسوقه الرقمي فقد خلقت معنى جديداً في مجال الوصول إلى القطع الموسيقية من خلال تسهيل البحث عنها واكتشافها وشرائها والاستماع إليها وتنظيمها، أينما كان العميل الذي يستخدمها، بينما غيّر جهاز آيفون معنى الهواتف الذكية وانتقلت من مجرد أدوات للعمل لتصبح أدوات للترفيه الاجتماعي. ولم تكن هذه المنتجات الأفضل بالضرورة بين نظيراتها على مستوى الأداء، لكنها كانت ذات معنى أكبر بالنسبة إلى المستخدمين.
وقد قدّم جوبز هذا المعنى نفسه لموظفيه، إذ من المعروف أنهم عملوا بجد في مشاريع ذات رؤية مستقبلية، وسعوا جاهدين إلى تحقيق أهداف قائدهم وإرضاء اهتمامه الجنوني بالتفاصيل. لقد غرس فيهم جوبز حس الالتزام بالمهام، وكان على آبل أن تضع بصمتها في عالم الحوسبة الشخصية، وتسهّل حياة المستخدمين، وتتحلّى بالجرأة وتفكر طبعاً “بطريقة مختلفة”.
وغالباً ما رفض الخبراء والأكاديميون في كليات إدارة الأعمال هذا النهج لأنه يمثل حصيلة شخصية ستيف جوبز الفريدة، وشكلاً من أشكال “نهج المرشدين الروحيين” كما قال لي أحد الزملاء ذات مرة. وليس من الممكن اعتباره نموذجاً يُحتذى به، لأن الإدارة المؤسسية متأصلة في مجالات التحليلات المحوسبة والهندسة والعلوم الاجتماعية. ولم يكن جوبز يحتقر هذه العلوم، لكن المعنى في اعتقاده كان مرتبطاً بمجالات أخرى أكثر نسبية كالثقافة والعلوم الإنسانية، التي لا يكاد يتقنها أساتذة كليات إدارة الأعمال للأسف إلا بصعوبة. وهكذا صرّح جوبز خلال إحدى المقابلات الصحفية أن: “المشكلة الوحيدة التي تواجهها شركة مايكروسوفت هي انعدام الذوق تماماً. أقصد على وجه التحديد أن إدارة مايكروسوفت لم تضفِ على منتوجاتها ما يكفي من العناصر الثقافية، فخطوط الكتابة الحاسوبية في برامجها على سبيل المثال نابعة بالأساس من تقنيات صف الحروف والكتب الجميلة”. وقال في خطابه الرئيسي الذي ألقاه سنة 2010 عند إطلاق جهاز آيباد: “إن سبب تمكننا من ابتكار منتجات كهذه هو أننا حاولنا دائماً أن نقف في نقطة التقاطع بين التكنولوجيا والفنون الحرة”.
ويتخوف المشرفون على الإدارة المؤسسية من الثقافة والعلوم الإنسانية، لأنها غير قابلة للقياس ولا يمكن تشفيرها. كما أنها تظل ذات طبيعة فردية. وقد علّمنا جوبز أن المدراء هم بشر قبل أن يكونوا مدراء، لديهم رؤية شخصية للعالم، طوروها بشق الأنفس على مدار حياة كاملة من البحث والاستكشاف. فلماذا يجب عليهم أن يتجاهلوا الثقافة؟ وفي غياب منهجية أو أداة أو عملية يمكن أن تعطيك القدرة على خلق المعنى والرؤية، فإن ثقافتك الشخصية وحدها هي القادرة على ذلك.
وقد أثبت جوبز أن الأعمال التجارية لا تتعارض مع الثقافة بل يكمّل بعضها بعضاً. لذا ألم يحن الوقت بعد كي نعدّ نهج جوبز نموذجاً يُحتذى به بدلاً من اعتباره مجرد حالة استثنائية؟ ألا يمكن أن يصبح نهج جوبز نهجاً مؤسسياً وتصبح “الإدارة بالمعنى” بمثابة الفصل الأساسي في مستقبل الأطر المرجعية لعلم الإدارة؟