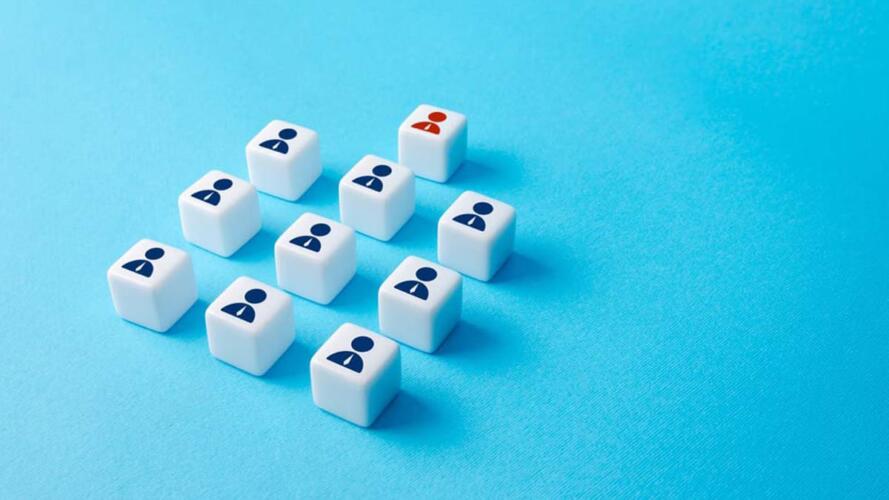يتطلب الأمر قطع مسافة طويلة من مدينة غوتنبرغ السويدية إلى مدينة بوسطن للحصول على فكرة مبتكرة في الإدارة، خاصة بالنسبة لفكرة يزيد عمرها عن 40 عاماً. قمت بتلك الرحلة لحضور اجتماع للرعاية الصحية، فقد كانت المحاضرة الافتتاحية من إلقاء دون بيرويك، الرئيس السابق لمعهد "تحسين الرعاية الصحية" (Institute for Healthcare Improvement)، الكائن في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.
بدأ بيرويك خطابه بمقارنة فريدريك وينسلو تايلور مع ويليام إدواردز ديمينغ: الأول رجل صناعة ساوى بين الماكينات والبشر (كلاهما يُدار لتحقيق أكبر قدر من النتائج)، والأخير كان باحثاً في الحركة الإنسانية، رأى أن الفرد يتسم بدوافع داخلية للقيام بعمل طيب وهادف. امتد حديث بيرويك إلى مجموعة من عظماء المفكرين في الإدارة ليُظهر للحضور مدى التقدم الذي أحرزناه من تايلور إلى ديمينغ في القرن العشرين.
وكان هذا التباين يعزى بصورة ملموسة إلى إعادة تمثيل كاملة لتجربة الخرز الأحمر الشهيرة التي ابتكرها ويليام إدواردز ديمينغ. في هذا الاختبار، يؤدي المشاركون دور موظفي المصانع الذين يحاولون وضع خرز أحمر في 50 تجويفاً على مجداف لتحريك السوائل. والغاية من التجربة هي إدخال المجاديف في صندوق مملوء بالخرز الأحمر والأزرق. وسرعان ما يدرك "موظفو المصانع" أن أداءهم يعتمد كلياً على عوامل عشوائية خارجة عن إرادتهم.
جعلتني إعادة تمثيل هذه التجربة أسأل نفسي عن سبب ابتعادنا عن ديمينغ. والمغزى من تجربة الخرز الأحمر هو أننا كثيراً ما نتلقى قراءة خاطئة عن الموظفين بسبب حكمنا السابق عليهم بشكل ضيق للغاية. وكان ديمينغ يعتقد أنه لا يمكننا تحسين أداء الموظفين إلا عندما نحسّن المنظومة التي يعملون فيها بأكملها. وكان يعتقد أن المدراء يطبقون على نحو خاطئ خطط الحوافز والتصنيفات القسرية وجميع أنواع الترهيب والترغيب لإنشاء وهم السيطرة دون حل المشكلات الجذرية في الأداء.
طرح ويليام إدواردز ديمينغ 14 مبدأ تتعارض بشكل صارخ مع أنواع الممارسات التي اعتقد أنها تقوض أداء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. قد تبدو القائمة غريبة اليوم، لكن الأمر يستحق إعادة ذكرها من جديد:
- وضع بيان يحتوي على أهداف الشركة ومقاصدها وتعميمه على جميع الموظفين.
- التكيف مع الفلسفة الجديدة في عالم اليوم. إذ إن مجالات العمل والاقتصاد تتغير دائماً.
- تضمين الجودة في المنتج على امتداد عملية الإنتاج.
- إنهاء ممارسة منح الأعمال على أساس السعر وحده، وبدلاً من ذلك، تجريب بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على الولاء والثقة.
- العمل باستمرار على تحسين الجودة والإنتاجية.
- إرساء التدريب في أثناء أداء العمل.
- تعليم القيادة وتشكيلها لتحسين جميع وظائف العمل.
- طرد الخوف وخلق الثقة.
- السعي للحد من الصراعات داخل الأقسام.
- التخلص من المواعظ التي توجه لقوة العمل، والتركيز بدلاً من ذلك، على المنظومة والروح المعنوية.
- القضاء على نظام حصص العمل العادية بالنسبة للإنتاج. انتهاج أساليب قيادة بديلة للتحسين.
- التخلص من نظام الإدارة بالأهداف، وتجنب الأهداف العددية. وبدلاً من ذلك، تعلم قدرات العمليات وكيفية تحسينها.
- إزالة الحواجز التي تسلب عن الأشخاص الفخر بالصنعة.
- التعليم باستخدام برامج تحسين الذات.
- إشراك الجميع في الشركة لإدارة التغيير.
لقد استند الكثير من مفكري الإدارة على فلسفة ديمينغ، لكن يبدو أن رسالته الجوهرية لم تُفهم. إذ يقول، بشكل مقنع، إن الشركات تقضي على القيمة أكثر مما تخلقها عندما تركز على النتائج قصيرة الأجل، والحوافز التقليدية، وتصنيفات الأداء. وتتمثل نقطته الرئيسية في أنه يتعين على القادة بناء ثقة عميقة بين الموظفين والمدراء، التي تنبع من غاية قوية وقيم مشتركة. ويبدو الأمر منطقياً بقدر كافٍ، وأكثر أهمية من أي وقت مضى. إذاً، كيف لا تستجيب المزيد من الشركات لرسالته اليوم؟
ديمينغ في مواجهة أنظمتنا الشريرة
توفي ديمينغ في عام 1993. وفي العام نفسه، أعلنت شركة آي بي إم أنها ستفصل 60 ألف شخص عن العمل. منذ ذلك الحين، أصبح تسريح الموظفين أداة شائعة للشركات العامة. وقد قضى الركود الاقتصادي الكبير على أكثر من ثمانية ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، ولم تبدأ الأجور في التزحزح إلا في الوقت الحالي، على الرغم من تقلص البطالة إلى أقل من 5%. ثم هناك فجوة عدم المساواة المستمرة هذه، التي تزداد مع مرور كل عام. فهل هذه حقاً ظروف يمكننا من خلالها إعادة بناء الثقة بين المدراء والموظفين في أكبر شركاتنا العامة؟
بدأ ديمينغ، في أواخر أيامه، بوضع نظريات بشأن سبب عدم اعتناق أفكاره بشكل كامل. وكان عمره 90 عاماً عندما كتب ما يلي إلى بيتر سينغي (الذي روى المراسلات بينهما في كتابه المؤثر "النظام الخامس" ’The Fifth Discipline‘) بقوله:
"دمر نظامنا السائد في الإدارة موظفينا. إذ يولد الأشخاص بالدافع الداخلي الجوهري، واحترام الذات، والكرامة، والفضول للتعلم، والسعادة في التعلم. وتبدأ قوى التدمير بالأطفال الصغار - بوضع جائزة لأفضل زي في عيد القديسين، وإعطاء الدرجات في المدرسة، والنجوم الذهبية - وصولاً إلى الجامعة. وفي المجال الوظيفي، يجري ترتيب الأشخاص والفِرق والأقسام ويحصل ذوو الأداء الرفيع على المكافآت، ويتلقى ذوو الأداء الضعيف العقاب. وتتسبب الإدارة بالأهداف ونظام الحصص والحوافز وخطط العمل مجتمعة بشكل منفصل ولكل قسم على حدة، في المزيد من الخسائر غير المعروفة التي لا سبيل لمعرفتها".
وقد كتب هذه الكلمات في عام 1990، لكنها لا تزال صالحة في العصر الحالي. والقول بأن هناك ثغرات كبيرة في الكيفية التي نتعلم بها يعني فعلاً القول بأن المجتمع مريض بشكل أساسي. إذ كان ديمينغ يعتقد أن الفرد يميل بشكل طبيعي إلى القيام بالعمل الطيب والهادف. وما يؤسف له أن المجتمع يحوّل هذه الطبيعة الإنسانية إلى منافسة غير طبيعية من شأنها، أساساً، تدميرنا.
ولم يكن ويليام إدواردز ديمينغ أول من تبنى هذه الأفكار. بل كان روسو هو الذي أشار، على عكس وجهة نظر هوبز القاتمة للطبيعة البشرية، إلى أن البشر طيبون بشكل بريء، لكن أفسدهم مجتمع يحرض الأفراد ضد بعضهم البعض، في سعيه - غالباً - لخصخصة الممتلكات. إذ كان روسو يعتقد أننا قد خُدعنا في عَقد اجتماعي احتيالي أتاح للإمبرياليين الأثرياء إخضاع الموظفين وإيقاعهم في براثن الفقر.
في القرن التاسع عشر، اعتقد مفكرون، مثل نيتشه وماثيو أرنولد أن نظامنا التعليمي ضل سبيله بسبب الميل المادي الذي وضع المعرفة المفيدة فوق البحث عن الحقيقة والجمال والكمال، والذي كانت تعرّفه أيضاً الثقافة. إذ قال ماثيو أرنولد: "ليس الامتلاك والراحة، بل النمو والتزايد، هو طابع الكمال كما تتصوره الثقافة... فكرة الكمال بصفتها توسعاً عاماً للعائلة البشرية تتعارض مع نزعتنا الفردية القوية وكراهيتنا لجميع القيود المفروضة على التأرجح الجامح لشخصية الفرد، ومبدأنا هو "كل شخص يهتم بشؤونه".
عامل الثقة
لكن ديمينغ هو الذي وضع هذه الأفكار التاريخية في الإطار الإداري. ويبدو أن الرابط الذي يحافظ على تماسك إطار ديمينغ يتمثل في الثقة بين المدير والموظف. بالنسبة إلى ديمينغ، تعد الثقة مكوناً رئيسياً في سعيه لتحقيق ما وصفه بشكل مبهم بأنه "المعرفة العميقة". الثقة بين المدير والموظف هي الأساس الذي سيتم استناداً إليه بناء علاقة إدارية سليمة. أطروحة ديمينغ جديرة بالإشارة إليها في العصر الحالي، ربما أكثر من أي وقت مضى، لأن هذه الثقة بالتحديد هي التي تضاءلت بشكل كبير منذ وفاته.
قد يكون من نافلة القول إن التكنولوجيا آخذة في تغيير أعمالنا اليوم بوتيرة سريعة، لكن هذا لا يعني أن ذلك غير صحيح. ويصاحب هذا التغيير عالم من عدم التيقن والقلق، حيث يبدو الأداء المتوقع لأي عمل أشبه بصورة متزايدة بتجربة الخرز الأحمر التي ابتكرها ديمينغ، في الطابع العشوائي لكليهما. ويمكن أن تكون النتائج وخيمة على عالم الأعمال؛ فالموظف لا يثق الآن في أنه لن يُستبدل بآلة، وعاد المستثمر غير واثق في حصوله على عائد على رأس المال، وفقد المدراء ثقتهم في استمرارهم في وظائفهم مدى الحياة بعد أكثر من ربع أو ربعين يكون فيها أداؤهم سيئاً.
وفي ضوء تضاؤل الكثير من ثقتنا، لم يتبق أمام إدارات الشركات سوى القليل من الثقة للتشبث بها، ولذا فهي تتمسك بالأمل الزائف المتمثل في الوسائل الفظة، مثل التصنيفات القسرية والتنبؤات الدورية، بغض النظر عن إمكانية أن تكون محض سراب خادع.
وهذا يعيدنا إلى روسو. إذ يبدو أن لدينا شعوراً زائفاً بالانضمام إلى كيان مهم عندما نلتحق بالشركات هذه الأيام، تماماً كما نصّ روسو على أن المجتمع قد دخل في عقد اجتماعي زائف. ويمكن أن يكون هذا هو ما يدفع الأجيال الجديدة للبحث عن "عمل هادف" عندما يشغلون وظائف: إنهم يتطلعون إلى السيطرة عن طريق المطالبة بالمغزى من العمل منذ اليوم الأول مباشرة. وقد يكون هذا هدفاً عسير المنال بالمقارنة مع الأجيال السابقة التي كانت تكتفي بأداء العمل وهي على ثقة من الحصول على المكافأة.
لكن كان روسو يعتقد أيضاً أن البشر يمكنهم إعادة تشكيل أنفسهم عبر مؤسساتهم، ويبدو أن ويليام إدواردز ديمينغ يشاركه هذا الاعتقاد.
وهذا هو ما يثير بشدة اهتمام شركات، مثل فيسبوك وجوجل وآبل. إذ غالباً ما تعمل هذه الشركات النادرة خارج قواعدنا وتقاليدنا: فهي تعلّم موظفيها بشكل مختلف، حيث يتعاونون بطريقة مختلفة بين الوحدات المنعزلة والأقسام. كما أنها تحفز الموظفين بطرق مختلفة. ونظراً لقدرتها الكبيرة على جني الأموال (سواء في البداية من خلال المستثمرين المبتهجين، أو في نهاية المطاف عبر الزبائن)، يبدو أن هذه الشركات تبدأ أشبه كثيراً بالدوائر البلدية. إذ إنها بمثابة جنات عدن يقل فيها الصراع على الموارد، وفي كثير من الأحيان، يشارك فيها الزبائن الرئيسيون بمحض إرادتهم.
علاوة على ذلك، تبدو هذه الشركات تقريباً تعمل من أجل المصلحة العامة، ويبدو أن إداراتها تتبع غريزياً فلسفة ديمينغ. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الكفاءة والأداء يتحسنان بشكل طبيعي داخل هذه الشركات دون الأساليب العادية التي تتبعها الشركات الأكثر استقراراً. ومن المؤسف أنه غالباً ما تحدث أيضاً كبوة تتعرض لها هذه الشركات عادةً عندما تصبح "طبيعية"، ويحل بها الصراع التقليدي بدرجة أكبر على الموارد.
وقد تساءل سينغ أيضاً عن سبب عدم انتشار هذه الأمثلة النادرة لديمينغ في الواقع العملي. وأعرب عن أسفه لأن ترسيخ طريقة ديمينغ في التفكير قد يستغرق عدة أجيال. لكنه قال إننا على الطريق نحو ما اعتبره الممارسات الإدارية الأكثر استنارة. إذ يقول المنظور المعاكس إن سمات عالَمنا الذي افترضه توماس هوبز، والمتمثلة في الطمع والخوف ستتفوق دائماً على فلسفة الخير الجوهري الأصيل. أو يمكن أن يكون أكثر فوضى مما توحي به هذه النُهج القطبية.
ربما يكمن الجواب بشكل أعمق فيما كان يحاول ديمينغ قوله عن "المعرفة العميقة". وكما كان يفترض ويليام إدواردز ديمينغ، نحن نعمل في أنظمة معقدة تكون فيها قوى الخير والشر حاضرة باستمرار، وقد تكون المسؤولية الأكثر أهمية لقادتنا هي صياغة هذه الديناميكية وتشكيلها بمهارة بطريقة تناسب مؤسساتهم، وتنتج بيئة عمل متكاملة قائمة على الاختيار الذاتي وتتكون من الموظفين والشركاء والزبائن والمساهمين الذين يتحقق التوافق بينهم بشكل طبيعي.
وينطوي كل هذا على نهج أكثر تقدماً إزاء القيادة. ومع ذلك، فإننا نستسلم بكل سهولة إلى دوافعنا التي تشبه نموذج تايلور الذي يفترض الأسوأ بشأن الموظفين، باستخدام الأتمتة لتتبع الإنتاجية وصولاً إلى وحدة القياس النانو ثانية، إذا كان ذلك ممكناً. والأمر المؤسف أن هذا يميل إلى مفاقمة فجوة الثقة المتنامية بين الموظفين، التي تزداد انتشاراً بين الوحدات المؤسسية التي تعمل بمعزل في عزلة، وتعرقل الإنتاجية نفسها التي نسعى إلى تعزيزها.
لا شيء مما ذُكر يسهل تحقيقه. وسيواجه الكثير منا بالتأكيد هذه المشكلات طوال حياتهم. ولكن في عالم يبدو أن المخاطر فيه تتزايد في كل دقيقة، يمكن أن يكون بناء ثقة وتعاون دائمين بين الشركات والمجتمعات - الجمع بين الأشخاص والوحدات التي تعمل بمعزل عن بعضها والمتحجرة منذ وقت طويل - هو السبيل الوحيد للاستمرارية.