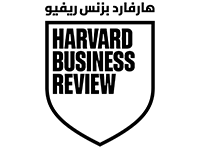الفصام النفسي هو أحد أكثر الاضطرابات العقلية تعقيداً، ويتميز بانفصال بين الفكر والواقع، بحيث يعيش المصاب في عالم داخلي يصعب عليه التمييز فيه بين ما هو حقيقي وما هو نتاج خياله. لا يعني الفصام تعدد الشخصيات كما يعتقد البعض، بل هو اضطراب في الإدراك والتفكير يجعل الإنسان يفسر الأحداث والمواقف تفسيراً غير منطقي، وتكمن خطورته في أن المريض لا يدرك في الغالب أنه مريض، فيتعامل مع أوهامه على أنها حقائق مطلقة. وقد جرى تشخيص الفصام لأول مرة في بدايات القرن العشرين من قبل الطبيب النفسي السويسري يوجين بلولر، الذي استخدم مصطلح "سكيتزوفرينيا" (Schizophrenia) المشتق من كلمتين يونانيتين تعنيان "انقسام العقل"، ومع مرور الزمن، اتضح أن الفصام ليس تدهوراً في القدرات العقلية كما ظن الأطباء الأوائل، بل هو اضطراب معقد في الإدراك والتفكير والانفعال.
وكما أن الفصام في الطب النفسي هو انفصال بين الفكر والواقع، فإن الإدارة أيضاً تعرف نوعاً مشابهاً من الانفصال أتجرأ على تسميته بـ "الفصام الإداري". لا يفقد القائد في هذه الحالة صلته بالعالم الخارجي بالمعنى الطبي، بل يفقدها بالمعنى المهني، حين تنفصل قراراته عن الحقائق المؤسسية، وتغيب الواقعية عن رؤيته للأداء والعمل. في هذه الحالة يصبح الخطاب شيئاً، والممارسة شيئاً آخر، وتتحول المؤسسة إلى كيان مزدوج الملامح، يتحدث بلغة القيم والكفاءة، بينما يعيش واقعاً مختلفاً تماماً.
كيف يبدو الفصام في سلوك المدراء؟
يبدأ الفصام الإداري حين يفقد القائد صلته بالميدان الذي يقوده، أي يبدأ باتخاذ القرارات في المكاتب المغلقة، بعيداً عن صوت المتعاملين، وهموم الموظفين، وحقائق الأداء اليومي. يرسم الخطط على الورق دون معرفة ما يعيشه العاملون في الصفوف الأمامية، فتتحول الإدارة إلى ممارسة نظرية تعتمد على الافتراضات أكثر من الواقع.
ثم يظهر انفصال الخطاب عن الفعل، حين يرفع في الاجتماعات شعارات عن الشفافية والإبداع والعمل الجماعي، بينما يمارس على الأرض عكسها تماماً. يتحدث القائد عن تمكين الموظفين، لكنه يضيق عليهم في القرار. يطلب الابتكار، لكنه يعاقب من يجرب. وهكذا، تتحول القيم المؤسسية إلى نصوص جدارية لا معنى لها.
يتسع الانفصال أكثر مع انفصال الصورة عن الحقيقة، فالقائد الذي يعيش داخل تقارير منسقة وجداول ملونة يظن أن كل شيء يسير على ما يرام. تعرض عليه مؤشرات الأداء على نحو انتقائي، وتخفي الأرقام عيوب نظام العمل، ويبنى بذلك وعيه المؤسسي على صورة تجميلية لا تعكس الواقع الفعلي، فيتخذ قرارات مبنية على وهم النجاح لا على حقائقه.
ولا بد من الإشارة إلى انفصال القائد عن الناس، وهو أخطر مظاهر الفصام الإداري. فالقائد المحاط بدائرة ضيقة من المقربين يفقد حس الإصغاء، ولا يسمع إلا ما يريد سماعه، فيغيب الحوار الصادق، ويتحول التواصل إلى مجاملة شكلية. ومع الوقت، يصبح القائد غريباً عن مؤسسته، هذه العزلة الفكرية والإنسانية هي ما يحول الإدارة من قيادة حقيقية إلى حالة من الوهم التنظيمي المستمر.
الجذور الخفية للفصام الإداري
لا يظهر الفصام الإداري فجأة، بل يتكون من خلال تراكمات خفية في بيئة العمل وثقافة القيادة. أول هذه الأسباب هو السلطة غير المقيدة، حين يتحول المدير من صاحب رؤية إلى مركز قوة لا يسائل نفسه ولا يسائله من حوله. تلفه طبقة عازلة تحجب النقد والملاحظات، فتتآكل موضوعيته من حيث لا يشعر، وكلما زادت العزلة الإدارية، تضاءلت الحقيقة وكبر حجم الوهم.
أما ثقافة الخوف، فهي البيئة المثالية لتفاقم هذا الانفصال. حين يخشى الموظفون نقل الحقيقة أو الإشارة إلى الخطأ، وتصبح المؤسسة مرآة مشوهة تعكس ما يراد منها لا ما هو موجود فعلاً، فإن الصمت هنا ليس دليلاً على الرضا، بل على غياب الأمان التنظيمي.
ويزيد الغرور المهني المشهد تعقيداً، حين يقتنع القائد بأنه يمتلك الإجابات كلها، فيغلق أبواب التعلم ويقصي من يخالفه الرأي، هذا الشعور الزائف بالكمال يحول الذكاء القيادي إلى جمود إداري، ويمنع المؤسسة من التطور الطبيعي عبر النقد البناء والتصحيح المستمر.
ويأتي أخيراً الاعتماد المفرط على المؤشرات الرقمية ليكمل دائرة الفصام الإداري، فحين تقاس النجاحات بالأرقام وحدها، يختزل الأداء في جداول ونسب، وتهمل الأبعاد الإنسانية والسلوكية التي تشكل جوهر العمل. قد تظهر الأرقام تحسناً، لكنها لا تكشف الإنهاك، ولا تترجم الدافعية، ولا تقيم جودة العلاقات الداخلية التي تصنع الاستدامة الحقيقية.
حين تدفع المؤسسة ثمن الوهم
عندما يستمر الفصام الإداري دون تصحيح، تبدأ أعراضه في الظهور على جسد المؤسسة بأكملها، أول ما يتآكل هو الثقة الداخلية، إذ يفقد الموظفون الإيمان بصدق القيادة وبقدرتها على رؤية الواقع كما هو، وتنشأ فجوة بين ما يقال وما يفعل، ويتحول العمل إلى التزام شكلي يخلو من الحماسة والانتماء.
ثم يظهر أثر آخر أكثر خطورة، هو تكرار الأخطاء دون تعلم، فحين تدار المؤسسة في بيئة تتجنب الحقيقة، لا يمكن لعمليات التعلم المؤسسي أن تعمل بفعالية. وهنا تكرر التجارب الفاشلة، ويعاد الإنفاق على الحلول نفسها، لأن أحداً لا يملك الشجاعة لطرح السؤال الجوهري: لماذا أخطأنا؟
تفقد المؤسسة في هذا المناخ أفضل عناصرها، فأصحاب الكفاءة لا يحتملون العمل في بيئة يغيب عنها المنطق والصدق، فيغادرون بصمت بحثاً عن قيادة ترى وتسمع وتتعلم. وما يبقى في الغالب هم المتكيفون مع الوهم، لا المساهمون في التغيير.
ومع مرور الوقت، يمتد الأثر إلى الخارج في صورة تدهور السمعة المؤسسية، فحين يختلف الداخل عن الصورة المعلنة، تبدأ الفجوة بين الخطاب والواقع بالانكشاف، ويكتشف العملاء والشركاء والمجتمع أن البريق الإعلامي لا يعكس الأداء الحقيقي، فتفقد المؤسسة مصداقيتها ورصيدها من الثقة العامة.
طريق التعافي المؤسسي واستيقاظ القادة
مواجهة الفصام الإداري تبدأ أولاً بالعودة إلى الجذر الأساسي، وهو استعادة الصلة بالواقع. القائد الناجح لا يكتفي بما يصله من تقارير أو عروض تقديمية، بل ينزل إلى الميدان بانتظام، يراقب ويسأل ويستمع دون وسيط، فالميدان هو المرآة الحقيقية التي تعكس نبض المؤسسة، وتعيد للقائد إحساسه بالحقائق بعيداً عن التجميل الإداري.
الخطوة الثانية هي تعزيز ثقافة المصارحة، فالمؤسسات تحتاج إلى بيئة آمنة يستطيع فيها الموظفون نقل الحقيقة دون خوف من العقاب أو التفسير الخاطئ، فالشفافية هي جهاز المناعة التنظيمي الذي يكتشف الأخطاء قبل أن تتحول إلى أزمات.
أما الفصل بين الوهم والواقع فيتحقق حين تبنى القرارات على بيانات موضوعية، لا على مؤشرات مختارة بعناية لتأكيد النجاحات. القائد الواعي يطلب التحليل لا العرض، والحقائق لا الانطباعات، ويدرك أن الشفافية لا تضعف المؤسسة، بل تحميها من الانحدار الصامت.
وأخيراً، تأتي القيادة بالوعي، وهي مهارة تتجاوز الإدارة التقليدية إلى ممارسة نقد ذاتي مستمر، فالقائد الواعي يراجع قراراته، يسائل نفسه قبل أن يسائله الآخرون، ويتعامل مع الخطأ على أنه فرصة للتصحيح لا لتهديد المكانة. بهذا الوعي فقط يمكن للمؤسسة أن تبقى متصلة بالواقع، وأن توازن بين الطموح والحقيقة، وبين الصورة والمضمون.
لا يقاس نجاح المدير بعدد القرارات التي يصدرها، بل بقدرته على رؤية ما لا يراه الآخرون وسماع ما لا يقال بصوت عال. المؤسسات التي تتعافى من الفصام الإداري هي تلك التي تعيد بناء وعيها من الداخل، فتتعلم كيف تشك في يقينها قبل أن يفرض الواقع عليها الدرس. فجوهر القيادة ليس في السيطرة ولا في الصورة المثالية، بل في القدرة على ملامسة الحقيقة كما هي، مهما كانت قاسية أو مزعجة، والمؤسسات التي تواجه واقعها بشجاعة هي التي تستطيع أن تصنع مستقبلاً يليق بما تقوله عن نفسها.