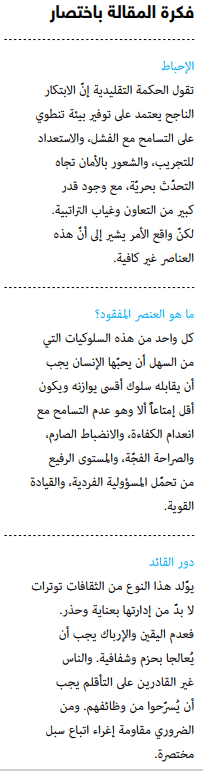الثقافة التي توفّر بيئة خصبة للابتكار ليست عاملاً داعماً لإيرادات الشركة فحسب، بل هي شيء يقدّره القادة والموظفون على حدّ سواء في مؤسساتهم.
في سلسلة ندوات أقيمت في عدة شركات في جميع أنحاء المعمورة، أجريت مسوحاً غير رسمية شملت مئات المدراء حول ما إذا كانوا يريدون العمل في مؤسسة تسود فيها السلوكيات الابتكارية بوصفها المعيار الطبيعي. لا يخطر في بالي أي مرّة قال فيها أحدهم لي: "كلا، لا أريد ذلك". ومن بوسعه لومهم على ذلك: فالثقافات الابتكارية توصف عموماً أنّها مُمتعة. وعندما طلبت من هؤلاء المدراء وصف هكذا ثقافات، فإنّهم قدّموا قائمة بخصائص مطابقة للخصائص التي تحتفي بها كتب الإدارة ألا وهي: التسامح مع الإخفاق، والاستعداد للتجريب، والأمان النفسي، والتعاون الكبير، وعدم وجود تراتبية. وتدعم الأبحاث الفكرة القائلة إنّ هذه السلوكيات تترجم إلى أداء ابتكاري أفضل.
لكن على الرغم من أنّ الثقافات الابتكارية مرغوبة ويزعم معظم القادة فهمهم لما تنطوي عليه، إلا أنّ تأسيسها والمحافظة على ديمومتها هما مسألتان صعبتان. وهذا أمر محيّر. فكيف يمكن لتطبيق ممارسات تحظى بكل هذا القدر من الحب وعلى نطاق واسع، وتُعتبرُ ممتعة حتّى، أن يكون محفوفاً بعدم اليقين إلى هذه الدرجة؟
يكمن السبب في اعتقادي في إساءة فهم الثقافات الابتكارية. فالسلوكيات المحبوبة بسهولة التي تحظى بهذا القدر الكبير من الاهتمام ليست إلا وجهاً واحداً للعملة. إذ يجب أن تُقابل بشيء من الصرامة وسلوكيات أقل إمتاعاً بصراحة. فالتسامح مع الإخفاق يستدعي عدم التسامح مع انعدام الكفاءة. والاستعداد للتجريب يستدعي الانضباط الصارم. والأمان النفسي يستدعي الارتياح إلى الصراحة الفجّة. والتعاون يجب أن يُوازن بتحمّل الأفراد لمسؤولياتهم. وغياب التراتبية يستتبع وجود قيادة قوية. تنطوي الثقافات الابتكارية على مفارقة. وما لم تخضع التوتّرات الناجمة عن هذه المفارقة إلى إدارة دقيقة، فإنّ محاولات إنشاء ثقافة ابتكارية ستُمنى بالفشل.
1- التسامح مع الإخفاق وليس مع انعدام الكفاءة
بما أنّ الابتكار ينطوي على استكشاف مجالات مجهولة تتّصف بعدم اليقين، من غير المفاجئ أن يكون التسامح مع الفشل إحدى الخصائص الهامّة للثقافات الابتكارية. فبعض أكثر المُبتكرين المرموقين شهرة كان لهم نصيبهم من الفشل. هل تتذكّرون ابتكارات من قبيل (MobileMe) من شركة آبل، و(Google Glass) من جوجل، و(Amazon Fire Phone) من أمازون؟
ومع ذلك، ورغم هذا التركيز الكبير من المؤسسات الابتكارية على التسامح مع الفشل، إلا أنّها لا تتسامح مع انعدام الكفاءة. فهي تحدّد لموظفيها معايير استثنائية رفيعة للأداء وتوظّف أفضل أصحاب المواهب. لا بأس من استكشاف الأفكار المحفوفة بالمخاطر التي قد تفشل في نهاية المطاف، لكن هناك مشكلة عندما يتعلّق الأمر بالمهارات التقنية المتواضعة، والتفكير الفوضوي، وعادات العمل السيئة، وسوء الإدارة. والأشخاص الذين لا يلبّون التوقعات إمّا يُسرّحون من وظائفهم أو ينقلون إلى مناصب أخرى أنسب لقدراتهم. اشتهر ستيف جوبز بأسلوبه المقذع في طرد أي شخص يعتبره غير أهل لشغل موقعه. وفي أمازون، يُصنّف الموظفون على طول منحنى بياني إلزامي، ومن يحتل منهم الجزء الأدنى يُصرف من عمله. من المعروف أنّ جوجل تتمتّع بثقافة ودودة جدّاً تجاه الموظفين، لكنّها واحد من أصعب الأماكن على وجه الأرض التي يمكن الحصول على عمل فيه (فكل عام تتلقى الشركة مليون طلب لشغل 5 آلاف وظيفة فقط). وهي أيضاً لديها نظام صارم لإدارة الأداء يقوم على نقل الموظفين إلى مناصب جديدة إذا لم يتميّزوا في مناصبهم الحالية. وفي شركة "بيكسار" (Pixar) يُستبدل مخرجو الأفلام الذين لا يتمكّنون من إنجاز المشاريع فوراً.
يبدو جليّاً أنّ الشركات يجب أن تضع معايير رفيعة لموظفيها، لكنّ المؤسف في الأمر هو أنّ عدداً كبيراً من المؤسسات تقصّر في هذه الناحية. لنأخذ على سبيل المثال حالة شركة أدوية عملتُ معها مؤخراً. لقد عرفت أنّ إحدى مجموعات البحث والتطوير فيها لم تكتشف عقاراً مرشّحاً جديداً منذ أكثر من عقد من الزمن. وعلى الرغم من الأداء السيئ، إلا أن كبار القادة فيها لم يُدخِلوا تغييراً حقيقياً على إدارة المجموعة أو موظفيها. في الحقيقة، وبموجب سياسة التعويض القائمة على المساواة في الشركة، كان العلماء العاملون في المجموعة يتلقّون تقريباً العلاوات والرواتب ذاتها التي يحصل عليها العلماء في وحدات البحث والتطوير الأكثر إنتاجية بكثير. وقد أسر لي أحد كبار المدراء أنّه باستثناء المخالفات الأخلاقية، نادراً ما كانت الشركة تسرّح أي شخص من قسم البحث والتطوير نتيجة تقديم أداء أقل من المطلوب. وعندما سألته عن السبب قال: "ثقافتنا تشبه ثقافة العائلة الواحدة. ونحن لا نرتاح لفكرة طرد أحد من مكانه".
الحقيقة هي أنّ التسامح مع الفشل يستدعي وجود أشخاص في منتهى الكفاءة. والمحاولات الرامية إلى صنع نماذج تكنولوجية أو تجارية جديدة هي عملية مفعمة بعدم اليقين. وأنت غالباً لا تعرف ما لا تعرف، ويجب عليك أن تتعلّم أولاً بأوّل. توفّر "حالات الإخفاق" ضمن هذه الظروف دروساً قيّمة حول المسارات المستقبلية. لكن الإخفاق يمكن أن ينجم أيضاً عن التصاميم غير المدروسة جيّداً، والتحاليل المشوبة بالعيوب، وغياب الشفافية، وسوء الإدارة. بوسع جوجل أن تشجّع على المجازفة والفشل لأنّها يمكن أن تكون واثقة أنّ معظم موظفي جوجل يتمتّعون بكفاءة عالية للغاية.
من الصعب ترسيخ ثقافة تقدّر التعليم من خلال الفشل والأداء المتميّز في الوقت عينه في المؤسسات التي تفتقر إلى تاريخ سابق في هذين الأمرين. إحدى النقاط الجيّدة للانطلاق منها هي أن يُعبّر أعضاء القيادة العليا بوضوح عن الفَرْق بين حالات الفشل المُنْتِج والفشل غير المُنْتِج: فالفشل المُنْتِج يعطي معلومات قيّمة مقارنة بتكلفته. ولا يجب الاحتفاء بالفشل إلا عندما يقود إلى التعلّم. (والكليشيه السائد "الاحتفاء بالفشل" يجافي المقصود، لأنّنا يجب أن نحتفي بالتعلّم، وليس بالفشل). والنموذج التقني البسيط الذي يخفق في تقديم الأداء المتوقع بسبب قضية تقنية غير معروفة مسبقاً هو إخفاق يستحق أن نحتفي به إذا كانت تلك المعلومات الجديدة يمكن أن تُستعمل في التصاميم المستقبلية. أمّا إطلاق منتج مصمّم بطريقة هندسية سيئة بعد إنفاق 500 مليون دولار على تطويره فهو عبارة عن خطأ باهظ التكلفة.
يستدعي بناء ثقافة تقوم على الكفاءة تحديد معايير الأداء المنتظرة بوضوح. فإذا لم تكن هذه المعايير مفهومة، فإنّ القرارات الصعبة الخاصّة بالموظفين يمكن أن تبدو زئبقية، لا بل أسوأ من ذلك قد تفسّر بوصفها عقاباً على الفشل. يجب على كبار القادة والمدراء في عموم المؤسسة أن يبيّنوا التوقعات بوضوح وبصورة منتظمة. وقد تكون هناك حاجة إلى رفع سوية المعايير المطلوبة للتوظيف، حتى لو أدّى ذلك مؤقتاً إلى إبطاء وتيرة نمو الشركة.
يشعر المدراء خصوصاً بشيء من عدم الارتياح تجاه فكرة طرد الموظفين أو نقلهم من أمكنتهم عندما لا يكون "انعدام كفاءتهم" هو ذنبهم. فالتحوّلات الطارئة على التكنولوجيا أو نماذج العمل التجارية قد تجعل من يتمتّع بكفاءة عالية في سياق معيّن شخصاً يفتقر إلى الكفاءة في سياق آخر. لنأخذ تأثير الرقمنة على قيمة مختلف المهارات في العديد من القطاعات. فمندوب المبيعات الذي جعلته براعته في مهارات التواصل الشخصي نجماً في عالم المبيعات قد لا يعود ذا قيمة بالنسبة للمؤسسة مثل مهندس البرمجيات الانطوائي الذي يطوّر الخوارزميات المستخدمة للتنبؤ بالعملاء الذين سيشترون على الأرجح منتجات الشركة. في بعض الحالات، من الممكن إعادة تدريب الموظفين لتطوير كفاءات جديدة لديهم. لكنّ ذلك ليس ممكناً على الدوام لاسيما عندما تكون هناك مهارات متخصّصة مطلوبة لأداء العمل (مثل الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية). قد ينطوي الاحتفاظ بالموظفين الذين لم يعد لهم عمل على شيء من التعاطف، لكنّه أمر خطر بالنسبة للمؤسسة.
ليس من السهل المحافظة على شيء من التوازن الصحي بين التسامح مع حالات الفشل المُنْتِج واجتثاث انعدام الكفاءة. وتوضح مقالة نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز" في 2015 حول أمازون مدى صعوبة هذا الأمر. فقد وصفت هذه المقالة التي استندت إلى مقابلات مع أكثر من 100 موظف حالي وسابق ثقافة أمازون بأنّها "دامية" وسردت قصصاً لموظفين يبكون على مكاتبهم وسط ضغوط هائلة عليهم لتقديم الأداء المطلوب. يتمثّل أحد أسباب صعوبة تحقيق التوازن في أنّ أسباب الفشل ليست دائماً واضحة. هل تبيّن أنّ تصميم المنتج فيه عيب بسبب سوء حكم المهندس على الأمور أم لأنّه واجه مشكلة كانت ستفوت حتى أكثر المهندسين موهبة؟ وفي حال إطلاق أحكام تقنية أو تجارية سيئة على أحد، فما هي التبعات المناسبة لذلك؟ كل الموظفين يرتكبون أخطاءً، ولكن ما هي النقطة التي ينزلق فيها الصفح ليتحوّل إلى تسيّب؟ وما هي النقطة التي يتحوّل فيها وضع معايير للأداء الرفيع إلى ضرب من القسوة أو الإخفاق في معاملة الموظفين باحترام وكرامة، بغض النظر عن أدائهم؟
يجب على القادة أن يتحلّوا بالشفافية الكبيرة مع المؤسسة بخصوص الوقائع الأصعب التي تنطوي عليها الثقافات الابتكارية. فهذه الثقافات ليست كلها ممتعة أو ضرباً من اللعب.
2. التجريب ولكن بانضباط شديد
تشعر المؤسسات التي تتبنّى فلسفة التجريب بالارتياح إلى عدم اليقين والغموض. وهي لا تتظاهر بامتلاك كل الإجابات مسبقاً أو بالقدرة على تحليل الطريق الذي يقودها إلى الاستنتاج، وإنّما تجرّب لتتعلّم عوضاً عن إنتاج منتجات أو خدمات يمكن تسويقها على الفور.
لكنّ الاستعداد للتجريب لا يعني العمل بأسلوب فنّان تجريدي من الدرجة الثالثة يضرب القماش بريشته عشوائياً. فدون انضباط، يمكن تبرير أيّ شيء على أنّه يندرج تحت إطار التجربة. تختار الثقافات التّي تركّز على الانضباط التجارب بعناية على أساس مدى إمكانية التعلّم منها، وهي تصمّمها بطريقة صارمة لكي توفّر أكبر قدر من المعلومات مقارنة بالتكاليف. وهي تحدّد معايير واضحة منذ البداية لتقرّر ما إذا كانت تريد المضي قدماً في فكرة معيّنة، أو تعديلها، أو التراجع عنها. وهي تواجه الحقائق التي تولّدها التجارب. قد يعني ذلك الاعتراف أنّ الفرضية الأولية كانت خاطئة، وأنّ المشروع الذي بدا واعداً يجب أن يتوقف أو أن يعاد توجيه في اتجاه مختلف تماماً. ووجود انضباط أكبر بخصوص وقف مشروع خاسر يقلّل من مخاطر تجريب أشياء جديدة.
من الأمثلة الجيّدة على الثقافة التي تجمع بين الاستعداد للتجريب والانضباط الصارم شركة "فلاغشيب بيونيرينغ" (Flagship Pioneering)، ومقرّها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة، وهي عبارة عن شركة يقوم نموذجها التجاري على إنشاء مشاريع جديدة بالاستناد إلى العلوم الرائدة. لا تطلب "فلاغشيب" عادة من روّاد الأعمال المستقلين تقديم نماذج عمل تجارية، وإنما تستعين بالفَرق الداخلية المؤلفة من العلماء لاكتشاف فرص لمشاريع جديدة. تمتلك الشركة عملية استكشاف رسمية، تتولّى فيها فرق صغيرة من العلماء الذين يعملون بتوجيهات من أحد شركاء الشركة، القيام بأبحاث على مشكلة ذات أهمية اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، مثل قضية التغذية. أثناء عمليات الاستكشاف هذه، تقرأ الفرق الأدبيات العلمية المتاحة حول الموضوع، وتتفاعل مع شبكة واسعة من المستشارين العلميين الخارجيين المرتبطين بالشركة للوصول إلى استنتاجات علمية جديدة. تتّصف عمليات الاستكشاف في بادئ الأمر بأنّها غير مقيّدة. تُدرسُ كل الأفكار، مهما بدت غير معقولة أو مفعمة بالمبالغة. ووفقاً لمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي نوبار أفيان، "في المراحل المبكرة من عمليات الاستكشاف لدينا، لا نطرح السؤالين التاليين: "هل هذا صحيح؟" أو "هل هناك بيانات تدعم هذه الفكرة؟" ولا نبحث عن أوراق أكاديمية توفّر برهاناً على أنّ شيئاً ما صحيح. بل نطرح على أنفسنا السؤالين التاليين: "ماذا لو كان هذا صحيحاً؟ أو "لو تبيّن أنّ هذا صحيح فهل يكون ذا قيمة؟" ومن خلال هذه العملية، يُنتظر من الفرق صياغة فرضيات لمشاريع قابلة للاختبار.
يُعتبرُ التجريبُ جزءاً أساسياً من عملية الاستكشاف في "فلاغشيب" لأنّ هذه هي الطريقة التي تسمح برفض الأفكار، وإعادة صياغتها، وتطويرها. لكنّ التجريب في "فلاغشيب" يختلف اختلافاً جذرياً وبعدّة طرق عمّا أراه غالباً في الشركات الأخرى. أولاً، لا تُجري "فلاغشيب" تجارب للتثبّت من صحّة أفكار أولية، بل يُفترض بالفرق تصميم تجارب مُحكمة تزيد من احتمال كشف عيوب فكرة معيّنة إلى الحد الأقصى. ثانياً، خلافاً للعديد من الشركات الراسخة التي تموّل المشاريع الجديدة بقوّة بناءً على الاعتقاد الخاطئ القائل إنّ المزيد من الموارد يُترجم إلى سرعة أكثر وإبداع أكبر، فإنّ "فلاغشيب" تصمّم تجاربها المُحكمة بحيث تتكلّف أقل من مليون دولار وتستغرّق أقل من ستة أشهر للانتهاء منها. هذه المقاربة الرشيقة لا تمكّن الشركة من اختبار المزيد من الأفكار بسرعة أكبر فحسب، وإنّما تسهّل نفسياً الابتعاد عن المشاريع التي تراوح مكانها. وهي تُجبر الفرق على تضييق نطاق تركيزها على أكثر نقاط عدم اليقين التقني أهمية وتعطيهم ردوداً أسرع. وتتمثّل فلسفة الشركة في معرفة الأخطاء التي ارتكبتها باكراً ومن ثم الانتقال بسرعة في اتجاهات مبشرة بشكل أكبر.
ثالثاً، البيانات التجريبية في "فلاغشيب" مقدّسة. فإذا ما أعطت تجربة معيّنة بيانات سلبية حول فرضيّة ما، فإنّ المنتظر من الفَرق هو إمّا إيقاف أفكارها أو إعادة صياغتها بناءً على النتائج. في العديد من المؤسسات، الوصول إلى نتيجة غير متوقعة هو "خبر سيء". وغالباً ما تشعر الفرق بالحاجة إلى تحوير البيانات – كوصف النتيجة على أنّها انحراف من نوع معيّن – بهدف إبقاء برنامجها حيّاً. أمّا في "فلاغشيب" فإنّ إهمال البيانات التجريبية هو أمر غير مقبول.
أخيراً، يمتلك أعضاء فريق المشاريع في "فلاغشيب" أنفسهم حافزاً قوياً للمحافظة على الانضباط في برامجهم. فهم لا يحقّقون مكاسب مادّية من الالتزام ببرنامج خاسر. في الحقيقة العكس هو الصحيح، فالاستمرار في السير في برنامج فاشل يعني تضييع فرصة الانضمام إلى برنامج رابح. ومرّة أخرى، لنقارن هذا النموذج مع ما هو شائع في العديد من الشركات، إذ يعد إلغاء برنامجك خبراً سيئاً بالنسبة لك شخصياً. فقد يعني ذلك خسارتك لمكانتك أو حتى خسارتك لوظيفتك. وإبقاء برنامجك على قيد الحياة هو أمر جيّد لمسارك المهني. أما في "فلاغشيب" فإنّ البدء بمشروع جديد، وليس الإبقاء على برنامجك حيّاً، هو ما يدعم مسارك المهني. (إفصاح: أنا عضو في مجلس إدارة شركة "فلاغشيب"، لكنّ المعلومات الواردة في هذا المثال مأخوذة من حالة أجريت بحثاً بشأنها لصالح كلية هارفارد للأعمال وشاركت في تأليفها).
التجريب المنضبط هو فعل يقوم على الموازنة. فمن موقعك كقائد، أنت تريد تشجيع الموظفين على دراسة "الأفكار غير المعقولة"، وإعطاءهم الوقت لصياغة فرضياتهم. كما أنّ طلب البيانات لتأكيد فرضية معيّنة أو نفيها بسرعة زائدة عن اللزوم يمكن أن يشكّل عنصراً ضاغطاً على الجهد الفكري الضروري للإبداع. بطبيعة الحال، حتّى التجارب ذات التصميم الأفضل والتنفيذ الأمثل لا تعطي نتائج من النوع الأبيض والأسود. لأنّ هناك حاجة إلى إطلاق أحكام علمية وتجارية لمعرفة أي من الأفكار يجب المضي بها قدماً، وأي منها تجب إعادة صياغته، وأي منها يجب وقفه. لكنّ كبار القادة بحاجة إلى ضرب نموذج يُحتذى في الانضباط، من خلال إنهاء المشاريع التي يترأسونها مثلاً، أو إبداء الاستعداد لتغيير أفكارهم في ضوء البيانات التي يحصلون عليها من تجربة معيّنة.
3. الشعور بالأمان النفسي رغم الصراحة القاسية
الأمان النفسي هو مناخ مؤسّسي يشعر فيه الأفراد أنّهم قادرون على الحديث بصراحة وصدق عن المشاكل دون الخوف من الانتقام. تشير عقود من الأبحاث التي أجرتها على هذا الموضوع إيمي إدموندسن، الأستاذة الجامعية في كلية هارفارد للأعمال، إلى أنّ البيئات التي تتّصف بالأمان النفسي لا تساعد المؤسسات على تجنّب الأخطاء الكارثية فحسب، وإنّما تدعم التعلّم والابتكار أيضاً. على سبيل المثال، عندما أجريت أنا وإدموندسون، وخبير الرعاية الصحية ريتشارد بومر بحثاً حول تبنّي فِرَق جراحة القلب لتكنولوجيا مبتكرة للقيام بعمليات التدخل الجراحي المحدود)، وجدنا أنّ الفَرق التي تضمّ في عضويتها ممرضين أو ممرّضات كانوا يشعرون بالأمان تجاه فكرة الحديث بصراحة عن المشاكل أتقنوا التكنولوجيا الجديدة في وقت أسرع. فإذا ما كان الموظفون يخشون من توجيه الانتقادات وتحدّي آراء رؤسائهم علناً ومناقشة أفكار الآخرين وطرح آراء معاكسة، فإنّ الابتكار يمكن أن يُسحق.
نحن جميعاً نعشق قول ما يدور في أذهاننا دون خوف – ونحن جميعاً نريد لصوتنا أن يُسمع – لكنّ الأمان النفسي هو طريق في اتجاهين. إذا كان من الآمن بالنسبة لي أن انتقد أفكارك، يجب أن يكون من الآمن أيضاً بالنسبة لك أن تنتقد أفكاري، سواء أكانت مرتبتك في الشركة أعلى من مرتبتي أو أدنى منها. الصراحة غير المنمّقة هي أمر أساسي للابتكار لأنها السبيل الذي يسمح للأفكار أن ترتقي وتتحسّن. وبما أنّني راقبت أو شاركت في عدد هائل من اجتماعات فرق البحث والتطوير، وجلسات مراجعة مشاريع، واجتماعات أعضاء مجالس إدارة، أستطيع أن أشهد، وبراحة ضمير، أنّ مقدار الصراحة يتفاوت تفاوتاً هائلاً. في بعض المؤسسات، يشعر الموظفون بارتياح شديد في مواجهة بعضهم بعضاً عندما يتعلّق الأمر بالأفكار، والمنهجيات، والنتائج. النقد يكون حادّاً ويُتوقع من الموظفين أن يكونوا قادرين على الدفاع عن مقترحاتهم استناداً إلى البيانات أو المنطق.
أمّا في أماكن أخرى، فإنّ المناخ يتّسم بقدر أكبر من الأدب. وهناك قيود تفرض على الاختلاف في الآراء، فالكلمات منتقاة بعناية، والنقد يعرّض صاحبه للإسكات (على الأقل علناً). ومن يتحدّى بقوّة زائدة قليلاً، يعرّض نفسه لخطر أن يُنظر إليه على أنّه لا يجيد العمل ضمن فريق. إحدى المديرات في شركة كبيرة عملت فيها استشارياً التقطت جوهر هذه الثقافة وعبّرت عنها قائلة: "تكمن مشكلتنا في أنّنا مؤسسة لطيفة بشكل لا يصدّق".
عندما يتعلّق الأمر بالابتكار، تتفوّق المؤسسة الصريحة على المؤسسة اللطيفة في كل مرّة. فالنوع الثاني من المؤسسات يخلط ما بين اللطف والأدب من جهة، والاحترام من جهة أخرى. فليس هناك تناقض بين الصراحة والاحترام. في الحقيقة، أنا أرى أن توجيه النقد الصريح إلى الآخرين وقبوله منهم هما من علامات الاحترام. ولا يمكن قبول نقد هدّام لفكرتك إلا إذا كنت تحترم رأي الشخص الذي يعطي تقويمه.
ومع ذلك، وإذا نحّينا هذا الشرط جانباً، فإنّ المؤسسات التي تتّسم "بالصراحة الفجّة" قد لا توفّر بالضرورة أكثر بيئة مريحة ليعمل الإنسان فيها. وبالنسبة للأشخاص الخارجيين والقادمين الجدد، فإنّ الموظفين قد يظهرون بمظهر العدوانيين أو ذوي الطباع الحادّة. لا أحد يتبختر بكلماته بخصوص فلسفات التصميم، أو استراتيجيته، أو افتراضاته، أو تصوّرات السوق تجاهه. كل شيء يقوله أي إنسان يتعرّض للتدقيق والتمحيص (بمعزل عن اللقب الوظيفي لذلك الشخص).
ينطوي بناء ثقافة من الحوار الصريح على تحدّيات ضمن المؤسسات التي يميل الموظفون فيها إلى الابتعاد عن المواجهة أو التي يُنظر فيها إلى هذا النوع من الحوار على أنّه خرق لقواعد السلوك المتحضّر. يحتاج كبار القادة إلى ضبط الإيقاع من خلال سلوكهم الذاتي. يجب أن يكونوا مستعدّين (وقادرين) على توجيه النقد البنّاء لأفكار الآخرين دون أن يكونوا قساة. إحدى الطرق التي يمكنهم اتباعها للتشجيع على هذا النوع من الثقافة هي أن يطلبوا من الآخرين توجيه النقد إلى أفكارهم ومقترحاتهم. ويمكن العثور على مثال نموذجي عن ذلك في اجتماع الإحاطة الذي عقده الجنرال دوايت أيزنهاور لعرض خطته الحربية أمام كبار قادة قوّات الحلفاء قبل ثلاثة أسابيع من غزو النورماندي. فكما ذُكِرَ في السيرة الذاتية لأيزنهاور والتي كتبها جيفري بارت بعنوان "إيزنهاور" (Eisenhower) فإنّ الجنرال بدأ الاجتماع بالقول: "أعتبر أنّ من واجب أي شخص يرى عيباً في هذه الخطّة ألا يتردّد في قول "لا". أنا لا أتعاطف على الإطلاق مع أي شخص لا يوجّه النقد مهما كان موقعه. فنحن موجودون هنا لتحصيل أفضل النتائج الممكنة".
لم يكن أيزنهاور يدعوا الناس إلى توجيه النقد أو عرض أفكارهم فحسب، وإنما كان يطلبه حرفياً ويتطرّق إلى جانب آخر مقدّس في الثقافة العسكرية ألا وهو الواجب. ما هي الوتيرة التي تطلب فيها من مرؤوسيك المباشرين توجيه النقد إلى أفكارك؟
4. التعاون مع تحمّل الأفراد لمسؤولياتهم
تحتاج الأنظمة الابتكارية التي تعمل بأسلوب ناجح إلى المعلومات، والآراء، وإلى تكامل كبير في جهود مجموّعة متنوّعة من المساهمين. وينظرُ الموظفون الذين يعملون في ثقافة تعاونية إلى طلب المساعدة من الزملاء على أنّه أمر طبيعي بغضّ النظر عمّا إذا كان تقديم هذه المساعدة يندرج ضمن التوصيفات الوظيفية الرسمية للزملاء أم لا، لأنّ لديهم إحساساً بالمسؤولية الجماعية.
لكن في أحيان كثيرة ثمّة خلط بين التعاون والتوافق في الآراء. فالتوافق في الآراء يسمّم عملية اتخاذ القرار بسرعة والتعامل مع المشاكل المعقّدة المقترنة بالابتكار ذي الطابع التحوّلي. وفي نهاية المطاف، هناك شخص يجب أن يتّخذ القرار وأن يتحمّل مسؤولياته. ففي الثقافة القائمة على تحمّل المسؤولية يُنتظر من الأفراد اتخاذ القرارات وتحمّل التبعات.
ليس هناك أي تناقص متأصّل في الثقافة التي تقوم على التعاون وتحمّل المسؤولية في الوقت ذاته. فقد تُجري اللجان مراجعات للقرارات أو قد توفّر الفَرق الآراء، لكن في نهاية المطاف هناك أفراد محدّدون مسؤولون عن الاختيارات الحرجة المتعلّقة بالتصميم، وهم من يقرّر ما هي المزايا التي تبقى والمزايا التي يجب أن تختفي، ومن هم المورّدون الذين سيُستعان بخدماتهم، وما هي استراتيجية قنوات التسويق المعقولة أكثر من غيرها، وما هي الخطة التسويقية الأفضل، وهكذا دواليك. أنشأت "بيكسار" عدّة طرق لتوفير الآراء التقويمية إلى مخرجي الأفلام لديها، ولكن كما يصف الشريك المؤسس للشركة ورئيسها إد كاتمول في كتابه "الإبداع في الشركات" (.Creativity, Inc)، فإنّ المخرج يختار ما هي الآراء التقويمية التي يقبلها وما هي الآراء التقويمية التي يتجاهلها وهو يتحمّل مسؤولية مضمون الفيلم.
يمكن لتحمّل المسؤولية والتعاون أن يكونا أمرين متكاملين، ويمكن لتحمّل المسؤولية أن يشكّل حافزاً للتعاون. لنأخذ مثلاً حالة مؤسسة ستكون أنت مسؤولاً عن اتخاذ قرارات محدّدة فيها ولا مجال للاختباء. ستتحمّل تبعات قراراتك الجيّدة منها والسيئة. آخر شيء يمكنك أن تفعله هو أن تغلق الباب في وجه آراء الأشخاص الآخرين من داخل المؤسسة أو من خارجها، أو أن تمتنع عن طلب العون والتعاون منهم.
شركة أمازون هي من الأمثلة الجيّدة على مدى دفع التحفيز على تحمّل المسؤولية للسلوك التعاوني. ففي معرض بحث أجريته لصالح كلية هارفارد للأعمال، علمت أنّه عندما تولّى أندي جاسي رئاسة قسم الحوسبة السحابية في أمازون عام 2003، وكان القسم وقتها يخطو خطواته الأولى، كان التحدّي الأكبر بالنسبة له هو معرفة الخدمات التي يجب عليه تقديمها (وتلك لم تكن بالمهمّة السهلة على الإطلاق نظراً لأنّ الحوسبة السحابية كانت مجالاً جديداً بالكامل بالنسبة لأمازون، والعالم حتّى). سعى جيسي على الفور إلى طلب المساعدة من الفرق التكنولوجية في أمازون، ومن قادة الأقسام والقادة التقنيين فيها، ومن المطوّرين الخارجيين. كانت آراؤهم بخصوص المتطلبات والمشاكل والاحتياجات أساسية جدّاً لنجاح ما أصبح في نهاية المطاف قسم خدمات الإنترنت في أمازون "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services)، وهو اليوم قسم مربح تبلغ قيمته 12 مليار دولار تحت قيادة جيسي. بالنسبة لجيسي، كان التعاون أساسياً لنجاح برنامج كان هو شخصياً مسؤولاً عنه.
بوسع القادة أن يشجّعوا على تحمّل المسؤولية من خلال إخضاع أنفسهم للمساءلة علناً، حتى عندما يتسبّب ذلك بمخاطر شخصية لهم. قبل بضع سنوات عندما ترأّس بول ستوفلز وحدة البحث والتطوير في قسم المستحضرات الصيدلانية في "جونسون آند جونسون"، عانت مجموعته من فشل في برنامج سريري أساسي يخصّ المراحل النهائية لاختبار دواء معيّن. (إفصاح: قدّمت شخصياً المشورة لعدّة أقسام مختلفة في "جونسون آند جونسون"). وكما ذكر ستوفلز في اجتماع حضرته مع مدراء "جونسون آند جونسون"، طلب كبار القادة وأعضاء مجلس الإدارة معرفة سبب النكسة التي أصابت البرنامج، فإنّ جوابه وقتها كان: "أنا أتحمّل المسؤولية لأنّني إذا تركت الأمر يتجاوزني، ووجهّت أصابع اللوم إلى أشخاص جازفوا لإطلاق المشروع وإدارته، فإننا سنخلق وقتها مؤسسة تتحاشى المجازفة وسنكون أسوأ حالاً. والأمر برمته عندي". غالباً ما يروي ستوفيلز، الذي بات اليوم المدير العلمي في شركة "جونسون آند جونسون"، هذه القصّة للموظفين في جميع أنحاء الشركة قائلاً: "أنتم تجازفون وأنا أتحمّل اللوم"، ثمّ يحثّ جمهوره على تعميم هذا المبدأ من القمّة إلى القاعدة في المؤسسة.
5. قيادة قويّة رغم غياب التراتبية
عطي الهيكلية التنظيمية لأيّ مؤسسة فكرة جيّدة إلى حدّ كبير عن مدى التسطّح في هيكلية الشركة لكنّه لا يعطي فكرة عن مدى التسطّح في ثقافتها – أي كيفية تصرّف الموظفين وتفاعلهم بغضّ النظر عن مناصبهم الرسمية. في المؤسسات التي تفتقر إلى التراتبية، يُمنح الموظفون مساحة عريضة للتحرّك، واتخاذ القرارات، والتعبير عن آرائهم. كما يُمنح الاحترام على أساس الكفاءة وليس بناء على اللقب الوظيفي. وعادة ما تتجاوب المؤسسات التي تفتقر إلى التراتبية الثقافية بسرعة أكبر مع الظروف المتغيّرة على نحو سريع لأنّ آلية اتخاذ القرارات لامركزية وأقرب إلى مصادر المعلومات ذات الصلة. وهي تميل إلى توليد تنوّع أغنى في الأفكار بالمقارنة مع المؤسسات القائمة على التراتبية، لأنها تستفيد من معارف مجموعة أوسع من المساهمين وخبراتهم وآرائهم.
لكنّ غياب التراتبية لا يعني غياب القيادة، بل المفارقة تكمن في أنّ المؤسسات التي تفتقر إلى التراتبية تحتاج إلى قيادة أقوى من المؤسسات القائمة على التراتبية. فالمؤسسات ذات الهيكلية التنظيمية المسطّحة غالباً ما تنحدر إلى الفوضى عندما تخفق القيادة في وضع أولويات وتوجّهات استراتيجية واضحة. أمازون وجوجل هما مؤسستان تتمتعان بهيكلية تنظيمية شديد التسطّح كما أنّ آليات اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية فيهما تُدفع نحو الأسفل، فيما يتمتّع الموظفون على جميع المستويات بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي للمضي قدماً في العمل على الأفكار المُبتكرة. مع ذلك، فإنّ كلتا الشركتين لديهما قادة في منتهى القوّة ويتمتّعون برؤى بعيدة المدى وقادرون على توصيل الأهداف والتعبير عن المبادئ الأساسية التي تخصّ الآليات التي يجب أن تعمل مؤسستيهما وفقها.
هنا مجدّداً يحتاج تحقيق التوازن بين غياب التراتبية والقيادة القوية إلى إدارة خبيرة. تسطّح الهيكل التنظيمي لا يعني أن ينأى كبار القادة بأنفسهم عن التفاصيل التشغيلية أو المشروع. في الحقيقة، يسمح غياب التراتبية للقادة بأن يكونوا أقرب إلى مراكز الفعل. كان الراحل سيرجيو مارتشيوني، الذي قاد عملية إعادة هيكلة شركة فيات أولاً ثم شركة كرايسلر (وكان الشخص الذي هندس عملية اندماجهما) قد علق لي خلال إحدى المقابلات التي أجريتها في معرض إعداد حالة دراسية لصالح كلية هارفارد للأعمال قائلاً: "في كلتا الشركتين، استعملت المبادئ الأساسية ذاتها لإحداث الانقلاب فيهما. أولاً، كنت أحوّل الهيكلية التنظيمية للمؤسسة إلى هيكلية مسطّحة تفتقر إلى التراتبية. اضطررت إلى تقليص المسافة الفاصلة بيني وبين من يتّخذون القرارات. (في وقت من الأوقات، كان هناك 46 مرؤوساً مباشراً لدى مارتشيوني من كلتا المؤسستين). إذا كانت هناك مشكلة، أودّ أن أعرفها مباشرة من الشخص المعني وليس من مديره".
في كل من فيات وكرايسلر، نقل مارتشيوني مكتبه إلى قسم الهندسة ليكون أقرب إلى برامج تخطيط المنتجات وتطويرها. وقد اشتهر بصفته شخصاً يركّز على التفاصيل، وبدفعه لعملية اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى في المؤسسة. (فمع وجود هذا العدد الكبير من المرؤوسين المباشرين، كان من شبه المستحيل بالنسبة له ألا يفعل ذلك!).
تحقيق التوازن الصحيح بين تسطّح الهيكلية التنظيمية والقيادة القوية هو أمر صعب على القيادة العليا والموظفين في عموم المؤسسة على حدّ سواء. بالنسبة للقيادة العليا، يحتاج الأمر إلى القدرة على التعبير عن رؤى واستراتيجيات مثيرة للاهتمام (الأشياء المتعلقة بالصورة الكبرى)، مع امتلاك المهارة والكفاءة في الوقت نفسه فيما يتعلق بالقضايا التقنية والتشغيلية. كان ستيف جوبز مثالاً عظيماً للقائد الذي يمتلك هذه القدرة. فقد وضع رؤى قوية لآبل مع التركيز في الوقت عينه وبجنون على القضايا التقنية والتصاميم. أمّا بالنسبة للموظفين، فإنّ غياب التراتبية يستدعي منهم تطوير قدراتهم الذاتية القيادية القوية، والارتياح إلى اتخاذ القرارات وتحمّل المسؤولية عن قرارتهم.
قيادة الرحلة
كل التغيّرات الثقافية صعبة. والثقافات المؤسسية تشبه العقود الاجتماعية في تحديدها لقواعد العضوية. وعندما يشرع القادة في تغيير ثقافة مؤسسة معيّنة، فإنّهم بمعنى من المعاني يخرقون عقداً اجتماعياً. لذلك لا يجب أن يكون مفاجئاً أن يُبدي العديد من الموظفين داخل مؤسسة معيّنة مقاومة، ولاسيما من يرتاحون للعمل بموجب القواعد الحالية.
تتّسم قيادة رحلة بناء ثقافة ابتكارية والمحافظة على ديمومتها بصعوبة خاصّة لثلاثة أسباب. أوّلاً، بما أنّ الثقافات الابتكارية تحتاج إلى مزيج من السلوكيات المتناقضة ظاهرياً، فإنّها معرّضة لخطر إثارة حالة من الإرباك.
عندما يُمنى مشروع رئيس معيّن بالفشل، فهل يجب أن نحتفي بذلك؟ هل يجب على قائد البرنامج أن يتحمّل المسؤولية؟ تتوقّف الإجابة عن هذين السؤالين على الظروف. هل كان بالإمكان الحيلولة دون حدوث الفشل؟ هل كانت هناك مشاكل معروفة سلفاً الأمر الذي كان يمكن أن يقود إلى خيارات مختلفة؟ هل كان أعضاء الفريق يتمتعون بالشفافية؟ هل كانت هناك أمور قيّمة تعلّمها الموظفون من هذه التجربة؟ وهكذا دواليك. دون الوضوح بشأن هذه التفاصيل الصغيرة، يمكن للموظفين أن يُصابوا وبكل سهولة بالإرباك، بل قد ينزلقون إلى التشكيك بنوايا القيادة والسخرية منها.
ثانياً، رغم أنّ بعض السلوكيات التي تحتاجها الثقافات الابتكارية يمكن تبنّيها بسهولة، إلا أنّ بعضها الآخر أقل استساغة بالنسبة للبعض الآخر في المؤسسة. فمن ينظرون إلى الابتكار على أنّه وضع يخلو من الضوابط يرون في الانضباط تقييداً غير ضروري لإبداعهم؛ ومن يرتاحون إلى الذوبان في بحر التوافق في الآراء لن يرحّبوا بأي نقلة نحو تحمّل المسؤولية الشخصية. بعض الموظفين سيتأقلمون بسهولة مع القواعد الجديدة – حتّى أنّهم قد يفاجئونكم – لكن البعض الآخر لن ينجح.
ثالثاً، بما أنّ الثقافات الابتكارية هي نظم من السلوكيات المتّكلة على بعضها البعض، فإنّه لا يمكن تطبيقها بأسلوب مجزّأ ومشتّت. خذوا بعين الاعتبار الكيفية التي تتكامل بها السلوكيات وكيف يعزّز بعضها بعضاً. فالأشخاص ذوو الكفاءات العالية سيكونون أكثر ارتياحاً إزاء عملية اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، كما أنّ "حالات فشلهم" أكثر ميلاً إلى أن تكون فرصاً للتعلّم ولن تذهب سدى. التجارب المنضبطة ستكلّف أقل وتعطي معلومات أكثر نفعاً – لذلك مجدّداً يصبح التسامح مع التجارب الفاشلة أمراً حصيفاً وليس ضرباً من قصر النظر. يُسهّل تحمّل المسؤولية على المؤسسة تبنّي هيكلية تنظيمية مسطّحة تفتقر إلى التراتبية، كما أنّ المؤسسات التي تضمّ هذا النوع من الهيكليات التنظيمية تخلق تدفقاً سريعاً من المعلومات، الأمر الذي يقود إلى عملية اتخاذ قرارات أسرع وأذكى.
الاستعداد للتجريب لا يعني العمل بأسلوب فنّان تجريدي من الدرجة الثالثة يضرب القماش بريشته عشوائياً.
بعيداً عن الأشياء المعتادة التي بوسع القادة فعلها لقيادة عملية تغيير الثقافة (التعبير عن القيم والسلوكيات النموذجية المستهدفة وغيرها وإبلاغ الموظفين بها)، يحتاج بناء ثقافة ابتكارية إلى بعض الإجراءات المحدّدة. أولاً، يجب على القادة أن يتحلّوا بالشفافية الكبيرة مع المؤسسة بخصوص الوقائع الأصعب التي تنطوي عليها الثقافات الابتكارية. فهذه الثقافات ليست كلها ممتعة أو ضرباً من اللعب. والعديد من الموظفين سيتحمّسون إلى احتمالات امتلاك حرية أكبر في التجريب، والفشل، والتعاون، والتحدّث بحرية، واتخاذ القرارات. لكنّهم يجب أن يدركوا أيضاً أنّ هذه الحريات لا تأتي دون مسؤوليات. فمن الأفضل التمتّع بالصراحة منذ البداية عوضاً عن المجازفة باستدراج السخرية لاحقاً عندما يبدو أنّ القواعد ستتغيّر في منتصف الطريق.
ثانياً، يجب على القادة أن يدركوا أنّه ليس هناك من طرق مختصرة لبناء ثقافة ابتكارية. وثمّة قادة كثر يعتقدون أنّ تقسيم المؤسسة إلى وحدات أصغر حجماً أو خلق "أعمال كريهة" تتمتّع بالاستقلال الذاتي يمكن أن يكون تقليداً ناجحاً للثقافة الابتكارية السائدة في الشركة الناشئة. لكنّ هذه المقاربة نادراً ما تكون ناجحة. فهي تخلط بين الحجم والثقافة. فمجرّد تقسيم مؤسسة بيروقراطية كبيرة إلى وحدات أصغر حجماً لا يمنحها الروح الريادية بسحر ساحر. فدون جهود قوية من الإدارة لتحديد القيم والمعايير والسلوكيات، فإنّ هذه الوحدات المتفرّعة تميل إلى وراثة الثقافة السائدة في المؤسسة الأم التي انبثقت عنها. هذا لا يعني أن الوحدات أو الفرق التي تتمتّع بالاستقلال الذاتي لا يمكن استعمالها لتجريب ثقافة معيّنة أو احتضانها، بل إن هذا ممكن. لكن لا يجب التقليل من شأن التحدّي المتمثّل ببناء ثقافات ابتكارية داخل هذه الوحدات. وهي لن تكون مناسبة للجميع، لذلك لا بدّ من اختيار من ينضمّون من المؤسسة الأم إلى هذه الوحدات بمنتهى العناية.
أخيراً، وبما أنّ الثقافات الابتكارية يمكن أن تفتقر إلى الاستقرار، وبما أنّ التوتّر بين القوى المتعارضة يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، فإنّ القادة بحاجة إلى أن يكونوا يقظين بحثاً عن إشارات على وجود إسراف أو تمادي في أي مجال والتدخّل بهدف استعادة التوازن عندما تقتضي الضرورة. التسامح المنفلت مع الفشل يمكن أن يشجّع على التفكير المتراخي واختلاق الأعذار، والإفراط في عدم التسامح مع انعدام الكفاءة يمكن أن يقود إلى الخوف من المجازفة. ليس أيّ من هذين الموقفين المتطرّفين مفيداً. فإذا ما كانت هناك مبالغة زائدة في الاستعداد للتجريب فإنّه يمكن أن يتحوّل إلى رخصة بالمجازفة غير المدروسة جيّداً؛ أمّا الانضباط المفرط في صرامته فيمكن أن يسحق الأفكار الجيدة غير الملتزمة بالقواعد. والمبالغة في التعاون يمكن أن تعرقل عملية اتخاذ القرار، لكن التشديد المفرط على تحمّل المسؤولية الفردية يمكن أن يقود إلى مناخ مُعَطّل يعمل الجميع فيه بغيرة لحماية مصالحهم الذاتية. ثمّة فرق بين الصراحة والوقاحة الفجّة. ويحتاج القادة إلى الانتباه إلى الميول المبالغ فيها، وتحديداً لديهم هم شخصياً. فإذا ما أردت لمؤسستك أن تحقق التوازن الحسّاس المطلوب، يجب عليك أن تظهر قدرتك كقائد على تحقيق هذا التوازن بنفسك.