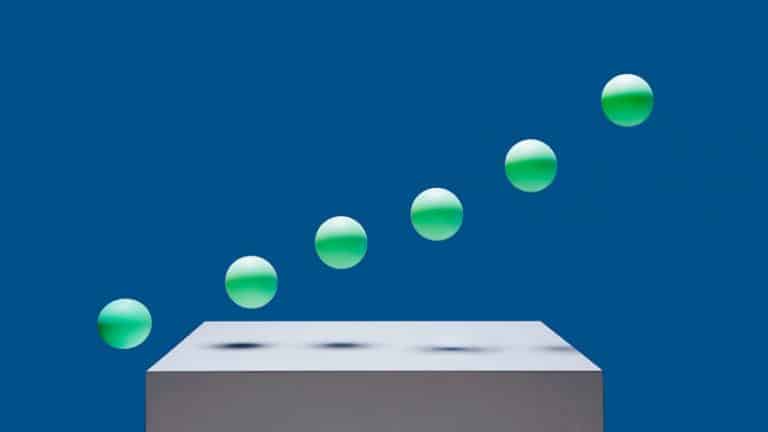إننا نواجه المعضلة التالية: في بيئة العمل التي يسودها التنافس والتعقيد والتقلب، باتت الشركات اليوم تتطلب من موظفيها الاجتهاد أكثر من أي وقت مضى. غير أنّ ذات القوى التي تعصف بالشركات تجهد الموظفين أيضاً وتفاقم مخاوفهم وتحد من قدراتهم.
وفي هذه الحالة، من غير المستغرب أن نجد الكثير من قادة الصف الأول في الشركات يركزون اهتمامهم على كيفية خلق ثقافة قائمة على رفع سوية الأداء. إلا أنّ المفارقة التي خلصنا إليها تتلخص في أنّ بناء ثقافة تركز على الأداء قد لا تكون الطريقة الأفضل والأصح والأكثر ملاءمة لتحقيق أفضل النتائج. بل ربما من الأجدى التركيز على خلق ثقافة حقيقية للنمو.
تتشكل الثقافة من مجموعة المبادئ والمعتقدات التي يبني على أساسها الناس سلوكهم. وباستخدام مفردات بيتر سينغي، عادة ما تركز "المؤسسات المتعلمة" تقليدياً على القضايا ذات التوجه الفكري كالمعرفة والخبرة. ولا شك في أهمية تلك القضايا، بيد أنّ ثقافة النمو الحقيقية يجب أن تركز أيضاً على قضايا أعمق مرتبطة بمشاعر الناس وما ينجم عنها من سلوك. وهكذا يبني الناس في ثقافة النمو قدراتهم لكي يتمكنوا من استيضاح البقع المظلمة في رؤاهم، والاعتراف بمواضع قصورهم وانعدام يقينهم بدلاً من الخضوع لها من دون وعي، وعدم هدر طاقتهم في الحفاظ على قيمتهم الذاتية بل توفير تلك الطاقة لخلق قيمة مضافة خارجية. وهكذا يغدو ما يشعر به الأشخاص – وما ينجم عن ذلك من تأثير على شعور الآخرين – بنفس أهمية ما يعرفونه وما يمتلكونه من خبرة.
ويدين نهجنا بجزء مهم منه للعمل الثوري الذي قام به كل من روبرت كيغان وليزا ليهي حول بناء "ثقافة تنموية مقصودة". ولقد وجدنا أنّ بناء ثقافة نمو حقيقية، إنما يتطلب توفر عدد من المركّبات الذاتية والمؤسسية:
- بيئة آمنة يديرها قادة من الصف الأول على استعداد لأن يلعبوا دور الشخص المعرّض للخطأ وتحمل مسؤولية أخطائه وأوجه قصوره.
- التركيز على التعلّم المستمر عبر طرح الأسئلة وحب الاطلاع والشفافية، بدلاً من الاعتماد على الأحكام والثقة بالنفس والدفاع عن المواقف الشخصية.
- تجريب سلوكيات جديدة على نحو محسوب ومحدود زمنياً، وذلك لاختبار افتراضنا في اللاوعي بأنّ تغيير الوضع الراهن أمر خطير ومن المرجح أن تكون له عواقب سلبية.
- إبداء الملاحظات باستمرار (وفي كل الاتجاهات ضمن المؤسسة) وذلك على أساس الالتزام المشترك بمساعدة كل واحد للآخر على النمو والتطور.
أما الثقافة المدفوعة بالأداء فكثيراً ما تفاقم مخاوف الناس من خلال خلق لعبة محصلتها صفر، يكون فيها الشخص الواحد إما ناجحاً أو فاشلاً، ويجري فيها فصل "الرابحين" بسرعة عن "الخاسرين". وفي حين أنّ النتائج تعد مهمة في ثقافة النمو، إلا أنّ هذه الثقافة تعمل بالإضافة إلى مكافأة النجاح، على معالجة الإخفاقات ومواضع القصور والنظر إليها كفرص للتعلم والتطور على المستويين الفردي والجماعي.
ولعله من السهل نطق هذه الكلمات، غير أنّ تطبيقها أصعب بكثير. فنحن نميل بالفطرة إلى إخفاء نقاط ضعفنا وأخطائنا وتبريرها والتقليل من شأنها والتستر عليها وإنكارها، لأنها تشعرنا بالضعف وتعرضنا للخطر وتقلل من قيمتنا. ولا شك في أنّ هذه المخاوف إنما تضيق منظور رؤيتنا للأمور وتحدده بدلاً من أن توسعه – في حين أنّ درجة تعقيد المشاكل التي نواجهها غالباً ما تكون أكبر من درجة التعقيد الواجبة في تفكيرنا لحل تلك المشاكل.
لقد بدأنا ببناء ثقافة النمو في شركتي الخاصة أعقاب فترة عصيبة قمنا خلالها بالاعتماد على عدد من القادة الجدد الذين يتمتعون بمهارات مختلفة، وذلك لإعادة ابتكار ما كنا نقدمه للزبائن وكيفية إدارتنا للشركة. وحتى ذلك الحين كنا دائماً نتبنى ثقافة تفادي الصراع، ونرغب في أن نرى أنفسنا كأسرة سعيدة ما دامت شركتنا مزدهرة وناجحة. فكنا نخفي مشاعر الكراهية ولا ندعها تظهر على السطح، ما جعل احتواءها أصعب أثناء هذه الفترة العصيبة من التغيير وانعدام اليقين. فتنامى التوتر بين الموظفين القدامى والموظفين الجدد وبين أسلوب الإدارة القديم وأسلوب الإدارة الجديد. وبوصفي المدير التنفيذي، كان الموظفون ينظرون إليّ بوصفي غير مقدر لما كنا عليه وغير مدرك للقيم التي يتعين علينا الاحتفاظ بها.
وبعد تشكيل فريقنا الجديد واتضاح طريقنا المستقبلي، كان أول ما دفعني إليه حدسي هو تسليط الضوء على ما بقي في الشركة من توترات، ومن ثم العمل على أن نكون أكثر شفافية في ما بيننا. غير أننا لم نكن في الواقع قد بنينا القدر الكافي من الأمان والثقة لجعل تلك الخطوة قابلة للتطبيق. وعوضاً عن ذلك، بدأنا العمل ضمن فريقنا الأصغر من مدراء الصف الأول، وطلبنا من جميع الموظفين الإدلاء بدرجة ثقتهم في كل منا من دون الكشف عن هوياتهم، وذلك من حيث الصراحة والنوايا والأصالة والمهارات والاستقامة والمعايير والنتائج.
ولقد كانت الآراء قاسية وصادمة. وعندما جلسنا معاً لمناقشتها، توافقنا على أن نراها من منظار تحمل المسؤولية الشخصية، لا من منظار الموقف الدفاعي. وبادرت إحدى الزميلات بشجاعة إلى الاعتراف بميلها نحو التسلط والسلوك الفظ بعض الأحيان وحالت دون تحديد الأسباب التي قد تكون دفعتها في الماضي إلى تبني هذا السلوك الدفاعي عن النفس. لكنها لم تحاول تبرير شيء. وهكذا انسحب إقرارها بضعفها على جميع المدراء في الفريق. ومن ثم تشاركنا أقسى الآراء التي تلقاها كل منا، وما كان يميزها، وما سببها في نظرنا، وكيف يمكن أن يكون السلوك المختلف. ولقد كان ذلك عملاً مركزاً وشاقاً، لكن أياً منا لم يخف مشاعره بل جعلناها تطفو على السطح.
وبعد أسبوع، قمنا بتشارك بعض التجارب التي قمنا بها في محاولة لاختبار أساليب جديدة في السلوك استجابة للتحدي الذي وضعه كل منا لنفسه. كما توافقنا على الاجتماع مرة كل أسبوع لتشارك النجاحات التي نحققها والإخفاقات التي نقع فيها والاستماع إلى آراء وملاحظات بعضنا البعض. وبعد ثمانية أسابيع، عقدنا اجتماعاً موسعاً مع باقي الموظفين خارج الشركة وأخبرناهم بما تلقيناه منهم من ملاحظات وآراء، وأياً منها كان له الصدى الأكبر والأعمق في أنفسنا، وكيف سنعالجها. وحينئذ، بدأنا فعلاً رحلة بناء ثقافة النمو الخاصة بشركتنا.
قد يكون أهم درس تعلمناه – وهو ينطبق أيضاً على تعاملنا اللاحق مع الزبائن – هو أنّ تأجيج النمو، إنما يتطلب توازناً دقيقاً بين التحدي والدعم. ولنأخذ مثلاً الطفل الصغير الذي يخوض مغامرة التعرف على العالم. إنه يحبو بعيداً عن أمه لاستكشاف البيئة المحيطة به، لكنه ينظر إلى أمه بشكل متكرر ويعود إليها من وقت لآخر لكي يشعر بالأمان والطمأنينة. ولعلنا نحن البالغين غير مختلفين كثيراً عن الأطفال، فتعرضنا للتحديات باستمرار وبشكل مبالغ فيه – ومن دون القدر الكافي من الأمان والطمأنينة – من شأنه أن يرهقنا ويكسرنا في نهاية الأمر. وفي المقابل فإنّ عدم تعرضنا للتحديات بالقدر الكافي – والبقاء لفترة طويلة أكثر من اللازم في وسطنا المريح – يحول دون نمونا ويضعفنا في نهاية المطاف.
إنّ السؤال النمطي الذي تطرحه ثقافة الأداء هو: "كم هو حجم الطاقة الذي يمكننا حشده؟"، والجواب هو: قدر محدد ومنته. أما ثقافة النمو فتسأل: "كم هو حجم الطاقة الذي يمكننا تحريره؟"، والجواب هو: قدر غير محدد ولا منته.