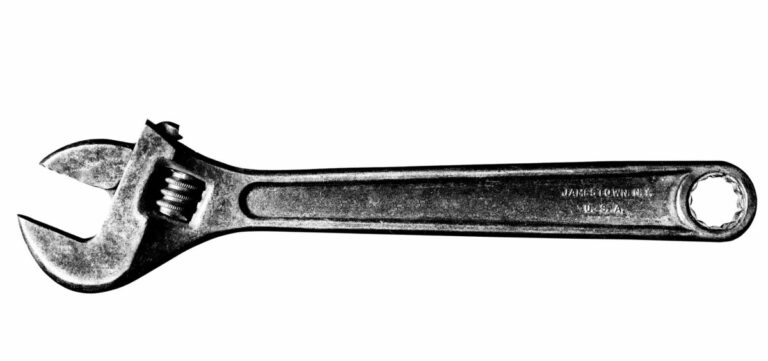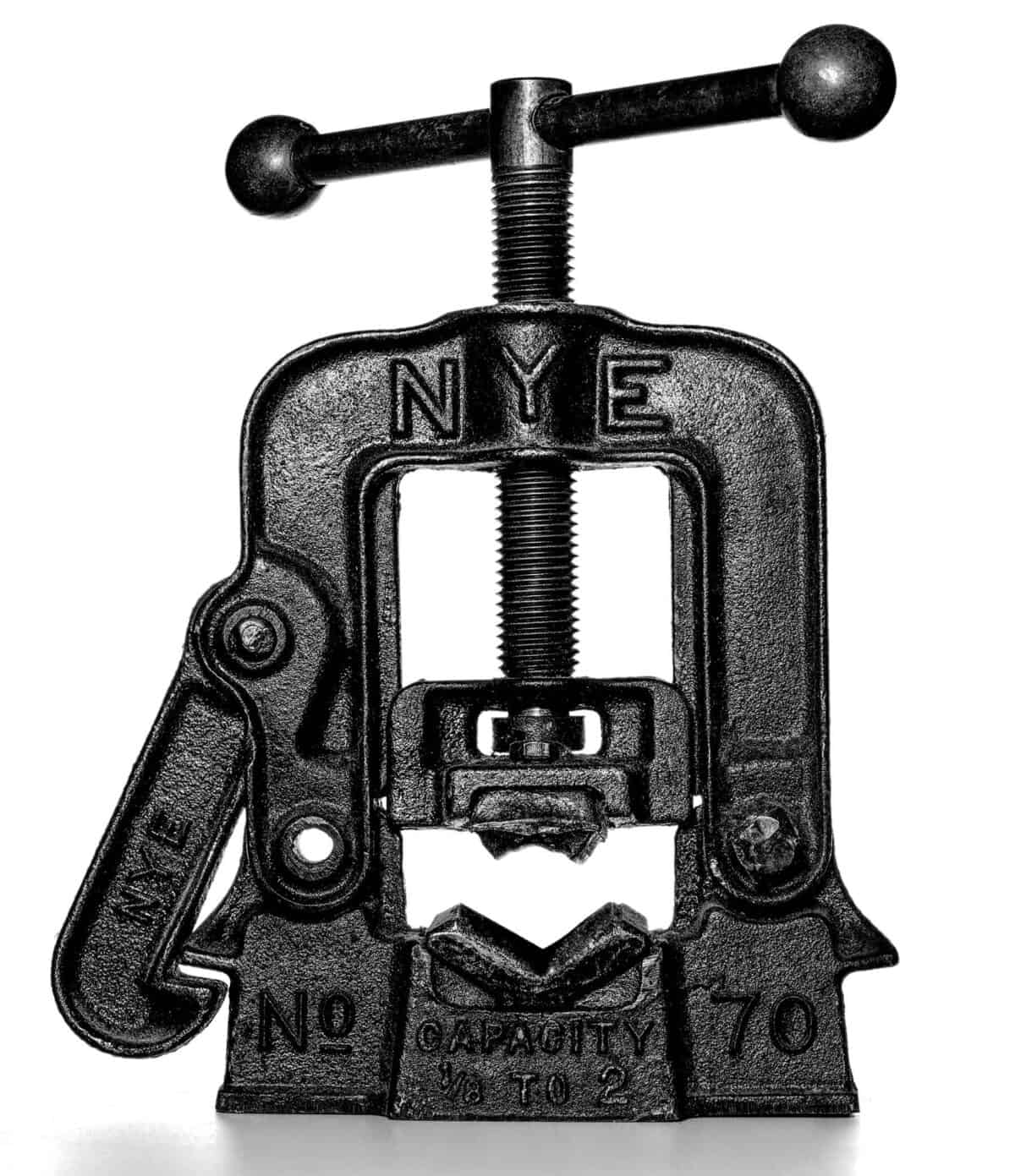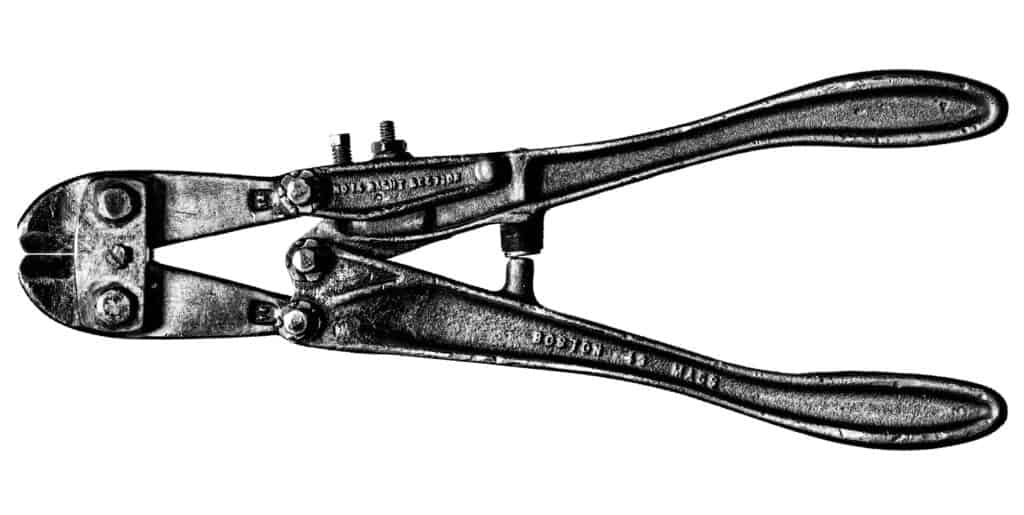انطلقت مطلع ثلاثينيات القرن الماضي مسيرة الإدارة المستنيرة والتي استمرت طويلاً منذ أن بدأ الباحثون والطرف الأهم في المعادلة ممثلين في قادة الشركات في التخلي عن الفرضية التي تنادي بضرورة التعامل مع العاملين كما لو كانوا آلات وإرغامهم على أداء المهمات وفقاً لمواصفات محددة بدقة.
وبدؤوا يؤمنون بضرورة إعادة تصور هندسة إدارة الأفراد والفكرة القائلة بتحسن أداء المؤسسات إذا سُمِح للموظفين بالمشاركة الفعلية في صناعة القرارات المتعلقة بالعمل. وعلى مدار عقود زادت أعداد المنتمين لصفوف الداعمين لمبدأ تمكين الموظفين، ولكن تلوح في الأفق دلائل قوية تشير إلى رجحان الكفة نحو الاتجاه المعاكس في الآونة الحالية، وها هو النموذج الهندسي القديم يعاود الظهور من جديد بقوة، وهو ما يثير موجة عاصفة من القلق.
فعلى الرغم من استمرار العديد من المؤسسات في المناداة بأهمية إشراك الموظفين، لاسيما المؤسسات التي تسعى لتبني، أو تبنت بالفعل، منهجيات مرنة، يبدو أن هناك عدداً كبيراً ومتزايداً يتبع نهج التحسين، وفيه يتولى الخبراء والخوارزميات عمليات الرقابة وصناعة القرار. يتعامل القائمون على هذه المؤسسات مع العمالة كسلعة تباع وتشترى، ويسعون جاهدين لتقليص حجمها للحد الأدنى بإحلال العمالة المؤقتة والعمالة المستقلة محل الموظفين الدائمين وبالاستعانة بالأتمتة والبرمجيات بهدف تقليص الحاجة إلى القدرة على الحكم لدى البشر، ويفرضون على بقية الموظفين الالتزام بالسلوكيات المثالية ويخضعونهم للرقابة الصارمة لضمان امتثالهم للأوامر. لكن لا يوجد حتى الآن دليل إثبات يشير إلى أن هذا التغيير سيكون للأفضل.
يتعامل القائمون على المؤسسات مع العمالة كسلعة تباع وتشترى، ويسعون جاهدين لتقليص حجمها للحد الأدنى بإحلال العمالة المؤقتة والعمالة المستقلة محل الموظفين الدائمين.
يروق التحسين لمعظم المسؤولين التنفيذيين لأنهم استوعبوه جيداً وتعلموا طرق تنفيذه، وإن كان التاريخ قد علمنا أن الكثير والكثير من المشكلات المستمرة قد نشأت كنتيجة عَرَضية لاعتبار أن إنتاجية العمال مجرد تحدٍ هندسي فقط، لذا يجب أن نكون أكثر وعياً هذه المرة، فقد تجاهلنا فيضاً غزيراً من الأدلة التي تُبرهن على الفوائد الجمة التي نجنيها من وراء تمكين الموظفين والخسارة التي نتكبدها نتيجة استبعادهم من منظومة صناعة القرار. ويظل تحقيق التوازن بين النموذجين والاستفادة من كليهما أمراً ممكناً، لكنه يتطلب التخلي عن الاعتقاد بأن أداء العمال هو مسألة هندسية في الأساس.
فكرة المقالة باختصار
التوجه
شهدنا على مدار أربعة عقود تصاعد التوجهات الداعية إلى تمكين العاملين، ولكن ذاع في السنوات الأخيرة صيت الحراك الذي ينادي بتحسين العمالة، ويتعامل مع العمالة كسلعة ويسعى جاهداً لتقليصها إلى الحد الأدنى بالاستعانة بالأتمتة والبرمجيات وفرض الرقابة الصارمة على كيفية أداء الأفراد لوظائفهم، وإحلال العمالة المستقلة والعاملين بعقود مؤقتة محل العمالة الدائمة.
الأسباب الداعية للقلق
لا يوجد دليل على أن هذا الشكل الجديد من "الإدارة العلمية" يُعد إصلاحاً للأفضل، وبانتزاع المسؤولية من أيدي العاملين، فإن الشركة تتسبب في تثبيط عزيمتهم وتقويض إنتاجيتهم وإسهاماتهم المبتكرة.
البديل الأفضل
لا تعطِ الأولوية لعمليات التحسين على حساب تمكين العمالة، بل عليك السعي للوصول للتوازن السليم بين الاثنين، كما هو الحال في نهج "الإنتاج المرن" الذي حقق نجاحاً باهراً، فمن الخطأ الاعتقاد أنه بإمكانك معاملة الأشخاص كالآلات.
يذيع صيت النهج الهندسي خلال فترات الانكماش الاقتصادي، حينما يرفض العاملون الاستقالة من عملهم على الرغم من كراهيتهم لفكرة أن يُعاملوا معاملة الآلات، بينما يشهد هذا النهج تراجعاً حين تتعالى أصوات العاملين بالاحتجاج واستعدادهم التام للقفز من سفينة الشركة. ومن المرجح أن يؤدي الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا إلى ترسيخ جذور هذا النهج، ومن المتوقع أن يكمل هذا النهج التحسيني مسيرته في ظل غياب أي مقاومة من سوق العمل وأي إجراءات رقابية لرصد التداعيات، وسيعد هذا خطأً فادحاً.
نشوء التوجهات المعارضة
ظهر مفهوم "الإدارة العلمية" لأول مرة على يد فريدريك تايلور في مطلع القرن العشرين بهدف إدارة المؤسسات بكفاءة. كان يرى أن هناك طريقة واحدة مثالية لأداء الأعمال، ولكن بإمكان المهندسين وحدهم اكتشافها وليس على العاملين سوى تنفيذها، ولكن سرعان ما امتد هذا الجدال من ساحة العمل الإنتاجي ليشمل الوظائف الإدارية حتى هيمن على كافة الجوانب بدءاً من أنظمة الأجور وصولاً إلى تصميم المكاتب والمباني.
وفي ثلاثينيات القرن الماضي، لاحظ وسترن إلكتريك وغيره من أصحاب العمل قصور هذا النهج، لاسيما مع ظهور أدلة تشير إلى تقاعس الموظفين عن بذل أي جهد، فراحوا يجربون البرامج التي يُمنح فيها العمال مساحة أكبر لإبداء آرائهم، وخففوا من أنظمة الدفع بالقطعة (تقاضي العمال لأجورهم مقابل الإنتاج) وخفضوا من مستهدفات الأداء. أدت هذه التغييرات إلى حدوث تحسينات هائلة. وثَّق إلتون مايو وزملاؤه في "كلية هارفارد للأعمال" هذه النتائج واستخلصوا الدروس المستفادة حول أنجح السبل لتحقيقها، ما أدى إلى ظهور حركة تدعو إلى تعزيز العلاقات الإنسانية. ركزت هذه الحركة على الاهتمام بالاحتياجات النفسية والاجتماعية للموظفين، فقد أراد روادها توطيد العلاقات مع الموظفين الآخرين وإشعارهم بأهمية العمل الذي يؤدونه وإشراكهم في عملية صناعة القرار، وبتوافر هذه الظروف ارتفع أداء العمال بنسب هائلة، وفي غيابها انهار كل ذلك.
وفي عام 1957، أشار دوغلاس ماكغريغور، أحد أشهر الباحثين في مجال الإدارة في مجلة "هارفارد بزنس ريفيو"، إلى وجود انقسام كبير في الآراء الإدارية حول كيفية الحصول على أقصى استفادة ممكنة من العاملين، فهناك المعسكر الذي يتبنى الرأي القائل بوجوب مراقبة العمال وتوجيههم بحزم، بينما يرى المعسكر الآخر أن إسهامات العاملين تزداد بصورة ملحوظة عندما يتمتعون بالحرية الكافية للتعبير عن أفكارهم وتتاح لهم الفرصة لأخذ زمام المبادرة. وفي كتابه الشهير "الجانب الإنساني للمؤسسات" (The Human Side of Enterprise) الصادر عام 1960، يطلق ماكغريغور على النهج الأول اسم "النظرية إكس" بينما يطلق على النهج الآخر اسم "النظرية واي".
شهد نموذج "النظرية واي" رواجاً على مدار العقود الأربعة الماضية، فانتشرت لجان الصحة والسلامة التي تجمع بين أصحاب العمل والموظفين، بالإضافة إلى حلقات الجودة وفرق العمل التي تتمتع بسلطات واسعة داخل المصانع، لكن لم يلبث أن تغير المسار وبدأت الأنظار تلتفت بقوة إلى "النظرية واي" في أواخر السبعينيات عندما ظهر دليل دامغ على تدنى جودة الأعمال التي تنتجها الصناعة الأميركية وبقية دول العالم حيثما تفشت أفكار تايلور. مثلت الأتمتة جزءاً من المشكلة على أقل تقدير، فقد جعلت أداء الوظائف أمراً يبعث على الملل الشديد لدرجة أن العاملين لم يعودوا يكترثون بالمهمات الموكلة إليهم، وعندما لجأت الإدارة لمراقبتهم عن كثب ومعاقبتهم بشدة جرّاء تقاعسهم عن العمل، استفحل تراجع مستوى الأداء والجودة أكثر فأكثر، وتمثل الحل آنذاك في اتخاذ الفحص النافي للجهالة لجعل العمال مسؤولين عن مراقبة الجودة في نهاية خطوط الإنتاج، إضافة إلى رصد المشاكل وإصلاحها. كانت الشركات اليابانية في طليعة الممتثلين لهذا التوجه، فجاء نهج الإنتاج المرن الذي سلكته "تويوتا" مشتملاً على عدة عناصر، وتكمن فكرته الأساسية في منح موظفي الخطوط الأمامية صلاحيات تحسين الجودة والإنتاجية لدرجة منحهم القدرة على إيقاف خطوط الإنتاج، وسرعان ما لاحظ المدراء التميز الواضح للسيارات وغيرها من المنتجات المصنَّعة في مثل هذه المصانع.
وبحلول العقد الأول من الألفية الثالثة، امتد مفهوم الإنتاج المرن (المعروف أيضاً باسم "نظام إنتاج تويوتا") من قطاع السيارات إلى قطاع الرعاية الصحية والقطاعات الحكومية وكافة القطاعات الأخرى. أدى ذلك تحسن معدلات الجودة والإنتاجية والنتائج المتعلقة بالعمالة، مثل انخفاض معدل دوران الموظفين. وفي المقابل، شهد الإنتاج المرن مقاومة في كثير من الأحيان، كان أشهرها في المصانع النقابية الأميركية لإنتاج السيارات، نظراً لاتساع نطاق قواعد العمل وتراجع الثقة بين المدراء والعاملين وساد موقف رافض لهذا المفهوم باعتباره مفهوماً "دخيلاً". على الرغم من ذلك، شهدت السنوات الأخيرة رواج مفهوم "النظرية واي" بعد التوجه نحو إدارة المشاريع التي تتبع المنهجيات المرنة.
الانتكاسة
يمكننا القول إن تراجع شعبية النموذج السلوكي قد بدأ في أعقاب الركود الاقتصادي الكبير الذي دامت آثاره طويلاً للحد الذي جعل العديد من المدراء الأصغر سناً يبلغون سن الرشد وهم لا يعرفون شيئاً آخر، لكن وفي المقابل كانت هناك عوامل أخرى فاعلة.
القوى العاملة السائلة
كان استمرار تقلب الطلب في السوق وثبات قوة العمل هو الهاجس الأكبر الذي لطالما تخوفت منه الشركات، حيث يصعب التخلص من العمالة الزائدة في أوقات الانكماش الاقتصادي كما يصعب إعادتها سريعاً من جديد إذا انتعشت الأحوال فجأة، وهنا ظهر مفهوم اقتصاد العمل الحر ليقترح نهجاً مغايراً.
وكان لقصص النمو الباهر الذي حققته شركات مثل "أوبر"، أثر كبير في أذهان أصحاب العمل الآخرين، فقد رأوا أن سائقي "أوبر" لا يتقاضون أجوراً إلا عندما ينجزون أداء المهمة التي بين أيديهم على أكمل وجه، ما دفعهم إلى تفضيل الاستغناء عن الموظفين بدوام كامل واللجوء لتعيين الموظفين بعقود، فهم لا يتمتعون بأي مزايا وحينئذ لن يُضطروا لدفع أي أجور لهم وقت ركود الأعمال. وكان هذا التحول أشبه بالصنبور الذي نفتحه وقت الحاجة ونغلقه بمجرد انتهاء حاجتنا إليه، وأصبح خفض التكاليف الثابتة لأدنى معدلاتها أكثر الأهداف وضوحاً، وهنا تدخلت شركات التوظيف وشركات التعهيد الخارجي للعمالة لتمكين هذا التحول، واستحدثوا مصطلحات مثل "القوى العاملة السائلة" وإتاحة "الكفاءات عند الطلب" لوصف الأنظمة التي تستعين بالموظفين بعقود لكل مهمة على حدة، ويتولى الموردون توفير الموظفين في الوقت المناسب. وتقدم الآن شركات التعهيد الخارجي للعمالة التعاون عبر "دورة كاملة" تتضمن إدارة موازنات عمليات التوظيف وتسريح العمال والتعاقد مع أصحاب العمل لتأمين الحد الأدنى من التوظيف المطلوب لإنجاز الأعمال المطلوبة يومياً.
وأصبح الآن نموذج إتاحة الكفاءات عند الطلب منتشراً على نطاق واسع. وتشير الدراسات إلى أن حوالي ثلث العاملين في الشركات الأميركية ليسوا بموظفين دائمين فيها، فعدد الموظفين بعقود والعاملين المؤقتين لدى شركة "جوجل" يفوق عدد الموظفين العاملين بدوام كامل (أكثر من 130,000 مقابل 123,000، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2020 في مقال بقلم دايسوكي واكاباياشي، وهي ظاهرة شائعة بين شركات التكنولوجيا. ويكاد يكون التوظيف التعاقدي أساساً لعمل جميع شركات خدمات السيارات وأعمال التوصيل مثل شركتي "أمازون فليكس" (Amazon Flex) و"ديليفرو" (Deliveroo). وتتمثل الحدود القانونية الفاصلة بين الموظفين الدائمين والموظّفين بعقود في الإشراف بفاعلية على الكثير مما يفعله المتعاقدون، مثل رصد أماكن وجود السائقين بالضبط وتحديد كافة المنعطفات التي سيسلكونها خلال مساراتهم، ووفقاً لمقال "نيويورك تايمز" بقلم باتريشيا كالاهان، فإن "أمازون فليكس" تشترط معدلات صارمة فيما يخص الدقة في مواعيد التسليم في الوقت المحدد لتبلغ 999/1,000 (لم نتلقَ أي رد من أمازون حين طلبنا منها التعليق على حقيقة الأمر).
يفقد الموظفون شعورهم بالمسؤولية حين نسلبهم سلطة اتخاذ القرار. لم تتضح حتى الآن أوجه الاستفادة من صناعة القرار استناداً إلى الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ولا يوجد دليل على أن تقليص القوى العاملة يؤدي حقيقةً إلى تحسين نتائج العمل، ولا يصاحب الاستغناء المبكر والعنيف عن الموظفين في فترات الركود تحسناً في الأداء المالي، فوفقاً للنتائج التي خلصت إليها الدراسات، بما في ذلك الدراسة التي أجراها واين كاسيو وأرجون شاترات وروهان كريستي ديفيد، أن الشركات التي تؤجل قرار تسريح العمال تؤدي أداءً أفضل. هذا بالإضافة إلى حاجتنا لمن يتولى متابعة كل موظف متعاقد، ولا شك أن ذلك يتعارض مع مبدأ توفير التكاليف، وهو ما كشفت عنه لورين ويبر الصحفية لدى "وول ستريت جورنال" عند دراستها لقطاع ألعاب الكمبيوتر.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أثبت بحثي وغيره من الأبحاث أن الاستعانة بموظفي شركات التوظيف جنباً إلى جنب مع موظفي الشركة له آثار سلبية على العمالة الدائمة، ويضعف ولاءهم وعلاقاتهم بأقرانهم ويقلل من مستوى الأداء التشغيلي، ولكننا لا نمتلك حتى الآن مقارنة واضحة بين إنتاجية الموظفين بعقود والموظفين الدائمين، وإن كنا نعلم أنهم غير ملزمين بأي التزام قانوني أو معنوي لرعاية مصالح الشركة، على عكس الموظفين الدائمين. لذا وفي ظل وجود الكثير من الموظفين الذين يعملون بعقود، يجب ألا تتوقع الشركات منهم إظهار أي جهود استثنائية، فالواقع أنهم قد يخرقون عقودهم إذا تطوعوا لأداء أمور لم تطلبها الشركات منهم. وينبغي ألا يُتوقع منهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لتمرير الأفكار الجيدة إلى الشركات (كما يفعل الموظفون غالباً) إذا كان بإمكانهم بيعها لعملاء آخرين أو للشركات المنافسة.
أما السبب الأخير الذي يؤكد الفرضيات القائلة بعدم صمود قوى العمل السائلة فهو أن الموظفين بعقود لا ينصرفون بالفعل عند انهيار الأعمال (وأبرز مثال على ذلك ما حدث إبان عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة والتي تسببت في معدلات بطالة مساوية لتلك الناتجة عن الكساد الكبير على مستوى الموظفين العاديين والموظفين بعقود). وقد أثبتت الأبحاث أن الموظفين بعقود يستمرون بالعمل لدى عملائهم في أغلب الأحيان شأنهم شأن الموظفين العاديين لأنهم يبدؤون في تولي مهمات أكثر أهمية، وبهذا ستضيع المعارف والمعلومات التي يمتلكونها إذا تُركوا يغادرون. على سبيل المثال، يعتبر المهندس الاستشاري تيم نير أن قيمته تتمثل في أنه الشخص الوحيد الذي يعلم المواصفات والتصميم الأصلي لأحد مكونات الطائرة، وبظهور مفهوم إتاحة الكفاءات، استطاع بدء العمل بنظام العقود منذ 15 عاماً مضت.
التفاوض على الأجر
نُطبق الآن مفهوم تمايز الأسعار لتحديد المرتبات المبدئية والذي يُعد إحدى أبسط الممارسات التي أنتجتها نظرية التحسين وأهمها، فمن السهل أن ننسى أن أصحاب العمل اعتادوا في السابق وضع رواتب ثابتة عند بدء العمل، خاصة بالنسبة للوظائف في بداية التعيين؛ أما الآن فقد أصبح التفاوض حول الراتب أكثر شيوعاً. وفي استقصاء أجراه موقع "كارير بيلدر" (Career- Builder) عام 2017، أفاد 52% من أصحاب العمل المشاركين أنهم عرضوا على الموظفين المحتملين رواتب أقل مما كانوا على استعداد لدفعه، على أمل ألا يحاول بعض الأشخاص المساومة على زيادة الراتب أو أنهم سيعجزون عن المساومة. وكانوا على حق، فمعظم الموظفين لم يفعلوا ذلك.
يعلم خبراء أماكن العمل أن بعض القضايا تتسبب على المدى الطويل في الكثير من المتاعب، ومن أهمها المشكلات القانونية الناتجة عن دفع أجور متباينة للأشخاص الذين يمتلكون مهارات متماثلة ويؤدون الوظائف ذاتها، ولكن يبدو أن الوفورات الأولية الناتجة عن تقليل الأجور الأساسية في بداية التعيين، والتي يسهل تحقيقها، قد أغرت الشركات باغتنام هذه الفرصة.
الذكاء الاصطناعي والتحسين
يُعد الذكاء الاصطناعي المحرك الأقوى الذي يدفع الشركات نحو تبني "النظرية إكس". وتتمثل أدوات الذكاء الاصطناعي حتى الآن في الخوارزميات المشتقة من برامج تعلم الآلة، وهي عبارة عن مجموعات من المعادلات التي تعمل على تحسين متطلبات التوظيف واختيار المرشحين المناسبين للوظيفة وحركة عمليات التسويق، وما إلى ذلك، فالخوارزميات تنزع سلطة صناعة القرار من أيدي الموظفين وتمنحها للخبراء، أي علماء البيانات الذين يتولون تأسيسها، وهذا هو التحول الذي دعا إليه تايلور بقوله: إيجاد الطريقة المثلى باستخدام المبادئ الهندسية.
تأمّل على سبيل المثال وظيفة النقل بالشاحنات لمسافات طويلة والتي لطالما كانت حصناً للفردية والاستقلالية، فقد كان بإمكان سائقي الشاحنات ذات يوم القيادة كيفما ووقتما شاءوا ما داموا سيصلون إلى وجهتهم المنشودة في الوقت المحدد، غير أن الخوارزميات باتت تفرض عليهم الآن كل شيء بداية من المسارات وجداول المواعيد الزمنية وممارسات القيادة وغيرها من الأمور، حيث زُودت كبائن الشاحنات بمعدات لمراقبة السائقين وجمع البيانات، وذلك للوفاء بالمتطلبات المفروضة ولتحسين الخوارزميات، وتتولى كاميرات المراقبة رصد ما إذا كان السائقون يرفعون أيديهم عن عجلة القيادة، وحينئذ بإمكان الشركة تخفيض رواتبهم، وتُراقب معدلات السرعة وزمن القيادة لحظة بلحظة، ويحصل السائقون على التعليمات خطوة بخطوة للوصول إلى كل وجهة (والتي تشمل، على سبيل المثال، تقليل الانعطافات جهة اليسار لأنها تسبب المزيد من الحوادث وتستغرق وقتاً أطول).
ولعل أحد أبرز الأمثلة على النتائج الإيجابية لهذه التقنية تلك التي نجدها في "أمازون" وموظفي المستودعات التابعين لها، والذين يتجاوز عددهم 125,000 موظف، فهم مطالبون بتحقيق مستهدفات أداء وضعتها الخوارزميات، وتحدد لهم المدة التي يجب أن يستغرقوها لتوصيل كل سلعة حسب ترتيبها في تسلسل طلبات الشراء، وفي حال الإخفاق في تحقيق مستهدفات الأداء يتلقى الموظف تحذيراً تصدره الخوارزمية أيضاً، وإذا تلقى 3 تحذيرات يُفصَل من العمل، وفقاً لما جاء في مقال سكوت شين المنشور في صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2019. صحيح أن القرار النهائي بشأن إقالة الموظف لا يزال بيد المشرف، ولكن ليس واضحاً بعد إلى متى سيستمر الحال على هذا الوضع.
يفقد الموظفون شعورهم بالمسؤولية ويفقدون اهتمامهم بتقديم أي إسهامات حين نسلبهم سلطة اتخاذ القرار، ولم تتضح حتى الآن أوجه الاستفادة من صناعة القرار استناداً إلى الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي. لنفترض أن سائق الشاحنة اكتشف طريقة أفضل للدخول والخروج من أرصفة التحميل، فحينئذٍ يخبر من؟ صحيح أن الخوارزميات توفر الوقود والمال عادةً، ولكن الابتكارات التي يأتي بها العمال لن ترى النور إذا سلبناهم حق التمكين الإداري وأحللنا محلها التخطيط والضوابط المرتبطة بالتحسين.
يؤدي سلب سلطة صناعة القرارات من أيدي المدراء المباشرين والعاملين ومنحها للخبراء والبرمجيات إلى عواقب سلبية جسيمة يصعب حصرها، فهو من جهة يقوّض جهود المشرفين والمدراء المباشرين الذين يتولون مهمات التعيين ووضع الجداول الزمنية وتقييم الأداء وما شابه، وكانت تلك المسؤوليات تمثل المصدر الوحيد لسلطتهم. فما المبررات التي يمكن أن يسوقها المشرف ليواسي بها موظفاً مستاءً بعد أن اختارته جدولة البرنامج للعمل 3 أيام جمعة على التوالي؟ كيف يمكن لهذا المشرف فيما بعد أن يطلب من الموظف مساعدة إضافية بينما لا يملك هو ما يقدمه له؟ ففي ظل هذه الظروف سيختفي مفهوم تبادل الخدمات الذي يبني العلاقات ويمنح الموظفين الإحساس بدعم المؤسسة لهم.
وبعد ذلك أتت مرحلة مراقبة الأعمال الإدارية التي لا تزال عملية عصية لا يسهل تنفيذها، إلا أن ذلك لن يدوم في ظل استمرار تدابير التحسين، ولكن ليس بعد. ويمثل برنامج إدارة الأداء الجديد الذي يحسب عدد مرات النقر على المفاتيح ويلتقط لقطات للشاشة ويحللها لرصد الوقت المهدر دون عمل جزءاً ضئيلاً من الإمكانات الهائلة لجمع البيانات. وتتيح شركات مثل "تيرامايند" (Teramind) و"إنترغارد" (InterGuard) أنظمة جاهزة تؤدي كل هذه المهمات وأكثر، وبالفعل تتولى البرامج الشهيرة مثل خدمة التقويم في "مايكروسوفت آوتلوك" (Microsoft Outlook Calendar) و"سلاك" (Slack) تحديد من سنلتقي بهم ومقدار الوقت الذي سنقضيه معهم، وتنتقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى نماذج ضابطة للوقت الذي يجب أن يستغرقه إنجاز المشاريع المحددة.
وتستطيع برامج الكمبيوتر معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه الأفراد داخل مكاتبهم عن طريق قياس المدة التي استمرت فيها إشعارات رصد الحركة قيد التشغيل. وأصبحنا نستعين بضوابط الوقت من خلال بطاقة نمررها لتسمح لنا بدخول المباني ومغادرتها، وتتولى تتبع وقت وصولنا ومغادرتنا العمل كما ترصد المناطق التي دخلناها لرؤية أشخاص آخرين. ويقدم برنامج رسم الخرائط الداخلية أكثر من ذلك بكثير، حيث يحدد لنا مكان أي موظف داخل المنشآت بصورة آنية. وتتيح الشركات الآن برنامجاً يزعمون أنه يحدد هوية الموظفين بالتعرف على طريقة سيرهم، رغم عدم وضوح وجوههم. وتلتقط أجهزة الاستشعار الاجتماعات بين الأفراد ومدة جلوسنا داخل مكاتبنا، وما شابه. وقد اكتشفت سارة كراوس الصحفية لدى "وول ستريت جورنال" أن أصحاب العمل يستمعون إلى ما يدور داخل غرف الاجتماعات ويحللون المحادثات حتى يتمكنوا من تنظيم فرق العمل وإدارتها بصورة أفضل. وتستعين شركة "لايف تايم" (Life Time) للياقة البدنية بتحليل المحادثات التي تُجرى داخل اجتماعات فرق العمل كتمرين لتطوير مهارات المدراء الجدد.
كشفت فترة الإغلاق التي تسبب فيها مرض "كوفيد-19" الكثير من الحقائق، حين طلبت المؤسسات من موظفيها العمل من المنزل، وظهر التساؤل الآتي: هل ستثق الشركات في موظفيها وقدراتهم الإنتاجية أم أنها ستسعى لمراقبتهم؟ واتضح أن الخيار الثاني هو الجواب الصحيح، فقد كشف درو هارويل الصحفي في "واشنطن بوست" عن ارتفاع معدلات استخدام برامج (tattleware) التي تراقب حرفياً كل ما يفعله الموظفون العاملون في المنزل على حواسيبهم، حتى إن أحد الموردين استشهد بمقولة مقتبسة من مقال هارويل حين قال إن عملاءه "يملكون الحق كاملاً لمعرفة ما يفعله الموظفون" في منازلهم.
وأفاد كونراد بوتسير وتشيب كاتر من صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه مع استعداد الشركات لإعادة الموظفين إلى محل العمل عقب فترة الإغلاق، بدأ البعض بتثبيت برامج رسم الخرائط الداخلية لمراقبة ما إذا كان الموظفون يلتزمون بضوابط التباعد الاجتماعي الجديدة أم لا، وأشار المراقبون إلى أنه لن يكون هناك سبب وجيه لإزالتها بعد انقضاء الجائحة.
يمكن الاستفادة من كل هذه المعلومات لتحقيق أغراض بنَّاءة مثل تحسين تصميم المكاتب، ولكن بالإمكان أيضاً استغلالها في ضبط الموظفين الذين تهربوا من مكاتبهم لفترات طويلة والذين ينظمون الرهانات الخاصة بالسباقات الرياضية داخل المكاتب وما إلى ذلك. أشار إيثان بيرنستاين وبِن وابر إلى أن الجهود المبذولة من القمة إلى القاعدة لتصميم مساحات العمل بهدف إحداث الأثر المنشود غالباً ما تأتي بنتائج عكسية، مثل تراجع التعاون بين الأفراد بدلاً من تكثيفه، ومن هنا فقد أوصيا الشركات بإجراء التجارب للتعرف على الممارسات التي تؤتي ثمارها.
لطالما كره الموظفون فكرة خضوعهم للمراقبة، حتى إن موجة الإضرابات التي أفرزت النقابات الصناعية في ثلاثينات القرن الماضي كانت قد اندلعت في الأساس بسبب رغبة العاملين في التصدي للسيطرة الإدارية ومتطلبات منهجية تايلور في العمل، مثل الفكرة المهينة التي تفرض وقتاً محدداً لاستخدام المرحاض، بالإضافة إلى عدم الرضا عن الأجور. كما أن المراقبة نادراً ما تحقق الأثر المنشود لأن الموظفين يجدون طرقاً للالتفاف عليها. ويوضح الاستقصاء الذي أُجري على موقع "سيمبلي هايرد" (SimplyHired) لتقديم خدمات الوظائف عبر الإنترنت أن أكثر من ربع الموظفين يلجأون إلى تغطية كاميرات الويب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المخصصة للعمل، ويستخدم ثلثهم تقريباً هواتفهم الشخصية عند التحدث إلى زملائهم في العمل بدلاً من استخدام الهواتف التي تخصصها لهم الشركة لتجنب تنصت أصحاب العمل على مكالماتهم.
يظل إيجاد المزيج السليم لتلك الممارسات على أرض الواقع هو التحدي الأكبر الذي يواجه المدراء، فالأمر لا يقتصر على اضطرارهم للاختيار بين "النظرية إكس" و"النظرية واي".
غير أن اللجوء إلى التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي لا يأتي دون تكلفة أيضاً، فمثلما استلزم تطبيق منهجية تايلور للإدارة العلمية توظيف عدد كبير من الخبراء المتخصصين في مجال الهندسة الصناعية الذي كان لا يزال مجالاً ناشئاً آنذاك، فإن جهود التحسين الحالية تلبي طلبات علماء البيانات، وتزداد الوظائف المتاحة للأفراد المشتغلين ببناء الخوارزميات بمعدلات سريعة، ويبلغ متوسط الراتب السنوي الأساسي لهم 113,309 دولارات، وفقاً لموقع "غلاس دور" (Glassdoor).
تحقيق التوازن
يمكن القول بأن هناك تحالفاً ضد "النظرية واي" مكوَّناً من المسؤولين التنفيذيين الحاصلين على درجات علمية في الهندسة وعلوم الحاسب الذين يمثلون حوالي ثلث الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى وفق بعض التقديرات، كما أن 47% من الرؤساء التنفيذيين لديهم خبرات سابقة في مجال الماليات، وهو مجال تُعطَى الأولوية فيه لتقليل التكلفة والاستعانة بالمعادلات الحسابية والمستهدفات الرقمية، وليس التمكين الإداري. وتظهر المنهجيات السلوكية التي ترتبط بدراسة "النظرية واي" في مناهج كليات إدارة الأعمال على استحياء، ولكنها محاصرة بمقررات الاقتصاد الجزئي والمحاسبة والماليات والعمليات، وتعتمد جميعها على عمليات التحسين. وفي الوقت نفسه، تراجعت الشركات إلى حد كبير عن توفير برامج التدريب على الإدارة التي تهتم بتدريس الأفكار السلوكية.
وأخيراً، فإن من أهم عيوب منهجيات "النظرية واي" أنها فضفاضة وتتطلب بذل المدراء والقادة للكثير من الوقت والجهد، بينما يمكن في المقابل حصر نهج التحسين في القواعد التي تفرضها الأولويات الملموسة وتتماشى معها، مثل رفع مستوى الكفاءة وخفض التكاليف وكل ما من شأنه أن يتسبب في سعادة كل من المدراء الماليين وعالم وول ستريت.
ومن الأمثلة المؤسفة للنظرة المهينة للإدارة التي تتبنى "النظرية واي" والتي تسيطر على أصحاب المناصب الإدارية العليا، ذلك المثال الذي نراه واضحاً في مقال أليك ماغيليس المنشور في مجلة "نيويوركر" حول إعادة هيكلة شركة "بوينغ" وكيف أسهم ذلك في حل مشاكل رحلات الطائرة النفاثة "737 ماكس". فقد اتبعت الشركة برنامجاً شبيهاً بنهج الإنتاج المرن والذي سعى فيه المهندسون إلى إدخال تحسينات على الإجراءات التي مثلت في السابق سمة مميزة للجودة والفاعلية من حيث التكلفة، حيث أعلن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين أن "بوينغ" ستخفض التمويل المخصص للإنفاق على تلك الإجراءات، وحينئذ اعترض أحد المهندسين المشاركين في أثناء تناول وجبة إفطار جمعت العمال والإدارة معاً، مشيراً إلى مقدار الأموال التي وفرها البرنامج. وحينئذ أجابه المسؤول التنفيذي بقوله: "إن القرارات التي اتخذتها حققت نتائج هائلة فما أهمية جميع القرارات التي اتخذتها أنت طوال حياتك".
ويظل إيجاد المزيج السليم لتلك الممارسات على أرض الواقع، وليس من الناحية النظرية، هو التحدي الأكبر الذي يواجه المدراء، فالأمر لا يقتصر على اضطرارهم للاختيار بين "النظرية إكس" و"النظرية واي". وعندما ظهر مفهوم الإدارة العلمية للمرة الأولى، أحدث تأثيراً إيجابياً هائلاً مقارنة بالفوضى التي سادت قطاع التصنيع من قبل، وكانت عاملاً رئيسياً ساعد الشركات الأميركية على الهيمنة على الأسواق العالمية. ويظل هناك العديد من الممارسات الإدارية التي نتجاهل تطبيقها، ولكن بالإمكان أن تصبح أكثر فاعلية وإنصافاً إذا خضعت لبعض التحسينات. وهنا يتبادر إلى الذهن عمليات التعيين، إذ يستمر المدراء الذين تلقوا تدريباً بسيطاً يخص طرق تعيين موظفين جدد في صناعة قرارات التعيين بناءً على حدسهم وتحيزاتهم في معظم الشركات.
ولكن يظل دمج التحسين وتمكين الموظفين جنباً إلى جنب خياراً أفضل بكثير، وتتمثل إحدى نقاط القوة في الإنتاج المرن في أنه يجسد كلاً منهما من خلال تكليف العاملين في الخطوط الأمامية بمهمة تحسين الإنتاجية والجودة، وتعليمهم طرق تحسين تصميم الوظائف، لذا فمن المحبط أن نرى الشركات تستبدل البرمجيات بهذا النهج. وها نحن نرى حدوث ظاهرة مماثلة مع وضع الجداول الزمنية والمرونة، فقد نجح العمال سابقاً في اكتشاف الطريقة المثلى لإنجاز العمل كمجموعة في ظل تلبية احتياجات الموظفين في الوقت ذاته، ويتوفر الآن برنامج يُبشر بتحسين جدول مواعيد العمل لتلبية احتياجاته. ويمكن أن نستشف الكثير من خلال مراقبة تحركات الشركات في ظل عكوفها على التوفيق بين مواعيد حضور الموظفين لتحقيق التباعد الاجتماعي في المكاتب، وملاحظة ما إذا كانت الشركات تستخدم النهج الذي يركز على الموظف أم أنها تخضع للخوارزميات.
ويبدو أن أكبر قيد يؤثر في المشهد العام لا يزال كما هو لم يتغير، ممثلاً في الجاذبية الفكرية التي يتمتع بها التحسين ووعوده البراقة بإيجاد طريقة موحدة ومُثلَى وبسيطة للإدارة يمكنك وضعها وتنفيذها في حيزها الصحيح. ويمكن للمدراء بعد ذلك تجنب العمل الشاق المتمثل في إشراك الموظفين في حل المشاكل المتعلقة بمكان العمل والتحول إلى هندسة إدارة الأفراد والتركيز على المهمات الاستراتيجية الأكثر حيوية. يقول كورت فونيجت في روايته "عازف البيانو" (Player Piano)، "لولا البشر، أولئك الماكرون الذين يستمرون في تخريب الآلات لأصبح العالم جنة المهندس". ربما يسهل تجاهل الأفراد، لكننا لا نزال نحيا ها هنا، ولا بد من مراعاة احتياجاتنا ومصالحنا، ويجب على القادة المؤثرين أخذ ذلك بعين الاعتبار.