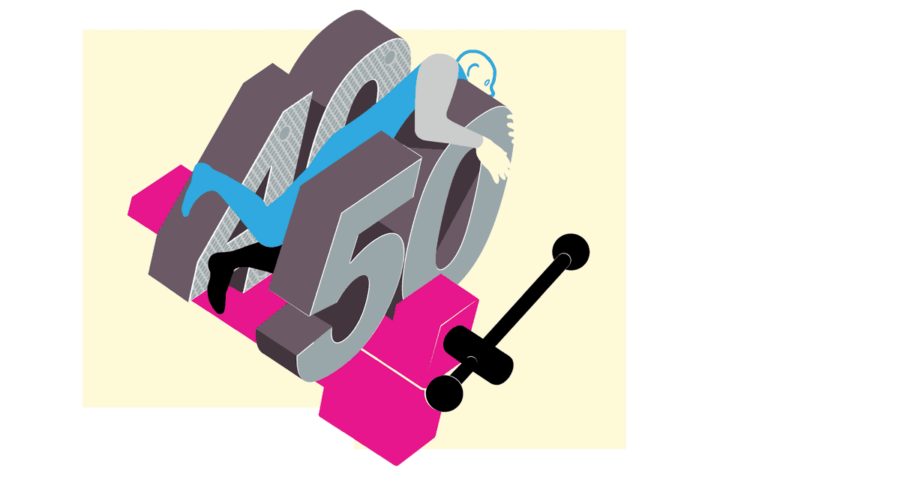قبل حوالي ثمانية أعوام، وجدت نفسي أعيش حياة نمطية متكررة بسبب أزمة منتصف الحياة المهنية التي واجهتها. وبوصفي كنت أستاذاً جامعياً مثبّتاً وأدرّس مادة الفلسفة في جامعة محترمة، كنت أحظى بالحياة المهنية التي أحلم بها. كنت قد نجحت في تجاوز مرحلة الدراسات العليا، مروراً بالجهد الشاق الذي تقتضيه مقولة "انشر إنتاجك العلمي وإلا خسرت حياتك الأكاديمية"، والتوتر المصاحب للسعي نحو الحصول على وظيفة جامعية دائمة والترقية. كانت لدي زوجة، وطفل، ومنزل اشتريته بقرض عقاري. كنت أزاول العمل الذي أحب، ومع ذلك فإن مجرد فكرة فعل المزيد منه أسبوعاً بعد أسبوع، وسنة بعد سنة، بدأت تُشعرني أنني شخص مقموع. كنت أنهي الورقة العلمية التي أعكف على كتابتها، ثم أنشرها، ثم أكتب ورقة علمية أخرى. كنت أدرّس هذه الدفعة من الطلاب؛ وكانوا يتخرجون، ويمضون قدماً في حياتهم؛ وكان يأتي غيرهم الكثير. كانت حياتي المهنية ممتدة أمام ناظري كنفق. كنت أعاني من أزمة منتصف العمر.
أزمة منتصف الحياة المهنية
سرعان ما اكتشفت أنني لم أكن وحيداً. فعندما عرضت محنتي على زملائي، ردوا عليّ بإلقاء النكات، لكنهم رددوا على مسامعي قصصاً مشابهة عن الإنهاك الشديد، والركود، والأسف وسط حالة بدت أشبه بالنجاح. ولعلكم قد سمعتم شيئاً مشابهاً من الموجهين أو الأقران. وربما أنتم بحدّ ذاتكم تعيشون هذه الحالة. ثمة كمّ هائل من الدراسات التي تؤكّد أن منتصف العمر، وسطياً، هو الفترة الأصعب في الحياة. في عام 2008، وجد الاقتصاديان ديفيد بلانشفلاوار وآندرو أوزوالد أن الرضا عن الحياة المعلن ذاتياً يأخذ شكل حرف (U) ناعم الانحناء، بحيث يبدأ مرتفعاً في الشباب، ويصل إلى القاع في أواسط الأربعينيات من عمرنا، ومن ثم يتعافى بعد أن نتقدم في العمر. يُعتبر هذا النمط قوياً في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر على الرجال والنساء على حدّ سواء. وهو يظل قائماً حتى عندما نصوّبه آخذين بالاعتبار متغيرات أخرى مثل الأبوة والأمومة. المنحنى لطيف لكنه هام: ففجوة الرضا الوسطية بين عمري العشرين والخامسة والأربعين مشابهة لحالة التراجع في الرضا عن الحياة المقترن بالطرد من العمل أو الطلاق.
تُعتبرُ البيانات الخاصة بالرضا عن الحياة متسقة مع الأبحاث السابقة التي تخص العمل. فقد توصلت مقالة نشرت عام 1996 بالاستناد إلى مسح شمل أكثر من 5,000 موظف بريطاني إلى أن الرضا الوظيفي أخذ أيضاً شكل حرف (U) ناعم الانحناء، رغم أن القاع قد سُجّل في وقت أبكر، بعمر 39 تقريباً. وإيليوت جاكس، المحلل النفسي صاحب عبارة "أزمة منتصف العمر" التي كان قد صاغها عام 1965، لم يكن يشير إلى المرضى ممن هم في أواسط العمر ويمارسون الخيانة الزوجية وإنما إلى التحولات الدراماتيكية في الحياة المُبدعة لفنانين من أمثال مايكل آنجلو وغوغان، لم يشعروا أن حياتهم السابقة كانت مفعمة بالإنجاز.
ليس ثمة فهم جيد لأسباب "أزمة منتصف الحياة المهنية". لماذا يحدث تدهور في الرضا الوظيفي في أواسط العمر؟ بحسب تجربتي الشخصية، وبناءً على أحاديثي مع أصدقائي، فإن هناك مجموعة من العوامل المتعددة ألا وهي ضيق الخيارات، وحتمية الندم، وطغيان المشاريع المتتالية المُنجزة والمُستبدلة.
لماذا يحدث تدهور في الرضا الوظيفي في أواسط العمر؟ هناك مجموعة من العوامل المتعددة ألا وهي ضيق الخيارات، وحتمية الندم، وطغيان المشاريع المتتالية المنجزة والمستبدلة.
عندما لجأت إلى الفلسفة علها تسعفني، وجدت أن الفلاسفة القدماء والمحدثين ورغم عدم تطرقهم إلى منتصف العمر بالاسم إلا نادراً، غير أنهم يوفرون أدوات تسمح لنا بالتفكير بشكل حياتنا المهنية والمواقف التي نتبناها تجاهها. وهذه الأدوات علاجية لكنها تشخيصية أيضاً، وهي قادرة على أن تساعدكم في معرفة ما إذا كان توعككم في أواسط حياتكم المهنية هو علامة على أنكم بحاجة إلى تغيير ما تفعلونه، أم تغيير الطريقة التي تفعلونه بها. ربما تكون الزعزعة أمراً إيجابياً، لكنها ليست مجدية على الدوام، وهناك علاجات للإحباط والندم يمكن أن تساعدكم في أن تُفْلِحوا حتى لو بقيتم في مكانكم.
الندم على الماضي
تتناول بعض الاستنتاجات التي حصلت عليها من حقل الفلسفة تحدي قبول الأشياء التي ليس بوسعنا تغييرها. فمع مضي الحياة قدماً، تتراجع الاحتمالات الممكنة، وتصبح الخيارات أكثر تعقيداً، بينما تفرض قرارات الماضي حدوداً علينا. وحتى لو أسأنا تقدير الأشياء التي ما نزال نستطيع فعلها، فإننا غير قادرين على تجنب حقيقة مفادها أن كل خيار يؤدي إلى استبعاد البدائل. وغالباً ما يكون منتصف الحياة المهنية هو الوقت الذي نعترف فيه بأشكال الحياة التي لن نستطيع عيشها أبداً والألم الذي سنشعر به نتيجة فوات الفرصة.
في حالتي أنا، كنت لفترة طويلة أريد أن أصبح طبيباً أسوةً بوالدي؛ ثم خطر لي أن أصبح شاعراً؛ وعندما حان موعد التحاقي بالكلية، كان خياري قد وقع على الفلسفة. وخلال السنوات الخمس عشرة أو العشرين التالية، لم أفكر كثيراً في البدائل. فمن الأسهل عليك أن تتخرج في كلية الدراسات العليا إذا لم تفكر كثيراً بهذه البدائل. ولكن في سن الخامسة والثلاثين، وبعد أن تجاوزت عوائق المسار الأكاديمي، توقفت لألتقط أنفاسي – وأدركت أنني لن أفعل أشياء كثيرة كنت أرغب من قبل بفعلها. فالوظيفة الأكاديمية تكون عادة ذات مسار مستقيم، ومن الصعب تركها. من ذا الذي يتخلى عن العضوية الدائمة في الهيئة التدريسية؟ والواقعية كانت تقول إنني لم أكن على وشك تبديل مساري والتقدم إلى كلية الطب أو التحول إلى قرض الشعر. في وقت لاحق، غادرت جامعة بيتسبرغ منتقلاً إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لكنني لم أغادر الحقل الأكاديمي.
الاحتمال الأكبر هو أن نمط حياتكم المهنية في الماضي كان أكثر تعقيداً. فالشخص البالغ من العمر 40 عاماً يكون على الأغلب قد شغل طيفاً من الوظائف. لكن النقطة الأساسية تظل قائمة. فعندما ننظر إلى الخلف في حياتنا، فإننا نستذكر الطرق التي لم نسر فيها، وفي بعض الأحيان قد تكون هذه العملية مبعثاً للراحة ولكن في أحيان كثيرة تكون هذه الذاكرة مشوبة بالندم. فهل بوسع الفلسفة أن تساعدنا في التصالح مع هذا الواقع؟
أعتقد أنها قادرة على إسعافنا من خلال إعادة صياغة معضلة الندم بطريقة مختلفة. فلماذا نشعر بإحساس الندم على حياة لم نعشها، أو مهن لمن نمتهنها؟ نحن نفعل ذلك، حتى عندما تكون الأمور على ما يُرام، لأن المكاسب التي نجنيها من تبني خيارات مختلفة ليست هي ذاتها. فالأنشطة التي تستحق أن نزاولها تستحق ذلك بطرق مختلفة. دعونا نأخذ مثالاً بسيطاً. بوسعكم الليلة الذهاب إلى حفلة يحييها فنان كوميدي أو حضور المباراة الافتتاحية في بطولة لكرة القدم. وحتى لو كنتم تعلمون أن مباراة كرة القدم هي الخيار المناسب لكم، إلا أنكم مع ذلك تشعرون بخسارة ضئيلة: فإذا كان هذا الفنان الكوميدي موجوداً لليلة واحدة فقط، فلن تتسنّى لكم الفرصة لحضور حفلته. والندم في الحياة المهنية هو الظاهرة ذاتها ولكن على نطاق أوسع. فقد لا تشعرون بالأسف عندما تعرض عليكم شركتان منصبين متشابهين وتختارون الوظيفة ذات الراتب الأعلى، ولكن من المنطقي الشعور بالخسارة عندما تختارون حياةً مهنيةً في المجال المالي على حساب عالم الأزياء، حتى لو كنتم واثقين أنكم قد اتخذتم القرار الصائب.
ما يُبينه ذلك هو أن الندم لا يعني بالضرورة أن هناك أي شيء خاطئ. فحتى عندما تكون النتائج وردية، فإن نوعاً معيناً من الندم قد يكون مناسباً، وليس شيئاً يجب الابتعاد عنه. فالندم يُظهرُ أنكم تُقدرون العديد من الأنشطة. وكنتم ستشعرون بالندم أصلاً حتى لو عملتم في مجال الأزياء وليس المجال المالي، رغم أن الأشياء التي كنتم ستركزون عليها ستكون مختلفة. والطريقة الوحيدة لتجنب الندم هي إبداء الاهتمام بشيء واحد فقط، ومقياس واحد لتحقيق أقصى نتيجة ممكنة فيه. لكن ذلك سوف يُفقر حياتكم. ذكروا أنفسكم أن شعوركم بفوات أمر ما عليكم هو النتيجة الحتمية لشيء جيد، ألا وهو القدرة على النظر إلى العديد من مناحي الحياة على أنها تنطوي على قيمة بالنسبة لكم.
الأخطاء، وسوء الحظ، والإخفاقات
ربما تقولون إن كل شيء على ما يُرام، باستثناء وجود نوع آخر من أنواع الندم، ألا وهو النوع الذي نحس به عندما لا تسير الأمور على ما يُرام. فماذا عن الأخطاء، وسوء الحظ، والإخفاقات؟ لكل حياة مهنية انعطافاتها الخاطئة، وبعضها فيها انعطافات خاطئة أكثر من غيرها. ففي منتصف الحياة نجد أنفسنا نتأمل بشيء من الأسف ما كان يمكن أن يحصل. إحدى زميلاتي تخلت عن حياة مهنية واعدة في مجال الموسيقى لتصبح محامية لدى شركة كبرى. وبعد مرور عشر سنوات، وجدت أن عملها أصبح رتيباً ومخيباً للآمال. لم تكن التساؤلات المتعلقة بكيفية تغيير حياتها المهنية هي ما يقض مضجعها، بل رغبتها بتغيير الماضي. لماذا ارتكبت خطأ التخلي عن الموسيقى؟ وكيف بوسعها التصالح مع هذه الفكرة؟
مرة أخرى تأتي الفلسفة لترشدنا إلى الطريق. يجب عليكم أن تميزوا بين ما كان يجب أن تفعلوه أو رحبتم به في ذلك الوقت، وكيف هو شعوركم تجاهه حالياً. من الواضح أنهما يفترقان عندما لا تسير الأمور كما كان متوقعاً. فإذا ما وضعتم المال في استثمار غبي لكنه صادف أن حقق لكم ربحاً، فأنتم لستم مضطرين إلى الندم على فعل شيء لم يكن يجدر بكم فعله. ولكن حتى لو لم تكن هناك مفاجأة، فإن المشاعر التي يجب أن تحسوا بها بعد وقوع الواقعة قد تتغير. تخيل الفيلسوف الأخلاقي ديريك بارفيت فتاة مراهقة تقرر أن تتزوج مبكراً وأن تنجب طفلاً رغم عدم الاستقرار في حياتها. كان القرار، بحسب ما قد نفترض، قراراً سيئاً، لأنه كان سيؤثر على تعليمها، وسيدخلها في معاناة طويلة لتأمين سبل معيشة هذا الطفل. ولكن بعد مرور سنوات، تشعر الأم بعد أن تعانق ابنها بالامتنان له، وبالسعادة من ارتكابها لما كان من الناحية الموضوعية خطأ. فتعلقكم بمن تحبون يمكن أن يقودكم إلى إضفاء العقلانية على أحداث الماضي – حتى غير المحبذ منها – التي تعتمد حياتكم عليها.
عندما راحت صديقتي تتباكى على حياتها المهنية التي خسرتها في عالم الموسيقى، ذكرتها أنها لم تكن لتقابل زوجها، ولم تكن ابنتها لتولد، لو لم تكن قد التحقت بكلية الحقوق في ذلك الوقت. كما أن كفة الحب يمكن أن توازي كفة الندم. وكذلك هو حال الشعور بتحقيق الإنجازات الذي نستمده من الصداقات، والمشاريع، والأنشطة التي نزاولها. وكما كتب الفيلسوف روبرت آدمز ذات مرّة: "إذا كانت حياتنا جيدة، فإن لدينا سبباً لنكون سعداء بأن لدينا هذه الحياة وليس حياة أخرى ربما كانت أفضل ولكن مختلفة اختلافاً جذرياً".
نحن نعيش في التفاصيل وليس في المجردات. ففي مقابل حقيقة مبهمة تقول إنكم كنتم ربما ستتخذون حياة مهنية أنجح، بوسعكم أن تضعوا الطرق الملموسة التي تبيّن أن حياتكم المهنية الفعلية جيدة. وإضافة إلى التعلق بالناس، هناك تعلق بالحيثيات الدقيقة، أي التفاعلات والإنجازات التي لم تكونوا لتحققوها في حياة أخرى. عندما أفكر أنني كنت يجب أن أكون طبيباً، وليس فيلسوفاً، وأبدأ بالندم على خياري، فإنني أتجاهل طبيعة عملي والسبل التي لا حصر لها التي تتراءى لي بموجبها قيمة ما أفعله – من خلال التقدم الذي يحرزه أحد الطلاب، مثلاً، أو محادثة بناءة مع أحد الزملاء. فالتفاصيل هي ما يُعتدّ به في مقابل الكاريكاتير الكبير لحياة لم تُعَش.
تتصف هذه الطريقة في إعادة تصور حياتكم المهنية بمجموعة من أوجه القصور. فليست هناك ضمانة بالتثبت من وقوع خطأ ما بأثر رجعي أو أن الندم هو دائماً في غير محله. لكن الندم الذي يتحول إلى رغبة بمراجعة كامل حياتكم كما لو كنتم تعيشون خارجها يمكن إسكاته من خلال إيلاء اهتمام عميق للشخصيات والعلاقات والأنشطة الأثيرة على قلوبكم، التي تعتمد على الحياة المهنية التي اخترتموها.
التبرم من الحاضر
تقبّل الأشياء التي لا نستطيع تغييرها هو جزء فقط من المشكلة التي نواجهها أثناء تهاوينا هبوطاً على طول المنحنى الذي يتخذ شكل حرف (U). بالنسبة لي، المصدر الأعمق لتوعكي في منتصف حياتي المهنية لم يكن الندم على الماضي وإنما إحساس باللاجدوى في الحاضر. فعملي كان ما يزال يستحق العناء بنظري. لقد رأيت قيمة كبيرة في التدريس وإجراء الأبحاث والكتابة. ومع ذلك، كان هناك شيء من الفراغ الذي يكتنف المشاريع المتتالية التي كانت تلوح في الأفق. كما أن فكرة القيام بشيء تلو الآخر حتى أتقاعد أخيراً بدت بالنسبة لي ضرباً من هزيمة الذات.
كيف يمكن لفعل شيء يستحق قيمته أن يبدو فارغاً؟ التفسير الأول يحيل إلى مفهوم "القيمة التحسينية"، أي القيمة الناجمة عن حل مشكلة أو تلبية حاجة، حتى لو كانت الحاجة هي شيء تفضلون عدم مجابهته. والكثير من العمل الذي نؤديه شبيه بذلك. فأنتم مضطرون إلى التوسط في النزاعات بين الزملاء، والتعامل مع العثرات التي تنشأ أثناء طرح منتج معين في السوق، وضمان الامتثال إلى القواعد. ورغم أن التحسين ضروري، لكنه لا يضيف إلا قدراً محدوداً من الرضا. فإذا كان أفضل ما نقوم به هو إصلاح الأخطاء، أو تحقيق الأهداف الكمية، أو الحيلولة دون خروج الأمور عن المسار المرسوم لها، فإننا بذلك لا نملك رؤية للأشياء الجيدة ذات الصبغة الإيجابية. فلماذا نتكبد عناء العمل بقدر كبير من الجد والاجتهاد؟
أحد أسباب أزمة منتصف الحياة المهنية هو أن قسطاً كبيراً من وقتكم الذي تُمضونَه في العمل يُخصص لإطفاء الحرائق وتجنب النتائج السيئة. ويتمثل الحل في إعطاء وقت للأنشطة التي تجعلكم تشعرون بإحساس إيجابي إما في المكتب – مثل إطلاق مشروع محبب كنتم تأجلونه منذ سنوات – أو خارج أروقة المكتب، من خلال إحياء هواية محببة أو تبني هواية جديدة. قد تبدو هذه النصيحة عادية ومتواضعة، لكنها عميقة. فممارسة رياضة المشي أو جمع الطوابع قد يبدو أنهما نشاطين أقل أهمية من عملكم، لكن الأنشطة الوجودية تنطوي على قيمة غير موجودة في أنشطة التحسين. ويجب عليكم أن تفسحوا المجال لمثل هذه المتع في حياتكم.
الشعور بالفراغ خلال المسيرة المهنية
ثمة تفسير ثانٍ للشعور بالفراغ في منتصف الحياة المهنية يتجاوز الحاجة إلى القيمة الوجودية. فعندما ننظر من الناحية الفلسفية إلى طبيعة المشاريع واستثمارنا فيها – سواء تعلق الأمر بتصحيح أوراق جامعية، أو صفقات يجب علينا المساعدة في إنجازها، أو منتجات يجب أن نصممها – فإننا يمكن أن نستخلص عيباً بنيوياً فيها. فالمشاريع تهدف إلى أن تُستكمل. إذ عندما أركز على كتابة هذا المقال، على سبيل المثال، فإنني أركز على هدف لم أحققه بعد، سيدخل حيز الذاكرة لحظة انتهائي من الكتابة. لا بل الأسوأ من ذلك هو أنه إذا كان المشروع ينطوي على معنى بالنسبة لكم، فإن الأمر لا يقتصر على تأجيل تحقيق الإنجاز، وإنما الانهماك فيه يدمر معناه. وعندما تنطلقون في إنجاز مشروع معين، فإما أن تخفقوا – وهذا شيء غير جيد – أو أن تنجحوا وبالتالي تضعون حداً لقدرته على توجيه حياتكم.
أحد أشكال أزمة منتصف الحياة المهنية يطلق العنان لحالة الاستثمار المُفرط في المشاريع، مما يفسح المجال أمام الإنجاز التالي والذي يليه. لكن ثمة طريقة أخرى للعيش. لقد باتت اليقظة الذهنية موضة دارجة جداً هذه الأيام وقد يُدهش المرء لكثرة تكرار لازمة "العيش في الحاضر". أنا لست غير متعاطف معها. عندما نعزل هذا الشعار عن سياقه في أفكار العقيدة البوذية الخاصة بعدم وجود الذات، فلن يكون واضحاً ما الذي يتبقى. لكن العيش في الحاضر له تفسير واضح غير ماورائي.
يتمثل المفتاح الأساسي في التمييز بين نوعين من الأنشطة التي ننخرط فيها. فالمشاريع هي عبارة عن أنشطة انتهائية من حيث أنها تهدف إلى الوصول نحو غايات نهائية لم تتحقق بعد. وهذه الأنشطة تسعى إلى فنائها الذاتي. فأنتم تحضرون العرض الذي ستقدمونه أمام أحد الزبائن ثم تعرضونه؛ وتتفاوضون على تلك الصفقة وتبرمونها؛ وتخططون للمؤتمر ثم تستضيفونه. والوصول إلى الهدف يجلب لحظة من الرضا، ولكن بعد ذلك، هناك الانتقال إلى المشروع التالي.
وهناك أنشطة أخرى غير انتهائية بطبيعتها، أو لا تنطوي في ثناياها على غاية نهائية محددة. فكروا في الفرق بين الذهاب إلى المنزل ومجرد التمشّي في الشارع، أو بين تنويم الأطفال وممارسة الأبوة والأمومة. وعندما تنخرطون في أنشطة غير انتهائية، فإنكم لا تستنفدونها. كما أنها لا تستدعي إلى الذاكرة فراغ المشاريع التي يكون إنجازها عادة إما في المستقبل أو الماضي. بل المشاريع غير الانتهائية تُنجز بالكامل في الحاضر.
في مكان العمل، نحن ننخرط في أنشطة انتهائية وأنشطة غير انتهائية. فأنتم مثلاً، تكتبون تقريراً عن الموارد البشرية (نشاط انتهائي) وتتلقون الآراء التقويمية من الزملاء (نشاط غير انتهائي). تتمتع معظم أنشطة العمل الانتهائية بجوانب غير انتهائية ذات معنى، فأنتم عندما تعملون على إبرام صفقة فإنكم بذلك تعززون استراتيجية النمو في شركتكم؛ وعندما تستضيفون ذلك المؤتمر، فإنكم تتفاعلون مع الجهات المعنية في القطاع. وبالتالي أنتم لديكم خيار. بوسعكم التركيز إما على النشاط الثابت أو على النشاط المستمر – أي المشروع أو العملية. وإذا ما عدلتم توجهكم لتصبحوا أقل تمحوراً حول المشروع، بوسعكم هزيمة الشعور بالفراغ في الحاضر، دون أن تغيروا الشيء الذي تفعلونه أو درجة الكفاءة التي تنجزونه بها.
يعيدنا هذا إلى مسألة التشخيص. متى يكون التوعك في منتصف الحياة المهنية إشارة إلى ضرورة تغيير هذه الحياة، في مقابل تغيير طريقة شعورك وتفكيرك؟ ربما تكونون غير راضين مهنياً لأن وظيفتكم لا تتناسب مع مواهبكم، أو لأن اهتماماتكم قد تغيرت، أو لأن آفاق الترقية تبدو ضعيفة. لكن عدم الرضا هذا قد يوقظ مشاكل الندم، أو التدمير الذاتي للمشاريع، وهما شيئان لا يعالجهما العثور على وظيفة جديدة. إن العمل بموجب الاستراتيجيات التي استكشفتها هو خطوة باتجاه تحديد الحالة. فهل هذه الاستراتيجيات كافية لكي تصالحكم مع القيود التي تفرضها حياتكم المهنية؟ إذا كانت الإجابة هي كلا، فهي بمثابة دعم لفكرة تبديل المسار. لا ينبئ منتصف العمر بفوات الأوان: فأزمة منتصف الحياة المهنية قد تكون محفزاً لتغيير جذري يبعث على الحيوية.
ولكن حتى لو حققتم هذا الانحراف عن المسار، لا يجب عليكم أن تنسوا التكتيكات التي مكنتني من التغلب على توعكي وأحيت متعة العمل لدي. اعترفوا أن تفويت أمر معين هو شيء لا يمكن تجنبه ولا تحاولوا أن تتمنوا زواله من تلقاء نفسه دون أن تفعلوا شيئاً حيال ذلك. افهموا أن كفة التعلق هي التي توازن كفة الندم المقابلة. أفسحوا المجال للأنشطة ذات القيمة الوجودية وامنحوا التقدير للعملية، وليس فقط للمشروع أو المنتج.
اقرأ أيضاً: