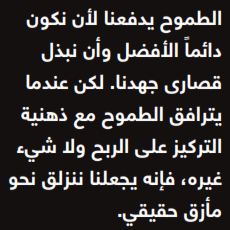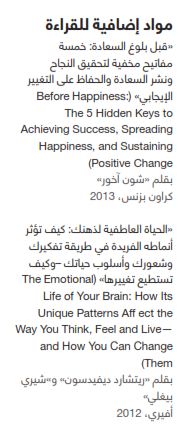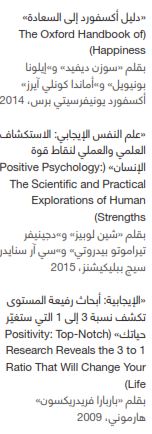الحياة قصيرة جداً لأن نحياها غير سعداء في عملنا. ومع ذلك، فإن العديد من المحترفين الذين يملكون حرية رسم مسيرتهم المهنية هم في الواقع منعزلون وتُعساء وغير راضين عن أنفسهم. خذ على سبيل المثال، سوزان، التي تشغل منصب نائب الرئيس في إحدى شركات الطاقة العالمية، ومن بين عملائي الذين أقدم لهم خدماتي الاستشارية. إنها ذكية ومجدّة في عملها، وقد تدرّجت على السلّم الوظيفي من خلال مراعاتها القواعد والقوانين الناظمة في الشركة. تجني سوزان الكثير من المال، وهي متزوجة من رجل تحبه، وتكرّس وقتها لتربية أولادها. فلديها كل ما كانت تعتقد أنها تريده، إلا أنها غير سعيدة. فلقد باتت تعاني من الضغوط في المنزل، ولم تعُد تشعر بالارتياح والرضى في عملها كما كانت في السابق. لقد تعبَت من السياسات المتَّبعة في بيئة عملها وباتت تسخر من التغييرات المستمرة التي كانت تحدث بحجة تصحيح بعض الأخطاء في آلية سير عمل الشركة لانتشال عائداتها المالية في أحد أرباع العام. لقد كانت سوزان مستاءة من ساعات العمل الطويلة التي كان عليها أن تكرّسها للعمل. ولم تنجح الترقية التي حصلت عليها مع ما رافقها من علاوات في تحفيزها ودفعها إلى الأمام كما كان يحدث سابقاً. ومع هذا كله، ثابرت على اجتهادها المعهود: فالعمل باجتهاد والسعي الدؤوب كانا من عاداتها.
كانت سوزان تلوم الآخرين على استيائها وخيبة آمالها. فقد كانت ترى أن فريق الإدارة التنفيذي كان منفصلاً عن واقع العمل اليومي. وراحت تشكو لأصدقائها وزملائها في العمل وتتذمر من سوء القرارات التي تتخذها الإدارة، ومن استراتيجية الشركة، ومن غياب الرؤية الشاملة لدى القيادة العليا؛ غير أن كل أعضاء فريقها بدوا غير مكترثين.
بعد أن عملتُ مع سوزان ودرّبتها لأشهر عدّة، وجدتها شخصاً محبّباً. غير أن تذمرها الدائم كان مرهِقاً حتى بالنسبة لي، وبالتالي أتفهم كيف كان زملاؤها ينظرون إليها. وعندما تجاوزنا أخيراً تحميل سوزان للآخرين مسؤولية عدم رضاها، قالت: "أعرف أنه كان بمقدوري جعل الأمور أفضل. لكنني كثيرة الانشغال؛ وفضلاً عن ذلك لا يهمني إن كنت سعيدة أم لا؛ المهم فقط أن أنجح في تحقيق أهدافي". لكنها أقرّت في لحظات تأمّلها بأن إحساسها بالضغط والتعاسة كان يؤثّر على علاقاتها في العمل وعلى أسرتها وصحتها أيضاً. حتى أنها لاحظت أيضاً أنها بدأت تساوم وتتنازل عن أخلاقياتها بعض الشيء. لكن ما لم تكن تراه هو الرابط بين تعاستها المتفاقمة وقدرتها المتضائلة على تأدية مهام عملها بفعالية.
سوزان ليست حالة فردية. فلطالما شهدنا على مدار سنوات عديدة حالات مشابهة من تدنّي مستوى انخراط الموظفين في بيئة عملهم. وهناك دراسات وأبحاث عديدة تُظهر أن ما يقارب ثلثي الموظفين في الولايات المتحدة يعانون من الملل والعزلة والإرهاق والتراخي في العمل والاستعداد لإفساد الخطط وإفشال المشاريع وتخريب علاقاتهم مع الزملاء والأشخاص المحيطين بهم. لكن هذا كله يفتقر إلى المنطق بالنسبة لي. فلماذا يقبل كل هؤلاء بوظائف لا ترضيهم ولا تحقق لهم ذواتهم، وببيئات عمل ضاغطة ومرهِقة ومستنزِفة، وبتعاسة مزمنة؟ لمَ لا نواجه هذا الأمر ونحول دون حدوثه؟
هنالك عوامل كثيرة مسؤولة عن هذا الاعتلال المعاصر. فلقد وجدت جمعية علم النفس الأميركية في مطلع العام 2017 أن الموظفين
الأميركيين يمرون بضغوطات في العمل أكثر من أي وقت مضى جراء السياسات وسرعة التغيير وانعدام الاستقرار في العالم. غير أن هذا الأمر لا يتعلق دائماً بقوى خارجية تُحيدنا وتحرفنا عن مسار السعادة. ففي بعض الأحيان نكون نحن المسؤولين عن تعاستنا. ومن خلال مسيرتي المهنية التي امتدت لأكثر من 30 عاماً أمضيتها في تقديم الاستشارة لقادة شركات وحكومات ومنظمات غير حكومية كبرى حول العالم، اكتشفت أن أعداداً كبيرة جداً منا يقعون في فخاخ تسمى "فخاخ السعادة" – وهي ذهنيات وأساليب عمل مدمِّرة تأسرنا وتُبقينا نراوح في مكاننا تعساء وبالتالي أقل نجاحاً. وتبدو أبرز "فخاخ السعادة" هذه وأكثرها شيوعاً – وهي الطموح، والعمل وفق توقّعات الآخرين، والإفراط في العمل - إيجابية وفعالة من المنظور السطحي، غير أنها في الواقع مؤذية إذا ما بالغنا فيها.
فخ الطموح
إن حافز تحقيق الأهداف وتعزيز مسيرتنا المهنية هو الذي يدفعنا إلى أن نبذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل دائماً. لكن عندما يترافق طموحنا مع التنافسية المفرطة والمبالغة في التركيز على الربح ولا شيء غيره، فإننا ننزلق حينئذ نحو مأزق حقيقي، حيث نغدو غير قادرين على رؤية تأثير تصرفاتنا على أنفسنا والآخرين؛ وتسوء العلاقات ويتزعزع التعاون فيما بيننا؛ ونلهث في العمل فقط لبلوغ أهداف مسبقة موضوعة من قبل الآخرين؛ ويفقد العمل معناه الحقيقي.
وهذا بالضبط ما حدث مع سوزان. فلطالما شجعها أبواها ومعلموها ومدرّبوها خلال جميع مراحل حياتها على الكفاح والسعي الدؤوب، فحقّقت الكثير من الإنجازات. إذ نالت علامات عالية في شهاداتها الدراسية وتفوقت في الرياضة ونالت ألقاباً وجوائز أكاديمية عدة. وعندما بدأت مسيرتها المهنية، كان طموحها لافتاً لدرجة أذهلت مدراءها: فلقد كانت تنجز ما يُطلب منها في الوقت المحدد وبجودة عالية.
بيد أن زملاء سوزان لم يكونوا معجبين بها بنفس الدرجة، وبعضهم ابتعد عنها كلياً بعدما اكتشف أنها كانت تريد أن تكون الأولى على الدوام، وأن الآخرين لا يستحقّون سوى المرتبة الثانية. كما أن أهداف الفريق لم تكن أولوية بالنسبة لها ما لم تخدم غاياتها وأهدافها الشخصية، فذاع صيتها بوصفها تضحّي بالآخرين في سبيل مصلحتها الخاصة.
بالطبع، ليس هنالك من خطأ متأصّل في الطموح بحدّ ذاته. فهو يدفع الموظفين أحياناً إلى صقل مهاراتهم الاجتماعية؛ إذ إن التعاون الفعال هو شرط لازم لإحراز النجاحات طويلة الأمد ضمن بيئات العمل المؤسساتية المعقدة. بيد أن طموح سوزان الجامح كان يركّز فقط على أهدافها الشخصية، ولذلك سرعان ما فقدت ثقة زملائها وخسرت مساعدتهم ودعمهم لها.
ولقد وصلت تحديات العمل بالنسبة لسوزان إلى الذروة حينما كانت تُدير مشروعاً حيوياً وبارزاً جداً، يتمثّل في أداء دور واجهة الاتصال بين قسمها وعميل داخلي قوي جداً. فلقد تبدلت استراتيجية الشركة وتغيّرت أهداف المشروع وارتفعت معايير العميل، في حين بقي التمويل على حاله. وكانت سوزان على الدوام تنظر إلى متطلبات العميل بوصفها غير منطقية، ولذلك كانت تردّ عليها كما في أغلب الأحيان -بتحويل الأمر إلى منافسة خياراتها الربح أو الخسارة فقط. فشرعت في اتّباع أساليب ملتوية مطالبة بدفع مبالغ طائلة لقاء العمل الذي كان قسمها ينجزه، حتى إنها لجأت إلى استخدام الأكاذيب لنيل مبتغاها.
وبالنتيجة، لم يكن أمام مدير سوزان الذي لطالما وقف إلى جانبها وحماها ودعمها لسنوات عديدة سوى أن يعترف بما هو واضح وجليّ: لقد باتت مساءلتها واجبة. فسحبها من المشروع ونحّاها جانباً. وتعطّل بذلك مسارها المهني. ولقد كان إرغامها على الخروج من مسار تطوّرها المهني السريع بمثابة إنذار لها لتستيقظ وترى الواقع، فبدأت تُدرك أنها كانت في الواقع وحيدة وتعيسة في عملها منذ زمنٍ طويل. فطموحها قد تحوّل إلى فخّ ولم يعد مكسباً ودافعاً لها. وقسوتها وعنادها في المنافسة كانا سلوكاً مكتسباً لا سمة متأصلة: فنجاحها الباكر قد عزّز عندها ذهنية أن من يربح يظفر بكل شيء، الأمر الذي أفضى إلى تعطّل مسيرتها على الصعيدَين الشخصي والمهني.
 فخ "الواجب"
فخ "الواجب"
إن القيام بما نظن أنه الواجب لا بما نرغب في القيام به حقّاً لهو فخ، جميعنا معرّض لخطر الوقوع به في مرحلة محددة من حياتنا المهنية. صحيح أن بعض القواعد غير المدوَّنة التي تصيغ مسارنا المهني هي قواعد إيجابية، مثل وجوب الحصول على مؤهّل علمي يمكّننا من مساعدة عائلاتنا، والتقيّد بالمواعيد والالتزام بآداب وقواعد العمل. غير أن هناك عدداً كبيراً جداً من قواعد بيئات العمل –التي أسميّها "واجبات"- يرغمنا على إنكار ذاتنا الحقيقية ويُجبرنا على اتّخاذ قرارات تقوّض مقدراتنا وطاقاتنا الكامنة وتكبح أحلامنا.
ففي معظم الشركات، لكي يكون الموظفون ناجحين يتعيّن عليهم الالتزام بقواعد محددة تتعلّق باللباس وطريقة المشي والأشخاص المسموح التعامل معهم، وأحياناً تؤطّر لهم أسلوب عيشهم حتى خارج بيئة العمل. لقد عمِلتُ في مؤسسات يكفي فيها ارتداء حذاء بالٍ ليحرم المرشّح من أية فرصة لنَيل الوظيفة، وحيث يتوجّب على السيدات أن يتبرّجن ويعتمدن تسريحة شعر محددة (قصيرة في الغالب). كما عملتُ أيضاً في شركات يستحيل فيها للرجال غير المتزوجين أن يشغلوا مناصب قيادية. وفي شركات قائمة "فورتشن 500"، فقط 4% من القادة الكبار هم من السيدات، وأقل من 1% منهم من السود. وتُخبرنا هذه الإحصائيات الصادمة عمَّن "يجب" أن يكون القائد ومَن "يجب" أن يكون التابع.
إن مثل هذه القواعد المسكوت عنها ليست فقط باطلة (إذ لا وجود لأية علاقة بين نوع الجنس أو العرق أو الحالة الاجتماعية من جهة، والمقدرة على القيادة من جهة أخرى)، بل إنها تؤثّر سلباً على حياتنا الشخصية أيضاً عندما نشعر بأن من واجبنا إخفاء هويتنا الحقيقية أو التظاهر بشخصية زائفة. فلقد أظهر "كينجي يوشينو" و"كريستي سميث" في دراسة موّلتها شركة "ديلويت" أُجريت على أكثر من 3,000 موظف، أن 61% من الموظفين يشعرون بأن عليهم "إخفاء هويّاتهم الحقيقية" بطريقة أو بأخرى لكي يتم قبولهم في أماكن عملهم: فهم إما يتعمّدون إخفاء أو التقليل من شأن عرقهم أو جنسهم أو ميولهم أو دينهم وغير ذلك من أوجه هويّاتهم وشخصياتهم وحيواتهم.
وفي بعض الشركات، تتفادى السيدات الحديث عن أولادهن لتجنّب ما يُدعى "عقوبة الأمومة". وغالباً ما يتجنّب الأميركيون من أصل أفريقي التعامل مع بعضهم البعض لكي لا يُصنّفوا ضمن مجموعة مهمّشة. حتى إن 45% من الرجال البيض يلجؤون إلى إخفاء بعض الأمور التي من شأنها أن تعزلهم وتُسهم في تهميشهم، مثل معاناتهم من الكآبة أو المشاكل في المدرسة. أعرف الكثيرين ممن يخفون أي شيء يجعلهم يبدون ضعفاء –كالمصاعب في المنزل، والشعور بالإرهاق والاستنزاف- لأنهم يشعرون أن من واجبهم أن يكونوا أقوياء في كل الظروف والأوقات.
لا تؤثّر "الواجبات" فقط على سلوكنا في العمل، بل إنها غالباً ما تُملي علينا نوع العمل الذي نطمح إليه. لنأخذ "سميح" كمثال آخر، وهو أحد العملاء الذين أدرّبهم. فخلال سنواته الأولى والمتقدمة في الكلية، كان سميح منخرطاً في العمل مع شركَتين ناشئتَين وقد استمتع كثيراً بتلك الخبرة. كان يأمل في قرارة نفسه أن يتابع العمل في مجال ريادة الأعمال، غير أنه شعر بالتردّد مع دنوّ موعد تخرّجه من الكلية. وعندما عُرض عليه العمل مع شركة استشارات مرموقة، وافق على الفور. لكنه أدرك بعد مضي ستة أشهر على عمله في هذه الشركة أنه في الحقيقة كان يمقت وظيفته، غير أنه لم يستطع التخلي عنها لأن أبويه كانا فخورين بمنصبه وراتبه ولأن أصدقاءه كانوا يحسدونه دائماً، ويطلبون منه أن يساعدهم على الدخول إلى شركته والعمل فيها.
وعندما بلغ سميح 42 عاماً أصبح شريكاً في الشركة. وكان يتقيّد بجميع القواعد المرعية، وكانت الأمور تبدو ممتازة بالنسبة له. إلّا أن ذلك شكّل بالنسبة له مشكلة حقيقية: فمسيرته المهنية بدت وكأنها لعبة. فلقد لمس سميح انفصالاً تاماً بين رسالة الشركة وما كانت تقوم به على أرض الواقع، ومع ذلك تابع مسيرته فيها. كما أدرك أن الطريقة المتوقّعة منه ليتعامل بها مع زملائه –وبخاصة أولئك الأدنى منه منصباً– كانت بعيدة عن القيم الإنسانية، لكنّه التزم بما كان متوقعاً منه.
بالطبع لا يقوم تفادي فخ الواجبات على التجاهل التام للقواعد. فالغياب التام للالتزام بالتقاليد والقواعد والانحراف الثقافي سيشكلان تحدّياً حتى لأكثر المؤسسات اتّساقاً وشمولاً. وما نحتاجه هو تحديد القواعد التي تؤذينا وتضرّ بنا. فكبت الذات والالتزام الأعمى والصارم لا ينتجان إسهامات فريدة وخلّاقة في العمل؛ ولا يؤديان إلى إرساء جوّ من السعادة في العمل، والذي يشكّل بدوره الوصفة الأساسية لاستدامة النجاح المهني. وفي حالة سميح دفعت الواجبات التي حكمت خياراته المهنية إلى اختياره الوظيفة الخطأ. فالقواعد التي اعتقد سميح أنها واجبة الالتزام تحوّلت إلى أدوات تدمير لروحه ومعنوياته وتسبّبت في نهاية المطاف بانحطاط مسيرته المهنية.
فخ الإفراط في العمل
يستجيب بعضنا للضغوطات الحقيقية التي تفرضها علينا حالة "الجهوزية الدائمة" التي تمتاز بها بيئة عمل القرن الواحد والعشرين بأن نقضي كل لحظة صحو في العمل أو في التفكير بالعمل. فلا يبقى لدينا وقت للأصدقاء أو لممارسة الرياضة أو لتناول الطعام الصحي أو للنوم. ولا نلعب مع أولادنا أو نُصغي إليهم حتى. ولا نلتزم بالبقاء في المنزل عندما نمرض. ولا نكرّس الوقت اللازم لنتعرّف على زملائنا في العمل أو لنتصور أنفسنا مكانهم قبل أن نطلق عليهم أحكاماً اعتباطية.
إن إفراطنا في العمل يُدخلنا في دوّامة: فالمزيد من العمل يسبّب قدراً أكبر من الضغوط؛ وزيادة الضغط تتسبّب بدورها في إبطاء عمل دماغنا وبالتالي تُضعف ذكاءنا العاطفي؛ كما أن ضعف الإبداع والمهارات الاجتماعية يضرّ بمقدرتنا على الإنجاز. وخير تعبير عن هذه الفكرة يلخّصه بشكل رائع عنوان مقالة جديدة في هارفارد بزنس ريفيو: "نتائج البحث واضحة: ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى نتائج عكسية على الموظفين والشركات".
الإفراط في العمل مُغرٍ والوقوع في شركه سهل جداً، وذلك لأنه لا يزال يُشاد به في بيئات عمل كثيرة جداً. فبالفعل قد وجد "إيريك رايد" من جامعة بوسطن أن بعض الموظّفين (وتحديداً الرجال) يكذبون في الإفصاح عن عدد ساعات عملهم، ويدّعون أنها تتجاوز 80 ساعة في الأسبوع، ظنّاً منهم في الغالب أن ساعات العمل الطويلة تترك انطباعاً إيجابياً عند مدرائهم. والأكثر من هذا أن الهَوَس بالعمل قد يكون نابعاً عن شياطيننا الداخلية: فهو يتغذّى على إحساسنا بانعدام اليقين، ويخفّف من شعورنا بالذنب عندما نرى زملاءنا الآخرين يُفرطون في عملهم، ويساعدنا على الهروب من مشاكلنا الشخصية. ويعتقد العديد من الموظفين أن إفراطهم في العمل يُسهم في التخفيف من ضغوطاتهم: إذ إن مجرّد انتهائهم من مشروعهم هذا وإنجازهم لذلك التقرير وقراءتهم لذاك البريد الإلكتروني، سيشعرهم بدرجة أقل من فقدان السيطرة على زمام الأمور. لكن من المؤكّد أن العمل لا ينتهي.
وهذا ما جرى مع سميح. فقد كان يعود إلى منزله في المساء متأخراً إلى العشاء، بينما يبقى هاتفه بجانبه على الطاولة، وما إن تمضي دقيقتان على حديثه مع أفراد أسرته حتى يضطر إلى الردّ على مكالمة بشأن العمل. وكان سميح يظنّ أن أفراد أسرته لا يكترثون لهذا الأمر، غير أنهم كانوا في الحقيقة منزعجين من سلوكه. وطيلة تلك السنوات، حين كانت عائلته تحاول مواجهته بهذا الخصوص، كان يردّ بغضب مدافعاً عن نفسه: "أنا مضطرّ للقيام بهذا! ماذا عليّ أن أفعل، هل أترك عملي مثلا؟" وفي النهاية يندم ويشرع بتقديم الوعود بالتغيير. غير أنه بعد فترة وجيزة يعود إلى إدمانه على العمل مجدداً.
بدأ سميح ينام وقتاً أقصر-من ناحية بسبب تلقيّه مكالمات متأخّرة في الليل ومبكّرة في الصباح، وبسبب شعوره بالضغط من ناحية أخرى. وخفّت شهيته للطعام، بينما غدا في عمله مديراً حادّ الطباع ومشتَّت الذهن. فبدأ يرتكب الأخطاء –كعدم الالتزام بالمواعيد النهائية ونسيان الردّ على رسائله الإلكترونية المهمة. فلم يعد قادراً على الارتقاء إلى مستوى توقعاته أو توقعات الآخرين، الأمر الذي أزعجه كثيراً. لذا قام ببذل المزيد من الجهد.
وكما سوزان، تلقّى سميح إنذاراً أيقظه من سباته. ففي إحدى جلساته مع عائلته عند المساء وخلال جدالهم وسجالهم اللانهائي المعتاد بخصوص هاتفه ورسائله الإلكترونية والمكالمات الليلية، وجّهت له زوجته إنذاراً نهائياً: "لا بدّ من وضع حدّ لهذه الحالة. لا أرغب في الاستمرار على هذا النحو". آلم هذا الإنذار سميح كثيراً، ووضعه أمام لحظة حاسمة. وقبل أسبوع من تلك الجلسة، أشارت مديرة سميح إلى وجود بعض المشاكل الخطيرة في أحد مشاريعه؛ وأخبرته بأن الجميع قلقون عليه –فلقد كان دائماً في حالة "الجهوزية" وبدت عليه أمارات الإرهاق والاستنزاف واضحة جداً. حتى إنها وجّهت له أيضاً ذات الإنذار الذي سمعه من زوجته: "لا بدّ من وضع حدّ لهذه الحالة".
كان من الصعب على سميح الاعتراف بأن لديه مشكلة. فإفراطه في العمل كان بمثابة قناع يحتمي خلفه، إذ لطالما كان الاجتهاد جزءاً من هويّته- وكما يصحّ بالنسبة للكثيرين منّا، فقد بدا ذلك الإفراط أكثر أهمية مع تطوّر مسيرته وازدياد وتيرة التغيير في شركته. ومعلوم أن الشركات الرشيقة والأسواق شديدة التنافس تجبرنا على فعل المزيد لقاء القليل. ومع تقدّم التكنولوجيا بتنا نقوم بمهام كانت فيما مضى من اختصاص الآخرين، أو كنا نكلّف الآخرين بالقيام بها. وبالنسبة للكثيرين منا ممن يعملون في مناطق زمنية متباينة، باتت اليوم المكالمات الجماعية في الصباح الباكر والمساء المتأخر أمراً روتينياً، كما بات ذلك الجهاز الصغير الذي نحمله أينما ذهبنا سيداً آمراً ومتطلباً. فلقد غدا العمل في هذه الأيام في جيوبنا -أو بجانب سريرنا.
وسواء أوَقعتَ في فخَّي "الواجبات" و"الإفراط في العمل" مثل سميح، أم في فخ "الطموح" مثل سوزان، فإن السؤال المهم هو: "كيف تستطيع التحرّر من هذا الفخ؟". الجيد في الأمر هو أن بعض مهاراتك وذهنياتك القيادية التي تجعلك فعالاً في العمل، بوسعها أيضاً أن تساعدك على التحرّر من الفخاخ آنفة الذكر واكتشاف السعادة من جديد.
التحرّر من الفخاخ
تتمثّل أولى الخطوات في الإيمان بفكرة أنك تستحقّ أن تكون سعيداً في عملك. وهذا يعني أن تتخلّى عن المعتقد المغلوط القائل بأن العمل ليس المقصود منه أن يكون مصدراً أساسياً للرضا وتحقيق الذات. فعلى مدار قرون من الزمن ساد الاعتقاد بأن العمل هو مجرّد وسيلة لدرء الجوع. وللإنصاف، لا يزال الكثيرون يكافحون ويعملون بأجور منخفضة وفي ظل ظروف مروّعة، وبالنسبة لهم فإن العمل كدح وشقاء. غير أن الأبحاث تُظهر أن جميع الوظائف، وحتى الوضيعة منها، بمقدورها أن توفّر لصاحبها الرضا وتحقيق الذات. والمفاجئ أن المدراء التنفيذيين الناجحين –وهم الذين يعملون اليوم في المجال المعرفي والإبداعي- قد لا يجدون أحياناً المعنى الحقيقي في عملهم، بل يقبلون بالخرافة القائلة بأن العمل يجب أن يكون قاسياً وطاحناً.
بمقدور العمل أن يكون مصدراً للسعادة الحقيقية، التي أعرّفها بأنها استمتاع فعلي ودائم بأنشطة العمل اليومية يغذّيه الشغف إلى هدف ذي معنى في العمل، ورؤية إلى المستقبل ملؤها الأمل، وعلاقات صداقة حقيقية مع الزملاء. ولاحتضان هذه المركّبات الثلاث للسعادة، يتعيّن علينا أولاً الخوض في الدوافع والعادات الشخصية جداً التي تمنعنا من تعزيز تلك المركّبات وتدعيمها. لماذا نعمل طوال الوقت؟ وهل طموحنا ورغبتنا بالربح يخدماننا أم يسبّبان لنا الأذى؟ ولماذا نجد أنفسنا أسرى لما نشعر أنه من واجبنا القيام به، بدلاً من أن نسعى إلى ما نريد ونرغب في فعله؟ للإجابة على هذه الأسئلة، علينا الاستفادة من ذكائنا العاطفي.
الانتقال من الفخ إلى السعادة
على مدار العقود الماضية، خلص علماء النفس والباحثون في هذا المجال، وأنا منهم، إلى التوافق على أن ثمة 12 معياراً لكفاءة الذكاء العاطفي (انظر الشريط الجانبي بعنوان "كفاءات الذكاء العاطفي")، بمقدورها جميعاً أن تساعدك على تفادي الوقوع في فخاخ السعادة أو التحرّر منها. وأظن أن ثلاثاً منها –وعي الذات العاطفي، وضبط الذات العاطفي، والوعي المؤسساتي- مفيدة على وجه الخصوص للتحرّر من ذهنيةٍ أكل عليها الدهر وشرب.
ويتمثّل الوعي العاطفي للذات بالمقدرة على ملاحظة مشاعرك وحالاتك العاطفية وفهمها والتعرّف على كيفية تأثيرها في أفكارك وأفعالك. فقد تُدرك على سبيل المثال أن الانزعاج الذي تشعر به عندما ترضخ لـ"واجب" ما في العمل –كأن تُجيب على بريد إلكتروني في الساعة الثامنة مساءً أو في عطلة الأسبوع- إنما يدلّ على أنك تخشى الإقصاء عن العمل. ولكن إذا ما تعمّقت أكثر، فإنك قد تُدرك أن علاقة هذا الخوف بوضعك الراهن في العمل ضعيفة جداً أو معدومة؛ بل قد يكون ذلك الخوف ببساطة من رواسب عاداتك الفكرية القديمة التي لم تعد تخدمك على الإطلاق.
ومع أهمية الوعي كخطوة أولى، إلا أنه يجب أن يتبعها خطوة عملية وفاعلة تتمثّل في ضبط الذات العاطفي: إنه يمكّنك من تحمّل الانزعاج الناتج عن فهمك لما تفعله في حق نفسك، فعندما تُدرك مثلاً أنك تتفقّد بريدك الإلكتروني ليلاً خوفاً من أن تكون قد وردتك رسائل جديدة، فإنك ستشعر بالإحباط والانزعاج. لكنك إذا نحّيت هذا الشعور جانباً، فإنك ستبقى عالقاً في شرك هذا السلوك. وفضلاً عن ذلك يمكّننا ضبط الذات العاطفي أيضاً من القيام ببعض الأفعال الضرورية التي قد تقع خارج حدود منطقتنا المريحة.
وأخيراً، بمقدور الوعي المؤسساتي –والذي هو فهم بيئة العمل المحيطة بك- أن يساعدك على التمييز بين ما ينبع من داخلك وما يأتي من الآخرين أو من الشركة. فقد تدرك مثلاً أن زملاءك يقرؤون رسائلهم الإلكترونية ويردّون عليها في جميع الأوقات، ولذلك فإن عملك الإضافي في البيت إنما هو ناتج عن ضغط التكيّف مع ما هو سائد –وليس بالضرورة عن شعورك بخطر فقدان وظيفتك. وهكذا بِتَّ أمام خيارَين يتعيّن عليك اتخاذ أحدهما: فبوسعك أن تكون شجاعاً وتقرّر كسر القاعدة السائدة وإيقاف العمل الإضافي في البيت، أو أن تستمر في انتهاج سلوك يتعارض مع منظومة قيمك (ويؤذي صحتك وحياتك الأسرية). حتى إنك قد تُدرك أن انسحابك من العمل الإضافي من شأنه أن يغيّر ديناميات وتطلّعات فريق عملك، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل نواة لثقافة ميكروية فاضلة ضمن مؤسستك الكبرى.
الهدف والأمل والصداقة
يُعدّ توظيف الذكاء العاطفي في التخلّص من المعيقات أمام الوصول إلى السعادة أولى خطوات الرحلة إلى درجة أعلى من تحقيق الذات في العمل. غير أن السعادة لا تحدث فجأة بمفعول سحري-بل يتعيّن علينا أن نسعى بشكل فعاّل إلى إيجاد المعنى والهدف الذي نبتغيه من نشاطنا اليومي في العمل، ونعزّز الأمل والثقة بأنفسنا وبالآخرين، ونبني علاقات الصداقة في العمل.
المعنى والهدف. من طبع الإنسان أن يبحث عن المعنى في أي شيء يقوم به، سواء أكان يجلس في مكتب، أم يتنزّه في الجبال، أم يتناول طعام الغداء مع أسرته. إن الحماس لقضية ما يعزّز الطاقة والذكاء والإبداع. والسبب يعود في جزء منه إلى الكيمياء: فلقد أظهر الباحثون أن المشاعر الإيجابية التي يُثيرها العمل فينا والتي نقدّرها عالياً، تمكّننا من أن نكون أكثر ذكاءً وإبداعاً وتكيّفاً في العمل. فلقد قام "دان أريللي"، بروفسور علم النفس في جامعة "ديوك"، مع زملائه بدراسة دُفع للمشتركين فيها أجراً مقابل بناء نماذج من قطع الـ"ليغو"، جرى تفكيك بعضها أمام أعين أصحابها بعد إنجازها. وفي النتيجة بنى أولئك المشتركون الذين لم تُفكَّك نماذجهم عدداً من النماذج الجديدة أكبر بنسبة 50% وسطياً من العدد الذي بناه أولئك الذين فُكِّكت نماذجهم، على الرغم من تساوي الحوافز المالية بين الجميع. إننا نجدّ ونجتهد أكثر عندما يكون لنا أثر-مهما كان صغيراً.
ولقد أظهر اختصاصيو الإدارة أن هذه الحقيقة تبقى صالحة بالنسبة للوظائف أيضاً: إذ يمثّل الهدف محرّكاً قوياً لتحقيق السعادة في مكان العمل. لكننا غالباً ما نُخفق في استغلال نبع التحفيز هذا. وكما كان الحال بالنسبة لسوزان وسميح، فإنه لمن السهل أن نغفل عن رؤية ما نقدّره ونتغاضى عن الأوجه التي تعنينا في العمل، بخاصة إذا كنا نعاني من مؤسسات فاشلة ورؤساء سيّئين وضغوط في العمل. وإذا ما حدث ذلك فإن احتمال الانعزال يكون كبيراً. ففي غياب المعنى، لا يكون لدينا حافز لنعطي كل ما عندنا.
كلّ منّا ينظر إلى معنى وهدف عمله بشكل مختلف، غير أنني ومن خلال خبرتي مع أناس من كل أنحاء العالم وفي جميع المهن والاختصاصات، وجدت أن هنالك قاسماً مشتركاً: فجميعنا يرغب في الكفاح من أجل قضية تعنينا شخصياً. نريد أن نبدع ونخترع. نريد أن نحلّ المشاكل ونحسّن بيئة عملنا. نرغب في أن نتعلّم وننمو. وكما أظهرت الدراسات، فإن العمل ذا المعنى أمر مهمّ بالنسبة للبوّاب والمدير الأوسط والمدير العام التنفيذي على حدّ سواء.
ومع اكتشافك لأوجه عملك التي تحقق ذاتك فعلاً –وتلك التي تحطّم معنوياتك- فإنك ستواجه خيارات عدّة حول كيف عليك أن تقضي وقتك وما الذي ستسعى إلى تحقيقه في مسيرتك المهنية. فلقد قرّر سميح أن يبدأ جديّاً باستكشاف الأعمال التي طالما حلم بإدارتها. ففكّر في الأمور المالية وفي كيفية الاستفادة من علاقاته في شركته الراهنة ومع الزبائن. وبالمحصلة قرر العمل كشريك في شركته الراهنة بدوام جزئي لمدة عامين اثنين سعى خلالهما إلى
الأمل. إذا واجهت مرة محنة أو أزمة أو خسارة، فإنك تعلم من دون شك أن الأمل هو الذي ساعدك على تخطّيها. فالأمل يجعلنا نستيقظ كل يوم ونستمر في المحاولة حتى في ظروف الحياة الصعبة. إنه يمكّننا من الخوض في القضايا المعقدة، والتعامل مع الضغوط والخوف والإحباط، وفهم المؤسسات وأساليب الحياة المحمومة. وذلك يعود في جزء منه، كما كان الأمر بالنسبة للهدف، إلى الآثار الإيجابية لكيمياء دماغنا. فلقد أظهرت الأبحاث أننا عندما نشعر بالتفاؤل فإن جهازنا العصبي يتحوّل من وضعية "القتال أو الهرب" إلى وضعية الهدوء والاستعداد للفعل. فلقد أظهرت إحدى الدراسات على سبيل المثال أن الأشخاص عندما يُدرَّبون بطريقة تستحثّ مشاعر إيجابية ونظرة ملهمة إلى المستقبل، تتفعّل بعض المساحات المرتبطة بجهازهم العصبي نظير الودّي من دماغهم: فيتباطأ تنفّسهم، وينخفض ضغط الدم ويتحسّن أداء جهاز المناعة لديهم. فنفكّر حينئذ على نحو أكثر عقلانية ونكون أكثر قدرة على التعامل مع مشاعرنا وأحاسيسنا، ونشعر بأننا نمتلك الطاقة والاستعداد لنخطّط للمستقبل.
تلك هي الطريقة التي اتّبعتها سوزان للانتقال من خطوة إدراك لماذا كان تفكيرها مركّزاً على الربح إلى الخطوة التالية المتمثّلة بإنشاء مسار مهني يُثير حماسها الحقيقي ويحقّق لها ذاتها. ومن خلال النقاشات مع زوجها (الذي كان قد حذّرها منذ سنوات من طموحاتها غير المنظّمة وغير الواقعية)، تمكّنت من وضع تصوّر حول ما تريده من عملها –تصوّر لا يعتمد على إحراز الترفيعة التالية أو ربح بعض الألعاب التي لا تنتهي، بل على نوع الحياة التي ترغب في أن تحياها.
كثيراً ما يلجأ أصحاب العمل إلى استخدام بيانات رؤية واعدة بهدف زرع التفاؤل والإيجابية في نفوس موظفيهم، لكن لسوء الحظ حتى تلك البيانات المُصاغة بشكل جيّد ومدروس نادراً ما تكون محفّزة بما يكفي لتعزيز الأمل لدى الموظفين على المدى الطويل. فلكي نكون سعداء في أماكن عملنا يجب أن تتّسق مسؤولياتنا وفرصنا مع رؤيتنا الشخصية –التي تخاطب قيمنا وأمنياتنا ومعتقداتنا- ويجب أن نمتلك تصوّراً عن الطرق المؤدية إلى تحقيق تلك الرؤية. ويتمحور الأمل حقاً حول التخطيط –فهو يشجّعنا على السير في دروب قد نواجه فيها آفاقاً تبدو مظلمة؛ كما يشجّعنا على اتخاذ خطوات ملموسة وعملية مرتبطة بكيفية رؤيتنا لتطوّر وتفتّح حياتنا ومسارنا المهني.
لطالما قابلتُ أثناء عملي أناساً يتجنّبون الأحلام الكبيرة خوفاً من أن آمالهم في تحقيقها ستخيب لا محالة. لكنني لا أعتقد بوجود ما يسمّونه "الأمل الزائف". فالأمل لا علاقة له بالتفكير السحري أو الخيال، بل هو خبرة عاطفية إيجابية قوية تؤدي إلى خطط مدروسة وشجاعة وخطوات عملية ملموسة.
الصداقة. إذا كنت تعمل مع أناس تحبّهم وتحترمهم وإذا كانوا بدورهم يحبّونك ويحترمونك، فقد تستمتع بالذهاب إلى العمل. أما إذا كنت تشعر في وظيفتك بأنك متأهّب ومُهان ومعزول على الدوام، فإنك في طريقك إلى تعاسة عميقة –إن لم تكن قد أصبحت فيها أصلاً. قد تظنّ أن الوضع محمول أو أنك لست بحاجة إلى الأصدقاء في العمل، غير أن ذلك ليس صحيحاً.
في الحقيقة، إن العلاقات الجيدة في العمل هي دعامة المؤسسات الناجحة. فالموظفون الذين يهتمّون لبعضهم البعض يعطون بسخاء من وقتهم ومهاراتهم ومواردهم. لقد وجدت مؤسسة "غالوب" لاستطلاعات الرأي أن العلاقات الجيدة في العمل تحسّن من رضا الموظفين بنسبة 50% وأن الموظفين الذين يعملون مع أحد أفضل أصدقائهم من المحتمل أن ينخرطوا كلياً في عملهم أكثر بسبع مرات من سواهم. كما إن الاحترام المتبادل يدفعنا إلى حلّ الخلافات بطريقة يربح معها الجميع. وعندما نعتقد أننا مقبولون كما نحن، وأننا نؤدي أدواراً مهمة في العمل، وأننا جزء من فريق، يتعزّز التزامنا بالأهداف الجماعية.
كما إن العلاقات الإيجابية الدافئة في العمل مهمة لأسباب إنسانية بحتة. فمنذ بدء الزمان، اعتاد الناس على تنظيم أنفسهم في قبائل يعملون ويلعبون فيها مع بعضهم البعض. أما الآن فمؤسساتنا هي قبائلنا. إننا نسعى لأن نعمل في مجموعة أو شركة تشعرنا بالفخر والاعتزاز بأنفسنا وتحفّزنا لنقدّم أفضل ما لدينا من جهد.
نحن نرغب في أن يهتمّ بنا الآخرون ويقدّروننا بوصفنا بشر. كما يتعيّن علينا نحن أيضاً أن نهتم بالآخرين ونقدّرهم. إننا نزدهر جسدياً ونفسياً عندما نتعاطف مع الآخرين ونرى أنهم يهتمّون لحالنا بالمقابل. وفي الواقع، لقد وجدت دراسة "هارفارد جرانت" وغيرها من الدراسات، أن الحب –نعم، الحب- هو أهمّ عامل منفرد محدّد للسعادة في الحياة. والأكثر من ذلك، أن الناس الذين يختبرون الحب –بما في ذلك الصداقة- هم أكثر نجاحاً، حتى من الناحية المالية. (وتُشير الدراسة إلى أن المشاركين الذين حصلوا على أعلى العلامات فيما يتعلّق بـ"العلاقات الودّية" قد كسبوا وسطياً، خلال سنوات الكسب الأعلى، 141,000 دولار أكثر من سواهم في السنة الواحدة).
ولكن هل من المعقول أن يحبّ المرء في العمل؟ قد ينفر الكثيرون من هذه الفكرة متمسّكين بالحذر من العلاقات العاطفية في العمل (مع أننا نعلم أن ذلك كثيراً ما يحدث فعلاً). غير أن ما نحتاجه في العمل هو الحب القائم على الاهتمام بالآخر والقلق عليه وروح الزمالة. فمثل هذه العلاقات مليئة بالثقة والسخاء ومصدر للسرور وتجعل من العمل متعة حقيقية.
يعتقد عدد كبير جداً من الناس أنهم إذا كانوا ناجحين، فإنهم سيكونون سعداء أيضاً. غير أن العكس هو الصحيح. فكما يقول الكاتب وعالم النفس "شون آكور" ببساطة ووضوح: "السعادة تمهّد للنجاح". ذلك أن المشاعر الإيجابية الناجمة عن كون المرء منخرطاً في علاقة سعيدة، ومحقّقاً ذاته، ويحظى باحترام ومحبة زملائه في العمل، لها فوائد كثيرة: فأدمغتنا تعمل حينئذ بشكل أفضل، ونكون أكثر إبداعاً وقدرة على التأقلم، ونمتلك قدراً أكبر من الطاقة، ونتّخذ قراراتنا بذكاء أكثر، ونُجيد التعامل مع المسائل المعقّدة. إنها حقيقة بسيطة وواضحة: الأشخاص السعداء يعملون بأداء أفضل من زملائهم التعساء.
حان الوقت لأن نطالب بحقّنا في العمل بسعادة. ولننطلق من التخلّص من الآراء والمعتقدات التي عفا عليها الزمن والاستعاضة عنها بفهم جديد لما يمكن أن نتوقّعه من العمل –ومن بعضنا البعض. لنتحرّر من الفخاخ التي تبعدنا عن السعادة، ولنبدأ رحلة تحقيق الذات من خلال التركيز على اكتشاف هدفنا في العمل وتحقيقه، وامتلاك رؤية مُقنعة ومحفّزة للمستقبل، وتحويل الزملاء إلى أصدقاء حقيقيين. ستساعدنا هذه الأشياء على خلق بيئات عمل تحترم إنسانيتنا وتعزّز الأخلاق العامة والنجاح المستدام، بيئات عمل تهتمّ بالأفكار والحاجات والرغبات –كما بالسعادة أيضاً.