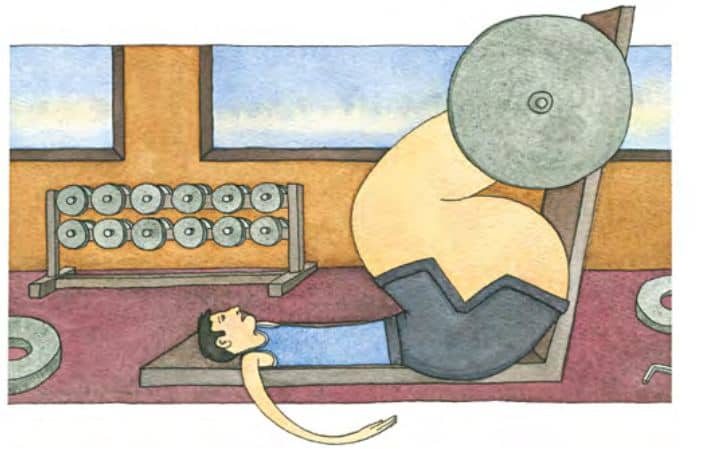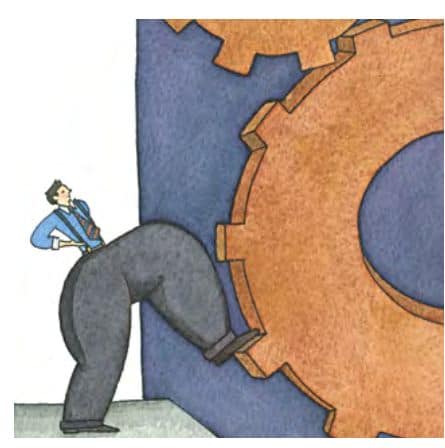سيكون النجاح في اقتصاد المعرفة حليفاً للأشخاص الذين يعرفون أنفسهم حق المعرفة، أي من يعرفون نقاط قوّتهم، وقيمهم، وكيف يقدّمون الأداء الأفضل.
لا تزال أفضل الطرق للفوز بالمنافسة العالمية خافية عن العديد من الشركات. فخلال عقد الثمانينات كان تقييم أداء كبار المسؤولين التنفيذين في الشركات مرتبطاً بقدرتهم على إعادة هيكلة شركاتهم وتنظيمها وتخفيف التراتبية فيها. أما في عقد التسعينات فسيصبح تقييم أداء هؤلاء المسؤولين مبنياً على قدرتهم على تحديد وتطوير واستغلال قدرات الشركة الأساسية لمساعدتها على النمو، مما يتطلب منهم، في الحقيقة، إعادة التفكير في مفهوم الشركة ذاته.
لطالما كان كبار العظماء في التاريخ مثل نابليون ودافنشي وموزارت قادرين على إدارة ذواتهم. فهذا بالضبط، وإلى حدّ كبير، هو ما يجعلهم من ذوي الإنجازات العظيمة. لكنهم استثناءات نادرة، عدا عن أن مواهبهم وإنجازاتهم غير اعتيادية إلى درجة تجعلنا نصنّفها خارج حدود الوجود الإنساني العادي. أمّا الآن فإننا بمعظمنا، وحتى من يمتلكون مواهب عادية منّا، بحاجة إلى أن نتعلّم كيف ندير ذواتنا. ويجب علينا أن نتعلّم كيف نطوّر أنفسنا. وينبغي لنا أن نضع أنفسنا في المقام الذي يسمح لنا بأن نقدّم أفضل ما لدينا. ويتعيّن علينا أن نظلّ متيقّظين ذهنياً ومتفاعلين مع محيطنا طوال 50 عاماً من العمل، ممّا يعني أن نعرف كيف ومتى نغيّر العمل الذي نقوم به.
ما هي نقاط قوّتي؟
يعتقد معظم الناس بأنهم يعلمون ما الذي يبرعون فيه. لكنهم عادة مخطئون في اعتقادهم هذا. ففي أغلب الأحيان، يعلم الناس ما الذي لا يبرعون فيه – وحتى في تلك الحالة، فإن عدد المخطئين أكبر من عدد المصيبين. ومع ذلك، لا يمكن للمرء أن ينجز إلا انطلاقاً من نقاط قوّته. ولا يمكن للمرء أن يبني أداءه على نقاط ضعفه، ناهيك عن أن يبني أداءه على أساس شيء لا يعلم أصلاً كيف يفعله.
على مدار التاريخ، لم يكن الناس إلى معرفة بحاجة كبيرة إلى معرفة نقاط قوّتهم. فقد كان الإنسان يُولد ويجدُ نفسه في موقع معيّن وفي مهنة معيّنة: فابن الفلاح سيغدو فلاحاً؛ وابنة الحرفي ستصبح زوجة حرفي، وهكذا دواليك. أمّا الآن فإن الناس باتوا قادرين على الاختيار. نحن بحاجة إلى أن نعلم نقاط قوّتنا لكي نحدّد انتماءنا.
والطريقة الوحيدة التي تسمح لك باكتشاف نقاط قوّتك هي تحليل تقييم الأداء (feedback). كلّما اتخذتَ قراراً رئيسياً أو أقدمتَ على فعل رئيسي، دوِّن أو سجِّل ما الذي تتوقّع حصوله. وبعد 9- 12 شهراً، قارن بين توقعاتك والنتائج الفعلية. أنا شخصياً أمارس هذه الطريقة منذ 15 - 20 عاماً، وفي كلّ مرّة أمارسها تصيبني الدهشة. فقد أظهر تحليلي للتغذية الراجعة مثلاً – لدهشتي الكبيرة – بأنني امتلك فهماً حدسياً للأشخاص التقنيين، سواء كانوا مهندسين، أو محاسبين، أو باحثي أسواق. كما أظهر لي التحليل أيضاً بأنني لا أنسجم مع الأشخاص غير المتخصصين أو الذين يبرعون في أمور كثيرة.
ليس تحليل الرأي والتقييم أمراً جديداً على الإطلاق. فقد وُضِعَت هذه الطريقة في القرن الرابع عشر على يد لاهوتي ألماني لم يكن معروفاً إلا بسبب وضعه لهذه الطريقة. وبعد 150 عاماً، عثر عليها شخصان مستقلان عن بعضهما، ألا وهما جون كالفين وأغناطيوس لويلا، واستعملها كل منهما في طقوسه الدينية مع اتباعه. ولكن في الحقيقة، هذه المثابرة في التركيز على الأداء والنتائج التي تفضي إليها هذه العادة يفسّران سبب هيمنة المؤسستين اللتين أوجدهما هذان الرجلان، على أوروبا خلال 30 عاماً، أقصد الكنيسة الكالفينية والرهبنة اليسوعية.
ستبيّن لك الممارسة الثابتة لهذه الطريقة البسيطة، وخلال فترة قصيرة من الزمن، ربما في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، أين تكمن نقاط قوّتك – وهو أهم شيء يجب أن تعرفه. وستُظهِرُ لك هذه الطريقة ما الذي تقوم به أو لا تقوم به فيحرمك من الاستفادة الكاملة من نقاط قوّتك. كما ستبيّن لك تحديداً أين تنقصك الكفاءة. وأخيراً، ستحدّد لك ما هي المجالات التي لا تملك أي نقاط قوّة فيها ولن تكون قادراً على أن تنجز أي شيء ضمنها.
يقود تحليل الرأي والتقييم إلى عدد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. ركّز، بادئ ذي بدء، على نقاط قوّتك. ضع نفسك حيث تسمح لك تلك النقاط بأن تحقق النتائج.
الطاقة والجهد المطلوبان للانتقال من حالة انعدام الكفاءة إلى كفاءة ضعيفة أكبر بكثير من الطاقة والجهد المطلوبين للانتقال من أداء رفيع الطراز إلى التميّز
ثانياً، اعمل على تحسين نقاط قوّتك. فسرعان ما سيُظهرُ لك التحليل أين تحتاج إلى تحسين مهاراتك أو اكتساب مهارات جديدة. كما أنه سيُظهر لك الفجوات الموجودة في معرفتك – وهي فجوات يمكن ملؤها عادة. فعلماءُ الرياضيات يولدون علماء رياضيات بالفطرة، لكن بوسع الجميع أن يتعلّموا علم المثلثات.
ثالثاً، اكتشف ما هي المجالات التي يصيبك غرورك الفكري فيها بنوع من الجهل المُعيق، وتغلّب عليها. ثمّة عدد كبير من الناس – وخصوصاً من يمتلكون خبرة هائلة في مجال معيّن – يزدرون المعرفة في المجالات الأخرى، أو يؤمنون بأن ذكاء المرء يُعتبر بديلاً عن معرفته. فالمهندسون من الطراز الرفيع، على سبيل المثال، يتفاخرون عادة بأنهم لا يعلمون شيئاً عن البشر. وهم يعتقدون بأن البشر أكثر فوضى من أن يحتملهم العقل الهندسي الرصين. أمّا المختّصون في الموارد البشرية، في المقابل، فيتفاخرون غالباً بجهلهم بمبادئ المحاسبة أو بجميع طرق القياس الكمّي على الإطلاق. بيد أن التفاخر بهذا الجهل هو شكل من أشكال الانهزامية. انطلق لاكتساب المهارات والمعارف التي تحتاجها لكي تعرف تماماً نقاط قوّتك.
وما يوازي ذلك أهمية أيضاً هو أن تعالج عاداتك السيئة – أي الأشياء التي تفعلها أو تفشل في فعلها وتحدّ من كفاءتك وأدائك. فهذه العادات ستظهر سريعاً في التقييم. فقد يكتشف أحد مسؤولي التخطيط، على سبيل المثال، أن خططه تفشل لأنه لا يقوم بالمتابعة المطلوبة أثناء تنفيذ الخطة. فهو يعتقد، جرياً على عادة الأذكياء، بأن الأفكار تحرّك الجبال. لكن الحقيقة أن الجرّافات هي التي تحرّك الجبال، أمّا الأفكار فتحدّد الأماكن التي يجب أن تذهب الجرّافات إليها. وبالتالي يتعيّن على مسؤول التخطيط هذا أن يتعلّم أن العمل لا يتوقّف عند الانتهاء من وضع الخطة. ويجب أن يعثر على الأشخاص الذين سيضعون هذه الخطة موقع التطبيق وأن يشرحها لهم. وينبغي له أن يعدّل الخطّة ويكيّفها عندما ينطلق العمل بها. وأخيراً، يجب أن يقرّر متى يتوقّف عن دفع الخطة إلى الأمام.
وفي الوقت ذاته، سيكشف لك التقييم متى تكون المشكلة ناجمة عن غياب اللباقة. واللباقة مثل زيت التزليق في المؤسسة. فقوانين الطبيعة تنصّ على أن تلامس أي جسمين متحرّكين يؤدّي إلى الاحتكاك بينهما. ويصحّ هذا الأمرعلى البشر بقدر ما يصحّ على الجماد. واللباقة – التي لا تتعدّى أشياء بسيطة من قبيل قول "شكراً" و "لو سمحت" أو معرفة اسم الشخص، أو سؤاله عن أحوال عائلته – تساعد أي شخصين على العمل معاً سواء كانا يحبّان بعضهما أم لا. وغالباً ما نجد أن الأشخاص الأذكياء، ولاسيما الشباب الأذكياء، لا يفهمون هذا الأمر. فإذا ما أظهر التحليل بأن العمل الممتاز لشخص معيّن يفشل مراراً وتكراراً عندما تستدعي الحاجة التعاون مع الآخرين، فإن ذلك ربما ينبئ عن غياب المجاملة – أي عن غياب اللباقة لديه.
تساعدك هذه المقارنة التي تعقدها بين توقعاتك ونتائجك الفعلية في معرفة ما يجب ألاّ تقوم به. فنحن جميعاً لدينا عدد هائل من المجالات التي نفتقر فيها إلى الموهبة أو المهارة، وليس أمامنا أية فرصة لامتلاك حتى خبرة متواضعة فيها. وبالتالي فإن أي شخص – ولا سيما من يعمل في حقل المعرفة – يجب ألاّ يقبل أي وظيفة أو عمل أو مهمة تندرج ضمن هذه المجالات. وينبغي على الإنسان ألاّ يضيع جهوده في تحسين المجالات التي يمتلك كفاءة متواضعة فيها. فالطاقة والجهد المطلوبان للانتقال من حالة انعدام الكفاءة إلى كفاءة ضعيفة أكبر بكثير من الطاقة والجهد المطلوبين للانتقال من أداء رفيع الطراز إلى التميّز. ومع ذلك، فإن معظم الناس – ولاسيما معظم المدرّسين ومعظم المؤسسات – يركّزون على تحويل الناس من أشخاص عديمي الكفاءة في مجال معيّن إلى أشخاص ذوي أداء عادي فيه. لكن الطاقة والموارد والوقت يجب أن تذهب عوضاً عن ذلك نحو تحويل الأشخاص ذوي الكفاءة إلى نجوم.
فكرة المقالة بإيجاز
نحن نعيش في عصر يمنحنا فرصة غير مسبوقة: فإذا كان لديك الطموح، والدافع، والذكاء الكافي، فبوسعك الارتقاء إلى أعلى سدّة في مهنتك التي تختارها – وبغض النظر عن الموقع الذي انطلقت منه. لكن الفرصة لا تأتي دون المسؤولية. والشركات اليوم لا تدير الحياة المهنية لموظفيها العاملين في حقل المعرفة. وإنما يجب أن يكون كل واحد منّا هو الرئيس التنفيذي لنفسه.
باختصار، أنت بمقدورك أن ترسم معالم موقعك في عالم العمل وأن تنتزع مكانتك المستحقة وأن تعرف متّى تغيّر المسار. والأمر يعود إليك بأن تظلّ منخرطاً في العمل ومُنتجاً خلال حياتك العملية التي قد تستمر على مدار 50 عاماً.
ولكي تنجز كل هذه الأمور على خير ما يُرام، فإنك بحاجة إلى أن تفهم نفسك فهماً عميقاً. ما هي أكثر نقاط قوّتك قيمة وما هي أخطر نقاط ضعفك؟ وبذات القدر من الأهمية، كيف تتعلّم وتعمل مع الآخرين؟ ما هي القيم التي تحملها في أعماقك؟ وما شكل بيئة العمل التي تجعلك قادراً على تقديم أفضل إسهاماتك؟
والنتيجة واضحة: فقط عندما تعمل انطلاقاً من خلطة مكوّنة من نقاط قوّتك ومعرفتك لذاتك بوسعك أن تحقّق تميّزاً حقيقياً ودائماً.
كيف أنجز عملي؟
من المذهل أن عدداً قليلاً من الناس فقط يعرفون كيف ينجزون أعمالهم. فمعظمنا لا يعلم حتّى بأن الأشخاص المختلفين يعملون وينجزون عملهم بطرق مختلفة. وهناك عدد كبير من الناس يعملون بطرق ليست طرقهم المفضّلة، وهذا كفيل بعدم إنجاز أي شيء. وبالنسبة للأشخاص العاملين في حقل المعرفة، قد يكون السؤال: "كيف أنجز عملي؟" أهم حتى من السؤال: "ما هي نقاط قوّتي؟"
تماماً كما أن نقاط قوّة المرء هي صفة فريدة تميّزه عن غيره، فإن الطريقة التي ينجز الإنسان بها عمله هي الأخرى فريدة. والأمر هنا يرتبط بشخصية الإنسان. وسواء كانت الطبيعة الشخصية موروثة أم مكتسبة، فإنها بالتأكيد تتكوّن قبل أن يزاول الإنسان أي عمل بفترة طويلة. كيف ينجز الإنسان عمله هو أمر محدّد سلفاً تماماً مثلما تكون إجادته أو عدم إجادته لعمل ما محدّدة سلفاً. ويمكن إدخال تعديل طفيف على الطريقة التي يؤدّي بها الشخص عمله، لكن من غير المرجّح تغييرها بالكامل، وإن حصل ذلك فلن يكون بالتأكيد سهلاً. وتماماً كما يحقق الناس النتائج من خلال فعل ما يجيدونه، فإنهم يحققون النتائج أيضاً من خلال العمل بالطرق التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم. وثمّة عدد من الطباع الشخصية التي تقرّر عادة كيف ينجز الإنسان مهامه.
كيف تستفيد عملياً من المقالة؟
لكي تبني حياة تتّصف بالتميّز، أبدأ بطرح الأسئلة الثلاثة التالية على نفسك:
ما هي نقاط قوّتي؟
لكي تحدّد نقاط قوّتك بدقّة، استعمل ما يُسمى تحليل التغذية الراجعة (Feedback Analysis). كلّما اتخذت قراراً رئيسياً، دوِّن وسجِّل المحصّلة التي تتوقّعها. وبعد بضعة أشهر، قارن ما بين النتائج الفعلية وتوقعاتك. حاول أن ترى إذا كان هناك أنماط بوسعك استخلاصها: ما هي النتائج التي تبرع في تحقيقها؟ ما هي القدرات التي تحتاج إلى تعزيزها لكي تصل إلى النتائج التي ترغب فيها؟ ما هي العادات غير المُنتِجة التي تمنعك من تحقيق المحصلات التي ترغب فيها؟ في معرض بحثك عن فرص إدخال التحسينات على حياتك، لا تهدر وقتك في تطوير المهارات التي لا تمتلك فيها كفاءة كبيرة. عوضاً عن ذلك، ركّز على نقاط قوّتك وحاول البناء عليها.
كيف أنجز عملي؟
ما هي الطرق التي تجعلك تقدّم أفضل ما لديك؟ هل تعالج المعلومات بأكبر قدر من الكفاءة إذا قرأتها أم إذا سمعت الآخرين يناقشونها؟ هل تحقق أقصى إنجازاتك من خلال العمل مع أشخاص آخرين أم من خلال العمل بمفردك؟ هل يكون أداؤك في أفضل حالاته عندما تكون في موضع الشخص الذي يتّخذ القرار، أم عندما تقدّم النصح والمشورة للآخرين بخصوص المسائل الهامّة؟ هل تكون في أحسن حالاتك إذا كنت معرّضاً للضغوط، أم أن أداءك يكون مثالياً ضمن بيئة كل ما فيها محسوب بدقّة وقابل للتكهّن به؟
ما هي قيمي؟
ما هي برأيك أهم مسؤولياتك لكي تعيش حياة مستحقّة؟ هل تجد بأن قيم مؤسستك تتناغم مع قيمك الذاتية؟ إذا لم يكن هذا التناغم موجوداً، فإن حياتك المهنية ستكون على الأغلب مفعمة بالإحباط وضعف الأداء.
إلى أين أنتمي؟
إذا ما أخذت بعين الاعتبار نقاط قوّتك، وأسلوب عملك المفضّل، وقيمك، فبناءً على هذه الخصال، ما نوع بيئة العمل التي تجد نفسك أقدر على التأقلم معها؟ إذا وجدت المكان الأنسب، فإنك ستحوّل نفسك من مجرّد موظف مقبول إلى نجم ساطع في الأداء.
ما الذي بوسعي تقديمه؟
فيما مضى من الحقب الزمنية، كانت الشركات هي من يخبر الناس العاملين لديها ما شكل الإسهامات التي يتعيّن عليهم تقديمها. أمّا اليوم، فإننا بتنا نملك خيارات مختلفة. ولكي تقرّر ما هي الطريقة الفضلى التي ستساعدك في تعزيز أداء مؤسستك، اسأل نفسك أولاً ما الذي يستدعيه الوضع. بناء على نقاط قوّتك، وأسلوب عملك، وقيمك، كيف يمكنك أن تقدّم أعظم الإسهامات إلى جهود مؤسستك؟
هل أنا قارئ أم مُستمع؟ أوّل شيء ينبغي أن تعرفه هو ما إذا كنت قارئاً أم مستمعاً؛ فقلّة من الناس فقط يعلمون أن هناك قارئين ومُستمعين، وأن المرء نادراً ما يجمع بين الصفتين. بل إن عدداً أقل منهم يعلم إلى أي فئة من الفئتين ينتمي. غير أن بعض الأمثلة ستوضح حجم الضرر الذي يمكن أن يتسبّب به هذا النوع من الجهل.
عندما كان دوايت أيزنهاور يشغل منصب القائد الأعلى لقوّات الحلفاء في أوروبا، كان معبود الصحافة. فمؤتمراته الصحفية كانت مشهورة بأسلوبها، إذ كان بارعاً في الإجابة على أي سؤال يُطرح عليه، وكان يجيد وصف أي وضع أو تفسير أية سياسة، بجملتين أو ثلاث جمل منمقة وبليغة. وبعد عشر سنوات، تحوّل الصحافيون الذين كانوا يوماً معجبين بالجنرال إيزنهاور، إلى الازدراء العلني له عندما أصبح رئيساً. كانوا يتذمرون من أنه لا يجيب بدقة على الأسئلة الموجّهة إليه، بل يحيد عن مقصد السؤال هائماً هنا وهناك بعيداً عن لب الموضوع. ويسخرون باستمرار من إنكليزيته قائلين إنه يعتدي على اللغة بهذه الإجابات المفككة الملأى بالأخطاء.
يبدو أن إيزنهاور لم يعلم بأنه كان قارئاً، وليس مُستمعاً. فعندما كان في منصب القائد الأعلى للقوات في أوروبا، كان مساعدوه يتأكّدون من تقديم جميع الأسئلة الصحفية خطياً له قبل انعقاد المؤتمر بنصف ساعة على الأقل. وهكذا كان بإمكان إيزنهاور أن يسيطر تماماً على الوضع. لكنه عندما وصل إلى سدّة الرئاسة، فإنه خلفَ مُسْتَمِعَينْ اثنين كانا قد شغلا المنصب قبله وهما فرانكلين د. روزفلت، وهاري ترومان. فكلا الرجلين كانا يعلمان بأنهما مُسْتَمِعَينْ، وكلاهما كانا يستمتعان بعقد مؤتمرات صحفية عامة مفتوحة. ولعل إيزنهاور قد شعر بأن عليه السير على خطى سلفيه. ونتيجة لذلك، فإنه لم يكن حتى يسمع الأسئلة التي يطرحها الصحافيون، علماً أن إيزنهاور لا يُعتبر حالة متطرّفة لشخص غير مُستمع.
لا تحاول أن تغيّر نفسك – فإنك على الأغلب لن تنجح في ذلك؛ وإنما اعمل بجد على تحسين طريقة أدائك
وبعد بضع سنوات، دمّر ليندون جونسون رئاسته إلى حدّ كبير حين غفل عن كونه مُستمعاً. فسلفُه جون كيندي كان قارئاً جمع من حوله مجموعة من الكتّاب البارعين كمساعدين له، حيث كان يؤكّد عليهم ضرورة أن يكتبوا له قبل أن يناقشوا معه مذكراتهم المكتوبة شخصياً. عندما خلفه جونسون استبقى هؤلاء المساعدين ضمن موظفيه، واستمرّوا، من جهتهم، في الكتابة له. لكنه على ما يبدو لم يكن يفقه كلمة واحدة ممّا كانوا يكتبون. بيد أن جونسون، كعضو في مجلس الشيوخ، كان ممتازاً في أدائه، لأن البرلمانيين يجب أن يكونوا، وقبل كل شيء، مُستمعين.
قليل من المُستمعين فقط يمكن تحويلهم، أو يمكن أن يحوّلوا أنفسهم، إلى قارئين أكفياء – والعكس صحيح. وبالتالي فإن المُستمع الذي يحاول أن يكون قارئاً سيعاني من المصير الذي وصل إليه ليندون جونسون، في حين أن القارئ الذي يحاول أن يكون مُستمعاً سيعاني من المصير الذي وصل إليه دوايت أيزنهاور. ولن يحققا نجاحا في أدائهما أو في الوصول إلى أهدافهما.
كيف أتعلّم؟ الشيء الثاني الذي يحتاج المرء إلى معرفته حول طريقة أدائه هو كيف يتعلّم. فالعديد من الكتّاب من الطراز الرفيع – والذي يُعتبر ونستون تشرشل مجرّد أحد الأمثلة عنهم – يكون أداؤهم المدرسي سيئاً. وغالباً ما يتذكّرون أيّام الدراسة بوصفها عذاباً صرفاً. بيد أن قلّة من زملاء دراستهم يتذكّرونها بالطريقة ذاتها؛ فلربما لم يستمتعوا بالمدرسة كثيراً، لكن أسوأ ما عانوا منه كان الشعور بالملل. وتفسير ذلك هو أن الكتّاب لا يتعلّمون بالإصغاء والقراءة، حسب القاعدة، وإنما يتعلّمون بالكتابة. وبما أن المدرسة لا تسمح لهم بالتعلّم بهذه الطريقة، فإنهم يحصلون على درجات سيئة.
تؤسس المدارس في كل مكان على افتراض أن هناك طريقة وحيدة صائبة للتعلّم، وهي الطريقة نفسها بالنسبة للجميع. لكن إجبار التلاميذ على أن يتعلّموا بالطريقة التي تتبعها المدرسة يجعلها جحيماً خالصاً بالنسبة للطلاب الذين يتعلّمون بطرق مختلفة. والواقع يشير إلى أن هناك ربما ستّ طرق مختلفة للتعلّم.
ثمة أشخاص، مثل تشرشل، يتعلّمون بالكتابة. وبعضهم يتعلّمون من خلال تسجيل كل ما يقوله المدرّس. بتهوفن، مثلاً، ترك وراءه عدداً هائلاً من المسودات، مع أنه قال بأنه لم ينظر إليها قط عندما كان يؤلف ألحانه. وعندما سئل عن سبب احتفاظه بها، قيل بأنه أجاب: "إذا لم أدوّن اللحن فوراً، فإنني أنساه على الفور؛ ولكن إذا دوّنته على المسودة، فإنني لا أنساه أبداً ولا أحتاج على الأطلاق إلى الرجوع إليه" وبعض الناس يتعلّمون الأشياء من خلال فعلها. بينما يتعلّم آخرون بالإصغاء إلى أنفسهم وهم يتحدّثون.
أعرف مديراً تنفيذياً تمكّن من تحويل شركة عائلية صغيرة وعادية إلى أبرز شركة في مجالها. كان هذا الشخص من الناس الذين يتعلّمون من خلال التحدّث. وكان من عاداته أن يجمع كبار المدراء في مكتبه مرّة في الأسبوع ليتحدّث إليهم لساعتين أو ثلاث. خلال تلك الاجتماعات، كان يطرح سياسات الشركة ويناقش الواحدة منها من ثلاث زوايا مختلفة. ونادراً ما كان يطلب من الحاضرين تقديم التعليقات أو طرح الأسئلة؛ كان بكل بساطة يحتاج إلى جمهور يسمعه وهو يكلّم نفسه. فتلك كان طريقته في التعلّم. ورغم أنه حالة متطرفة نوعاً ما، إلا أن التعلّم عن طريق الحديث ليس حالة غير عادية على الإطلاق. كما أن محامي المرافعات الناجحة يتعلّمون بالطريقة ذاتها، تماماً كما هو حال الأطباء التشخيصيين (وأنا شخصياً من الذين يتعلّمون بهذه الطريقة).
من بين جميع الجوانب الهامّة في معرفة الذات، فإن فهم كيف تتعلم يُعتبر هو الأسهل. وعندما أوجّه إلى الناس السؤال التالي: "كيف تتعلّمون؟" فإن معظمهم يعلمون الإجابة. ولكن عندما أُتْبِعْهُ بالسؤال الثاني: "وهل تفعلون أي شيء بناءً على معرفتكم بهذه المعلومة؟" فإن قلّة منهم تردّ بالإيجاب. ومع ذلك فإن التصرّف بناءً على معرفة هذه المعلومة يُعتبر أمراً أساسياً لتحسين الأداء؛ أو بالأحرى إذا لم يتصرف المرء اعتماداً على تلك المعرفة فإنه سيظل محكوماً بضعف أدائه.
"هل أنا قارئ أم مُستمع؟" و "كيف أتعلّم؟" هما أوّل سؤالين يجب أن يطرحهما الإنسان على نفسه. لكنهما ليسا أبداً السؤالين الوحيدين. فالإدارة الفعّالة للذات تقتضي طرح سؤال آخر أيضاً. "هل أجيد العمل مع الناس، أم أنني أحبّذ العمل بمفردي؟" وإذا كنت تجيد العمل مع الناس، فإنك يجب أن تطرح سؤالاً إضافياً: "ضمن أية علاقة؟"
بعض الناس يقدّمون أفضل ما لديهم في العمل عندما يكونون مرؤوسين. والجنرال جورج باتون، البطل الأميركي العظيم في الحرب العالمية الثانية خير مثال على ذلك. فقد كان باتون أفضل قائد فرقة في أميركا، ولكن عندما جرى ترشيحه ليكون قائداً مستقلّاً وليس تحت أمرة أحد، فإن قائد الأركان الأميركي الجنرال جورج مارشال، الذي يمكن أن نصفه بأنه خير من اختار الرجال لمناصبهم في تاريخ الولايات المتّحدة الأميركية، قال عن باتون بأنه: "أفضل مرؤوس أنجبه الجيش الأميركي على الإطلاق، لكنه سيكون أسوأ قائد."
بعض الناس يقدّمون أفضل أداء لهم عندما يكونون أعضاء في فريق. بينما يبدع آخرون عندما يعملون بمفردهم. والبعض يمتلكون موهبة فذّة في تدريب الآخرين وتوجيههم؛ بينما لا يتمتع غيرهم بأي كفاءة في التدريب والتوجيه.
ثمّة سؤال أساسي آخر: "هل أحقق نتائج أفضل عندما أكون في موقع صانع القرار أم عندما أكون مستشاراً؟" فعدد كبير من الناس يكون يؤدّون كأفضل ما يكون الأداء عندما يقدّمون المشورة والنصح إلى غيرهم، لكنهم غير قادرين على تحمّل عبء وضغط عملية اتخاذ القرار. وفي المقابل، فإن الكثير من الناس يحتاجون إلى موجّه ناصح ليستطيعوا أن يجبروا أنفسهم على التفكير؛ وعندها يستطيعون اتخاذ القرارات والتصرّف بسرعة وبثقة بالنفس وبشجاعة.
وبالمناسبة، هذا هو السبب الذي يجعل المسؤول الثاني في المؤسسة يفشل غالباً عندما يُرقّى إلى المنصب الأول فيها. فالمركز الأوّل يحتاج إلى شخص قادر على اتخاذ القرار. كما أن صانعي القرارات الأقوياء يضعون في المرتبة الثانية بعدهم شخصاً يثقون به ليكون مستشاراً لهم – ويكون ذلك الشخص مبدعاً في هذا المنصب. ولكن عندما يوضع هذا الشخص ذاته في المنصب الأول يفشل. فهو يعلم ما القرار الذي يجب أن يتّخذه لكنه غير قادر على تحمّل مسؤولية اتخاذه.
وثمّة أسئلة أخرى هامّة ينبغي طرحها: "هل يكون أدائي أفضل عندما أتعرّض للضغوط، أم أننّي بحاجة إلى بيئة تتّسم بقدر كبير من التنظيم والوضوح؟" "هل الأفضل لي أن أعمل في مؤسسة كبيرة أم في مؤسسة صغيرة؟" قليلون هم من يقدرون على العمل في جميع أنواع البيئات. وأعود لأكرّر مجدّداً أنني رأيت أناساً يحقّقون نجاحات باهرة في المؤسسات الكبيرة، لكنهم يفشلون فشلاً ذريعاً عندما ينتقلون للعمل في مؤسسات صغيرة. والعكس صحيح تماماً.
وخلاصة كل ما سبق تستحق أن تُعاد من جديد: لا تحاول أن تغيّر نفسك – فإنك على الأغلب لن تنجح في ذلك؛ وإنما اعمل بجد على تحسين طريقة أدائك. وحاول ألا تقبل مهاماً لا تستطيع إنجازها أو ستنجزها إنجازاً سيئاً.
ما هي قيمي؟
لكي تكون قادراً على إدارة ذاتك، يتعيّن عليك أخيراً أن تطرح على نفسك السؤال التالي: "ما هي قيمي؟" وهذا السؤال لا يتعلّق بالأخلاق. فالقواعد في ما يتعلق بالأخلاق، هي ذاتها بالنسبة للجميع، والاختبار بسيط. وأنا أسميه "اختبار المرآة."
في السنوات الأولى من هذا القرن، كان أكثر من يحظى بأعلى درجات الاحترام والتقدير من بين سفراء الدول العظمى هو السفير الألماني في لندن، وكان واضحاً أنه في طريقه لتقلّد مناصب أعلى، كأن يصبح وزير خارجية بلاده على الأقل، إن لم يصبح المستشار الألماني الاتحادي. ولكنه استقال فجأة في العام 1906، لكي لا يترأس مأدبة عشاء أقامها السلك الدبلوماسي على شرف الملك إدوارد السابع. وقد كان الملك مشهوراً بأنه زير نساء، وقد أوضح تماماً ما نوع مأدبة العشاء التي يرغب فيها. وقد نُقِل عن السفير أنه قال: "أرفض أن أرى منافقاً في المرآة صباحاً عندما أحلق ذقني".
هذا هو اختبار المرآة. فالأخلاق تقتضي أن تطرح على نفسك السؤال التالي: "أي نوع من الأشخاص أريد أن أراه صباحاً في المرآة؟" فما يُعتبر سلوكاً لا أخلاقياً في بعض المؤسسات، هو سلوك أخلاقي في مؤسسة أخرى. لكن الأخلاق هي جزء واحد فقط من منظومة القيم، وخاصة منظومة قيم مؤسسة.
فمن يعمل في مؤسسة نظام القيم فيها غير مقبول بالنسبة له أو غير منسجم مع قيمه، يحكم على نفسه بالإحباط وبضعف الأداء.
ولنأخذ هنا على سبيل المثال تجربة مديرة تنفيذية ناجحة جدّاً لقسم الموارد البشرية في شركة استحوذت عليها مؤسسة أكبر حجماً. بعد الاستحواذ، رقّيت هذه المديرة لتتولّى تنفيذ المهام التي كانت تبرع حقّاً فيها، مثل اختيار الأشخاص الذين سيشغلون المناصب الهامّة. كانت هذه المديرة تؤمن بعمق أن أي شركة يجب ألاّ تلجأ إلى تعيين أشخاص من خارجها في هذه المناصب إلا بعد أن تكون قد استنفذت جميع الفرص للعثور على شخص مناسب من داخلها. غير أن الشركة كانت تعتقد بضرورة البحث في الخارج أولاً من أجل "ضخ دماء جديدة في عروق الشركة." لكل مقاربة من هاتين المقاربتين مزاياها، ولكن بحسب تجربتي الشخصية، فإن المقاربة المناسبة هي مزيج من الاثنتين. بيد أن هاتين المقاربتين غير منسجمتين جوهرياً فيما بينهما، ولا أقصد من ناحية السياسات وإنما من ناحية القيم. فهما تنمّان عن اختلاف في وجهات النظر تجاه العلاقة بين المؤسسات والموظفين، وحول مسؤولية المؤسسة تجاه موظفيها وتطويرهم، وتجاه أهم إسهام يمكن للشخص أن يقدّمه للمؤسسة. وبعد سنوات عدّة من الشعور بالإحباط، استقالت المديرة وتكبّدت جراء قرارها ذاك خسارة مالية كبيرة. فقد كانت قيمها، بكل بساطة، غير منسجمة مع قيم المؤسسة.
وعلى نحو مماثل يمكن القول إن محاولة شركة للأدوية الحصول على نتائج من خلال إجراء تحسينات دائمة صغيرة على منتجاتها، أو من خلال تسجيل "اختراقات كبيرة" باهظة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر كل فترة، ليست مسألة اقتصادية بالأساس. فنتائج كلا الاستراتيجيتين قد تكون متشابهة إلى حدّ كبير. لكن ثمة تضارب كبير في الجوهر بين نظام قيم يرى أن إسهام الشركة يكون من خلال مساعدة الأطباء على تحسين عملهم الحالي للحصول على نتائج أفضل، وبين نظام قيم يركّز على تحقيق اكتشافات علمية.
كما أن السؤال المطروح حول ما إذا كان ينبغي أن تُدار الشركة على قاعدة تحقيق نتائج قصيرة الأجل، أو على قاعدة التركيز على الأهداف بعيدة المدى، هو أيضاً سؤال يتعلّق بالقيم. يعتقد المحللون الماليون، من جهتهم، بأن الشركات يمكن أن تدار مع التركيز على الأمرين معاً في الوقت ذاته. ورجال وسيدات الأعمال الناجحون يعرفون ذلك تماماً. فمن المؤكّد بأن كل شركة تحتاج إلى تحقيق نتائج على المدى القصير. ولكن في حال وجود أي تضارب بين النتائج القصيرة الأجل والنمو على المدى البعيد، يتعيّن على الشركة أن تقرّر ما هي أولويتها. ولا يتعلّق الخلاف هنا أساساً بالجوانب الاقتصادية، بل نحن إزاء صراع قيمٍ يتعلق بوظيفة الشركة ومسؤولية الإدارة.
ولا تقتصر حالات صراع القيم على المؤسسات التجارية فحسب. فواحدة من أسرع الكنائس الرعوية نموّاً في الولايات المتّحدة تقيس نجاحها بعدد المنضمّين الجدد إليها. فرئاستها تعتقد أن المسألة الأهم تكمن في أعداد الأشخاص الجدد الذين ينضمّون إلى الرعية؛ فالربّ سيعنى بالاحتياجات الروحية للمنضمين، أو احتياجات نسبة مئوية كبيرة منهم على الأقل. وهناك كنيسة رعوية إنجيلية أخرى تؤمن بأن المهمّ هو النمو الروحي للناس. فهي تساعد القادمين الجدد الذين انضموا إليها ولم يدخلوا في الحياة الروحية على الخروج منها.
مرّة أخرى، الأمر هنا ليس مسألة أرقام. فللوهلة الأولى تبدو الكنيسة الثانية وكأنها تنمو ببطء أكبر. لكنها في الحقيقة تحتفظ بعدد من القادمين الجدد أكبر بكثير مقارنة مع الكنيسة الأولى. إن نموها، بعبارة أخرى، أكثر صلابة. وهذه أيضاً ليست مشكلة لاهوتية، أو على الأقل هي مشكلة لاهوتية ثانوية. إنها مشكلة تتعلق بالقيم. وفي أحد النقاشات العامّة، حاجج أحد الكهنة قائلاً: "إذا لم تأتِ إلى الكنيسة أولاً، فإنك لن تجد السبيل إلى أبواب مملكة السماء."
"كلا،" أجاب الكاهن الآخر. "ما لم تبحث أولاً عن سبيل الدخول إلى مملكة السماء، فإنك لا تصلح للكنيسة."
فالمؤسسات، مثل الناس، لديها قيم. ولكي يكون المرء فعّالاً في مؤسسة ما، فينبغي أن تكون قيمه منسجمة مع قيم تلك المؤسسة. ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بينها، لكنها يجب أن تكون متقاربة بقدر يمكّنها من العيش معاً. وإلا فإن الشخص لن يُصاب بالإحباط فحسب، وإنما سيكون عاجزاً عن إحراز نتائج أيضاً.
نادراً ما يكون هناك تعارض بين نقاط قوّة المرء والطريقة التي يؤدّي بها عمله؛ لأن الأمرين يكمّلان بعضهما بعضاً. لكن قد يكون ثمة صراع أحياناً بين قيم الشخص ونقاط قوّته. فما يقوم به المرء بشكل جيّد – بل حتى بشكل جيّد جدّاً وبنجاح – قد لا يتناسب مع منظومة قيمه. في تلك الحالة، قد لا يبدو العمل مستحقاً أن يكرّس المرء له حياته (أو حتى جزءاً كبيراً منها).
واسمحوا لي في هذا المقام أن أذكر ملاحظة شخصية. فقبل بضع سنوات، اضطررت إلى الاختيار بين قيمي وما كانت أؤدّيه بنجاح. فقد كنت أبلي بلاءً حسناً في عملي كموظف في بنك استثماري في لندن في أواسط عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، وكان واضحاً أن العمل يناسب نقاط قوّتي؛ ومع ذلك، فقد وجدت بأنني لم أكن أقدّم المساهمة التي أريدها من خلال العمل كمدير للموجودات. لقد اكتشفت بأن ما أقدّره هو العمل مع الناس ولم أرَ فائدة من أن أكون أغنى رجل في المقبرة التي سأدفن فيها. لم أكن أملك المال أو أي فرصة عمل أخرى؛ ورغم استمرار شعوري بالاكتئاب إلا أنني استقلت وكان ذلك هو القرار الصائب. إن القيم، بتعبير آخر، هي الاختبار الحقيقي ويجب أن تكون هي المحك دائماً.
إلى أين أنتمي؟
قلّة من الناس فقط تعلم في مرحلة مبكّرة جدّاً من حياتها إلى أين تنتمي. فعلماء الرياضيات، والموسيقيون، والطبّاخون، على سبيل المثال، يصبحون علماء رياضيات، وموسيقيين، وطبّاخين منذ سن الرابعة أو الخامسة. أمّا الأطبّاء فإنهم يقرّرون المهنة التي يريدون العمل فيها في فترة المراهقة إن لم يكن أبكر من ذلك. لكن معظم الناس، ولاسيما الأشخاص الموهوبين، لا يعلمون حقّاً إلى أين ينتمون إلا بعد أن يتجاوزا أواسط الثلاثينيات من العمر. ولكن بحلول ذلك الوقت، يجب أن يمتلكوا الإجابات عن الأسئلة الثلاثة التالية: ما هي نقاط قوّتي؟ وكيف أنجز عملي؟ وما هي قيمي؟ ووقتها سيكونون قادرين على أن يقرّروا إلى أين ينتمون، ويجب أن يقرّروا.
أو بالأحرى، يجب أن يكونوا قادرين على أن يقرّروا إلى أين لا ينتمون. فالشخص الذي يكون قد عرف أن أداءه لن يكون جيّداً في مؤسسة كبيرة، يجب أن يكون قد تعلّم كيف يقول لا لمنصب عُرِضَ عليه في مؤسسة كبيرة. والشخص الذي يكون قد عرف أنه لا يجيد اتخاذ القرارات، ينبغي أن يكون قد تعلّم كيف يقول لا لمهمّة تنطوي على اتخاذ القرارات. والجنرال باتون، كان يجب أن يكون قد تعلّم كيف يقول لا لمنصب القائد المستقل (وإن كان ربما لم يتعلّم ذلك بنفسه).
وثمّة أمر يوازي ذلك في الأهمية وهو أن معرفة أي شخص للإجابة عن هذه الأسئلة تمكّنه من أن يقول لأي جهة تمنحه فرصة، أو عرضاً، أو مهمّة: "نعم. سوف أقوم بهذا العمل. ولكن هذه هي الطريقة التي سأنجزه بها. وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينظّم بها. وهذه هي الطريقة التي يجب أن تسير العلاقات وفقها. وهذه هي النتائج التي يجب أن تتوقعوها مني، وبهذا الشكل، لأن هذا هو أنا."
ما يقوم به المرء بشكل جيّد – بل حتى بشكل جيّد جدّاً وبنجاح – قد لا يتناسب مع منظومة قيمه
ليست مسارات الحياة المهنية الناجحة أمراً مخططاً له سلفاً. وإنما تتطوّر عندما يكون الناس جاهزين لتلقّف الفرص لأنهم يعلمون ما هي نقاط قوّتهم، وطريقتهم في العمل، وقيمهم. فمعرفة المرء إلى أين ينتمي يمكن أن تحوّل شخصاً عادياً – يعمل بجد ويقوم بمتطلبات عمله ولكنه متوسط الكفاءة – إلى شخص متفوّق في الأداء.
ما الذي يجب أن أقدّمه؟
لم يكن غالبية البشر، عبر التاريخ، مضطّرين أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي: "ما الذي يجب أن أقدّمه؟" فقد كان يُقال لهم ماذا يجب أن يقدّموا، وكان الذي يملي عليهم مهامهم هو العمل– كحال الفلاح والحرفي – أو السيّد والسيّدة– كحال خدم المنازل. وإلى عهد قريب جدّاً، كان من المسلّم به أن معظم الناس تابعون يفعلون ما يؤمرون به. وحتى في الخمسينات والستينات، كان العاملون في حقل المعرفة الجديد (من يُسمّون "المنصاعين للمؤسسة") يتطلعون إلى قسم شؤون الموظفين في الشركة كي يخطط لهم حياتهم المهنية.
ثمّ في أواخر عقد الستينيات، لم يعد أحد يريد أن يُؤمر بما يجب أن يفعله. وبدأ الشبّان والشابات في طرح السؤال التالي: "ما الذي أريد أنا أن أفعله؟" وكانت الإجابة هي أنه لكي تقدموا إسهاماتكم "افعلوا ما يحلو لكم"، لكن هذا الحل كان خاطئاً بقدر ما كان سلوك "الموظفين المنصاعين للمؤسسة" الذين ذكرتهم قبل قليل. فقلّة قليلة من الأشخاص الذين اعتقدوا بأن فعل المرء ما يحلو له سيقوده إلى تقديم الإسهامات، وإلى تحقيق الذات، وإلى النجاح، قد تمكنوا من تحقيق أيّ من هذه الأشياء الثلاثة.
ومع ذلك، فليس هناك من رجوع إلى الإجابة القديمة التي تنصّ على أن تفعل ما أُملي عليك أو كُلّفت به. ويتعيّن على العاملين في حقل المعرفة تحديداً أن يتعلّموا طرح سؤال لم يُطرح من قبل وهو: "ما هو الإسهام الذي يجب أن أقدّمه؟" وللإجابة عن هذا السؤال، ينبغي عليهم التعامل مع ثلاثة عناصر مميّزة: أولاً ما الذي يتطلّبه الوضع؟ ثانياً، في ضوء نقاط قوّتي وطريقتي في الإنجاز وقيمي، كيف يمكنني تقديم مساهمة كبرى لإنجاز ما ينبغي إنجازه؟ وأخيراً، ما هي النتائج التي يجب تحقيقها لإحداث الفرق؟
ولنأخذ تجربة مدير إداري عُيِّن حديثاً في أحد المستشفيات. كان المستشفى كبيراً ومرموقاً، لكنه كان يتّكل على سمعة تزيد على 30 عاماً. وقد قرّر هذا المدير الإداري الجديد أن يكون إسهامه من خلال إنشاء معيار للتميّز في أحد المجالات الهامّة خلال عامين. وقد اختار التركيز على غرفة الإسعاف، التي كانت كبيرة ومكشوفة وتفتقر إلى النظافة. وقرر وجوب أن يخضع كل مريض يدخل غرفة الإسعاف للفحص على يدي ممرّض متخصّص خلال 60 ثانية. وبعد 12 شهراً، باتت غرفة الطوارئ في المستشفى نموذجاً يُحتذى لجميع المستشفيات في الولايات المتّحدة الأميركية، وخلال عامين لاحقين، كان المستشفى برمّته قد شهد تحوّلاً جذرياً.
يكمن السر الأول في الفعالية في فهم الناس الذين تعمل معهم، بحيث تكون قادراً على الاستفادة من نقاط قوّتهم.
كما يشير هذا المثال، من النادر أن يكون ممكناً – أو حتى مثمراً – التطلّع إلى المدى البعيد جدّاً. فأي خطّة لا يمكن أن تغطّي أكثر من 18 شهراً وتظل مع ذلك واضحة ومحدّدة بشكل معقول. لذلك فإن السؤال في معظم الحالات يجب أن يكون: أين وكيف يمكنني أن أحقق النتائج التي ستحدث فرقاً مهمّاً خلال السنة ونصف السنة القادمين؟ ويتعيّن على الإجابة أن توازن بين أشياء عدّة. أولاً، يجب أن تكون النتائج صعبة التحقيق – يجب أن "يتمطط" المرء للوصول إليها، إذا أردنا استعمال الكلمة الطنّانة هذه الأيام في التمرينات الرياضية. لكن هذه النتائج يجب أن تكون أيضاً في متناول اليد. فالتطلع إلى نتائج لا يمكن تحقيقها – أو يحتاج تحقيقها إلى الوقوع تحت ظروف صعبة جداً، لا يسمى طموحاً، بل ضرباً من الحماقة. ثانياً، يجب أن النتائج تكون ذات مغزى. ويجب أن تُحدث فرقاً. أخيراً، يجب أن تكون النتائج ظاهرة وقابلة للقياس، إن كان ذلك ممكناً. وإليكم المسار الذي يجب أن تتّخذه الأمور: ما يجب فعله، وأين وكيف تكون البداية، وما هي الأهداف والمهل النهائية التي يجب أن تحدّد.
المسؤولية عن العلاقات مع الآخرين
قلّة من الناس فقط يعملون بمفردهم ويحققون نتائج بمفردهم- عدد قليل من الفنانين الكبار، وعدد قليل من العلماء الكبار، وعدد قليل من الرياضيين الكبار- أمّا معظم الناس فإنهم يعملون مع الآخرين، وهم فعّالون عندما يكونون مع الآخرين. ويصحّ هذا الأمر سواء كانوا أعضاء في مؤسسة أو يعملون لحسابهم الخاص. فإدارتك لنفسك تتطلّب منك تحمّل المسؤولية عن العلاقات مع الآخرين. ولهذا الأمر شقّان:
الشق الأول هو قبول الحقيقة القائلة أن الأشخاص الآخرين، هم أيضاً أفراد مستقلون، مثلك تماماً. وهم يصرّون بعناد على التصرّف كبشر. وهذا يعني بأنهم هم أيضاً لديهم نقاط قوّتهم، وطرقهم في إنجاز العمل، وقيمهم. ولكي تكون فعّالاً فإنك يجب أن تعرف نقاط قوّة زملائك في العمل، وأسلوبهم في الأداء، وقيمهم.
قد يبدو ذلك واضحاً وجلياً، لكن قلّة من الناس فقط تولي هذا الأمر اهتماماً. فمن الشائع أن نرى شخصاً دُرِّب على كتابة التقارير في وظيفته الأولى لأن مديره في تلك الوظيفة كان قارئاً. وحتى لو كان المدير التالي مُستمعاً، فإن ذلك الشخص يواصل كتابة التقارير التي لا توصل أبداً إلى أية نتيجة. وسيظل المدير الجديد يعتقد أن هذا الموظف غبي، وعديم الكفاءة، وكسول، وأنه فاشل لا محالة. ولكن كان بالإمكان تحاشي هذا الأمر فقط لو أن الموظف قد راقب هذا المدير وحلّل أداءه.
فالمدراء ليسوا لقباً في مخطط المؤسسة أو "وظيفة محددة." بل هم أفراد ولهم الحق في أن ينجزوا عملهم بالطريقة التي يرون أنها تساعدهم على الأداء الأفضل. ويقع على عاتق الأشخاص الذين يعملون معهم أن يراقبوهم، وأن يكتشفوا طريقتهم في العمل، ويكيّفوا أنفسهم مع ما يجعل مدراءهم في أقصى درجات الفاعلية. وهذا، فعلياً، هو السر في كيفية "إدارة" المدير.
ويصحّ الأمر ذاته على جميع زملائك في العمل. فلكل عامل طريقته هو وليس طريقتك أنت. ولكل إنسان الحق في العمل بالطريقة التي يرتئيها. وما يهمّ هو إذا كان الشخص يعمل أم لا، وما هي القيم التي يحملها. أمّا بالنسبة للطريقة التي يعمل بها، فكل واحد على الأغلب سيعمل بطريقة مختلفة. ويكمن السر الأول في الفعالية في فهم الناس الذين تعمل معهم وتعتمد عليهم، بحيث تكون قادراً على الاستفادة من نقاط قوّتهم، وطرقهم في العمل، وقيمهم. فعلاقات العمل تعتمد على الأشخاص بقدر اعتمادها على العمل.
أمّا الجزء الثاني من المسؤولية عن العلاقة فيتعلّق بتحمّل مسؤولية التواصل. فكلّما بدأت أنا، أو أي استشاري آخر، في العمل مع مؤسسة، فإن أول شيء أسمع عنه هو النزاعات الناجمة عن الاختلاف في الطباع الشخصية. ومعظم هذه النزاعات تنشأ لأن الناس لا يعلمون ما الذي يقوم به الآخرون وكيف ينجزون عملهم، أو ما هي الإسهامات التي يركّزون عليها وما النتائج التي يتوقعونها. وسبب عدم معرفتهم بهذه الأمورهو أنهم لم يسألوا، ولم يُخبرهم، بالتالي، أحد.
هذا الفشل في طرح السؤال لا ينمّ عن غباء بشري بقدر ما يعكس تاريخاً بشرياً. فحتى عهد قريب، لم يكن من الضروري أن نخبر أحداً بأي من هذه الأشياء. ففي مدينة من العصور الوسطى، كان الجميع في منطقة معينة يمارسون العمل ذاته. وفي الريف، كان جميع من يعيشون في أحد الوديان يزرعون المحصول ذاته حالما يذوب الصقيع عن وجه الأرض. وحتى الأشخاص القلائل الذين كانوا يقومون بأشياء لم تكن "شائعة"، كانوا يعملون بمفردهم، لذلك لم يكن يتعيّن عليهم إخبار أي إنسان بما كانوا يقومون به.
أمّا اليوم، فإن الغالبية العظمى من البشر يعملون مع أشخاص آخرين لديهم مهام ومسؤوليات مختلفة. فلربما تكون نائبة الرئيس لشؤون التسويق قد جاءت من قسم المبيعات وتعرف كل شيء عن المبيعات، لكنها لا تعلم شيئاً عن الأمور التي لم تقم بها البتّة – مثل تحديد الأسعار، والإعلان، والتعبئة والتغليف، وما شابه. وبالتالي فإن الأشخاص الذين يقومون بهذه الوظائف يجب أن يضمنوا فهم نائبة الرئيس لشؤون التسويق لما يقومون به، ولماذا يقومون به، وكيف سيقومون به، وما هي النتائج التي يجب توقعها.
فإذا لم تكن نائبة الرئيس لشؤون التسويق تفهم ما الذي يقوم به هؤلاء الخبراء من ذوي الخبرات العالية، فإن ذلك هو ذنبهم بالأساس وليس ذنبها هي. فهم لم يطلعوها على هذه الأشياء. وفي المقابل، تقع على عاتق نائبة الرئيس لشؤون التسويق مسؤولية ضمان فهم جميع زملائها لنظرتها إلى التسويق: ما هي أهدافها، وكيف تعمل، وما الذي تتوقعه من نفسها ومن كل واحد منهم.
وحتى الأشخاص الذين يتفهّمون أهمية تولّي زمام المسؤولية عن العلاقات مع الآخرين، غالباً ما لا يتواصلون كفاية مع زملائهم. فهم يخشون بأن يُنظر إليهم على أنهم مغرورون، أو حشريون، أو أغبياء. وهم مخطئون في ذلك. فكلّما ذهب شخص إلى زملائه وقال لهم: "هذا ما أبرع فيه. وهذه هي الطريقة التي أعمل بها. وهذه هي القيم التي أؤمن بها. وهذا هو إسهامي الذي أنوي التركيز عليه والنتائج التي أتوقّع إنجازها"، فإن الإجابة ستكون دائماً: "هذا مفيد للغاية. ولكن لماذا لم تخبرنا بهذه الأمور من قبل؟"
وسيحصل المرء على رد الفعل ذاته – ودون استثناء، بحسب تجربتي – إذا واصل كلامه بطرح السؤال التالي: "وما الذي أحتاج أنا إلى معرفته عن نقاط قوّتك، وكيفية تأديتك لعملك، وقيمك التي تؤمن بها، وإسهاماتك المقترحة؟" في الحقيقية، يتعيّن على العاملين في حقل المعرفة أن يطرحوا هذه الأسئلة على جميع الأشخاص الذين يعلمون معهم، سواء أكانوا مرؤوسين، أو رؤساء، أو زملاء، أو أعضاء في الفريق ذاته. ومجدّداً، وكلّما حصل هذا الأمر، فإن رد الفعل سيكون دائماً على النحو التالي: "شكراً لأنك سألتني. لكن لماذا لم تسألني من قبل؟"
لم تعد المؤسسات قائمة على القوّة وإنما على الثقة. ووجود الثقة بين الناس لا يعني بالضرورة بأنهم يحبّون بعضهم البعض. وإنما ذلك يعني بأنهم يفهمون بعضهم البعض. وبالتالي فإن تولّي زمام المسؤولية عن العلاقات مع الآخرين هو ضرورة مطلقة. هذا واجب. وسواء كان المرء عضواً في المؤسسة، أو استشارياً، أو مورّداً، أو موزّعاً، فإنه مدين بتحمّل المسؤولية عن العلاقة مع جميع زملائه في العمل: سواء كان عمله يتعلّق بهم أو كان عملهم يتعلّق به.
النصف الثاني من حياتك
عندما كان العمل بالنسبة لمعظم الناس يعني العمل اليدوي، لم تكن هناك حاجة لأن تشعر بالقلق تجاه النصف الثاني من حياتك. فقد كنت ببساطة تواصل القيام بالعمل الذي كنت تعمل به طوال حياتك. وإذا كنت محظوظاً بما يكفي كي تنجو بعد 40 عاماً من العمل الشاق في مطحنة أو في مد قضبان السكك الحديدية، فإنك كنت ستشعر بالسعادة في قضاء بقيّة حياتك دون فعل أي شيء. أمّا اليوم، فإن معظم الأعمال هي أعمال في حقل المعرفة، والعاملون في حقل المعرفة، لا "ينتهون" بعد 40 عاماً قضوها في العمل، بل يشعرون بالملل.
نسمع الكثير من الأحاديث حول أزمة منتصف العمر في أوساط المدراء التنفيذيين. والأمر بمعظمه ملل وسأم. ففي سن الخامسة والأربعين، يكون معظم المدراء التنفيذيين قد وصلوا إلى ذروة حياتهم المهنية، وهم يدركون ذلك. وبعد 20 عاماً من ممارسة العمل ذاته تقريباً، يصبحون بارعين في أداء عملهم، لكنهم لا يشعرون بأنهم يتعلّمون، أو يقدّمون إسهاماً، أو يستمدّون التحدّي والرضى من عملهم. ومع ذلك فإن أمامهم على الأغلب 20 أو 25 سنة أخرى من العمل. وهذا هو السبب الذي يجعل إدارة تقود المرء على نحو متزايد إلى البدء بحياة مهنية ثانية.
ثمّة شرطاً مُسبقاً واحداً لإدارة النصف الثاني من حياتك: يجب أن تبدأ قبل فترة طويلة من دخولك فيه.
وثمّة طرق ثلاث لتطوير حياة مهنية ثانية. الطريقة الأولى هي أن تبدأ فعلياً بحياة مهنية ثانية. ولا يحتاج هذا الأمر غالباً سوى إلى الانتقال من نوع من المؤسسات إلى نوع آخر: كأن ينتقل المراقب المالي في أحد أقسام مؤسسة كبيرة، مثلاً، ليصبح مراقباً مالياً في مستشفى متوسّط الحجم. لكن هناك أعداداً متزايدة أيضاً من الناس الذين يغيّرون مجالهم المهني بالكامل: مثل المدير التنفيذي أو المسؤول الحكومي الذي يدخل الوزارة في سن الخامسة والأربعين، مثلاً؛ أو المدير الذي يشغل منصباً في الإدارة الوسطى ويغادر حياة الشركات بعد 20 عاماً ليدرس في كلية الحقوق ويصبح محامياً في مدينة صغيرة.
وسوى نرى أعداداً أكبر من الناس الذين حققوا نجاحات متواضعة في وظائفهم الأولى يبدؤون حياتهم المهنية في وظائف ثانية. وهؤلاء الناس يمتلكون مهارات هائلة، ويعلمون كيف يعملون. إنهم بحاجة إلى إلى الاجتماع مع الآخرين – فالبيت أصبح خاوياً بعد أن غادره الأولاد – وهم بحاجة إلى الدخل أيضاً. لكنهم أولاً وقبل كل شيء محتاجون إلى التحدّي.
أمّا الطريقة الثانية في التهيئة للنصف الثاني من حياتك فتتمثّل في تطوير حياة مهنية موازية. يستمرّ العديد من الأشخاص الناجحين جدّاً في حياتهم المهنية الأولى في العمل الذي يمارسونه منذ زمن بعيد، إما بدوام كامل أو بدوام جزئي أو بصفة استشاري. ولكنهم، إضافة إلى ذلك، يخلقون وظيفة موازية، تكون عادة في منظمة لا تتوخّى الربح، تحتاج منهم إلى 10 ساعات عمل أسبوعياً. وقد يتولّون مثلاً إدارة شؤون الكنيسة في منطقتهم، أو رئاسة مجلس الفريق الكشفي المحلي للبنات. أو قد يتولّون إدارة مأوى النساء المعنّفات، أو ربما يعملون كأمناء لمكتبات الأطفال في المكتبة المحلية العامّة، أو يشغلون منصباً في مجلس إدارة المدرسة، وهلمّ جراً.
أخيراً، هناك روّاد الأعمال الاجتماعية. وهم عادة أناس سبق لهم النجاح في حياتهم المهنية الأولى، فهم يحبّون عملهم، لكنه لم يعد يشعرهم بالتحدي. وفي العديد من الحالات، يواصلون ممارسة العمل نفسه لكنهم يختزلون شيئاً فشيئاً ما يمضونه من وقت فيه. كما أنهم يبدؤون نشاطاً آخر، يكون عادة من النوع الذي لا يتوخّى الربح. فقد بنى صديقي بوب بوفورد، مثلاً، شركة تلفزيونية ناجحة للغاية لازال يديرها حتى اليوم. لكنه أوجد أيضاً مؤسسة ناجحة لا تتوخّى الربح تعمل مع الكنائس البروتستانتية، وهو يبني مؤسسة أخرى لتعليم روّاد الأعمال الاجتماعية كيف يديرون مشاريعهم غير الربحية في ذات الوقت الذي يواصلون فيه إدارة أعمالهم الأساسية.
قد يظلّ الأشخاص الذين يديرون الجزء الثاني من حياتهم أقلّية على الدوام. أمّا الغالبية فإنهم قد "يتقاعدون وهم ما زالوا على رأس عملهم" ويعدّون السنين حتى يأتي يوم تقاعدهم الحقيقي. لكن هذه الأقلية المؤلفة من الرجال والنساء الذين يرون في "طول حياة العمل المتوقع" فرصة لهم ولمجتمعاتهم، هي من ستنجب الأشخاص الذين سيصبحون القادة والنماذج التي تُحتذى.
بيد أن ثمّة شرطاً مُسبقاً واحداً لإدارة النصف الثاني من حياتك: يجب أن تبدأ قبل فترة طويلة من دخولك فيه. فعندما بدأ يتّضح قبل 30 عاماً بأن طول حياة العمل المتوقع آخذ بالزيادة بوتيرة سريعة، أعتقد العديد من المراقبين (بمن فيهم أنا شخصياً) بأننا سنرى تزايداً في أعداد الأشخاص المتقاعدين الذين سيتطوّعون للعمل في المنظمات التي لا تتوخّى الربح. لكن ذلك لم يحصل. فإذا لم يبدأ المرء بالتطوّع قبل أن يبلغ الأربعين من العمر أو نحوه، فإنه لن يتطوّع بعد أن يكون قد تجاوز الستين.
وبصورة مشابهة، فإن كل روّاد الأعمال الاجتماعيين الذين أعرفهم بدأوا العمل في مشاريعهم الثانية التي اختاروها لأنفسهم قبل فترة طويلة من وصولهم إلى الذروة في عملهم الأصلي. ولنأخذ المثال التالي لمحامٍ ناجح، والذي عمل مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات الكبيرة. فقد أسس مشروعاً لإنشاء مدارس نموذجية في ولايته. وقد بدأ بممارسة الأعمال القانونية التطوّعية لصالح إحدى المدارس عندما كان بعمر الخامسة والثلاثين تقريباً. وقد انتخب لعضوية مجلس إدارة المدرسة في سن الأربعين. وعندما بلغ الخمسين، وكان قد جمع ثروة كبيرة، أطلق مشروعه الخاص لبناء مدارس نموذجية وإدارتها. بيد أنّه لازال يعمل وبدوام شبه كامل ككبير للمستشارين القانونيين في الشركة التي ساعد في تأسيسها عندما كان محامياً شاباً.
وثمّة سبب آخر لتطوير اهتمام رئيسي ثانٍ، لا بل تطويره مبكّراً. فلا أحد يمكنه أن يتوقّع عيش فترة طويلة دون المرور بنكسة خطيرة في حياته أو عمله. فهناك المهندس الكفء الذي يفوته قطار الترقية بعمر الخامسة والأربعين. وهناك الأستاذة الجامعية الكفوءة التي تدرك في سن الثانية والأربعين بأنها لن تحظى بفرصة التدريس في جامعة كبيرة، رغم أنها قد تكون مؤهلة بالكامل لتلك المهمّة. وهناك احتمال حصول مآسٍ في حياة الإنسان: كأن تنهار حياة المرء الزوجية أو أن يخسر أحد أطفاله. في تلك الأوقات، قد يُحدث الاهتمام الرئيسي الثاني – وليس مجرّد الهواية –فرقاً كبيراً في حياة ذلك الإنسان. فذلك المهندس مثلاً يعلم الآن بأنه لم يمكن ناجحاً جدّاً في وظيفته، لكنه في نشاطه الخارجي –كأمين للصندوق في الكنيسة- ناجح جداً. وقد تنهار حياة المرء العائلية، لكن ذلك النشاط الخارجي قد يمنحه الصلات الاجتماعية التي يحتاجها.
وفي مجتمع بات فيه النجاح أمراً في غاية الأهمية، ستتزايد ضرورة امتلاك الإنسان للخيارات. فعلى مرّ التاريخ، لم يكن هناك شيء اسمه "النجاح." لأن الغالبية الساحقة من الناس لم تكن تنتظر أي شيء غير البقاء "في المحطة المناسبة" التي وصلت إليها. والتحرك الوحيد كان نحو الأسفل.
أمّا في مجتمع المعرفة، فإننا نتوقّع بأن يكون الجميع ناجحاً. وهذا ضرب من المستحيل. فبالنسبة لغالبية البشر، هناك في أفضل الأحوال غياب للفشل. فحيثما وُجِدَ النجاح، يجب أن يكون هناك فشل. ثمّ إنه من الضرورة بمكان بالنسبة لأي فرد، ولعائلته أيضاً، أن يكون لديه مجال حيث يمكنه تقديم إسهاماته، وإحداث فرق، وإحراز مكانة. هذا يعني إيجاد مجال ثانٍ – سواء في مهنة ثانية، أو في مهنة موازية، أو في منظمة اجتماعية – يمنح الفرصة للمرء لكي يكون قائداً، ويحظى بالاحترام، ويكون ناجحاً.
قد تبدو تحدّيات إدارة المرء لذاته واضحة، إن لم تكن بسيطة. وقد تبدو الإجابات بديهية إلى حدٍّ تظهر معها وكأنها ساذجة. لكن إدارة المرء لذاته تتطلّب منه أشياء جديدة وغير مسبوقة، وتحديداً من العامل في حقل المعرفة. إذ تحتاج إدارة الذات من كل عامل في حقل المعرفة أن يفكّر وأن يتصرّف وكأنه رئيس تنفيذي. وعلاوة على ذلك، فإن التحوّل من العمّال اليدويين الذين يفعلون ما يؤمرون به إلى العاملين في حقل المعرفة الذين يتعيّن عليهم إدارة ذاتهم، يُحدث تحوّلاً عميقاً في البنية الاجتماعية. فكل مجتمع قائم، بما فيها أكثر المجتمعات فردانية، يسلّم بأمرين اثنين، وإن بطريقة لاواعية: الأمر الأول هو أن المؤسسات تبقى لفترات أطول من فترات حياة العمّال، والأمر الثاني هو أن معظم الناس يظلون ساكنين في مواقعهم.
أمّا اليوم فإن العكس هو الصحيح. فالعاملون في حقل المعرفة يعيشون أكثر من المؤسسات، كما أنهم يتحرّكون. فالحاجة إلى إدارة الذات تخلق إذن ثورة في الشؤون الإنسانية.