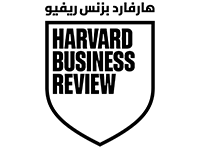ما مفهوم نظرية الوكالة؟
نظرية الوكالة (Agency Theory): نظرية خاصة بالعلاقات التعاقدية صاغها الباحثان "جنسن" (Jensen) و"ميكلنج" (Meckling) عام 1976، وتُعرّف الوكالة على أنها "عقد يستخدم فيه شخص طبيعي أو معنوي (أو أكثر من شخص واحد)، يُسمى المفوِّض أو الموكِّل، خدمات شخص آخر يُسمى الوكيل، لأداء مهمة معينة باسمه، مما يعني تفويض اتخاذ القرار إلى الوكيل".
هناك العديد من العلاقات في الشركة التي تدخل ضمن الوكالات مثل العلاقات القائمة بين الموظفين وصاحب العمل، والموردين والشركة، والمساهمين والرئيس التنفيذي.
التكاليف الناتجة عن العلاقات التعاقدية
يترتب على أي علاقات بالوكالة مجموعة من التكاليف ناتجة عن عوامل مثل حالة عدم اليقين، و"السلوك الانتهازي" (Opportunism)، و"الرشادة المحدودة" (Bounded Rationality)، وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
- تكاليف المراقبة: تتحملها الشركة نتيجة للرقابة التي يفرضها المدراء من أجل الحد من السلوك الانتهازي؛
- تكاليف الحوافز: تشمل توزيع عدد من الأسهم على المدراء من أجل إشراكهم في اهتمامات المُلاك؛
- تكاليف الفرصة البديلة: تتحملها الشركة نتيجة للخسارة الناجمة عن تباين مصالحها مع مصالح الوكيل.
لذلك، تكون الشركة "فاعلة" (Efficient) عندما تخفّض هذه التكاليف أكبر قدر ممكن وتحدّ من مخاطر الانتهازية في سلوك الوكيل، أي أنّ الشركة يُنظر لها كمجموعة من العلاقات التعاقدية حسب هذه النظرية.
أهمية نظرية الوكالة
تستمد نظرية الوكالة أهميتها من أنها تشرح العلاقة بين الموكِّل والوكيل وتساعد على حل المشكلات التي قد تنشأ بينهما بسبب تضارب المصالح.
مشكلات نظرية الوكالة
يختلف الوكيل والموكل في الرأي والأولويات والمصالح، وتنشأ هذه الاخلافات عن الاختلاف في الأهداف أو الاختلاف في مستوى تحمل المخاطرة.
على سبيل المثال؛ قد يركز المدراء في الشركات على تحقيق أرباح في الوقت الحالي دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج على المدى الطويل، على الرغم من أن مسهمي الشركة يولون اهتماماً إلى استمرار الشركة في تحقيق الأرباح على المدى الطويل.
ومن الأمثلة الأخرى على الوكالة علاقة المخططين الماليين ومدراء المحافظ مع عملائهم، وعلاقة المستأجر مع المؤجر إذ يكون المستأجر مسؤولاً عن حماية الأصول التي لا تنتمي إليه.
حلول نظرية الوكالة
من الحلول المقترحة لحل المشكلات الناتجة من الوكالة التحلي بالشفافية ووضع بعض القيود على الوكالة والتي تحد من صلاحية الوكيل في بعض الأمور، وتقديم الحوافز والمكافآت.
وعلى الرغم من أن الحوافز والمكافآت طريقة جيدة لتقليل الخلافات؛ إلا أنه قد ينشأ بسببها مشكلة تتمثل في أن المدراء قد يسعون إلى تحقيق أرباح من أجل الحصول على المكافآت دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج على المدى الطويل.
وبشكل عام، من البديهي أن تختلف كل علاقة وكالة عن الأخرى لذلك من الضروري الأخذ بعين الاعتبار اختيار أفضل الطرائق المناسبة لكل حالة محددة لضمان علاقة إيجابية وصحية.
اقرأ أيضاً: