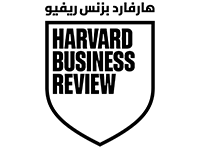كانت رئيسة أحد الأقسام في شركة لتجارة التجزئة عملتُ لصالحها، ولنسمها جودي، معرّضة للفصل من عملها، والغريب أنها كانت من أصحاب الأداء المتميز. وقدمت لعلامة الشركة التجارية في سنة واحدة أكثر ممّا قدمه أسلافها في 5 سنوات.
اللا مبالاة
كانت المشكلة أن العمل معها صعب؛ عملت بجدّ أكثر مما تتحمله طاقة البشر وكانت تتوقع المثل من الآخرين، وغالباً ما كانت تفقد أعصابها عندما لا يبذلون الجهد الجبار نفسه الذي بذلته. وكانت تميل إلى التنافس في العمل وبسط سيادتها على منطقة عملها، وتحرص على أن تكون لها الكلمة الفصل في كل القرارات المتخذة عن بعد والمتعلقة بعلامتها التجارية حتى عندما يكون لأقرانها صلاحية اتخاذ القرار من الناحية الفنية. لم تحسن الإصغاء إلى الآخرين أو منحهم صلاحيات إضافية أو مساعدتهم على الثقة بقدراتهم أو فرقهم. وعلى الرغم من عملها طوال الوقت، كانت الأمور تخرج عن نطاق سيطرتها.
لكن لم تكن أيّ من هذه المشكلات سبب تعرّضها لخطر الفصل من العمل؛ كانت مشكلتها الحقيقية هي عدم وعيها بوجود مشكلة أصلاً.
فطُلب منّي العمل معها، وكانت خطوتي الأولى تتمثل في إجراء مقابلات شخصية مع جميع من عملت معهم لأفهم الموقف وأنقل لها وجهات نظرهم.
وعندما فعلت ذلك ونقلت إليها ملاحظاتهم فاجأني ردّها: "لم أكن أعتقد أن الأمر بهذا السوء، لكنه لم يفاجئني". سألتها: لماذا؟
فأجابت: "هذه هي الملاحظات نفسها التي تلقيتها في الشركة السابقة التي كنت أعمل فيها، ولهذا غادرتها".
ربما تعترينا الرغبة في الضحك على لا مبالاة جودي وعدم رغبتها في تأمل إخفاقاتها وتكرارها بالتالي. لكنه سيكون مجرد ضحك عصبي، لأن العديد منّا، وأنا شخصياً، نفعل الشيء نفسه.
كثيراً ما يدهشني عدد المرات التي أرتكب فيها الخطأ قبل أن أكتشفه. أؤمن أن أغلبنا يزداد ذكاء مع التقدم في السن، لكننا مع ذلك غالباً ما نكرر الأخطاء نفسها، وفي المقابل كثيراً ما ننجح في إنجاز مهام أخرى ثم نفشل في تكرارها، وهو أمر لا يدعو أيضاً إلى الارتياح.
ثمة سبب بسيط لذلك: نادراً ما نأخذ الوقت اللازم للتمعن فيما ننجح في إنجازه وما لا ننجح فيه، لأن لدينا الكثير من العمل وليس لدينا أيّ وقت للتفكير.
سُئلت ذات مرة: إذا كان بإمكان مؤسسة معينة أن تعلّم موظفيها مسألة واحدة، فما المسألة التي يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر؟ كان جوابي فورياً وواضحاً: تعليم الموظفين كيفية التعلّم، أي تأملُ تصرفاتهم السابقة واكتشاف السلوكيات التي كانت مفيدة وتكرارها، مع الاعتراف الصادق بالتصرفات التي لم تكن مفيدة ثم تغييرها.
وإذا نجح أيّ موظف في فعل ذلك، فكل ما بقي سيكون على ما يُرام. هكذا يصبح الناس متعلّمين مدى الحياة، وهكذا تصبح الشركات مؤسسات تعليمية. يتطلب ذلك الثقة والانفتاح والتخلي عن التحفظ تجاه الملاحظات، ولا يتطلب الكثير من الوقت،
بضع دقائق للتفكير
بل بضع دقائق فقط، نحو 5 دقائق في الواقع. وقفة قصيرة في نهاية اليوم للتفكير فيما كان مجدياً وما لم يجدِ نفعاً.
إليك ما أقترحه:
خصص كل يوم 5 دقائق قبل مغادرة العمل للتفكير فيما حدث ذلك اليوم. انظر إلى جدول مواعيدك وقارن بين ما حدث في أثناء اليوم، كالاجتماعات التي حضرتها والعمل الذي أنجزته والمحادثات التي أجريتها والأشخاص الذين تفاعلت معهم، بل حتى الاستراحات التي أخذتها، مع مخططك الذي كنت تعتزم تنفيذه. ثم اسأل نفسك 3 مجموعات من الأسئلة:
- كيف مضى يومي؟ ما النجاح الذي حققته؟ ما الصعوبات التي واجهتها؟
- ما الذي تعلمته في ذلك اليوم؟ ماذا تعلمت عن نفسي؟ وماذا تعلمت عن الآخرين؟ ما الذي أخطط لإنجازه على نحو مختلف أو مشابه في الغد؟
- مع مَن تفاعلت؟ مَن يجب عليّ إخباره بالمستجدات؟ مَن يجب عليّ شكره؟ مَن يجب عليّ طرح سؤال عليه؟ مَن يجب عليّ تقديم ملاحظة له؟
هذه المجموعة الأخيرة من الأسئلة لها قيمة بالغة في الحفاظ على العلاقات وتطويرها، إذ يتطلب الأمر دقائق قليلة فقط لإرسال رسالة إلكترونية، أو 3 دقائق فقط للتعبير عن تقديرك للطف أحد زملائك، أو طرح سؤال على أحدهم أو إطلاع آخر على مستجدات مشروع ما.
وإذا لم نتوقف للتفكير في ذلك فقد نتجاهل هذه الأنواع من التواصل، وهذا ما نفعله في الغالب. لكن هذا التواصل ضروري في هذا العالم الذي نعتمد فيه على الآخرين لإنجاز أي شيء في حياتنا.
بعد عدة محادثات طويلة مع جودي، أدركَت فاعلية التريث بما يكفي للانتباه للآخرين من حولها، ورأت أنها تبذل جهداً كبيراً للغاية وتتحرك بسرعة كبيرة إلى درجة أنها على الرغم من نتائجها الجيدة تعمل ضد مصلحتها الشخصية، وتخاطر بوظيفتها، وتصعّب الأمور على الجميع.
وهكذا بدأت تتغير مع مرور الوقت بفضل انضباطها الكبير، وشيئاً فشيئاً بدأ زملاؤها يلاحظون ذلك. أدركتُ أن أمورها ستصبح على ما يرام عندما أرسلت إليها رسالة متوقعاً أن ترد عليها خلال بضعة أسابيع، أو ألّا ترد عليها مطلقاً، لكنها اتصلت بي في ذلك المساء نفسه.
قالت لي: "مرحباً بيتر، أردت فقط أن أخبرك أنني تلقيت اتصالك وأقدّر تواصلك معي. أنا ذاهبة مع أعضاء فريق العمل لتناول القهوة، سأحاول الاتصال بك مجدداً في غضون أيام".
وفعلَت ذلك بالتأكيد.