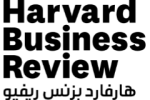مع استقالة أعداد قياسية من الناس من وظائفهم، تعاني جميع القطاعات الاقتصادية في ملء الشواغر الوظيفية. وفي مسعى من المؤسسات لإعادة الناس إلى العمل، أخذت تلجأ إلى تعديل سياساتها التي كانت متبعة منذ مدة طويلة، وتقديم حوافز غير مسبوقة.
شركات النقل، مثلاً، زادت من أجورها لاستقطاب سائقي الشاحنات المخصصة لرحلات المسافات الطويلة من جديد وإعادتهم إلى قمرات القيادة. وها هي المدارس العامة في كاليفورنيا تسمح للمعلمين المتقاعدين بالعودة إلى العمل دون الاضطرار إلى إعادة تجديد تراخيص مزاولة المهنة. كما أن الرؤساء التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين لشؤون الموارد البشرية يبذلون قصارى جهدهم لتوفير ترتيبات عمل بدوام مرن تكون أكثر جاذبية من العروض التي يقدّمها منافسوهم. لكن هذه المحاولات لا تنتبه إلى المشكلة الجوهرية.
الأمر ببساطة هو أن العمل لا يلبّي شروطنا. وهو كان كذلك قبل الجائحة، ويظل على هذه الحال الآن. فوفقاً للاستبيانات التي أجريتها أنا وزملائي في معهد إيه دي بي للأبحاث (أيه دي بي آر آي) (ADPRI)، لم تكن نسبة الأشخاص المتفاعلين بالكامل مع عملهم ضمن عيّنة الاستطلاع قبل الجائحة تزيد على 18%، في حين أن 17% منهم فقط كانوا يشعرون بمرونة عالية في العمل، فيما قال 16% إنهم يثقون بقياداتهم العليا وقائد فريقهم. وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أميركا قد قالت في 2018 إن 71% من البالغين كان لديهم عَرَض واحد على الأقل من أعراض التوتر في مكان العمل، مثل الصداع أو القلق أو الشعور بالإنهاك.
جاءت الجائحة لتفرض ضغوطاً إضافية وتزيد من شعورنا الحالي بالألم. وقد وصلت درجة التفاعل والمرونة في مكان العمل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث كانت قد تراجعت بمقدار نقطتين مئويتين خلال الجائحة. (قد يبدو هذا التغير طفيفاً، ولكن نظراً إلى الانخفاض الذي كان مسجلاً في هذه الأرقام بالأصل وفي ضوء حجم العيّنات، فإن لهذا الأمر دلالة إحصائية ودلالة عملية كبيرتين). وفي غضون ذلك، بلغت نسبة العمال الأميركيين الذين تركوا وظائفهم في عام 2021 الربع، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً.
إذا ما أردنا اجتذاب أفضل الموظفين واستبقاءهم، فيجب أن نُعيد تصميم الوظائف بحيث تتمحور حول مفهوم بسيط ولكن قوي ألا وهو حب مضمون العمل ذاته.
يشير ذلك إلى مشكلة لن تحلها زيادة الأجور أو تسهيل الارتقاء الوظيفي لوحدهما، رغم أن هذه الجهود تساعد بالتأكيد في تحسين جودة حياة الموظفين. نحن نعرف ذلك، لأنه في أحدث استبيان لمعهد أيه دي بي للأبحاث شمل 50 ألف شخص ينتمون إلى عيّنات عشوائية طبقية من الفئات العمالية في أنحاء العالم، لم تشمل المؤشرات الأقوى على استبقاء الموظفين، وأدائهم، ومستوى تفاعلهم، ومرونتهم، وشمولهم، لا الأجر، ولا حب الشخص لزملائه أو موقع عمله، ولا حتى وجود إيمان قوي برسالة المؤسسة. فقد وفّرت هذه الأشياء بعض التفسيرات، لكن أياً منها لم يكن بأهمية البنود الثلاثة التالية:
هل كنتُ سعيداً بالعمل كل يوم الأسبوع الماضي؟
هل أتيحت لي الفرصة لأستفيد من نقاط قوتي كل يوم؟
هل تسنح لي الفرصة في العمل لكي أفعل الأشياء التي أبرع فيها وبعض الأشياء التي أحبّها؟
تشير هذه النتائج، وأبحاث علوم الأعصاب، وعقود من الخبرة العملية التي أملكها في العمل مع الأفراد في المؤسسات، وبكل قوة إلى أن أي شركة لن تتمكن من تحقيق أداء أعلى، ومستويات تفاعل ومرونة أعلى، وتقلبات أقل في الموظفين إلا إذا ربطت بطريقة ذكية بين ما يحبّه الموظفون والأنشطة الفعلية.
فإذا ما أردنا السباحة عكس هذا التيار، واجتذاب أفضل الموظفين واستبقاءهم، فإننا يجب أن نُعيد تصميم الوظائف بحيث تتمحور حول مفهوم بسيط ولكن قوي ألا وهو حب مضمون العمل ذاته. قد تبدو كلمة “حب” في هذا السياق قوية، لكن تعلّق الناس بعملهم يمكن أن يرقى إلى هذا المستوى وهو يجب أن يبلغه أصلاً. وعندما يحصل ذلك، يمكن أن تحدث أشياء مذهلة.
إن بناء مكان عمل يساعد جميع الموظفين على حب عملهم يعني إدخال ثلاثة مبادئ إلى كل ما تفعله شركتكم: الموظفون هم الغاية الأساسية. فالموظفون، وليس الزبائن أو المساهمون، هم أصحاب المصلحة الأهم في مؤسستكم. كل موظف هو حالة فردية ويجب التعامل معه على هذا الأساس. فكل واحد من هؤلاء الموظفين هو شخص فريد من نوعه له أشياؤه الخاصة التي يحبّها، واهتماماته ومهاراته المميزة. نحن ننمو من خلال الثقة. لكي يكتشف الموظفون الأشياء التي يحبونها في العمل ولكي يجعلوا حبّهم هذا جزءاً من إسهاماتهم، يجب على القادة أن يرسخوا حالة صريحة من الثقة لتكون أساساً لجميع الممارسات والسياسات.
سوف نلقي نظرة على الأسلوب الذي بدأت تتّبعه الشركات الأكثر استشرافاً للمستقبل لتطبيق كل مبدأ من هذه المبادئ بدوره. ولكن دعونا في البداية نمحّص في سبب الأهمية الكبيرة للحب في مكان العمل وما الذي خسرته الشركات من خلال تجاهله.
فكرة المقالة باختصار
المشكلة
بلغت معدلات استقالات الموظفين من أعمالهم مستوى قياسياً غير مسبوق، بينما تسعى الشركات يائسة إلى ملء الشواغر الوظيفية وتحاول في سبيل ذلك تجريب كل ما بوسعها من رفع الأجور إلى تقديم رزم ومنافع تساير الاتجاهات الجديدة السائدة. لكن هذه الإجراءات لا تفي بالغرض – لأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الوظائف هي مصدر للتوتر، وعديمة المعنى، وعصية على الحب.
الحل
تحتاج الشركات إلى الاستفادة من المهارات وحالات الشغف الفريدة من نوعها الموجودة لدى كل شخص. وهذا يعني تحويل الموظفين إلى أصحاب المصلحة الأساسيين في المؤسسة، وتقليل أدوات إدارة الأداء التي تعتمد الأساليب المعيارية والقياسية إلى الحد الأدنى، والوثوق بالموظفين لكي ينجزوا أهدافهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.
المكسب
ليس من الضروري أن يحب الموظفون جميع جوانب عملهم، لكن الأبحاث تثبت أن وجود مقدار من الحب للعمل، ومهما كان ضئيلاً، له منافع كثيرة، ويسهم في التقليل من الاحتراق الوظيفي، ويساعد على زيادة تفاعل الموظفين. وقد تمكنت الشركات التي بدأت بتبنّي بعض المبادئ المذكورة في هذه المقالة من تحقيق تحسينات في معدلات استبقاء الموظفين والمستوى الإجمالي للأداء.
ما علاقة الحب بالموضوع؟
عندما تكون مُغرماً بشخص آخر، تتغير كيمياء دماغك. ونحن لا نعلم حتى الآن السبب الكيميائي الحيوي للحب الرومانسي، إذ يبدو أنه مزيج من هرمونات الأوكسيتوسين، والدوبامين، والنوربينفرين والفاسوبرسين. لكن الأبحاث تكشف أنك عندما تكون منخرطاً في نشاط تحبّه، فإن هذا المزيج ذاته من المركبات الكيماوية يكون حاضراً في دماغك – إلى جانب أنانداميد، الذي يتسبب لك بمشاعر المتعة والذهول.
فبتحريض من هذا المزيج، أنت تتفاعل مع العالم بطريقة مختلفة. إذ يشير بحث لعلماء البيولوجيا العصبية إلى أن “كيماويات الحب” هذه تقلل من وظيفة التنظيم التي تمارسها قشرتك الدماغية الجديدة، ما يوسّع نظرتك إلى نفسك، ويحرر ذهنك، ويسمح له بقبول أفكار ومشاعر جديدة. كما أنك تستقبل عواطف الناس الآخرين بكثافة أكبر وتحفظها. وتتذكر التفاصيل بقدر أكبر من الحيوية. وتؤدي المهام الذهنية بوتيرة أسرع وبشكل أفضل. أنت أكثر تفاؤلاً وإخلاصاً وتسامحاً، وأكثر انفتاحاً على المعلومات والتجارب الجديدة. يمكن القول إن فعلك لما تحبّه يجعلك أكثر فعالية، لكن الأمر أكثر من ذلك بكثير، حيث أنك تندفع بكامل طاقتك دون أن تُصاب بالاحتراق الوظيفي.
لذلك، إذا كنت تنجز عملاً تحبّه، فإن العمل لن يشكل مصدر توتر لك، بل سيكون مصدراً للطاقة والمرونة. في الحقيقة، تُظهِرُ بيانات معهد “أيه دي بي آر آي” أن الناس الذين يعثرون على الحب، والقوة، والمتعة، والإثارة فيما يفعلونه كل يوم أكثر ميلاً إلى أن يكونوا منتجين، وإلى البقاء في الشركة لفترة أطول بالمقارنة مع الآخرين، وإلى المحافظة على رباطة جأشهم في مواجهة التحديات اليومية التي تفرضها الحياة. لذلك، فإن العثور على الحب في العمل ليس ضرباً من النرجسية أو الميوعة، بل أساس الأداء الجيد ويعمل على تضخيمه.
ولكي نكون واضحين، فإن هذا الكلام لا يعني أن العمل يجب أن يتألف حصرياً مما تحب. فليس لدينا بيانات تثبت أن أكثر الناس إنتاجية وتفاعلاً في العمل يحبون كل ما يفعلونه. لكن مغزى الكلام هو أنه إذا أراد القادة أن يكون موظفوهم من أصحاب الأداء العالي، وأن يبقوا في المؤسسة، وأن يكونوا متفاعلين ومرنين، فيجب أن يبذلوا جهداً متعمداً لمساعدتهم على العثور على الحب في شيء مما يفعلونه، كل يوم.
ثمة بيانات من “مايو كلينيك” تعزز هذه النتيجة، إذ تشير إلى أن 20% هي عتبة مفيدة. فأبحاثها الخاصة بالاحتراق الوظيفي بين صفوف الأطباء والممرضين تشير إلى أنه إذا كان أقل من 20% من عملك يتألف من أشياء تحب فعلها، فإنك أكثر ميلاً بكثير إلى أن تشعر بالاحتراق الوظيفي من الناحيتين البدنية والنفسية. لكن اللافت جداً في الأمر هو أن حب أكثر من 20% لا يبدو أنه سيقود إلى زيادة كبيرة في المرونة. وبالتالي فإن قليلاً من الحب لما تفعله يؤدي إلى نتائج إيجابية كثيرة.
بالنسبة لكثيرين منا، ينطوي العثور حتى على هذا المستوى من الحب في عملنا على تحديات كبيرة. فثمة مدراء كثيرون ربما يشعرون بالتهيّب جرّاء اتّساع مدى المصادر التي يمكن للموظفين أن يعثروا على الحب منها، أو ربما هم لا يثقون بنوايا هؤلاء الموظفين، أو ربما يفترضون أن “أحداً لن يحب هذا العمل”، ولذلك فإنهم يصممون عملاً يفتقر إلى الحب، تُعرَّف فيه الوظيفة بخطوات قياسية ومعيارية أو بحسب المهارات المطلوبة، بينما يُقاس النجاح بمدى الالتزام الوثيق للموظفين بها. ويندرج العمل في مركز توزيع أو وظيفة سائق توصيل بضائع ضمن هذه الفئة.
ليس من المنصف أو الواقعي تكليف الموظفين الذين يواجهون وظائف من هذا النوع – ويحتاجون إلى كل قرش يكسبونه لإطعام أفراد عائلاتهم – بمهمة العثور على الحب فيما يفعلونه، وإن كان من الواضح بناء على عقود من الدراسات التي أجريتها وشملت جميع أشكال الوظائف أن الناس يستطيعون العثور على الحب في أماكن مفاجئة. فقد أجريت مقابلة مع عامل في مصنع كان يعشق التعرف على “شخصية” كل آلة من الآلات التي يعمل عليها والتدخل قبل أن “تختار” أي منها أن تتعطل مباشرة. وأجريت جلسات مع مجموعات مركزة من عمّال المناجم الذين كشفوا عن أشياء كثيرة ومتنوعة تثير شغفهم مثل حب الدقة المتناهية، والسعادة الغامرة التي تنتابهم جرّاء اكتشاف الطريقة التي تسمح لهم بالعمل لمدة مئة يوم دون أن تقع أي حادثة مهما كانت ثانوية تهدد السلامة، والانتماء ببساطة إلى فريق. كما أن العمل في مسلخ للحوم، أو قيادة شاحنة في رحلة لمسافة طويلة، أو تنظيف المنازل هي كلها وظائف تشمل طيفاً من الأنشطة المحددة بما يكفي لتكون المادة الخام لبعض الحب للعمل. وحقيقة أننا لم نصمم هذه الوظائف من منظار أشخاص لديهم خيارات أو حالات شغف محددة لا تعني أنه لا يوجد مجال للعثور على الحب فيها.
لذلك دعونا ننتقل إلى المؤسسات. فقد حان وقت البدء بتصميم الوظائف بطريقة تأخذ الحب بالحسبان. فلو أخذ القادة هذه البيانات على عاتقهم وتعاملوا معها من صميم قلوبهم وتعمدوا محاولة إنشاء مؤسسة تبتنى شعار “الحب + العمل”، وتضم نسبة مئوية أعلى من الموظفين الذين يحبّون عملهم الذي يؤدونه – حتى لو اقتصر الأمر على 20% من الوقت – فكيف سيمضون قدماً؟ سيضمنون أن تكون معنويات موظفيهم المتفاعلين والمرنين أعلى، وألا يكونوا مستنزفين في وظائفهم، وأن يقدّموا نتيجة لذلك خدمات ومنتجات أفضل إلى زبائنهم، ويتعهدون بالتزامات أكثر استدامة تجاه مجتمعاتهم. رغم أنني لا أعرف أي مؤسسة تتبنى شعار “الحب + العمل” وتجسّده تجسيداً كاملاً كأحد المثل التي تتبناها، إلا أن عدداً كبيراً منها قد بدأ يطبّق أجزاء من المبادئ الأساسية الثلاثة.
الموظفون هم الغاية الأساسية
المؤسسة التي تبتنى شعار “الحب + العمل” كشعار حقيقي هي مؤسسة تُبنى على أساس الاعتراف بالأهمية الجوهرية لكل شخص يأتي إلى العمل والالتزام بهذا الشيء. ويمثل ذلك موقفاً متقدماً على ما طرحه ميلتون فريدمان من مفهوم رأسمالية المساهمين، الذي ينص على أن الغاية الوحيدة للمؤسسة هي تحقيق أقصى قيمة ممكنة للمساهمين، وعلى ما طرحه جوزيف ستيغليتز عن مفهوم رأسمالية أصحاب المصلحة، الذي ينص على فكرة أن المؤسسات يجب أن تحقق أقصى قيمة ممكنة للزبائن، والموظفين، والمجتمع الأوسع عموماً.
ترى المؤسسة التي تتبنى شعار “الحب + العمل” في الموظفين النقطة التي يتقاطع عندها جميع أصحاب المصلحة، عوضاً عن أن تراهم أحد أصحاب المصلحة فقط. فهم في نهاية المطاف من ينجز العمل، و ينتج قيمة المنتجات أو ينتج القيمة التي يحصل عليها الزبائن. ويتطلب ذلك أن يُنظرَ إلى كل موظف على أنه إنسان كامل، وليس مجرد عزقة في آلة. وبالتحديد، المؤسسة التي تتبنى شعار “الحب + العمل” تفعل الأشياء التالية:
تعيّن بشراً وليس قوى عاملة. في المقاربة التي تُعطي أهمية أكبر للبشر في عملية إعداد الموظفين الجدد، تتبنى هذه الشركات آلية أكثر صرامة وتفصيلاً تشرح فيها سبب اختيار كل مرشح، ونقاط القوة الموجودة لدى كل شخص، والأشياء التي يحبها، بما في ذلك كيف يمكن لهذه العناصر أن تضيف القيمة إلى الرسالة الإجمالية للمؤسسة، بل وما يتجاوز هذه القيمة حتى.
“لولوليمون” (Lululemon) هي شركة رائدة في هذا المجال. فأثناء عملية إعداد الموظفين الجدد في الشركة، يتلقى هؤلاء الأشخاص التشجيع لكي يحددوا أهدافهم المهنية والشخصية. وثمة احتفاء بجميع الموظفين وعلى قدم المساواة، سواء أراد أحدهم أن يصبح الرئيس التنفيذي للشركة، أو أن يطلق علامته التجارية الخاصة به في عالم الأزياء في المستقبل. ويساعد تركيز “لولوليمون” هذا على الطموحات الفريدة من نوعها خلال مرحلة إعداد الموظفين الجدد على تسجيل الشركة لمستويات أعلى في استبقاء الموظفين لمدة تسعين يوماً، وفي تفاعل الموظفين خلال العام الأول، حيث بلغت هذه المستويات ضعف المعدلات الوسطية المسجّلة في القطاع.
تلتزم بالتعلم مدى الحياة. تستثمر المؤسسة التي تتبنى شعار “الحب + العمل” في التعليم المتواصل لكل موظف. وقد يأخذ ذلك شكل دفع أقساط الشهادات الجامعية، كما هو حال أمازون، و”وول مارت” (Walmart) وغيرها؛ أو الإعفاء من القروض الدراسية أو تقديم تعويض عنها، كما هو حال “جيكو” (Geico)، وستاربكس، و”يو بي إس” (UPS)؛ أو منح الموظفين بعض الوقت الذي يحق لهم إمضاؤه كما يشاؤون لتطبيق مشاريعهم الخاصة كما فعلت جوجل بين الفينة والأخرى على مدار السنوات الماضية. تبعث هذه الجهود كلها برسالة صريحة مفادها أن نمو الموظف وتطوره أمران ينطويان على قيمة ضمنية، حتى لو لم تحصل عليها المؤسسة على الفور.
تدعم الموظفين السابقين. تطبّق المؤسسة التي تتبنى شعار “الحب + العمل” برنامجاً متأنياً ومدروساً ورسمياً لإنهاء علاقة العمل مع الموظف، وهو يعزز الرسالة التي تقول إن قيمة الموظفين كبشر تتجاوز بأشواط الوقت الذي يمضونه مع المؤسسة. وقد وجدت شركات عديدة، بما في ذلك “أكسنتشر” (Accenture) وماكنزي أن المحافظة على علاقة وثيقة مع مجتمع قوي مكوّن من الموظفين السابقين تنطوي على منافع عملية تأخذ شكل النمو في أعداد الزبائن الحاليين والإحالات. لكنها طريقة تسمح للمؤسسات أيضاً أن تُظهِر التزامها بكل موظف كشخص.
مجدداً يبرز اسم “لولوليمون” في هذا المضمار. فاستعداد الشركة للبقاء على اتصال بالموظفين السابقين ودعمهم أسس لشبكة من الشركات الريادية في فانكوفر تعمل في قطاعات عديدة، بما في ذلك الأزياء، والخدمات الغذائية، واللياقة البدنية. ويتحول العديد من الموظفين الذين يغادرون الشركة للسير وراء أحلامهم وافتتاح استديو أو صالة رياضية لاحقاً إلى “سفراء” تعلّق صورهم بفخر في متاجر “لولوليمون” المحلية لإبراز مشاريعهم الجديدة. ويُظهر ذلك للموظفين الحاليين مدى عمق استثمار الشركة في ضمان استمرار نجاح من جاء قبلهم – سواء كان هذا النجاح بين جنبات الشركة أو خارجها.
كل موظف هو حالة فردية ويجب التعامل معه على هذا الأساس
تكشف علوم الدماغ أن عدد الوصلات العصبية في كل دماغ بشري يفوق عدد النجوم في 5000 مجرة بحجم درب التبانة، ما يؤدي إلى تنويعات لا نهاية لها في طريقة تفكيرنا وفي مشاعرنا. لذلك لا يجب أن نتفاجأ من حقيقة أن الأشخاص الذين يشغلون ذات الوظيفة يحبّون عملهم وينجزونه بطرق مختلفة للغاية. والمؤسسة التي تكرّس نفسها لكي يحب موظفوها عملهم تبني ممارساتها الخاصة بالتعامل مع الموظفين على هذا الأساس. (راجعوا الفقرة الجانبية بعنوان “طرق مختلفة لحب الوظيفة ذاتها”). وإذا ما أرادت أي مؤسسة أن تساعد موظفيها على تحديد أنماط الحب والكره التي يتبنونها وتحويلها إلى أداة تسهم في دعمها، فيجب أن تعطي الفِرَق وقادة الفِرَق الصلاحيات التي تسمح لهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التفرد الموجود لدى كل موظف.
تجنّبوا الأدوات التي تقوم على المعايير القياسية. تقوم نماذج الكفاءات، وأدوات تقديم الآراء التقييمية، والمسارات المهنية الصارمة، التي أصبحت المعيار السائد في معظم الشركات الكبيرة اليوم، على استبدال حالات الحب الشخصية الموجودة لدى الموظفين بإجراءات وسلوكيات موحدة ومعيارية. أما في المؤسسات التي ترفع شعار “الحب + العمل، فإن كل منصب أو دور يُعرَّف بواسطة عدد قليل من المحصلات القابلة للقياس عوضاً عن يكون معرّفاً بواسطة نموذج للكفاءة. وبالتالي فإن أداء المدراء العموميين للفنادق يُقاس بحسب مستويات الأشغال ودرجات رضا الضيوف. ويخضع الممرضون للمساءلة بناء على النتائج التي يحصل عليها المرضى وعلامات رضا المرضى. ويُقاس أداء مندوبي المبيعات بحسب أحجام المبيعات ونمو أعداد الزبائن. وهكذا دواليك. وعندما تُنتقى المحصلات والنتائج وتُعاير بعناية، فإن الموظفين سيكونون قادرين على تحديد الأنشطة التي يحبونها، ويمكن أن يحصلوا على المساعدة لإرشادهم إلى الطريق التي تقودهم إلى تلك المحصلات. ويُعتبرُ النمو الهائل للشركات التي تقدّم الإرشاد كخدمة مثل “بيتر أب” (BetterUp) علامة على أن الشركات أخذت تبتعد عن الأساليب القياسية والمعيارية وتتجه نحو تقديم التوجيه الفردي للموظفين على جميع المستويات.
[su_expand more_text=”المزيد” less_text=”الأقل” height=”50″ link_color=”#66abe8″ link_style=”button” link_align=”right”]طرق مختلفة لحب الوظيفة ذاتها
في إطار دراسة مستمرة للتميز في العمل يضطلع بها معهد أيه دي بي للأبحاث، يُجري المعهد أبحاثاً كيفية (نوعية) تشمل أفضل أصحاب الأداء في مجموعة متنوعة من الأدوار. وفيما يلي، مثلاً، كلمات ثلاثة من المدراء العموميين المتميزين لفنادق يصفون فيها الجوانب التي يحبونها في عملهم:
“أعلم أن الأمر يبدو غريباً تقريباً، لكنني مُغرم بالحالة التي يندفع فيها ضيف غاضب إلى مكتب الاستقبال. أجد وقتها أن دماغي يعمل بسرعة أكبر، ويبدأ جسدي بضخ الأدرينالين. هذا شعور مذهل ويجعلني متحفزاً جداً، لكنني أحبه. أعتقد أنني أعاني من عقدة البطل الخارق، أليس كذلك؟”
“أشعر أن أفضل لحظاتي هي عندما أحاول أن أعثر على طريقة تسمح لي بمساعدة فريقي على العمل بطريقة متآزرة. وهذا أمر صعب بسبب وجود اختلاف في الشخصيات، وفي جداول المواعيد، والأدوار والمناصب، ويجب أن أرتب هذه الأمور نوعاً ما بحيث أوكل إلى الشخص المناسب مهمة إنجاز الوظيفة المناسبة في الوقت المناسب. وبطبيعة الحال، أنا لا أنجح في هذه المهمة على أكمل وجه أبداً، لكنني أعمل بجد على هذا الموضوع”.
“الناس يقولون إن إرضائي غاية صعبة. لكنني لا أرى الأمر على هذا النحو. فأنا أحب أن أنظر إلى شيء يعمل بطريقة ناجحة ثم أحاول البحث عن طرق أحدث عهداً وأفضل في إنجاز الأشياء. أشعر بالسأم بسرعة. فإذا كنت أتعامل مع أمر جديد، ولم يسبق إنجازه من قبل، وهي المرة الأولى، فإنني أكون حاضراً للعمل عليه. لا أستطيع أن أخبركم كم مرة عدّلنا جوائز فريقنا أو برامجنا المخصصة لتقدير الضيوف. فأنا لا أتوقف البتة”.
[/su_expand]كما تتجنب هذه المؤسسات أدوات تقديم الآراء التقييمية، التي تعتمد بحسب تعريفها على قياس أداء كل شخص في مقابل قائمة معيارية من المهارات أو الكفاءات. وقد سبق لي أن شرحت في هذه المجلة لماذا تُعتبر الآراء التقييمية مؤذية (“الأفكار المغلوطة حول الآراء التقييمية” هارفارد بزنس ريفيو العربية، العدد 20، سنة 2019). فباختصار، الآراء التقييمية للناس محكومة في نهاية المطاف بالأشياء التي يحبونها (والأشياء التي يكرهونها) وهي ليست نافعة كثيراً في مساعدة الموظفين على اكتشاف الأشياء التي يحبونها والمساهمة بها. فبعيداً عن المعطيات المطلوبة بخصوص الحقائق أو الخطوات التي يجب اتّباعها، فإن الآراء التقييمية، ومهما كانت النية من ورائها سليمة، تتألف عادة من شخص يقمع شخصاً آخر.
إن تنظيم العمل ليتمحور حول الحب يعني عدم تعريف المسارات المهنية بواسطة المهارات أو الكفاءات المطلوبة في كل مستوى – في الحقيقة ليس هناك أي بحث أعرفه في أي مجلة علمية محكمة يثبت أن أفضل الممارسين في منصب أو دور معيّن يمتلكون ذات المهارات والكفاءات. فنماذج الكفاءات هي فكرة مجردة تنكر حقائق الواقع التي مفادها أن الأشخاص الموجودين في المنصب ذاته يجدون الحب في أنشطة وجوانب مختلفة منه – ولذلك فهم ينجحون ويتميزون في المنصب باستعمال منهجيات مختلفة تماماً. وسوف نشهد تزايداً في تصميم المسارات المهنية بحسب اهتمامات الموظف ومهاراته. وثمة مجموعة من البرمجيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل “غلوت” (Gloat)، و”فيول 50″ (Fuel50)، و”فلكس” (Flux)، وهي تُعد البرمجيات الرائدة في سلسلة متنامية من المنصات التي تبني المسارات المهنية بهذه الطريقة.
ركّزوا على الفِرَق. إذا ما أرادت الشركات تجنّب استعمال الأساليب المعيارية والقياسية، فإنها يجب أن تنظّم ذاتها بطريقة تتمحور حول الفِرَق.
في عام 2019، وبينما كنت أنا وزملائي في معهد أيه دي بي للأبحاث نحلل البيانات التي حصلنا علينا من دراستنا العالمية لعمّال العالم، اكتشفنا مدى أهمية الفِرَق بالنسبة للموظفين. فالعاملون الذين قالوا إنهم شعروا أنهم جزء من فريق لم يكونوا أكثؤ ميلاً بمرتين وسبعة أعشار المرة إلى إبداء قدر كامل من التفاعل فحسب، وإنما كانوا أكثر ميلاً بثلاث مرات إلى إبداء قدر شديد من المرونة، وأكثر ميلاً بمرتين إلى الإعلان عن إحساس قوي بالانتماء إلى مؤسستهم.
يعود السبب في ذلك إلى أن الفِرَق تفسح المجال أما التميز الفردي. فضمن الفريق الواحد، يمكن لحالات الحب والكره الفريدة من نوعها والموجودة لدى كل شخص أن تُجمع مع حالات الحب والكره الموجودة لدى الآخرين لصنع شيء أكبر من أن يكون أي إنسان قادراً على تحقيقه بمفرده. ولطالما عرف البشر هذه الحقيقة منذ أمد بعيد. ففي واقع الأمر، كان أقدم عمل فني إنساني مكتشف على الإطلاق هو لوحة يزيد عمرها على 45 ألف عام رُسِمت على جدار كهف في جزيرة سولاويسي وهو يصف مجموعة صغيرة من الصيادين، رُسِم كل واحد منهم بخصائص حيوان مختلف للدلالة على المساهمة الخاصة لكل عضو من أعضاء الفريق: خرطوم فيل لإظهار قوة أحد الأعضاء، وذيل تمساح لتجسيد دهاء عضو آخر. مقولة “ليس هناك “أنا” في “الفريق”” هي مقولة لا تعكس الغاية الجوهرية من الفريق التي تقوم بالضبط على فكرة الاستفادة من إسهام كل “أنا” فريدة من نوعها. فإذا ما كان هناك عضو في فريق وكان مديره وأعضاء فريقه يرونه ويعرفون الأشياء التي يحبّها، فإنهم سيكونون قادرين على العثور على طرق لمساعدته على إنجاز العمل الذي يحب بطريقة أفضل مما يمكن لأي مؤسسة أن تنجزه على الإطلاق.
لكن معظم المؤسسات اليوم غير مبنية بحيث تكون متمحورة حول فِرَق. فرغم أن قدراً كبيراً من العمل الجماعي يُنجز هذه الأيام، إلا أن القادة لا يستطيعون رؤيته أو الاستفادة منه. كل ما عليكم فعله هو النظر إلى معظم البرمجيات الحالية المخصصة لإدارة رأس المال البشري. فهي تُظهر الأفراد ورؤساءهم، لكنها لا تبيّن الفِرَق التي يعتمدون عليها.
تنشئ المؤسسة التي تركز على الفرق برامج رسمية للانضمام إلى هذه الفرق، حيث يتعرف الموظفون في هذه البرامج على أسباب اختيارهم لأداء المهام التي أوكلت إليهم. وتشمل عملية التعريف هذه توصيفات مفصلة للمهارات والمواهب التي يضيفونها إلى فرقهم، وما هي الأشياء التي يمكنهم الاعتماد عليها لدى كل عضو في الفريق. فشركة “باتاغونيا” (Patagonia)، مثلاً، تنقل عملية بناء الفرق لديها إلى خارج أروقة المقر الرئيس حيث تأخذ موظفيها في رحلات لتسلّق جبال سانتا ينيز القريبة، أو في رحلات تخييم على شاطئ فينتورا لمساعدة أعضاء الفريق على أن يروا بعضهم البعض كأشخاص كاملين فريدين من نوعهم. وهناك قد يكتشفون أن أحد الأعضاء يحبّذ العمل تحت الضغط، وأن عضواً آخر يكون في أقصى درجات إبداعه بين السادسة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، بينما يفضّل آخر أن يجري لمسافة خمسة كيلومترات حول منطقة سكنه كل صباح وإلا فإنه سيفقد حافزه للعمل. ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يعملون عن بعد، سيتعين على الشركات أن تبذل جهداً متعمداً أكبر في جعل الانضمام إلى فريق جزءاً أساسياً من عملية إعداد الموظفين الجدد. أتوقع أن نرى الكثير من تطبيقات البرمجيات التي ستظهر لملء هذا الفراغ.
لكن الجزء الأهم من الانتماء إلى فريق هو تطوير الثقة مع الأفراد الذين يشكّلونه.
بعيداً عن المعطيات المطلوبة بخصوص الحقائق أو الخطوات التي يجب اتّباعها، فإن الآراء التقييمية، ومهما كانت النية من ورائها سليمة، تتألف عادة من شخص يقمع شخصاً آخر.
نحن ننمو من خلال الثقة
تدعم البيانات فكرة وجود ارتباط قوي بين الثقة وجميع المحصلات الجيدة التي ينتجها الحب في العمل. فعندما سأل معهد أيه دي بي للأبحاث 50 ألف مشارك في استبيانه العالمي إذا ما كانوا يثقون بأعضاء فريقهم، وقائد فريقهم، وكبار قادتهم، كان الأشخاص الذين قالوا إنهم يتفقون بقوة مع فكرة أنهم يثقون بالناس في فئتين من الفئات الثلاث كانوا أكثر ميلاً بثلاثة مرات من الآخرين إلى الإعلان أنهم في حالة تفاعل كامل ويتصفون بالمرونة العالية. أما الأشخاص الذين قالوا إنهم يتفقون بقوة مع فكرة أنهم يثقون بالناس في الفئات الثلاث كلها كانوا أكثر ميلاً بخمس عشرة مرة إلى الإعلان أنهم في حالة تفاعل كامل، وأكثر ميلاً باثنتين وأربعين مرة إلى القول إنهم يتصفون بالمرونة العالية.
يعود السبب في ذلك إلى أن الثقة تزيد من قدرة الموظفين على اكتشاف ما يحبونه، وفعل ذلك الشيء. وفي دراسة للعمّال المسؤولين عن الترتيب والتدبير المنزلي في “عالم ديزني”، توصّلت إلى أن العديد منهم أحبّوا عملهم بالتحديد لأنهم كانوا ينجزونه بطريقة خلاقة.
كان أحدهم، على سبيل المثال، مسؤولاً عن إعادة ترتيب الحيوانات القماشية المخصصة لتأدية مشاهد تمثيلية أمام الأطفال كل يوم. وكانت موظفة أخرى مسؤولة عن الاستلقاء على السرير لتفقّد الغرفة من تلك الزاوية لأنها كانت تعلم أن ذلك هو أول شيء سيفعله الضيف بعد نهار طويل يقضيه في الحديقة. كانت الثقة الممنوحة للعمّال المسؤولين عن الترتيب والتدبير المنزلي لممارسة استقلالهم الذاتي – على الرغم من القواعد الرسمية التي كانت تنص على عكس ذلك – هي ما جعلهم يحبّون وظائفهم، وقد سمح لهم هذا الحب بالتميز بطرق لم تكن لتجدها مدرجة في أي قائمة مهام.
فإذا ما أردتم ترسيخ الثقة بطريقة مدروسة في مؤسستكم، فإنكم ستكونون بحاجة إلى إنهاء العمل ببعض الطقوس والبدء بتنفيذ غيرها.
تخلّصوا من الطقوس التي تؤدي إلى تناقص الثقة. غالباً ما تبعث الأهداف المفروضة من الأعلى، وتصنيفات الأداء، واستبيانات تقييم الأداء بطريقة 360 درجة – الآليات التي نميل إلى النظر إليها على أنها تزيد التوافق وتعزز الأداء – بإشارة مفادها أن المؤسسة لا تثق بموظفيها. فالأهداف التي تقررها الإدارة العليا وتطالب باقي الموظفين في الهرمية المؤسسية بالتقيد بها هي أهداف مصطنعة تؤدي إلى منع الموظفين من التفكير فيما يحبّونه وكيف يمكن أن يستفيدوا من هذا الحب في إنجاز عملهم. وفي المقابل، تثق المؤسسة التي تتبنى شعار “الحب + العمل” بموظفيها وتتيح لهم تحديد أهدافهم الذاتية، التي تناقش وتُعدّل حسب الضرورة خلال العام.
سبق لي أن كتبت على صفحات هذه المجلة مقالاً بعنوان (“إعادة ابتكار إدارة الأداء”، أبريل/ نيسان 2015) حول سبب عدم موثوقية تصنيفات الأداء. فلا أحد يثق بها – بما في ذلك الأشخاص الذين يحصلون على أعلى التصنيفات. فعندما يُختزل الجميع إلى رقم، لن تستطيع المؤسسة رؤية الشخص كإنسان كامل. وعلى المنوال ذاته، الجميع يشك عن حق بقدرة استبيانات تقييم الأداء بطريقة 360 درجة على توليد بيانات موثوقة، لأنها لا تكشف بأي طريقة من الطرق الشخصية الحقيقية لموظف معيّن. وتُرْسِل هذه الآليات إلى الموظفين رسالة مفادها أنهم خاضعون للمراقبة، لكن دون أي ثقة حقيقية بأنهم يعرفون ما هو المطلوب لأداء وظائفهم.
عوضاً عن ذلك، عليكم الانتباه. تبني المؤسسات التي تتبنى شعار “الحب + العمل” الثقة من خلال إيلاء الانتباه فعلياً إلى الموظفين من خلال قادة فِرقهم. ويتطلب الأمر تزويد هؤلاء القادة بالصلاحيات، وتقليص نطاق مسؤوليتهم من أجل إعطائهم الفرصة للانتباه المتكرر والمتناسب مع وضع كل فرد.
تنظر المؤسسات التي تبني الثقة إلى عمليات المراجعة التي تجري مرة في الأسبوع بين الموظفين وقادة فرقهم على أنها الطقس الإنساني الأساسي في العمل. فأثناء هذه الدردشة، لن يُجري قائد الفريق تفقداً أو تقييماً للشخص، ولن يقدّم له أي آراء تقييمية. بل سيتحدث القائد عن الماضي القريب وعن المستقبل، ويطرح الأسئلة التالية: “ما هو الشيء الذي أحببته خلال الأسبوع الماضي؟” و”ما هو الشيء الذي كرهته؟” و”ما هي أولوياتك هذا الأسبوع؟” و”ما هي أفضل طريقة تسمح لي بمساعدتك؟”
سيضمن طرح هذه الأسئلة الأربعة كل أسبوع على مدار عام كامل بناء الثقة بين الموظفين وقادة فرقهم. ولا يبدو أن من المهم ما إذا كانت هذه المراجعة تجري حضورياً، أو عبر الهاتف، أو بالبريد الإلكتروني، أو ضمن تطبيق. الأمر المهم ببساطة هو أن تحصل. وخلال عملية المراجعة، يمكن للشخصين أن يتحدثا عن التفاصيل المحددة للعمل الذي يقوم به الموظف، والتحديات التي ربما تنشأ، وما الذي يمكن لقائد الفريق فعله لكي يمد يد العون. فكل حديث يدور عن أحد التحديات المعيّنة، وكل فعل صغير لتقديم الدعم يساعدان في بناء الثقة بينهما. ولا يقتصر الأمر على ذلك. فذكر الموظفين للأنشطة المحددة التي أحبوها الأسبوع الماضي تُبقي حالة الحب لدى الموظفين حاضرة في أذهانهم، بحيث تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل الحقيقي الذي يجب إنجازه.
هناك مؤسسات كثيرة اعتمدت هذه المراجعة كأحد الطقوس الأساسية. فشركة “سيسكو” وحدها تنفّذ ما يقرب من 3 ملايين مراجعة سنوياً في المتوسط. صحيح أنها لا تشكّل علاجاً لجميع المشاكل، بطبيعة الحال. فبعض القادة ينفّذون الإجراءات بطريقة رتيبة فحسب، فيما قد يحتاج بعض الموظفين إلى وقت طويل لكي يشعروا أن المؤسسة تهتم لأمرهم بصدق وتريد أن تعرف ما الذي يحبّونه. لكن البيانات المستندة إلى ملايين المراجعات مذهلة. فقادة الفرق الذين يُجرون مراجعة كل أسبوع يرفعون مستويات تفاعل أعضاء فرقهم بنسبة قد تصل إلى 77%، في حين يتراجع معدل ترك أعضاء فريقهم للعمل بشكل طوعي في الأشهر الستة التالية بنسبة 67%.
لكي تُحوّلَ المؤسسات التي تتبنى شعار “الحب + العمل” هذا الطقس إلى واقع ممكن، فإنها تتجنب إنشاء أقسام أو وظائف تكون كبيرة جداً إلى حد أن نطاق السيطرة يجعل من المستحيل على قائد فريق إجراء مراجعة مع كل عضو من أعضاء فريقه. قد تكون النسبة المتمثلة في قائد واحد لكل 70 عضو فريق منطقية من الناحية المالية في الميزانية العمومية للشركة، لكنها غير منطقية كثيراً لأناس يحاولون بناء الثقة.
يقول قادتنا علناً إنهم يريدوننا أن نعود إلى العمل، ولكن بالنسبة لكثيرين منا تنبع جميع التوترات الحالية المتعلقة بالعمل من تشكيكنا فيما إذا كنا نريد حتى العودة إلى طريقة سابقة في فعل الأشياء. فـ”الوضع الطبيعي” يقودنا إلى منظومة مكان عمل بدت مصممة لاستغلالنا، وإشعارنا بالتوتر، والتقليل من اعتمادنا على عقولنا. لقد جعلنا هذا “الوضع الطبيعي” أشخاصاً غير صحيين. فإذا ما تجاهلت المؤسسات تحفظات الموظفين على هذا الوضع أو كانت تأمل ألا تكون هذه الاحتجاجات إلا موجة عابرة، فإنها ستظل تجد صعوبة وإلى الأبد في اجتذاب أفضل الموظفين، وستظل تتساءل عن سبب معاناتها الكبيرة في استبقاء الموظفين الذين تجتذبهم.
في المقابل، ستدرك المؤسسات الأذكى أنها إذا استطاعت إعادة تصميم العمل بحيث يكون الحب في صميمه، فإنها ستكون قادرة على تقديم التزامات جديدة وأصدق تجاه العاملين فيها، ومع مرور الوقت سوف تصبح جاذبة لأصحاب المواهب. وساعتها سوف تستحق أفضل الناس عن حق.
تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .