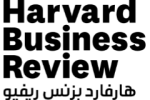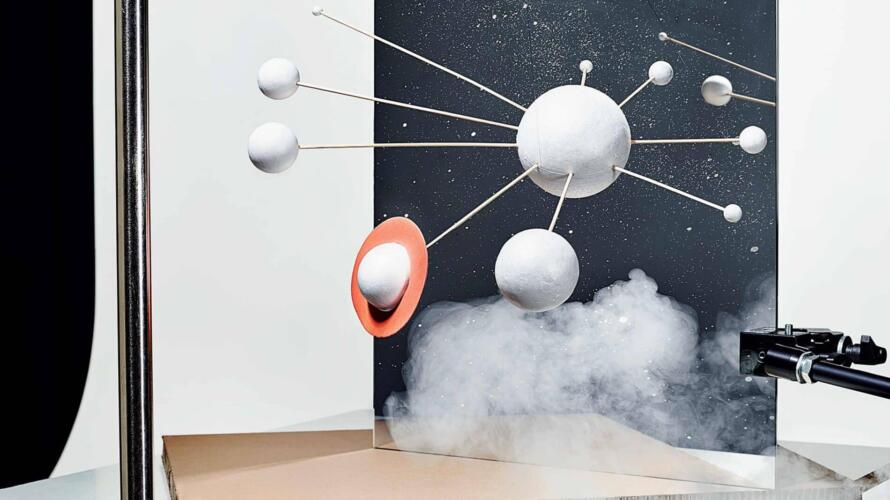
القادة العظماء يَتَحدّون الافتراضات الشائعة، ويُجرون التجارب، ويعملون بما تثبته البراهين.
يتّخذ المدراء كل يوم قرارات بشأن المنتجات، والزبائن، وتخصيص الموارد، وأجور الموظفين، مستندين إلى افتراضات لم تخضع لأي مراجعة نقدية، فضلاً عن أن تكون قد تعرّضت للتحدي أصلاً.
ولسان حال أحدهم هو: “لطالما نجحتُ عندما عملتُ بهذه الطريقة ولم يخطر في بالي أن أعمل بطريقة مختلفة”. فهذه هي الإجابة التي غالباً ما نسمعها من المدراء عندما يُسألون عن سبب عدم تشكيكهم في الممارسات التي تبيّن أنها خاطئة. ولكن عندما يُثبت المشككون أن الأفكار التي تشكل أساساً ضمنياً للممارسات خاطئة، أو مُربِكة، أو مكلفة للغاية، فإن القادة يستوعبون أهمية اختبار الافتراضات بطريقة منهجية.
خذوا مثلاً ما حصل مع شركة الفنادق وصالات الألعاب هاراز إنترتينمت في بدايات القرن الحالي، عندما عمل أحدنا، ألا وهو غاري الذي كان الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، مع فريق تحليل البيانات لديه على إعادة النظر في المقاربة التي كانت تتّبعها الشركة في تقديم الحوافز التسويقية. كان قادة هاراز مقتنعين بالحكمة التقليدية السائدة في القطاع ومفادها أن الحوافز المالية مثل أسعار الغرف المنخفضة، وقسائم الوجبات الغذائية، وقسائم الشراء من متاجر التجزئة كان لها تأثير كبير على قرارات الزبائن بزيارة لاس فيغاس، وأن تقديم المزيد من هذه الحوافز يزيد من احتمال حجز الناس للغرف هناك. أراد غاري وفريقه الانطلاق في رحلة تهدف إلى تحسين الإنفاق على التسويق من خلال إجراء اختبار صارم لكل مبادرة من المبادرات بمفردها. (وبما أن غاري كان قد درس الاقتصاد، فقد كان يفهم أهمية تقييم المساهمة الجزئية لكل عنصر من عناصر البرنامج التسويقي – عوضاً عن قياس الأثر الإجمالي للبرنامج بأكمله، كما كان سائداً في القطاع). أجرى الفريق مئات الاختبارات لتحديد أي من الحوافز شجّع الناس على البقاء في فنادق الشركة وإلى أي درجة. كشفت النتائج أن بعض هذه الحوافز، مثل الخصومات في متاجر التجزئة، لم تؤثر على الحجوزات الفندقية ويمكن التخلص منها. وعلاوة على ما سبق، إذا أعيد تخصيص المال المُنفق عليها لمبادرات فعّالة، مثل تقديم حسومات أكبر على أسعار تأجير الغرف، فإن هاراز ستكون قادرة على تعزيز أرباحها من استجابات الزبائن.
فكرة المقالة باختصار
المشكلة
يلجأ الكثير من القادة إلى الإفراط في الاعتماد على شعورهم الغريزي أو تجاربهم الشخصية عند اتخاذ القرارات – على الرغم من عقود من التحذيرات التي تشير إلى مخاطر الإقدام على ذلك.
جذر المشكلة
غالباً ما يعتقد التنفيذيون أن الأساليب والأشياء التي نجحت معهم في الماضي – الإنجازات التي أوصلتهم إلى المناصب القيادية التي يشغلونها – ستنجح في المستقبل. وغالباً ما يعزز مرؤوسوهم هذه المشاعر.
الحل
يجب على كبار المدراء تبنّي نهج علمي في عملية اتخاذ القرارات. ويجب عليهم تحدّي الافتراضات، وتقصّي الحالات غير المألوفة عبر وضع فرضيات قابلة للاختبار، وإجراء تجارب صارمة تسهم في الوصول إلى براهين دامغة.
بحلول عام 2005، كانت الشركة تستعمل التجارب لتحسين العديد من القرارات الاستراتيجية والتشغيلية. فعلى سبيل المثال، كان تنفيذيو الشركة قد افترضوا أن حب الناس للشفافية والإنصاف يجعلهم يفضّلون الوقوف في طابور فعلي منظم في بوفيه مفتوح تستطيع أن تأكل فيه كل ما يحلو لك من لذيذ الطعام في سيزرز بالاس (Caesars Palace) على طابور افتراضي – وهو نظام إشعارات رقمي يسمح للزبائن بمغادرة المنطقة مع الاحتفاظ بدورهم في الطابور. لكن اختباراً كشف أنه إذا أرسل المطعم إلى الزبائن رسالة نصية قبل 10 دقائق من حلول موعد منحهم مقاعدهم في المطعم، فإنهم يستغلون الوقت لشراء المشروبات أو اللعب في صالة الألعاب، ما أدى إلى تحقيق إيرادات تتجاوز بكثير الإيرادات المفقودة من الأشخاص الذين لم يكونوا راغبين بالانتظار. ومع مرور الوقت، قادت تجارب مشابهة هازار إلى ترسيخ ثقافة تقوم على تشجيع حب الاستطلاع والفضول، ولم يَعد تحدي الحكمة التقليدية السائدة في القطاع أمراً مقبولاً فحسب، وإنما أصبح تقليداً يُحتفى به.
فإذا كان تحدّي الافتراضات الشائعة أمراً قيّماً إلى هذه الدرجة، فلماذا لا يعتمده المدراء كأحد معايير العمل؟ بعد أن أمضينا عقوداً في دراسة الابتكار وعملية اتخاذ القرار والممارسة في هذين المجالين، توصّلنا إلى أن السبب الجوهري هو أن معظم قادة الشركات لا يفكرون أو يتصرّفون كما يفعل العلماء. وهذه فرصة هائلة ضائعة. فقد كشف بحث أجراه أحدنا، ألا وهو ستيفان، أن التجارب الصارمة يمكن أن تساعد المدراء على اكتشاف ما إذا كان النجاح سيحالف منتجاً جديداً، أو خدمة جديدة، أو برنامجاً تجارياً جديداً. راجعوا: مقالة بعنوان “علم التجارب التجارية” (The Discipline of Business Experimentation). أما غاري، ومن موقعه كرئيس تنفيذي للعمليات، ورئيس تنفيذي، ورئيس لشركتي ترفيه ورعاية صحية كبيرتين، فقد رأى أن الاستثمارات في تحليل البيانات تقود إلى قرارات أفضل. لكن العديد من المدراء مازالوا مترددين في تمويل التجارب، ورغم عقود من التحذيرات بخصوص مخاطر السير وراء ما يقوله الشعور الغريزي، إلا أنهم مستمرون في الاعتماد المفرط على الحدس والتجربة الشخصية في عملية صنع القرار، حتى لو كانت البراهين تناقض ذلك.
يجد القادة صعوبة في إدارة الأمور بأساليب العلماء لأن ذلك يشكل تحدياً لمشروعيتهم. ويعود السبب في ذلك، دون شك، إلى أن وصول أي شخص إلى موقع مسؤولية في الهرمية المؤسسية هو نتيجة لخبرته وسجلّه الحافل في التحركات والأفكار الناجحة، كما يُفترض. كما يعيش كبار التنفيذيين في حلقات تغذية راجعة من التعزيز الإيجابي ما يجعلهم غير ميالين إلى التشكيك في أساسيات قراراتهم. أما الطريقة العلمية، في المقابل، فتتطلب التحلي بالتواضع الفكري في مواجهة المشاكل الصعبة، وهي تعتمد على عملية موضوعية مُسْندة بالبراهين، عوضاً عن اعتمادها على استنتاجات شخصية إلى حد كبير، في صياغة القرارات والتعامل معها.
عندما نفكر بطريقة علمية، ندرك أن البشر يرتكبون أخطاء معرفية ويجانبون الصواب في الحكم على الأمور، ويمكن أن يشعروا بعدم المبالاة وبالرضا عن النفس مستندين إلى افتراضات تشوبها العيوب. وعندما نتصرف بطريقة علمية، فإننا نسعى إلى سبر افتراضاتنا بلا هوادة ونغيّرها إذا ظهرت براهين تشير إلى خطئها. وبالتالي فإن تبنّي مقاربة علمية في عملية اتخاذ القرار هو شيء أساسي في مؤسسات اليوم، وتحديداً في ضوء الاضطرابات الهائلة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.
في هذه المقالة، سوف نناقش خمسة من عناصر المنهج العلمي نعتبرها مفيدة تحديداً في مجال ممارسة الإدارة.
يزخر التاريخ بالكثير من الأمثلة التي تبيّن كيف ساعد هذا النوع من التشكيك في الانقلاب على أفكار شائعة وقاد إلى فتوحات علمية مهمة.
تصرّفوا بأسلوب العارف المشكك
عندما يتبنى قادة الشركات هذه الذهنية، فإن تحيزاتهم وأخطاءهم لن تقف حجر عثرة في طريقهم ولن تمنعهم من العثور على الحقيقة. فهم سيستعينون بالمنطق، وسيسعون إلى البحث عن البرهان، وسيكونون منفتحين على الأفكار الجديدة. وفي الممارسة العلمية، هذا يعني السعي إلى التثبت من الحقائق من مصادر مستقلة، مع إيلاء أهمية أكبر للخبرة على حساب السلطة، ودراسة الفرضيات المتنافسة. والأهم من ذلك كله هو أن المشككين يُعرّضون الافتراضات للمساءلة. فهم يطرحون أسئلة من قبيل: “لماذا نصدّق هذا؟” أو “ما الدليل على صحة هذا الكلام؟” يزخر التاريخ بالكثير من الأمثلة التي تبيّن كيف ساعد هذا النوع من التشكيك في الانقلاب على أفكار شائعة وقاد إلى فتوحات علمية مهمة.
عندما يكون المدراء من العارفين المشككين، فإن هذا الشيء يمكن أن يقود إلى حصول تحول في الطريقة التي تّدار بها الشركة. خذوا مثلاً حالة شركة سوني. فعندما تولى كازو هيراي المسؤولية عن قسم الإلكترونيات الاستهلاكية فيها عام 2011، كانت الشركة في وضع صعب. فقسم التلفزيونات الذي حالفه النجاح ذات يوم فيها كان قد عانى من تعمّق خسائره المالية لسنوات. كان السبب وراء ذلك هو أن أسلاف هيراي في المنصب تبنّوا افتراضاً أساسياً مفاده: إذا ما أراد القسم استعادة قدرته على تحقيق الأرباح، فإنه بحاجة إلى أن يزيد من أعداد التلفزيونات التي يبيعها لكي يعوّض جزءاً من التكلفة الباهظة لمزاولة الأنشطة في سوني. كان هيراي (الذي أصبح لاحقاً الرئيس التنفيذي لسوني في 2012) من المشككين في هذه الفرضية وطلب إجراء تحليل. كشف التحليل أن القسم سيحتاج إلى بيع 40 مليون تلفزيون سنوياً لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة. لكن في 2010، لم تكن الشركة قد باعت إلا 15 مليون جهاز. وما زاد الطين بلّة هو أن القادة السابقين أرادوا تحقيق أرقام مستهدفات المبيعات العالية عبر الخصومات المتكررة على الأسعار، ما أدى إلى دورة إضافية من الخسائر.
أمر هيراي قسم المبيعات ببيع عدد أقل من التلفزيونات ورفع الأسعار. فقلّصت الشركة من عدد شاشات التلفزيون من نوع (إل سي دي) (LCD) التي تبيعها في الدول المتقدمة بنسبة 40% تقريباً، كما قللت عدد طرازاتها الأميركية إلى النصف تقريباً. وفي الوقت ذاته، أعادت هيكلة عملياتها لتقليل التكاليف الثابتة، وطلبت من المهندسين تحسين جودة الصورة من أجل تبرير الأسعار الأعلى، وأطلقت نموذجاً في تجارة التجزئة يميّز منتجاتها عن منتجات الآخرين، حيث أنشأت متجراً ضمن متجر في سلسلة بيست باي (Best Buy). وفي 2015، أعلن قسم التلفزيونات في سوني عن تحقيق أرباح تشغيلية للمرة الأولى في 11 عاماً. فقد نجح الإجراء الذي اتخذه المشكك.
استقصوا وضع الحالات الخارجة عن المألوف
لطالما كان التمحيص في الحالات الخارجة عن المألوف في العلوم عنصراً أساسياً في تحديد الافتراضات القابلة للتشكيك فيها. فالحالات غير المألوفة أو الشاذة هي الحالات غير المتوقعة، أو التي لا تبدو صحيحة، أو التي قد تبدو غريبة، وهي تبرز بشكل ملحوظ لأنها غير منسجمة مع النتائج المرجوة أو لا تتوافق معها. ويجب على المدراء أن يترصدوها ويستكشفوها لأنها يمكن أن تقود إلى استنتاجات جديدة مهمة للشركة. (راجعوا مقالاً بعنوان “قوة الخروج عن المألوف“).
قادت إحدى الحالات غير المألوفة مثلاً العالم لويس باستور إلى تحقيق اكتشاف هام أثناء دراسته لكوليرا الدجاج. ففي عام 1879، ولدى عودته من العطلة الصيفية، انتبه إلى أن مستنبتات كوليرا الدجاج قد فقدت خباثتها المرضية (أو ما يسمّى بلغة الطب فوعتها). كما لاحظ أيضاً أنه عندما حقن مساعده المستنبتات الفاسدة في الدجاجات، لم تظهر لديها إلا أعراض طفيفة وشفيت تماماً. وعندما حُقِنت هذه الطيور ذاتها ببكتيريا حيّة جديدة خبيثة، ظلت الدجاجات في حالة صحية سليمة. وقاد اكتشافه هذا – أي أن المكروبات المضعّفة أو الميتة التي تؤدي إلى الإصابة بمريض خفيف قادرة على الوقاية من المرض ذاته بشكله الفتاك – إلى تحقيق واحد من أهم الاختراقات العلمية في مكافحة الأمراض المُعدِية ألا وهو التطعيم بالفيروسات الحية الموهَّنة.
بمقدور قادة الشركات الذين يبحثون عن الحالات غير المألوفة ويتعاملون معها، وعلى المنوال ذاته، كشف النقاب عن استنتاجات تقود إلى فرص مهمة، كما اكتشف غاري في عام 1999، بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة هاراز. ففي إحدى الليالي وبينما كان في مصعد فندق الشركة في لاس فيغاس، سمع أحد الزبائن يقول لزبائن آخرين، “لا أستطيع أن أربح في لاس فيغاس. فالآلات الموجودة في صالات اللعب لا تقدّم ذات الأرباح التي تقدّمها الآلات في مدينة أتلانتيك سيتي”، وهو يقصد أن حجم الأرباح التي يحصل عليها اللاعب من الآلة أدنى وسطياً. وقد وافقه الزبائن الآخرون الرأي.
كانت هذه الملاحظة مفاجئة لغاري. فهو أولاً كان يعرف أن الآلات الموجودة في صالات الألعاب في لاس فيغاس أكثر سخاءً من حيث وسطي الأموال التي يمكن للمرء أن يربحها منها. (فالآلات في لاس فيغاس كانت تعيد 94.5% من أموال الزبائن التي يلعبون بها، وسطياً، في حين أن النسبة في صالات أتلانتيك سيتي كانت 93%). ثانياً، كان ثمة افتراض شائع منذ مدة طويلة في القطاع مفاده أن الآلات التي تدفع مبالغ أقل في صالات الألعاب كانت تقود الزبائن إلى الصالات التي تدفع مبالغ أكبر. فماذا لو كان معظم الزبائن مثل هؤلاء الذين في المصعد ولا يعرفون الفرق؟ هل يُعقَل أن يكون القطاع بأكمله قد فهم الأمر على نحو خاطئ؟ فطلب من فريق تحليل البيانات لديه تقصّي الأمر.
اكتشف الفريق أن القطاع قد أساء فهم الطريقة التي يستعمل بها الأفراد الآلات في صالات الألعاب. فالزبائن لا يحصلون على المبالغ الوسطية خلال زيارة عادية واحدة أو خلال عدة زيارات حتى؛ بل بحاجة إلى أن يلعبوا بالآلات 80 ألف مرة حتى يحدث ذلك. وبناءً عليه، لم يكونوا قادرين ربما على اكتشاف الفرق في المدفوعات الوسطية بين فيغاس وأتلانتيك. وفي نهاية المطاف، قاد حوار المصعد إلى ثورة في عالم صالات الألعاب. فقد بدأت الشركات بتوظيف علماء بيانات لكي يستعملوا تحليل البيانات والتجريب ليحددوا المدفوعات المثالية لآلات صالات الألعاب وأين يجب وضعها بالضبط. ومع مرور الوقت، تراجع وسطي المدفوعات بعد أن باتت صالات الألعاب أكثر ثقة في قدرتها على تخفيض تلك المدفوعات دون إثناء الزبائن عن اللعب.
يمكن للحالات غير المألوفة أن تكشف النقاب أيضاً عن مشاكل مهمة على وشك أن تحصل في المؤسسة. أحد الأشخاص الذين يؤمنون بهذا المبدأ بمنتهى الشغف هو يورغن كنودستروب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ليغو. فقد أخبر ستيفان أنه حتى لو كانت النسبة المئوية للزبائن الذين يشتكون من منتج ما ضئيلة للغاية، فإن الشركة يجب “أن تصغي حقاً وبإمعان شديد”. وقد تعلّم ذلك شخصياً عندما شحنت الشركة 15 ألف وحدة من مجموعة معيّنة من مجموعات ألعاب ليغو دون أحد المكونات الأساسية، لكن أقل من 5% من الزبائن الذين اشتروها فقط اشتكوا من هذا النقص. “يعلّمنا هذا الشيء درساً هاماً” كما يقول، “ألا وهو أنك عندما تسمع شكوى من شخص معيّن، فإن من المنطقي الافتراض أن هناك عدداً أكبر بكثير من الأشخاص غير السعداء”.
اطرحوا فرضيات قابلة للاختبار
إذا ما كنتم تريدون تحدّي الفرضيات بطريقة فعّالة، فلا بد من أن تُصاغ على هيئة فرضيات يمكن تأكيدها أو دحضها بطريقة كمية. “عندما تستطيعون قياس ما تتحدثون عنه والتعبير عنه بالأرقام، فإنكم تعرفون شيئاً عنه”، كما قال لورد كلفن، أحد أبرز الشخصيات العلمية والهندسية في القرن التاسع عشر. “أما عندما لا تكونون قادرين على قياسه، ولا تستطيعون التعبير عنه بالأرقام، فإن معرفتكم هي من النوع الرديء وغير المُرضي”. (راجعوا الفقرة الجانبية التي تحمل عنوان “الفرضية القوية في مقابل الفرضية الضعيفة”). فالتجربة التي تُنتج براهين تناقض فرضية معيّنة تسمح لنا بالتعرف على الأخطاء الكامنة في طريقة تفكيرنا أو حكمنا على الأمور، وتعديل الفرضية، ومن ثم إعادة صياغتها بطريقة جديدة. وتقود هذه العملية التكرارية من الاختبار وإعادة التنقيح في نهاية المطاف إلى فرضيات أقوى.
إليكم المثال التالي من العلم: لقرون طويلة، كان هناك افتراض يقول إن الكون مؤلف من مادة تسمّى الأثير ينتقل الضوء عبرها. وكانت فرضية الأثير قد نشأت لأن العلماء كانوا يؤمنون أن الموجات الضوئية كانت بحاجة إلى وسط لكي تنتقل في الفراغ. في عام 1887، شرع الفيزيائيان ألبرت آينشتاين وإدوارد مورلي بإثبات صحة هذه الفرضية. وقد أجريا تجربة قاست سرعة الضوء في اتجاهات متعامدة. كان أي فرق في السرعة سيشكل إثباتاً على وجود الأثير. لكن العالِمين لم يتوصلا إلى وجود أي فرق، ما أدى إلى دحض الفرضية وتسريع البحث عن نظرية علمية جديدة عن الفراغ والزمن، ألا وهي “النسبية الخاصة”. وقد فتحت التجربة الباب على طريقة جديدة في التفكير بخصوص آلية عمل الكون.
يمكن لقطاع الأعمال أن يطبّق منهجية مشابهة. فقد استعملها فريق في مصرف بنك أوف أميركا (Bank of America) أوكلت إليه مهمة تحسين تجارب الزبائن في مكاتب الفروع. كانت إحدى المشاكل التي سعى الفريق إلى حلّها هي الإزعاج الذي كان الزبائن يشعرون به عند الانتظار للحصول على الخدمة. كانت دراسة داخلية شملت 1000 زبون (تأكدت نتائجها عبر مجموعين مركزتين وتحليل أجرته مؤسسة غالوب) قد كشفت أنه بعد وقوف الشخص في الطابور لمدة ثلاث دقائق تقريباً، تظهر فجوة واسعة بين أزمنة الانتظار الفعلية وأزمة الانتظار المتخيلة. فالانتظار لمدة دقيقتين يعطي إحساساً بالانتظار لمدة دقيقتين فعلياً، لكن الانتظار لمدة خمس دقائق قد يجعل صاحبه يحس كما لو أنه قد انتظر لمدة 10 دقائق. وبما أن الفريق كان مطلعاً على دراسات تشير إلى أنك عندما تشتت انتباه إنسان عن مهمة رتيبة مملة، فإنه يشعر أن الزمن يمر بسرعة أكبر، فقد وضع فرضية صريحة ومباشرة: وضع شاشات تلفزيون فوق صف صرّافي البنك سيقلل زمن الانتظار المتخيَّل. ولكي يختبر الفريق هذه الفرضية، أجرى تجربة، حيث وضع شاشات تلفزيون تبث إرسال قناة سي إن إن فوق رؤوس الصرافين في أحد الفروع في أطلنطا، وقارن بين تصورات الزبائن المنتظرين هناك، وتصورات الزبائن المنتظرين في فرع مشابه لا يضم شاشات. أفسح الفريق في المجال مدة أسبوع لكي يتراجع بريق الظاهرة المستجدة المتمثلة في التلفزيونات ثم قاس تقديرات الزبائن لأزمة الانتظار لمدة أسبوعين. في الفرع الذي يضم شاشات تلفزيون، انخفضت نسبة المبالغة في التقدير من 32% قبل الاختبار إلى 15%؛ وفي الفرع المخصص للمقارنة، ارتفعت النسبة من 15% إلى 26%.
في عالم الشركات والأعمال، يمكن للأفكار الخاصة بوضع الفرضيات أن تأتي من عدة مصادر. وإحدى النقاط الجيدة التي يمكن البدء منها هي رؤى الزبائن المستمدة من الأبحاث الكيفية أو النوعية (المجموعات المركزة، ومختبرات قياس قابلية الاستعمال، وما شابه) أو تحليل البيانات (البيانات المجموعة من المكالمات الواردة إلى مراكز خدمة الزبائن، مثلاً). وكما رأينا، فإن الفرضيات يمكن أن تستوحى من الحالات غير المألوفة، التي يمكن العثور عليها في أي شيء من الأحاديث التي استُرِق السمع إليها مصادفة، إلى الممارسات الناجحة التي جاءت نتيجة الخروج عن المعايير المعتادة في شركات أخرى.
استنتجوا براهين دامغة
في محاضرة ألقاها عالم الفيزياء النظرية ريتشارد فينمان في عام 1964 في جامعة كورنيل يشرح فيها المفتاح الأساسي للعلم أعلن قائلاً: لا يفرق كثيراً مدى جمال التخمينات التي تضعها. ولا يهم مدى ذكائك، أو من وضع التخمينات، أو ما هو اسمه. إذا كانت هذه التخمينات تخالف التجربة، فهي خاطئة. هذه هي الخلاصة الأساسية باختصار”. يجب على كبار قادة الشركات وقطاع الأعمال أن يأخذوا بهذه النصيحة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فالافتراضات الضمنية التي يقوم عليها جهد معيّن لا يجب أن تستند حصراً إلى مشاعر الأشخاص الذين يحملونها أو تجاربهم، أو تخميناتهم، أو مكانتهم. كما أنها يجب أن تنبع من براهين قاطعة. فإذا لم تكن هذه البراهين موجودة أصلاً، فإن التجارب المنضبطة يمكن أن توفّرها. وينبغي لهذا المبدأ أن يكون الركيزة التي تقوم عليها ثقافة الشركة (راجعوا: “بناء ثقافة التجريب“).
توفّر بيئات الشركات فرصاً عديدة لإجراء هذا النوع من التجارب. دعونا نراجع جهداً آخر قاده غاري في هذا المضمار. ففي أواخر عام 2009، بدأت عدة فنادق في لاس فيغاس وبعض شركات الضيافة في أماكن أخرى بفرض رسوم على زوار المنتجعات، وكانت عبارة عن رسم واحد شامل لجميع الرسوم الجزئية بدلاً من رسوم انتقائية تُفرَض على خدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، وزجاجات المياه الموضوعة في الغرف، والحق في الدخول إلى صالات اللياقة البدنية، وهكذا دواليك. وعندما كان الزبائن يسعون إلى حجز غرفة فندقية، كانوا يُخبرون أولاً بأجور الليلة الفندقية. ولكن بعد أن ينتقلوا ويحجزوا الغرفة، كانوا يرون رسم منتجع يُضاف إلى المبلغ الإجمالي إلى جانب الضرائب.
في ذلك الوقت، كان غاري قد أصبح الرئيس التنفيذي لشركتي هاراز وسيزرز إنترتينمنت مجتمعتين ولفترة أربعة أعوام. وقد افترض هو وفريق إدارة العمليات لديه أن الضيوف المستقبليين سينظرون إلى رسم المنتجع على أنه زيادة في السعر. وقد خشي من أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الغرف – ولاسيما بالنسبة للزبائن الذين تهمهم الأسعار – وأن يتسبب بتراجع في معدلات الإشغال. (في لاس فيغاس، تُعتبر معدلات الإشغال العالية أمراً أساسياً. فالضيوف الذين يقيمون في فنادق تضم صالات ألعاب غالباً ما ينفقون على الألعاب، والطعام، والشراب، والترفيه، وغير ذلك من المرافق الخدمية في المنتجع مبالغ أكبر من تلك التي ينفقونها على استئجار غرفهم). كان هناك دعم لفرضياتهم على شكل براهين مروية. فشركة الطيران ساوث ويست إيرلاينز (Southwest Airlines)، على سبيل المثال، كانت تجتذب الزبائن من خلال عدم تقاضي رسوم مقابل الأمتعة المنقولة بينما كان المنافسون يتقاضون هذه الرسوم. لذلك قرر غاري وفريقه عدم مجاراة الآخرين في تقاضي رسم المنتجع. وفي 2010، أطلقت الشركة حملات إعلانية وترويجية تسلّط الضوء على حقيقة أن “فنادقها لا تتقاضى رسوم المنتجعات”.
تطلّب إدخال التحول الرقمي على الشركة إصلاح أنظمة عملها ومواصلة طرح أسئلة من قبيل: “هل هذا صحيح فعلاً؟” و”هل نؤمن بهذا حقاً؟”
لكن عندما صدرت البيانات الأولى الخاصة بمعدلات إشغال فنادق الشركة وفنادق منافسيها، لم يكن هناك برهان على أن قرار التخلي عن تقاضي الرسوم يعطي النتائج المرجوة. وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر، طلب غاري من فريق إدارة العمليات لديه اختبار الفرضية الأولى من خلال إجراء تجربة. بدأت الشركة تفرض رسم المنتجع على الضيوف الذين كان من المفترض أن يُبدوا قدراً أقل من العدوانية، وتحديداً القادمين لحضور المؤتمرات والاجتماعات والزبائن الذين لم يكونوا يحتلون مراتب عليا في برنامج المكافآت. وبعد ثلاثة أشهر من الاختبار، اتّضح أن الزبائن لم يكونوا حساسين لرسم المنتج بما يكفي لكي ينتقلوا إلى الإقامة في فنادق أخرى (ومعظمها كان يتقاضى هذه الرسوم أصلاً). واصلت الشركة إجراء تجاربها من خلال فرض رسوم على فنادقها الواقعة خارج فيغاس. أخيراً، تجمّع ما يكفي من الأدلة الدامغة التي أقنعت غاري وفريقه أن الزبائن كانوا أقل حساسية تجاه رسوم المنتجعات مقارنة بحساسيتهم تجاه أسعار الغرف.
تحققوا من السبب والنتيجة
يُعتبر اتكال المدراء على الافتراضات المتعلقة بالسبب والنتيجة أمراً خطيراً عليهم. فالبشر يرون أحياناً ارتباطات بين أفعال ونتائج غير مترابطة – حيث نخلط بين الارتباط والسببية – ونتجاوب مع عوامل “التشويش” غير المهمة عند اتخاذ القرارات. (راجعوا: “تعرّف على الطريقة التي يمكن من خلالها تجاوز ما ندعوه “التشويش”). كما نميل إلى أن نقبل بسعادة البراهين “الجيدة” التي تؤكد على افتراضاتنا السببية، لكننا نتحدى البراهين “السيئة” التي تناقضها.
يسبر العلماء السببية بطرق مختلفة. ففي التجارب التقليدية، يغيّرون واحداً أو أكثر من المتغيرات (السبب المفترض) ويلاحظون التغيرات في المحصلة (النتيجة)، مع إبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة. وعندما لا يستطيعون إبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، فإنهم يعتمدون على التعشية (من العشوائية)، التي تحول دون تأثير الانحياز في المنظومة، سواء الانحياز المتعمد أو غير المتعمد، على التجربة. وتُسهِم التعشية في التوزيع المتساوي لأي أسباب محتملة متبقية للمحصلة بين مجموعتي الاختبار والضبط.
في التجارب الطبيعية، تقع المتغيرات خارج سيطرة الباحث المستقصي، لكنها تظل قادرة على كشف استنتاجات عن السببية. (العام الماضي، حصل الباحثان جوشوا أنغريست وغيدو إمبينز على جائزة نوبل لإظهارهما الكيفية التي يحصل بها ذلك. فلكي يحدد إمبينز والباحثون المتعاونون معه ما إذا كان الدخل غير المكتسب قد غيّر حوافز الناس للعمل، على سبيل المثال، راجعوا البيانات الخاصة بالرابحين في اليانصيب في ماساتشوستس. وبما أن الجوائز تُدفع في الولاية على مدار سنوات عديدة، فإنها مشابهة جداً للدخل الأساسي المضمون. ومن خلال دراسة إمبينز للأشخاص الذين فازوا باليانصيب ومقارنتهم بأشخاص لم يفوزوا به، تمكن من استنتاج التأثير السببي للدخل الأساسي المضمون).
عندما لا تكون التجارب التقليدية مُجدية – لأن التفاعل بين المتغيرات غير قابل للملاحظة، مثلاً – قد تكون نماذج المحاكاة مفيدة غالباً. فالعثور على براهين أن “(أ) يسبب (ب)” يمنح العلماء الثقة بأن ما لاحظوه ليس مجرد ارتباط. لكن الاختبار الأقوى للسببية يتمثل في استعمال الوقائع المضادة، مثل “هل كان (ب) ليحصل لولا (أ)؟” بالنسبة لقادة الشركات، هذا يعني عدم الاكتفاء بالبحث عن برهان على أن قسيمة خصم بنسبة 10% قد زادت المبيعات، وإنما السعي إلى استكشاف ما إذا كانت الزيادة ستحصل، حتى لو كانت الشركة لم تعرض الخصم. يُعتبر طرح أسئلة من قبيل “ماذا لو؟” والتفكير في الوقائع المضادة طريقة قوية لدراسة السيناريوهات في ظل افتراضات مختلفة والوصول إلى استنتاجات بخصوص السبب والنتيجة.
يجب على القادة استعمال هذه المقاربة لاختبار الافتراضات المرتبطة بالعوامل الأساسية التي تقود شركاتهم إلى النجاح. وهذا بالضبط ما فعله كنودستروب بعد أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لليغو في عام 2004. فعندما تولى مقاليد القيادة، كانت الشركة على كف عفريت، وتعاني من تراجع هائل في المبيعات وركود في النمو. وخلال العقد التالي، حولها إلى شركة رائدة في قطاع الألعاب. تطلّب الوصول إلى هذه النتيجة إصلاح أنظمة عملها ومواصلة طرح أسئلة من قبيل: “هل هذا صحيح فعلاً؟” و”هل نؤمن بهذا حقاً؟” كان واحد من الأمور التي أعاد فريق الإدارة دراستها من جديد هو قرار الشركة بتعهيد عملياتها إلى فليكسترونيكس (Flextronics). كان الافتراض الكامن وراء خطوة التعهيد هذه هو أنها ستبسّط سلسلة التوريد الخاصة بليغو، وتقلل التكاليف. لكن تبيّن أنها قد قادت إلى فترات إنتاج أطول، ومصاريف شراء أعلى، وعمر زمني أقصر لقوالب الحقن. وقد أدركت قيادة ليغو أن استعادة عمليات التصنيع إلى داخلها سيزيد من قدرة الشركة على المنافسة. فعلى سبيل المثال، استثمرت ليغو في تكنولوجيا حديثة جداً لقوالب الحقن الأمر الذي مكّنها من أن توفّر للمستخدمين تجربة أفضل لم يكن بوسع المنافسين مضاهاتها، وتحديداً في مجال بناء الحجارة البلاستيكية. (كانت قوى الربط بين قطع ليغو يجب أن تكون قوية بما يكفي لإبقائها ملتصقة معاً، لكنها لا يجب أن تكون قوية جداً إلى حد لا يمكن لطفل صغير أن يفصلها عن بعضها البعض. إضافة إلى ذلك، كانت الحجارة الجديدة يجب أن تكون متوافقة مع تلك التي صُنّعت قبل عقود. كانت تقنية القوالب التي استعملتها الشركة هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق النتيجة المرجوة).
شملت عملية السبر أيضاً الإصغاء إلى مجموعات عشّاق المنتجات، وهي عملية أدت إلى الحصول على ملاحظة مفادها أن تعليمات البناء التي توفّرها ليغو كانت أهم مما تعلمته الشركة فيما سبق، لأنها سمحت للمستخدمين العاديين بصنع مجسّمات إنشائية فذّة واستثنائية. واستجابة لذلك، زادت ليغو من حجم الموارد المخصصة لصياغة التعليمات، التي تحسّنت جودتها وأسلوبها. وقد بات العديد من هذه التعليمات اليوم متاحاً بشكل رقمي وثلاثي الأبعاد.
عرّفتنا الجائحة العالمية على عالم مليء بالمخاطر ويتّسم بقدر أكبر من عدم اليقين. كما انقلبت الافتراضات الخاصة بطريقة عملنا وحياتنا رأساً على عقب. فلا يبدو أن سلاسل التوريد قادرة على العمل وتأدية المطلوب منها، فيما تبدو حلول معظم المشاكل التجارية الملحّة بعيدة المنال. فما الذي يحصل للثقافات المؤسسية، على سبيل المثال، عندما لا يعود الموظفون إلى العمل في المكاتب؟ وهل بوسع شركة صناعية إدارة معمل دون موظفين؟ وهل بوسعنا تقليل تكاليف التأمين التي سجّلت ارتفاعاً صاروخياً من خلال تحفيز الموظفين على فعل المطلوب لتحسين صحتهم؟ لكن الأوقات المحفوفة بعدم اليقين هي فرصة أيضاً لإعادة النظر في الافتراضات التي اعتقد قادة الشركات أنها صحيحة. وسيكون من الخطأ الاكتفاء بالاعتماد على الخبرة، والحدس، وإطلاق الأحكام لتكون مرشداً لنا في هذه الحقبة التي تشهد اضطرابات عنيفة.
وفّر لنا الرجال والنساء الذين اتّبعوا المنهج العلمي علاجات طبية مذهلة؛ وإمدادات غذائية أكثر أماناً ووفرة؛ وأنواعاً جديدة من الطاقة، والنقل، والتواصل؛ وغير ذلك الكثير. فهو طريقة فعّالة جداً لمساعدة الشركات على زيادة احتمالات نجاحها، والتقليل من الأخطاء التي ترتكبها في الحكم على الأمور، والعثور على مصادر للابتكار والنمو. ويجب أن يكون للبحث العلمي دور أساسي في عمليات اتخاذ القرار فيها.
تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .