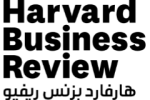أعلنت شركة “موديرنا ثيرابيوتكس” (Moderna Therapeutics) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أن التجارب الإكلينيكيّة للمرحلة الثالثة للقاحها المُعتمِد على تقنية الحمض النووي الريبوزي (RNA) أثبتت فاعليته بنسبة 95% في الوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا-سارس-2” (SARS-CoV-2) الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص حول العالم خلال الأشهر العشرة الماضية. ونظراً لتحقيقها قفزة هائلة ومفاجئة نسبياً في سباق إنتاج لقاح مضاد لمرض “كوفيد-19″، ولأنها شركة لم يسمع عنها سوى قليل من الناس قبل الجائحة، بدا أن “موديرنا” حققت نجاحاً مشهوداً بين عشية وضحاها. ولكن كما أشار رئيسها التنفيذي، ستيفان بانسل، فإن هذا النجاح استغرق 10 سنوات بالتمام والكمال. فلم يكن اللقاح مجرد ضربة حظ تأتي مرة واحدة في العمر، بل كان نتاج عملية قابلة للتكرار تم استخدامها مرات لا تُحصى من قِبَل الشركة التي انبثقت منها شركة “موديرنا”، أي شركة “فلاغشيب بيونيرينغ” (Flagship Pioneering) المتخصصة في إنشاء المشاريع ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، التي تتمثل رسالتها في وضع تصور للابتكارات الخلاقة وصنعها وتسويقها في مجالات علوم الحياة التي لم يجرِ استكشافها من قبل.
ويمكننا تفهُّم الفكرة المغلوطة حول حالة “موديرنا” والكثير من الابتكارات الخلاقة الأخرى. فعادةً ما يُنظر إلى الابتكارات الخلاقة على أنها نتيجة جهود فوضوية وعشوائية لا يمكن السيطرة عليها، بمعنى أنها إما نتاج مصادفة محضة أو فكرة هبطت من السماء على شخص مُلهَم قلما يجود به الزمان. ونعتقد أن هذا التصوَّر مغلوط تماماً. فقد توصلنا بحكم مواقعنا المتميزة (قضى أفيان العقود الثلاثة الماضية في إنشاء مشاريع تعتمد على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودرس بيسانو عمليات الابتكار خلال الفترة نفسها) إلى قناعة تامة بأن النجاحات الخارقة تتحقق نتيجة اتباع عملية محددة ومُحكمَة نسبياً على غرار المبادئ الأساسية التي تستند إليها عملية التطور في الطبيعة: توليد التباين الذي يخلق مجموعة متنوعة من أشكال الحياة، والضغط الانتقائي لانتخاب الصفات التي يمكنها البقاء والتكاثر بشكل أفضل في بيئة معينة. فالنهج المسمى بالاكتشاف الابتكاري ما هو إلا عملية منظمة ومنضبطة من القفزات الفكرية والبحث المتكرر والتجريب والاختيار. وعلى الرغم من اعتماده على أشخاص ذوي مواهب استثنائية، فإنه لا يتطلب بالضرورة أن يكون هؤلاء الأشخاص بقيمة وقامة ليوناردو دا فينشي أو ستيف جوبز، مثلاً، لتحقيق ابتكار خلاق.
يبدأ الاكتشاف الابتكاري بالبحث عن الأفكار المهمة المحتملة في حيّز علمي أو تكنولوجي أو سوقي جديد نسبياً بهدف توليد استنتاجات تخمينية أو طرح أسئلة “ماذا لو” الافتراضية. تعد هذه العملية بمثابة نقطة انطلاق لعملية انتخاب مكثفة على النمط الدارويني للتوصل إلى أفكار أفضل والتحقق من صحتها، والتماس تعليقات نقدية من أطراف خارجية للوقوف على التحديات الماثلة وتطوير المفهوم إلى حل شامل وعملي. ويتطلب الاكتشاف الابتكاري ثقافة يشعر فيها الأشخاص، لا سيما القادة، في المؤسسة بالطمأنينة لطرح أفكار تبدو غير قابلة للتطبيق وتحدي الأفكار الراسخة، أي ثقافة تنظر إلى الأفكار “المعيبة” ليس باعتبارها طرقاً مسدودة، ولكن باعتبارها لبنات أساسية يمكن البناء عليها، وتَعتبِر تطور الأفكار بمثابة مسؤولية مشتركة بين الجميع.
فكرة المقالة بإيجاز
الفكر السائد
يعتقد الكثيرون أن عملية تحقيق ابتكارات خلاقة هي عملية فوضوية وعشوائية لا يمكن التحكم فيها.
الواقع
يمكن تحقيق نجاحات خارقة بشكل منهجي باستخدام عملية تشبه المبادئ التي تستند إليها عملية التطور في الطبيعة: توليد التباين الذي يخلق مجموعة متنوعة من أشكال الحياة، والضغط الانتقائي لانتخاب الصفات التي يمكنها البقاء في بيئة معينة.
العملية
تستخدم شركة “فلاغشيب بيونيرينغ” المتخصصة في إنشاء المشاريع، ومن ضمنها إنشاء شركة “موديرنا ثيرابيوتكس”، هذا النهج الذي تسميه الاكتشاف الابتكاري. وينطوي على التنقيب عن الأفكار في مجالات جديدة والتوصل إلى استنتاجات تخمينية والتشكيك في الفرضيات القائمة بلا هوادة.
تعريف الابتكار الخلاق
من المهم أن نعرّف بالضبط ما نعنيه بعبارة “الابتكار الخلاق”. ونحن نستخدم معيارين. الأول هو عدم الاستمرارية. إذ تجسد النجاحات الخارقة قفزات في مبادئ العلوم والتكنولوجيا والتصميم والاقتصاد وغيرها من مجالات المعرفة، وتؤسس نماذج جديدة للابتكار المستقبلي من خلال تغيير ما هو متوقع أو ما يُعتبر ممكناً. وبحسب هذا المعيار، فقد كان تصميم هوندا للطائرات النفاثة نجاحاً خارقاً لأنه كان أول تصميم يستخدم فكرة وضع محرك فوق الجناح، التي كانت تُعتبر فكرة غير عملية في الطائرات الصغيرة وفق قوانين الديناميكية الهوائية، إلى أن نفّذت هوندا الفكرة. وليس كل النجاحات الخارقة ذات طابع علمي أو تكنولوجي بحت بطبيعة الحال. فقد كان محرك بحث “جوجل” بمثابة نجاح تكنولوجي خارق، ولكن طريقة تسعير تكلفة النقرة للشركة أدت إلى ابتكار نموذج عمل أدى إلى قلب اقتصاديات قطاع الإعلان رأساً على عقب.
أما المعيار الثاني فيتمثل في القيمة المضافة. إذ تولد النجاحات الخارقة مصادر جديدة للقيمة المضافة من خلال حل المشكلات المستعصية أو خلق طلب لم يكن موجوداً من قبل. وربما أدت الكاميرات الرقمية، بحسب هذا المعيار، إلى تدمير مجال التصوير الفوتوغرافي للأفلام، ولكن اليوم يتم التقاط صور رقمية أكثر من أي وقت مضى باستخدام الأفلام. علاوة على ذلك، فنظراً لأن الصور الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، فقد خلق التصوير الرقمي قيمة اقتصادية هائلة.
مغالطة التسديد المكثَّف على المرمى
تتمثل الاستراتيجية السائدة اليوم في منهج “التسديد المكثَّف على المرمى” سعياً لتحقيق ابتكارات خلاقة، وهو المنهج الذي يتناقض مع منهج الاكتشاف الابتكاري. فهو يستلزم تمويل مجموعة كبيرة من المشاريع على أمل أن تكون أرباح النجاح النادر أكثر من تكلفة العديد من الإخفاقات. وتنص هذه النظرية على أنك إذا استثمرت في عددٍ كافٍ من المشروعات، فوفقاً لقوانين الاحتمالات (الحظ المطلق) ستحرز هدفاً في النهاية. وتشيع هذه الاستراتيجية في علوم الحياة وقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية المغلَّفة والقطاع الترفيهي وقطاع رأس المال المغامر (الجريء). وينطوي هذا المنهج على عنصر أساسي يتمثل في المراجعات الصارمة التي يمكن أن تؤدي إلى وأد ما يبدو أنها مشاريع ضعيفة بسرعة. كل هذا يبدو معقولاً للوهلة الأولى. حيث تسلط نظرية المحفظة المالية الحديثة وتطبيقاتها العملية الضوء على مزايا تنويع المخاطر، وقد يبدو أن نظام المراجعات الصارمة للتأكد من أنك لا تلقي بأموالك في مشاريع خاسرة إدارةٌ رشيدةٌ للموارد.
لكن منهج “التسديد المكثَّف على المرمى” يتجاهل حقيقة أن الأفكار الخلاقة عادة ما تبدو حافلة بالعيوب في البداية. في الواقع، بدت العمليات التكرارية السابقة للكثير من النجاحات الخارقة الشهيرة في البداية وكأنها ستبوء بالفشل المحقق. وقد لاقى جهاز “آيفون” استحسان الكثيرين باعتباره نقطة تحول جذرية، لكننا نتجاهل الفشل الذريع الذي مُنيت به النسخ التجريبية السابقة، مثل جهاز “نيوتن” (Newton) من إنتاج شركة “آبل”. ويعتبر دواء “كريكسيفان” (Crixivan) علاجاً ممتازاً لمكافحة الإيدز، ويمثل نجاحاً خارقاً في هذا السياق، ولكن تم وقف برنامج تطويره تقريباً عندما أسفرت التجارب الإكلينيكيّة المبكرة عن نتائج مخيبة للآمال. ولأن شعار منهج “التسديد المكثَّف على المرمى” هو الوأد المبكر ودون هوادة للأفكار غير الناجحة، فإن الكثير من الأفكار الواعدة تجد صعوبة في البقاء على قيد الحياة بعد المرحلة الجنينية.
ثمة عيب آخر يكتنف هذا المنهج وهو أن الضغط من أجل تحقيق نتائج مبكرة يمكن أن يخلق علاقة عدائية مختلة بين فرق العمل على المشاريع ومموليها. إذ يتوق الممولون إلى رؤية تقدم ملموس، بينما يكابد أعضاء الفريق معاناة التعايش مع شبح إلغاء مشاريعهم في أي لحظة (مع احتمال حدوث عواقب وخيمة تهدد وظائفهم أو سمعتهم) إذا كانت النتائج الأولية دون المستوى المطلوب. قد تؤدي هذه الديناميكية إلى مواقف تدفع فرق العمل إلى التردد في مشاركة الأخبار السيئة مع الممولين، أو مشاركة المعلومات مع فرق المشروع الأخرى التي يعتبرونها أطرافاً منافسة على الموارد الشحيحة. وهذا يعني أيضاً افتقار فرق العمل إلى الحافز لإجراء تجارب مبكرة قد تسلط الضوء على عيوب قاتلة في أفكارهم ومفاهيمهم النظرية.
وتستخدم شركة “فلاغشيب” المنهج الشامل لتنفيذ عملية الاكتشاف الابتكاري التي تم تصميمها على أساس المبادئ الأساسية للتطور، ممثلةً في توليد التباينات الوراثية وانتخابها، التي أثبتت أنها محفزات قوية للابتكار في الطبيعة. ويتم توليد التباين الوراثي عن طريق الطفرة (وهي عبارة عن تغيّرات نقطية عشوائية في شفرة الحمض النووي الوراثي) وإعادة التركيب (إعادة ترتيب شفرات الحمض النووي الوراثي). ويشير الضغط الانتقائي إلى عناصر البيئة، مثل التنافس على الغذاء، التي تؤثر على ما إذا كانت سمة معينة (مثل طول الأرجل) تناسب البقاء على قيد الحياة من عدمه. وتشير الأبحاث حول الابتكار ودراسات الحالة على قطاعات متنوعة، مثل الكيماويات والأدوية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والإلكترونيات والطائرات، إلى أن الآليات المماثلة لتوليد التباين والضغط الانتقائي تلعب دوراً حاسماً في الابتكار. وإذا تم تصميم هذه العمليات وإدارتها بالشكل الصحيح، فيمكن تسخيرها لتحقيق نجاحات خارقة. وقد طورت شركة “فلاغشيب” مبادئ الاكتشاف الابتكاري وطبقتها لإنشاء أكثر من 100 شركة في مجال علوم الحياة على مدار العقدين الماضيين. وتُعتبر شركة “موديرنا ثيرابيوتكس” خير مثال على ذلك. (إفصاح: قدّم بيسانو خدمات استشارية لشركة “موديرنا” ويرتبط معها بمصالح مالية، وهو عضو في مجالس إدارة شركتين أخريين تدعمهما شركة “فلاغشيب” ويرتبط معهما بمصالح مالية، وهما شركة “أكسيلا هيلث” (Axcella Health) وشركة “جينريت بايو ميديسنز” (Generate Biomedicines)).
لم تكن هناك لحظة “اكتشاف” مفاجئ عندما حقق “الحمض النووي الريبي المرسال” نجاحاً خارقاً. فقد تأسست منصة “موديرنا” استناداً إلى مجموعة من التكنولوجيات والأساليب والمعرفة التي تطورت بمرور الوقت.
نتاج الاكتشاف الابتكاري: “موديرنا”
تمتد جذور لقاح “موديرنا” إلى ما قبل تفشي الجائحة بفترة طويلة. وقد التقى أحدنا (أفيان) في ربيع عام 2010 روبرت لانغر من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، وهو مخترع غزير الإنتاج وأستاذ الهندسة الكيميائية، لمناقشة بعض الأفكار التي كان ديريك روسي من “جامعة هارفارد” يجري عليها أبحاثه حول استخدام جزيئات “الحمض النووي الريبي المرسال” (mRNA)، التي تنقل تعليمات الحمض النووي الوراثي إلى العضو المسؤول عن تخليق البروتين في الخلية، لإعادة برمجة نوع معين من الخلايا (الخلايا الليفية) لتخليق خلايا جذعية يمكن استخدامها بعد ذلك في الكثير من أنواع الخلايا الأخرى. اعتمد بحث روسي على العمل السابق الذي أنجزه كاتالين كاريكو ودرو وايزمان من “جامعة بنسلفانيا”، اللذان استخدما “الحمض النووي الريبي المرسال” المعدل كيميائياً لتقليل ردود الفعل المناعية الفطرية العكسية لدى الحيوانات، وليس القضاء عليها قضاءً مبرماً. وخلال مناقشاته مع لانغر، وجد أفيان أن النهج العام مثير للاهتمام، ولكن ليس بسبب إمكانية إعادة برمجة الخلايا البالغة إلى خلايا جذعية شبيهة بالأجنة. وتساءل بدلاً من ذلك عما إذا كان من الممكن استخدام “الحمض النووي الريبي المرسال” لتوجيه الخلايا لتخليق الأدوية، وهي فكرة كانت موجودة منذ عقود ولكنها لم تتحقق على أرض الواقع.
وعلى أساس هذه المناقشات وغيرها، دشّن أفيان ودوغ كول، الشريك الإداري في شركة “فلاغشيب”، عملية استكشافية لمدة 7 أشهر داخل مختبرات الشركة “فلاغشيب لابز” (Flagship Labs) التي تشهد إجراء التجارب على ابتكارات الشركة، لاستكشاف إجابات السؤال التالي: “ماذا لو استطعنا تخليق ’الحمض النووي الريبي المرسال‘ هندسياً، عند حقن المرضى به، هل سيحول خلاياهم إلى مصانع مصغرة تخلّق أي دواء علاجي حيوي نريده؟” لم ينجح أحد على الإطلاق في هندسة “الحمض النووي الريبي المرسال” لاستخدامه كدواء، أو أثبت إمكانية حدوثه. ناقش أفيان وكول جدوى الفكرة مع علماء من مختلف التخصصات، بدءاً من البيولوجيا الجزيئية والخلوية إلى الهندسة البيولوجية وتكنولوجيا النانو. ثم عينا اثنين من الباحثين الشباب من مختبر جاك زوستاك الحائز على جائزة نوبل، وهو عالم رائد في بيولوجيا “الحمض النووي الريبي”، لمحاولة التعرف على إجابة للسؤال التالي: “هل يمكن استخدام ’الحمض النووي الريبي المرسال‘ لتمكين المرضى من تخليق علاجاتهم الخاصة؟”.
أدى استكشاف هذا السؤال إلى توليد عشرات الأحجيات الأخرى. فقد أثبتت الدراسات المعملية السابقة في المختبر نجاحاً ملموساً في الحد من ردود الفعل المناعية الفطرية العكسية لـ “الحمض النووي الريبي المرسال” الاصطناعي، ولكن حتى بعد التعديلات الكيميائية، عندما تم حقن الخلايا بـ “الحمض النووي الريبي المرسال”، فقد أدى إلى تفاعلات مناعية كانت لا تزال مرتفعة جداً بحيث لا تسمح باستخدامها في الحيوانات أو لتكرار الجرعات. ولم يتم تحديد المسارات البيوكيميائية المحددة المسؤولة عن ردود الفعل المناعية. وتساءل الفريق عما إذا كانت التعديلات الكيميائية المختلفة ستؤدي إلى استجابات مناعية فطرية أقل حدة. كما ظهرت أسئلة تتعلق بالاستقرار، فجزيئات “الحمض النووي الريبي المرسال” غير مستقرة في جوهرها وعرضة للتحلل في مجرى الدم. وقد اكتشفت الأبحاث السابقة حول أنواع أخرى من “الحمض النووي الريبي” تعديلات كيميائية تجعلها أكثر استقراراً. فهل يمكن تعديل “الحمض النووي الريبي المرسال” بالطريقة نفسها؟ (اتضح فيما بعد أن هذا غير ممكن. فعلى عكس “الأحماض النووية الريبية” الأخرى، كان على جزيئات “الحمض النووي الريبي المرسال” أن تنجو من عمليتي النسخ والترجمة، وتداخلت التعديلات مع كليهما). ما التعديلات البديلة التي قد تفلح؟ تأكد من جديد عدم توافر بيانات من الحيوانات للتعرّف على إجابة هذا السؤال وغيره. فلم يعرف أحد، مثلاً، أين ذهب “الحمض النووي الريبي المرسال” بعد حقنه في الحيوانات. ولم يعرف أحد ما إذا كان “الحمض النووي الريبي المرسال” الاصطناعي سيقاوم التحلل أم لا، وما إذا كان بإمكانك الحصول على ما يكفي منه في الخلايا لتخليق البروتين. وإذا افترضنا أنك تستطيع إيصال كميات كافية منه إلى الخلايا لتحفيز إنتاج البروتين، فلم يعرف أحد ما إذا كانت البروتينات سوف “تتحول” بشكل صحيح إلى الأشكال ثلاثية الأبعاد اللازمة للعمل بشكل صحيح. وبافتراض إمكانية تخليق بروتينات وظيفية، فلم يكن من المؤكد ما إذا كان يمكن إنتاج كميات مؤثرة علاجياً. لم يتم البحث عن إجابات لهذه الأسئلة فحسب، بل لم يتم حتى التوصل إلى الأدوات اللازمة لمعالجتها.
وبعد عدة أشهر، كان لدى الفريق الكثير من الأسئلة الصعبة والقليل من الإجابات. ورأى أعضاء فريق المشروع في “بروتوكو إل إس 18” (ProtoCo LS18)، وهو الاسم الذي كان يُطلَق على النموذج الأولي التجريبي للشركة، أن هذه الفكرة ستحقق قيمة تجارية هائلة إذا تمكنوا من الإجابة عن هذه الأسئلة. ومع ندرة الأبحاث السابقة في هذا المجال، فإن الكثير من إنجازاتهم ستكون قابلة للتسجيل كبراءة اختراع. وفي خريف عام 2010، بدأت شركة “فلاغشيب” في تسجيل براءات اختراع تغطي التعديلات الكيميائية الجديدة والتراكيب العلاجية لـ”الحمض النووي الريبي المرسال”. وفي عام 2011، تم تغيير اسم المبادرة إلى “موديرنا”، وانتقل علماؤها إلى مختبر “فرست ستريت” (First Street) في كامبريدج. عكف الفريق خلال الأشهر الستة التالية على حقن فئران التجارب بتراكيب مختلفة من “الحمض النووي الريبي المرسال” المعدل كيميائياً. ولم يكن من المفاجئ ألا يُفلِت الكثير من الجزيئات من عمليتي النسخ والترجمة، ولكن أفلت بعضها منهما. وبدأ بعض الفئران في إنتاج بروتينات لم تكن لتنتجها لولا حقنها بهذه التراكيب، وأنتجتها بكميات صغيرة في البداية ثم بكميات أكبر. كان هذا أول دليل فعلي على الجدوى العلمية للفكرة.
تسلط قصة “موديرنا” الضوء على العديد من الجوانب البارزة لعملية تحقيق نجاحات خارقة. أولاً: تنشأ النجاحات الخارقة من تراكم الكثير من التطورات، بعضها كبير وبعضها صغير. لم تكن هناك لحظة “اكتشاف” مفاجئ بالمعنى الدقيق للكلمة عندما حقق “الحمض النووي الريبي المرسال” نجاحاً خارقاً. في الواقع، لم يكن هناك نجاح خارق واحد لـ”الحمض النووي الريبي المرسال”: فقد تأسست منصة “موديرنا” حول “الحمض النووي الريبي المرسال” استناداً إلى مجموعة من التكنولوجيات والأساليب والتقنيات والمعرفة التي تطورت بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال: أدرك الفريق في وقت مبكر أن الجهاز المناعي اعتبر أن “الحمض النووي الريبي المرسال” المحقون جسمٌ غريبٌ ومُعادٍ، وبالتالي فقد هاجم الجزيئات وأوقف إنتاج البروتينات المطلوبة. استغرق حل هذه المشكلة سنوات، وتضمن تطوير طرق مبتكرة للتوصل لتركيبة معينة لـ”الحمض النووي الريبي المرسال” بحيث يمكنه خداع جهاز المناعة والوصول إلى الخلايا المناسبة في الجسم.
ثانياً: لا تتطلب النجاحات الخارقة توجيه التركيز على مشكلة أو حاجة معينة في البداية. فقد بدأ بحث شركة “فلاغشيب” بتكهنات حول حالة استخدام موسّعة: هل يمكن استخدام “الحمض النووي الريبي المرسال” كوسيلة دوائية جديدة؟ ولكن لم يكن هناك مرض معين يحتاج إلى علاج أو حالة مَرَضية تحتاج إلى تدخل طبي. ورغم أن شركة “موديرنا” تشتهر هذه الأيام بلقاح “كوفيد-19″، فإن اللقاحات المضادة للأمراض المعدية لم تكن تشغل بال الشركة في المراحل المبكرة، ولا علاجات السرطان أو أنواع اللقاحات الأخرى التي تشكل الآن قوة دفع رئيسية للشركة. وقد تطور البحث عن التطبيقات العملية المصحوب بالفهم العميق للتكنولوجيا.
ثالثاً، وأخيراً: تنشأ النجاحات الخارقة على وقع التخمينات المستبعدة بعض الشيء، بل والتكهنات التي قد تبدو غير معقولة بالمرة، بدليل أن السؤال الذي يقول: “ماذا لو كان ’الحمض النووي الريبي المرسال‘ يصلح كدواء علاجي؟” كان سؤالاً افتراضياً بحتاً عام 2010 (حتى إن الكثير من الخبراء أبدوا شكهم في جدوى اللقاحات القائمة على “الحمض النووي الريبي المرسال” ضد فيروس “كوفيد-19” في أواخر صيف عام 2020). ولكن كان هذا هو الهدف. كان الغرض الوحيد من طرح سؤال “ماذا لو” الافتراضي هو ضبط الاستكشاف وتوجيهه. وهكذا لم يكن شرطاً أن تكون الشركة على صواب لكي تحقق النجاح. في الواقع، ثبت خطأ الكثير من التكهنات الأولية حول “الحمض النووي الريبي المرسال”، ولكن تم التوصل إلى رؤى مهمة أخرى خلال هذه المرحلة. ورغم أن أحداً لم يستطع التنبؤ بمآلات العملية الاستكشافية، فإنها لم تكن عملية عشوائية ولا فوضوية. فقد تطورت الفكرة وظهر الحل من خلال مجموعة دقيقة التنظيم من الأنشطة التي تتضمن توليد التباين والضغط الانتقائي.
والآن لنستعرض هذين العنصرين من عملية الاكتشاف الابتكاري بمزيد من العمق.
توليد التباين: طرح أسئلة “ماذا لو” الافتراضية
لا يحدث توليد التباين تلقائياً في عالم الابتكار، بخلاف ما يحدث في العالم الطبيعي. إذ يجب تحفيزه من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة لتحقيق الأهداف أو الذين يبحثون عن تصورات جديدة. لكن فرق الابتكار كثيراً ما تحصر تفكيرها في تعديل الأفكار المعروفة بنجاحها وتنقيحها. فعلى سبيل المثال: ظلت الأفكار المرتبطة برفع كفاءة السيارات في استهلاك الوقود وتقليل أضرارها على البيئة لعقود عديدة تتألف من تحسينات تدريجية في تصميم المحرك (كإضافة شواحن توربينية واستخدام الأجهزة الإلكترونية للتحكم بشكل أكثر دقة في عملية الاحتراق الداخلي للوقود) وجعل المركبات أخف وزناً وإضافة أجهزة جديدة، مثل المحولات الحَفَّازة. استندت كل هذه التحسينات إلى محرك الاحتراق الداخلي كنقطة انطلاق. ويتطلب الابتكار الخلاق التفكير في بدائل تتجاوز الآفاق العلمية أو التكنولوجية أو التصميمية أو الاقتصادية الحالية. فلم تصبح السيارات الكهربائية ذات جدوى حقيقية إلى أن أصبحت بطاريات أيون الليثيوم فاعلة بالشكل الكافي، بفضل التقدم الذي حدث في مجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة. ولا تتحقق هذه القفزات تلقائياً. في الواقع، غالباً ما تؤدي التحيّزات المعرفية والحوافز غير المتوافقة والتشبث بأفكار راسخة وغيرها من العوامل السلبية إلى عرقلة التكهنات. وهناك حاجة إلى آليات عمل تساعدنا على التغلب على هذه العراقيل.
وقد تصميم عملية توليد التباين في شركة “فلاغشيب” لإحداث نجاحات خارقة في المجالات التي لم تتعرض للاستكشاف من قبل، ومن الواضح أنها تستثني مجالات العلوم التي شهدت بالفعل تأسيس شركات أخرى أو أُجريت فيها أبحاث مكثفة في السابق. حيث يتم تعيين فرق صغيرة متعددة التخصصات من علماء “فلاغشيب” وكبار قادتها (وجميعهم لديهم خلفيات علمية) لاستكشاف مجالات محددة (مثل تطبيق الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية). ولأن أعضاء فرق الاستكشاف يعملون في مجالات لم يسبق أن تعرضت للكثير من الأبحاث، فلا يمكنهم اتباع العملية التقليدية المؤلّفة من قراءة الدراسات السابقة وتحديد الثغرات ثم معالجة هذه الثغرات. ولكنهم بدؤوا بدلاً من ذلك بطرح سلسلة من أسئلة “ماذا لو” الافتراضية المشتقة من الاستكشاف الدقيق لمختلف فروع العلوم.
فنحن نعلم، على سبيل المثال، أن جسم الإنسان يحتوي على الكثير من أشكال الحياة المختلفة أو يتفاعل معها من خلال استهلاك المواد الغذائية، ممثلة في الخلايا الحيوانية والفطريات والبكتيريا والنباتات والفيروسات وغيرها من الكائنات وحيدة الخلية. قد تقود هذه الحقيقة إلى طرح أسئلة، مثل: ماذا تفعل كل أشكال الحياة هذه في أجسامنا، وكيف تتفاعل مع بعضها؟ هل هناك تواصل جزيئي عبر أشكال الحياة هذه؟ هل تعمل البكتيريا في أجسامنا مع خلايانا لأداء وظائف التمثيل الغذائي والمناعة، بل والوظائف العصبية؟ (اتضح أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي “نعم”). وهذه بدورها تؤدي إلى استنتاجات تخمينية: ماذا لو تمكنا من تطوير أدوية تستخدم هذه الشبكات لتحسين أحوالنا الصحية؟ كانت أسئلة “ماذا لو” الافتراضية من هذا القبيل هي الأساس الذي قام عليه مشروع “سيندا بايو ساينس” (Senda Biosciences) التابع لشركة “فلاغشيب”، وهو مشروع يركز على تطبيقات الرعاية الصحية المرتبطة ببيولوجيا أجهزة الجسم.
ورغم أنها أسئلة تخمينية، فإن أسئلة “ماذا لو” الوجيهة تستند إلى فهم عميق للظواهر البيولوجية. (على سبيل المثال: يحتوي النظام الإيكولوجي البشري على الكثير من أشكال الحياة، ويلعب “الحمض النووي الريبي المرسال” دوراً حاسماً في إنتاج البروتينات داخل الخلايا). وتم التوصل إليها من خلال دراسة ما هو معروف وغير معروف عن أنظمة بيولوجية معينة دراسة دقيقة. على سبيل المثال: دشّن فريق “فلاغشيب” أولى محاولاته بدايةً من عام 2014 لاستكشاف طرق استخدام خلايا الدم الحمراء البشرية كعوامل علاجية. في ذلك الحين، كان هناك علماء آخرون يعكفون على تطوير “الخلايا التائية” (T Cells) المُعدّلة وراثياً كطريقة جديدة لمحاربة السرطان. أدى هذا إلى تساؤل أعضاء الفريق: “ماذا لو استطعنا إنتاج خلايا الدم الحمراء المُعدّلة وراثياً (أكثر أنواع الخلايا وفرة في الجسم) التي تحتوي على واحد أو أكثر من البروتينات النشطة علاجياً، سواء داخلها أو على سطحها، كنوع جديد من الأدوية؟” في ذلك الحين، لم تكن هناك بيانات تشير إلى إمكانية صنع مثل هذه الخلايا أو أنها ستنجح في أداء هذا الدور. وتحول مشروع “بروتوكو إل إس 24” لاحقاً إلى مشروع “روبيوس ثيرابيوتكس” (Rubius Therapeutics).
تتطلب عملية توليد التباين أيضاً تعاوناً قوياً بين مختلف التخصصات. فقد تضم فرق مشاريع “فلاغشيب”، مثلاً، مهندساً كيميائياً وعالم أحياء حاسوبياً وعالم أحياء خلوياً وطبيباً للأورام، وكلهم يمتلكون عدداً من الرؤى والأفكار التي تعد في حد ذاتها مصدراً لتوليد التباين. وأثبتت الأبحاث أن الفرق متعددة التخصصات التي تعمل بشكل جيد تسهم في توسيع نطاق الاستكشاف من خلال الجمع بين مجالات المعرفة المتباينة في الأساس.
ويُعتبر طرح أسئلة “ماذا لو” الافتراضية أسلوباً قديماً يعود إلى حقبة أرسطو، إلا أن هذه الأداة الإبداعية التي تبدو في غاية البساطة يصعب استخدامها في الواقع العملي. ونستطيع أن نقول بحكم في خبرتنا إن هناك 3 أشياء تعترض طريقنا.
الخطأ الأول: يجب إثبات صحة الفرضية على وجه السرعة. تتعرض فرق الابتكار في أغلب الأحيان إلى ضغوط هائلة لإثبات صحة فرضياتها في مرحلة مبكرة. لكن تحقيق هذا المطلب يخلق ما يُطلَق عليه “قوة الجاذبية الفكرية”، وهو ما يعني التحيز ضد المحاولات التجريبية البعيدة عن قواعد المعرفة المستقرة. إذ يجب أن يكون سؤال “ماذا لو” الافتراضي نقطة انطلاق تخمينية بحتة، وهو ما يعني أن يصبح التخمين بؤرة التجريب التكراري المكثف والاختبار وإعادة التقييم والتطور. وقد أرست شركة “فلاغشيب” ثقافة مؤسسية تعترف بصورة لا لبس فيها بأن هذه الفرضيات قد لا تكون صحيحة بالضرورة في لحظة طرحها. إذ يفترض الجميع أن هذه الفرضيات تكتنفها بعض العيوب، وهذا أمر طبيعي، فعند العمل في مجال مجهول، يكاد يكون من المستحيل أن يكون افتراضك الأولي صحيحاً بنسبة 100%.
الخطأ الثاني: يجب أن يعالج سؤال “ماذا لو” الافتراضي مشكلة معينة. يبدأ الاكتشاف القائم على المشكلة الذي تم استخدامه بنجاح كبير من قبل مؤسسات، مثل “وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة” الأميركية (داربا)، بمشكلة مستهدفة يجب حلها (مثل كيفية تصميم طائرة قادرة على الطيران أسرع من الصوت بـ 20 ضعفاً). ويوضح سجل إنجازات “وكالة داربا” أن هذا النهج يمكن أن يكون فاعلاً. في حين أن سجل إنجازات شركة “فلاغشيب” يشير إلى أن حصر التركيز على مشكلة معينة ليس ضرورياً لتحقيق الابتكار الخلاق، وأن عدم وجود مشكلة يؤدي في بعض الظروف إلى مزيد من الإبداع. حيث تراعي شركة “فلاغشيب” في المراحل الأولى من الاستكشاف مجالات واسعة محتملة للتطبيقات العملية أو الاستخدامات المحتملة بدلاً من التركيز على المشكلات أو الأسواق المحددة. فعلى سبيل المثال، لم يكن الدافع وراء عملية الاستكشاف لمشروع آخر من مشاريع “فلاغشيب”، ممثلاً في شركة “جينريت بايو ميديسنز”، هو الرغبة في علاج مرض معين، لكنه بدأ بدلاً من ذلك كمحاولة للتحقق مما إذا كان بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي لتوسيع ترسانة الأدوية البيولوجية الممكنة. أدى ذلك إلى تطوير منصة حاسوبية قادرة على إنتاج بروتينات جديدة تماماً للعلاج الحيوي.
ولا يمكن الزعم بأن أحد النهجين أفضل من الآخر، لكن كلاً منهما يناسب أنواعاً معينة من المؤسسات والاستراتيجيات، حسب طبيعتها وظروفها الخاصة. وتقتضي المهمة المؤسسية لـ “وكالة داربا” التصدي لمجموعة محددة جداً من المشاكل العسكرية التي لا بد من حلها. وبالتالي، فإن نهجها القائم على المشكلة يناسب استراتيجيتها. لكن المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق ابتكار خلاق في مجالات غير مستكشفة تحتاج إلى مزيد من الحرية لطرح أسئلة أولية وتوسيع نطاق الاستكشاف. ويمكن في الواقع المزج بين هذين المنهجين للعثور على حلول جديدة، من خلال البدء بفرضيات حول الحلول والمشكلات.
الخطأ الثالث: قد تكون الفرضية غامضة وغير دقيقة. يجب ألا تكون الفرضيات رؤى تفتقر إلى أي من صور الأفكار غير المنظمة، بل يجب أن تكون تأكيدات ملموسة لكيفية عمل شيء ما. فمجرد اعتبارها تخمينية لا يعني أنها تتصف بالغموض أو تفتقر إلى السمات التفصيلية. قد يبدو هذا منافياً للمنطق، وإلا لماذا نتعب أنفسنا في تحديد التفاصيل في مرحلة مبكرة إذا كان من الوارد جداً أن يَثبُت خطأ الحل المقترح؟ تكمن الإجابة في أن التفاصيل مهمة لأنها توفر نقطة محورية للبحث والاختبار والتطور اللاحقين. وسيكون من الصعب في غيابها معرفة الأسئلة التي يجب طرحها بعد ذلك والتجارب التي قد يكون من الضروري إجراؤها. وعليك أن تراعي الفرق بين الافتراضين التاليين: “ماذا لو استطعنا صنع سيارة ذاتية القيادة؟” مقارنة بالفرضية القائمة على التساؤل التالي: “ماذا لو استطعنا إنشاء نظام قيادة ذاتي الحركة تماماً باستخدام تقنيات الرؤية بزاوية 360 درجة المزودة بأجهزة الاستشعار الليدارية (أجهزة رادار تعمل بالليزر)، وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء والموجات فوق الصوتية، وكاميرات مثبتة في مقدمة السيارة ومؤخرتها وعلى جانبيها، وجهاز كمبيوتر مثبت على جسم السيارة يستطيع معالجة 30 تريليون عملية فاصلة عائمة في الثانية (فلوبس)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام تحديد المواقع (جي بي إس) دقيق في حدود متر واحد، ونظام قياس عن بُعد في الوقت الحقيقي من سيارة إلى أخرى؟” من الصعب معرفة كيفية الرد على السؤال الأول بخلاف قول شيء (غير مفيد بالمرة)، مثل: “مدهش، يبدو هذا رائعاً”. بينما يدعو الاقتراح الثاني الملموس إلى طرح عدد من الأسئلة، مثل: “هل تكفي 30 تريليون عملية فاصلة عائمة في الثانية؟” و”ما نوع نظام القياس عن بُعد المطلوب للسيارة؟”. من الواضح أن المرء لن يعرف على الأرجح ما يكفي لصياغة فرضية دقيقة للغاية في بداية الاستكشاف، ولكن طرح مثل هذه الفرضيات في أسرع وقت ممكن يجب أن يكون هدفاً تسعى إليه المؤسسات. فكر في الفرضيات كمقاصد بديلة (غالباً ما تترك “فلاغشيب” مساحة لأكثر من فرضية). وإذا لم تكن واضحاً بشأن المقصد الذي تريد الوصول إليه في النهاية، فمن الصعب اختيار اتجاه محدد، ومن المستحيل معرفة ما إذا كنت تحرز تقدماً في سبيل الوصول إليه.
الضغط الانتقائي: الوصول إلى مرحلة “لقد تبين أن…”
يُعتبر التباين في الطبيعة مجرد خطوة أولية في رحلة التطور. ويشكّل الضغط الانتقائي من خلال التنافس على الموارد (كالغذاء، مثلاً) أشكالاً للتغيرات الوراثية (كطول المناقير، مثلاً) التي تعجز عن امتلاك القدرة على البقاء. ويؤدي تطبيق الضغط الانتقائي في مجال الابتكار إلى التشكيك في الفرضيات وتنقيحها بلا هوادة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها وإجراء التجارب بصورة رسمية وطلب آراء خبراء خارجيين وملاحظاتهم النقدية. وتستخدم شركة “فلاغشيب” كل هذه الوسائل. إذ تعرض فرضياتها على شبكة واسعة من العلماء، مدركة تمام الإدراك أن الكثيرين منهم سينظرون إليها نظرة تنم عن الشك، ولكنها تدرك أيضاً أن أكثرهم شكاً (الشخص الذي يقول: “لن تنجح هذه الفكرة على الإطلاق”) سيمدها برؤى قيمة تسهم في تطوير أفكارها. ويتعرّف أعضاء فريق “فلاغشيب” من خلال هذه المناقشات على العلوم السابقة التي قد تكون ذات صلة بأفكارهم المطروحة وعلى الأشخاص الذين قد يمتلكون خبرات مفيدة في هذا السياق.
وإذا نجح الضغط الانتقائي، فستظهر عيوب في الفرضيات الأولية. فقد تكون العيوب عميقة في بعض الحالات لدرجة أنها تستدعي التخلي عن المفهوم الأساسي أو إعادة النظر فيه. ويتم إجراء “تجارب إقصائية” في المراحل المبكرة لتحديد ما إذا كانت الفكرة تواجه عقبة لا يمكن تجاوزها. على سبيل المثال: في الأيام الأولى لبرنامج أبحاث “موديرنا”، كانت التجارب تهدف إلى فهم الخصائص المناعية لـ “الحمض النووي الريبي المرسال” وما إذا كان يمكن تجنب الاستجابة المناعية، لأنه إذا لم يكن من الممكن تجنبها، فإن فكرة استخدام “الحمض النووي الريبي المرسال” كدواء سيكون محكوماً عليها بالفشل.
ولكن حتى إذا ثبت “فشل” التجربة، فإن هذا يوفر في كثير من الحالات نقطة انطلاق لمزيد من البحث أو تطوير فرضيات بديلة. ومع كل تكرار يتم تجاهل الفرضيات أو تأكيدها أو تنقيحها، وتتطور الأفكار الأساسية حول ما هو ممكن ومفيد، حتى يتم التوصل إلى اختراع قابل للتنفيذ. وتعتبر شركة “فلاغشيب” أن هذه الخطوة هي اللحظة التي يتم فيها تحويل سؤال “ماذا لو” الافتراضي إلى عبارة “لقد تبين أن…”.
ويشتمل أحد العناصر الأساسية للضغط الانتقائي على تحقيق التكامل بين مفاهيم متنوعة. وغالباً ما تبذل شركة “فلاغشيب” جهوداً موازية لاستكشاف قضية معينة (مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أدوية جديدة). ولا يتمثل الهدف من الجهود الموازية في تعزيز المنافسة الداخلية التي تؤدي إلى إقصاء الأفكار “الفاشلة” (كما يحدث غالباً في الشركات الكبرى)، ولكنه يهدف بدلاً من ذلك إلى توسيع دائرة التعلم وإيجاد مسارات لتحقيق التقدم المنشود. في بعض الحالات عندما يكون هناك جهدان متوازيان أو أكثر، فقد يحل كل منهما جزءاً من الأحجية وليس الأحجية كلها، وسيكون من الأفضل دمج الحلين معاً. فعلى سبيل المثال: دشّنت شركة “فلاغشيب” جهدين عام 2013 لاستكشاف ما إذا كانت هناك سلالات من البكتيريا في أمعائنا يمكنها التحكم في الخلايا المناعية، إما لتنشيط الاستجابات المناعية أو لكبحها. وأسفر الجهدان عن تطوير مناهج بحثية خاصة، وأديا إلى التوصل إلى أدلة تثبت وجود مثل هذه البكتيريا، وإذا تم تطويرها إلى سلالات وحيدة النسيلة، فيمكن أن تشكّل عناصر فاعلة في ضبط المناعة. وأدى قرار دمج الجهدين وتطوير منصة مشتركة إلى اكتشاف أدوية جديدة تُؤخَذ عن طريق الفم وإنتاجها في شركة “إيفيلو بايو ساينسز” (Evelo Biosciences) التابعة لشركة “فلاغشيب”.
يختلف هذا النهج التجريبي عن النهج المُستخدَم في الكثير من المؤسسات، بما في ذلك شركات رأس المال المغامر ووكالات التمويل. حيث يشيع استخدام التجارب كأدوات لغربلة الأفكار وفق منهج “التسديد المكثَّف على المرمى” المُستخدَم في الابتكار. وتعد التجارب في عملية الاكتشاف الابتكاري بمثابة أدوات استقصائية مصممة لتحقيق التقدم المنشود. وعندما تفشل التجربة في دعم فرضية ما، فمن المتوقع أن يبحث أعضاء فريق المشروع عن الأسباب الجذرية لتوسيع فهمهم للقضية محل البحث. وما لم يكتشف الفريق خطأً قاتلاً في الفرضية الأساسية، فإنه يستمر في تطوير الفكرة، متسائلاً: “ما الذي فاتنا؟ وما النهج البديل؟ وما الذي يجدر بنا تغييره؟ وما التجربة التالية؟”.
على سبيل المثال: في الأيام الأولى للمشروع الذي أخذ فيما بعد اسم “أكسيلا هيلث”، ركز فريق “فلاغشيب” على إنتاج بروتينات مُعادة التركيب للحصول على الفائدة العلاجية التي تتكون من الأحماض الأمينية الموجودة بكثرة في جسم الإنسان. وفي حين أن هذا كان ممكناً من الناحية النظرية، فقد تبين أنه من الصعب للغاية تخليق البروتينات بالكميات المطلوبة وبمستوى النقاء الضروري وبتكلفة ميسورة. لكن هذا العائق أدى إلى فكرة أخرى: لماذا لا نستخدم تراكيب مصممة بعناية من الأحماض الأمينية نفسها (المتوفرة بسهولة) كمكونات للعقاقير بدلاً من محاولة إنتاج بروتين يحتوي عليها؟ وأثبتت التجارب الإضافية صحة هذه الفكرة الجديدة ووفرت مساراً تطويرياً أسرع مما كان متوقعاً في ظل النهج الأساسي.
قد يبدو الاكتشاف الابتكاري محفوفاً بالمخاطر ومكلفاً. لكن إذا تم تصميم العمليات التكرارية وإدارتها بشكل صحيح، فيمكن أن تكون فاعلة للغاية في الواقع. ويكمن مفتاح السر في جعل كل عملية تكرارية رخيصة وسريعة قدر الإمكان، بدلاً من الخوض في كل الفرضيات. وتحرص شركة “فلاغشيب” على رشاقة المراحل الأولى من الاستكشاف والاختبار التجريبي قدر الإمكان. وتهدف من وراء ذلك إلى تحديد جدوى الأفكار المطروحة باستثمار لا يتجاوز مليون دولار إلى مليوني دولار على مدى فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. ولا تُقدِم على إنشاء شركة خاصة بتنفيذ الفكرة وضخ استثمارات رأسمالية أكبر إلا بعد ثبوت الجدوى المعقولة لهذه المرحلة والمضي قدماً. وتهدف هذه العملية التكرارية إلى تعظيم “نسبة التعلم إلى التكلفة”، أي توليد أقصى قدر من الاستفادة من كل دولار يتم إنفاقه.
وما لم يكتشف الفريق خطأً قاتلاً في الفرضية الأساسية، فإنه يستمر في تطوير الفكرة، متسائلاً: “ما الذي فاتنا؟ وما الذي يجدر بنا تغييره؟ وما التجربة التالية؟”.
تعزيز ثقافة الاكتشاف الابتكاري
لا تمثل العملية المنضبطة والمحددة بدقة سوى جزءاً مما يتطلبه الأمر لممارسة الاكتشاف الابتكاري. إذ لا بد أيضاً من امتلاك العقلية والثقافة المؤسسية والسلوكيات القيادية الصحيحة. وإليك فيما يلي 3 من أكثر الأمور أهمية:
احرص على إرساء ثقافة قبول تحدي اللامعقول. يمكننا أن نستشف من تعريف النجاحات الخارقة أنها تتحدى في مراحلها الجنينية النظريات والمبادئ المتعارف عليها وما توصلت إليه الخبرات السابقة. ويجب اعتبارها من هذا المنطلق قفزات في وجه المعتقدات الراسخة. لذا عليك أن تُرسي ثقافة تقبل بالتفكير فيما قد يبدو مستحيلاً، إن أردت تعزيز الاكتشاف الابتكاري في مؤسستك. إذ يجب أن يكون قادة الفريق وأعضاؤه على أتم الاستعداد في المراحل المبكرة من العملية للتخلي عن عدم تصديقهم لنجاعة الأفكار المطروحة وأن يحتفظوا لأنفسهم بالحكم على صحة الفرضيات من عدمها. وهناك أسئلة شائعة (ومنطقية جداً) يمكن أن تُنهي عملية الاستقصاء قبل أن تبدأ، مثل: “لماذا تعتقد أن هذه الفكرة صحيحة؟” و”كيف عرفت أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها؟”. احرص بدلاً من ذلك على طرح أسئلة، مثل: “ما التجربة التي يمكنك إجراؤها لاختبار صحة هذه الفرضية؟” و”إذا كانت فرضيتك صحيحة، فما الاستخدامات المحتملة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة؟”. إذ تؤثر الطريقة التي يتفاعل بها القادة مع الفرضيات الأولية بشكل كبير على مصير الأفكار الأكثر إبداعاً، وما إذا كانت ستموت في مهدها أم ستتاح لها الفرصة للتطور لتتحول إلى شيء مؤثر.
استفد من رؤى النُقَّاد لتحسين أفكارك. عادةً ما تتحدى الابتكارات الخلاقة الأفكار السائدة، أي مجموعة المعتقدات الجماعية حول ما هو ممكن وما هو مقبول. واعلم أن تحدي الأفكار السائدة يعني أيضاً تحدي الأشخاص (“الشخصيات المهيمنة على الساحة”) التي بنت سمعتها حول موثوقيتها. ونستشف من أحداث التاريخ أن الأشخاص الذين يتحدون الفكر السائد غالباً ما يتعرضون لاتهامات بالتهور أو انعدام الكفاءة أو ما هو أسوأ.
فيجب على القادة إرساء ثقافة قبول تحدي الأفكار الراسخة. ولك أن تنظر مثلاً إلى الممارسة الشائعة المتمثلة في الاستعانة بخبراء خارجيين لفحص الأفكار المبتكرة داخلياً أو لإجراء عملية الفحص النافي للجهالة بشأن الاستثمارات المقترحة. لا شك في أن الحصول على مثل هذه الآراء الخارجية يعد فكرة جيدة من حيث المبدأ. لكن هؤلاء الخبراء ينبرون في كثير من الأحيان للدفاع عن الفكر السائد. لذ يُفضَّل أن تستعين بهم لتحسين الأفكار، وذلك من خلال تحديد الافتراض النقدي الذي يجب اختباره، على سبيل المثال لا الحصر. فإذا استعنا بخبراء يُبدون شكهم في الأفكار المطروحة واستطعنا تحمل انتقاداتهم اللاذعة في بعض الأحيان، فيمكننا أن نتعلم الكثير حول ما يتعين علينا فعله لتطوير أفكارنا.
اربط النجاح بالأفكار وليس الملكية الشخصية. يقر منهج الاكتشاف الابتكاري بوضوح أن الأفكار تُبنى بمرور الوقت نتيجة إسهامات الكثير من الأشخاص. وهكذا، فقد تكون الفكرة الخاطئة المطروحة من قِبَل أحد الأشخاص الشهر الماضي هي اللبنة الأساسية لفكرة ناجحة يطرحها شخص آخر هذا الشهر. وهذا يعني أن الفكرتين على القدر ذاته من الأهمية للعملية الابتكارية. وتتطلب متابعة الاكتشافات الابتكارية في مؤسستك إرساء ثقافة لا تجعل الأفكار “مملوكة” للأفراد ولكنها تعتبر جزءاً من الأطروحات الفكرية المتاحة على المشاع. وفصل الأفكار عن الأشخاص يعني أيضاً أن الفكرة الفاشلة لا تمثل فشلاً شخصياً، وهو ما يعني بدوره أن الاكتشافات الابتكارية ستعمل بشكل أفضل إذا نالت الفرق المشاركة في الجهود المبذولة نصيبها من الحوافز والمكافآت.
قيادة الاكتشافات الابتكارية
ثمة فكرة سائدة تقول بأن الابتكارات الخلاقة هي عملية عشوائية وفوضوية تعتمد إلى حد كبير على البصيرة الفذة للعباقرة الموهوبين، ما يجعل المؤسسات تتردد غالباً في تبنيها كعنصر أساسي في استراتيجيتها. وهذا أمر مؤسف نظراً للقيمة الهائلة التي تنتجها النجاحات الخارقة للمجتمع والشركات التي تنجح في تحقيقها. لكن لا يوجد شيء غامض أو سحري في هذه العملية. إذ يمكن أن يتحقق الابتكار الخلاق من خلال عملية صارمة ومنضبطة من القفزات الفكرية والبحث التكراري والتجريب والاختيار. فالاكتشاف الابتكاري هو عملية قابلة للتكرار يمكن تعلمها.
بيد أن إتقانها يتطلب ما هو أكثر من فهم آليات هذه العملية، فهو يتطلب مؤسسة يتبنى فيها الأفراد، ولا سيما القادة، العقلية والسلوكيات الصحيحة. يجب أن يكونوا على استعداد للنظر بعين الاعتبار إلى الأفكار التي تبدو غير معقولة ويتخلوا عن الحكم على صحتها من عدمها في المراحل الأولى من عملية الاكتشاف. يجب عليهم تبني فكرة التعلم من خلال إجراء تجارب مكثفة ومن الفشل، إلى جانب إعطاء الأولوية للإسهامات الجماعية على حساب الملكية الشخصية للأفكار.
فاعتماد المؤسسة لهذه العادات يتوقف في النهاية على سلوكيات قادتها. ويعد السعي وراء الابتكار الخلاق تحدياً للقيادة بقدر ما هو تحدٍ تقني. وإذا كنا قد تعلمنا شيئاً من كارثة “كوفيد-19″، فقد علمتنا أن العالم يمكن أن يتغير بشكل كبير في وقت قصير. وباستشراف المستقبل، فيجب على كل الشركات بناء القدرة على القفز إلى ما وراء مناطق الراحة الحالية. فنحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى قادة يمكنهم قيادة الابتكار الخلاق.
تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .