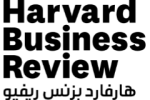في كل يوم من أيام عملي طبيباً نفسانياً للأطفال، يُطلب مني أن أساعد صغار السن الذين يجدون صعوبة في تحسين أدائهم. فعلى سبيل المثال، شاهدتُ بالأمس صبياً، ولنسميه “تومي” كان متعثراً في السنة السادسة بالمدرسة رغم المساعي المستميتة التي كان يجربها معه مدرسوه ووالداه لحثه على بذل مجهود أكبر. ولما لاحظتُ ملامح اليأس عالقة على وجهه، لم أتردد في اللجوء إلى منهجية ابتكرتُها للتعامل مع أطفال في مثل حالته. وتبدأ الخطوة الأولى بالتعرف على ما يحب عمله (بناء أشكال ولعب الغيتار) وما يجيده (الرياضيات والعلوم والموسيقى والمشاريع العملية)، ثم تشجيعه على أن يداوم على ممارستها. كما رتَّبتُ مع المدرسة أن تعفيه من حضور فصل مع معلِّمة لم يكن على وفاق معها، وإلحاقه بفصل يشعر فيه براحة أكثر، وأوصيتُ الأشخاص الكبار في حياته أن يتأكدوا من مشاركته الخلاقة في الفصل، بدلاً من الجلوس الخامل الذي يصيبه بالضجر. وطلبتُ منهم أن يستنفروا التحدي بنفس “تومي” ولكن بلا عقاب؛ فالرسالة التي يجب أن تصله هي “أنا أطلب منك المزيد لأني أعرف أنك تقدر على ذلك”. وفي غضون أسابيع، كان يبذل جهداً أكبر، بل كان حريصاً على الذهاب إلى المدرسة. وبدأ يسمع التعقيبات الإيجابية؛ مما شحذ رغبته في الإصرار على بذل مجهود أكبر.
ولعلك تتساءل عن وجه الصلة بين هذه القصة وعملك، وأنت شخص راشد وتعمل في مؤسسة أعمال لها أنشطة ضخمة، بل ربما تديرها. والإجابة هي أن الكثير من الناس يشعرون تماما مثلما شعر “تومي” في المدرسة. ولتنظر إلى هذه النماذج الثلاثة لأشخاص في مناصب تنفيذية: ميغان التي تعمل في التسويق وتتحلى بأعلى مستويات المهارة وأفضل عادات العمل، تجرّ نفسها جرّاً للذهاب إلى شركتها حيث لا تطيق الثقافة السائدة فيها من غيبة ومحسوبية وتحزبات. وأليكس الخريج من كلية هارفارد للحقوق يمضي قدماً بخطى واثقة كي يصبح شريكاً في مكتب محاماة مرموق في نيويورك، ومع ذلك، فإنه يكره وظيفته. وكل يوم يحمل نفسه على ارتداء بذلته الرسمية وربطة عنقه، ويحرص على رسم ابتسامة على وجهه وهو خارج من المصعد. أما “لوك”، وهو مدير أقدم في شركة ناجحة من شركات أغذية الحيوانات المنزلية، التي استحوذت عليها مؤخراً مؤسسة ضخمة. وكان مندهشاً من السرعة التي انقشع بها السحر عن شركته الصغيرة بعد الاستحواذ.
وفي كل نموذج من النماذج الثلاثة كان تشخيصي لحالتهم هو “داء” سمَّيتُه “الانفصال” يمكنه الانتشار كما يجتاح الفيروس الأجسام، فيمتص العصارة الحيوية التي تضمن الصحة للشركات. ففي ظل التغير السريع الذي يشهده عالم الأعمال؛ حيث ما كان جديداً يصبح قديماً، وما كان سريعاً يصبح بطيئاً، وما كان خاصاً يصبح عاماً، وما كان جامعاً يُستعاض عنه باتجاه تفكيكي، وينحسر الوفاء، ويتحول النقاش القوي البنَّاء إلى أصوات ضعيفة متفرقة، وتصبح السياسات مبتذلة؛ مع هذا التغير السريع، تتأثر أيضاً المؤسسات وينتشر فيها هذا الداء. وهنا يأتي السؤال: كيف لك أن تصل إلى قمة أدائك في هذه الظروف؟
ظللتُ عاكفاً على استجلاء هذه المسألة لمدة ثلاثين عاماً للوقوف على الطريقة التي يمكن أن يحقق المرء بها أفضل ما بوسعه، وذلك في إطار تخصصي في نمو الأطفال وفي التعامل مع اختلاف قدراتهم على التعلم، مثل اضطراب نقص الانتباه وصعوبة القراءة، وكذا في إطار تخصص عملي في تقديم المشورة لكل الأعمار. فكانت المنهجية التي وضعتُ خطواتها لمساعدة الأطفال مثل “تومي”، والكبار مثل التنفيذيين الثلاثة، والتي ذكرتُها للتو هي “دورة التميُّز”. وتشتمل على خمس خطوات: اختيار المهام الصحيحة، والتواصل مع الزملاء، واللعب بالمشكلات والتجريب والابتكار. إضافة للتعامل مع التحديات والتعلم منها سعياً للتطور، والتألق عند إدراكك أنك حققت الإنجازات.
اختر
يعمل ملايين الأشخاص في وظائف لا تناسبهم حيث لا تُثمر جهودهم المضنية عن أي شيء يُذكر. ولا يودون بتذمرهم أن يتسببوا في المشاكل، أو يخاطروا بمناصبهم، لذا فإنهم يفعلون ما يؤمرون. ولطالما قدمتُ إلى مئات الأشخاص البالغين النصائح التي يبحثون عنها لتحسين أدائهم في حياتهم العملية. وأكدتُ لهم مراراً وتكراراً أن عليهم البحث أولاً عن الوظيفة المناسبة. ففي استعراض بحثي أجراه “توموكي سيكيغوتشي” في عام 2004 بشأن العلاقة الملائمة بين الأشخاص والمؤسسات وبين الأشخاص والوظائف، كانت النتيجة التي استخلصها هي أن ملاءمة العلاقة بين هذين الطرفين تعزز الشعور بالرضا الوظيفي، وتقلل التوتر، وتحسِّن نسب الحضور، وترفع مستوى الأداء. فمن خلال عملي مع المرضى، لاحظت أن الملاءمة الوظيفية تتساوى في أهمية اختيار الأصدقاء وصلة ذلك بتوقعات النجاح والصحة العامة.
وفي عملك، ينبغي أن يكون هدفك تخصيص معظم الوقت في الجمع بين ثلاثة أبعاد: ما تحب عمله، وما تجيد عمله، وما يضيف قيمة للمؤسسة. وهناك اختبارات نفسانية مختلفة تُجرَى بهدف تقييم درجة الملاءمة الوظيفية؛ غير أن مثل هذه الاختبارات يمكن أيضاً إجراؤها من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي وضعتُها (انظر العمود الجانبي “هل تلائمك وظيفتك؟”). وإذا أشارت إجاباتك إلى أن وظيفتك لا تلائمك بالقدر الكافي، فيجب أن تفكر في التحدث مع مديرك بشأن تغيير بعض مسؤولياتك. وأقصى حالات التغيير قد تتطلب منك التفكير في تغيير منصبك، بل حتى نوعية عملك.
قابلت مؤخراً سيدة كانت تشعر بأنها عالقة في وظيفتها في خدمة العملاء، حيث كانت تشرف على الموظفين وعملهم القائم غالباً على الرد على العملاء عبر الهاتف، وكانت تبغض معالجة النزاعات المستمرة التي تنشأ من شكاوى العملاء. واقترحتُ عليها أن تتحدث مع مديرها للبحث عن مهام تلائمها. ووجد المدير مبادرتها جديرة بالتقدير، فأعاد تكليفها للقيام ببحوث التسويق، وهو عمل فضلته أكثر من عملها السابق. ولعل هذا التغيير البسيط بإعادة تكليفها هو ما جنَّبها الوقوع في سنوات من العلاج النفسي وتناول العقاقير المضادة للاكتئاب.
تواصل
التواصل هو الصلة التي تربط شخصاً بشخص آخر، أو جماعة، أو أي شيء آخر يحرك مشاعر الترابط، والوفاء، والإثارة، والإلهام، والراحة، والاستعداد للتضحية. إذ إن العمل مع فريق مترابط يؤدي إلى تحفيز أعضائه على نحو لا يضاهيه أي شيء آخر. ولكن اليوم تنغلق قنوات التواصل الإيجابي تدريجياً في مجال الأعمال؛ ففي كثير من الأحيان يعمل الزملاء في مدن وبلدان وقارات مختلفة، وبفضل التكنولوجيا، حتى أولئك الذين يعملون في نفس المبنى قد لا يتحدثون وجهاً لوجه لأشهر أو حتى سنوات. وفي الوقت نفسه، تسببت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في بث مشاعر الخوف والقلق الشديد والريبة. ويؤدي ذلك إلى تعزيز حالة الانفصال، التي تُعتبر سبباً من الأسباب الرئيسية لتدني مستويات الإنجاز، وزيادة حالات الاكتئاب؛ مما يفضي بدوره إلى آثار خطيرة على الأشخاص.
على سبيل المثال، في دراسة أجريت مؤخراً على حوالي 20,000 موظف يعملون في وظائف شديدة التباين في السويد، وفنلندا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، تبيَّن منها أن الأشخاص الذين شعروا بالانفصال عن مديريهم كانوا أكثر احتمالاً للإصابة بالمرض، أو التغيب عن العمل، أو حتى الإصابة بالنوبات القلبية. وفي المقابل، أظهرت البيانات التي نشرتها شركة “غالوب” في عام 2007 أن الأشخاص الذين تربطهم علاقة صداقة حميمة في العمل تزداد احتمالات انخراطهم الإيجابي في وظائفهم سبعة أضعاف احتمالات غيرهم ممن لا تتوفر لهم هذه العلاقات.
فقد أظهرت البحوث أن الانخراط في العمل يرفع مستوى الأداء، وما يعزز الانخراط في العمل هو ارتباط الشخص بمكان العمل. لذلك يجب أن تكون العلاقات المتينة في العمل على قمة أولويات المؤسسات والعاملين فيها؛ فعلى ما يبدو من تفاهة الأحاديث الاجتماعية السطحية، فإن مردودها كبير على العلاقات التي تقوم على الوئام والثقة. لذا أوصيك بأن تسعي للتواصل مع زملائك والاهتمام بكل شخص، وأن تعبّر عن تقديرك للعاملين بالصيانة والكافتيريا، وأن تلاحظ التفاصيل الشخصية – مثل رداء جديد أو نظرة حزينة – ولكن أهم من كل ذلك، أن تكون صادقاً، وتشارك بكل كيانك في كل تفاعل.
يبذل المسؤولون التنفيذيون مجهوداً جباراً، ويقضون وقتاً هائلاً، وينفقون موارد ضخمة، سعياً لتعريف الموظفين بمهمة المؤسسة وتبنِّيها؛ في حين أن العلاقات الإنسانية الإيجابية يجب أن تحظى بقدر أكبر من اهتمامهم. فإذا كنت تتطلع للذهاب إلى العمل، لا يهم الهدف الذي تعمل من أجل الوصول إليه؛ فالجنود العالقون في الخنادق لا يحاربون في تلك اللحظة من أجل الحرية أو الوطن، وإنما من أجل بعضهم بعضاً.
وحينما يقول الناس أن الوقت لا يكفي للتواصل بهذه الدرجة، فإني أخبرهم عن صديقي “جو لوسكالزو” وهو أستاذ في كلية هارفارد للطب، ورئيس القسم الطبي في “مستشفى برغهام آند ومنز” في بوسطن، وعالم باحث، ورئيس تحرير المجلة الطبية لأمراض القلب “سيركوليشن”(Circulation)، وطبيب في عيادة مسجَّل بها عدد كبير من المرضى. فمن الصعب أن يتخيل المرء كيف يمكن أن تكون أيام أي شخص آخر مزدحمة إلى هذا الحد، إلا أن أقصر مدة يخصصها للقاء الأشخاص العاملين معه هي نصف ساعة. ويقول “جو”: “يفترض الناس بداهةً أنك منغمس في أعمالك لدرجة أنك لا تستطيع التحدث معهم. وهو ما لا أظنه أفضل طريقة للعمل.” ويضيف شارحاً “إذا كان ما يحتاجه الشخص أقل من 15 دقيقة، فهو سعيد بالوقت الذي نقضيه في الحديث. ولكننا نبدأ بعدها بالكلام عما يحدث فعلاً”. ولا يفعل “جو” هذا من أجل الموظفين فحسب، بل أيضاً من أجله؛ فمن الأسباب التي تجعله يحب عمله أن يتعرف بصورة وافية على من يعمل معهم، لأن قيمة الاتصال الحقيقي تعود دائماً على طرفي العلاقة.
العب
إذا اخترت الوظيفة المناسبة وأصبحت تعمل في بيئة مشمولة بالترابط، فالطبيعي أن تتحرك نحو الخطوة التالية: الانخراط الخلاق في المهمة، وهي حالة أطلق عليها “اللعب”؛ بعبارة أخرى، النشاط الذهني الذي يمكِّنك من تشكيل الأفكار ونُهُج العمل وخططه. وعندما تكون في حالة “اللعب” سيُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي FMRI نشاطاً في النصف الأيمن من المخ – حيث التلقائية والحدس في التفكير – وهو ما يقابله نشاط النصف الأيسر المسؤول عن الثبات والتفاصيل والتحليل في التفكير. غير أنك قد تنتقل من نشاط النصف الأيمن إلى النصف الأيسر عندما تقوم بعمل روتيني، مثل المحاسبة.
ويجب أن يكون هدفك، كما يطلق عليه ميهاي تشيكسنتميهاي، “التدفق”، حيث يكون الشخص منغمساً فيما يفعله لدرجة أنه ينسى نفسه. وهو ما يحدث عندما يكون الشخص في قمة أدائه. وكما يقول شعار شركة الطيران “ساوث ويست أيرلاينز” (Southwest Airlines): “قلما ينجح الناس في أي عمل ما لم يكن ممتعاً”.
وما نعرفه من علم الأعصاب أن اللعب يبني المخ، حيث ينشِّط إفراز “العامل التغذوي العصبي بالدماغ” أو BDNF، وهو جزييء جرى كشفه موخراً ويحفِّز نمو الأعصاب. كما أن اللعب ينشِّط عمل اللوزة الدماغية، وهي حزمة من الأعصاب تساعد على تنظيم الانفعالات. وهذا بالإضافة إلى أثره المفيد على قشرة الجبهة الأمامية، التي تنظم الوظائف التنفيذية – مثل التخطيط، والتنظيم، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات، والتخطيط الزمني، واستباق الأحداث، والتفويض، والتحليل – وهي باختصار معظم المهارات التي تحتاج إليها للتميُّز في مجال الأعمال.
وقد يبدو اقتران اللعب بالعمل تناقضاً في المعنى؛ فلا شك أنك تحصل على أجر نظير أدائك لوظيفتك – أي لاتباع خطة وتحقيق النتائج. ولكن هذا لا يعني عدم إعمال الخيال في كل ما تفعله. وبدلاً من الأداء الآلي لإتمام أي مهمة، أعطِ نفسك الفرصة للتفكير كي تغير المسار متى لزم الأمر أو اقتضى الفضول. وستكون النتيجة النهائية أفضل.
ففي الحقيقة، إن أداء الناس يصل إلى الذروة حينما يكون العمل مقروناً باللعب. فهم بيذلون الجهد – وهذا أحد تعريفات العمل – غير أنهم يفعلون ذلك في ظل حالة من الإثارة وليس شعور بالسخرة. فالجراح الذي يعمل في غرفة العمليات، ومحامي الدفاع الذي يقدم المرافعة النهائية، والمسؤول التنفيذي الذي يوضح استراتيجية جديدة، والمتداول في البورصة الذي يستهدف شراء أسهم جديدة، والمدير الذي يُجري اجتماعاً معقدا، كل هؤلاء يجتهدون في عملهم ولكنهم أيضاً يقرنون العمل باللعب.
في يوم من الأيام، كان لدي مريض يكره وظيفته لأن مديره كان يصر أن يلتزم بالقواعد والإجراءات التزاماً صارماً. وعلى حد قوله: “يُطلب مني أن أقوم بأشياء سخيفة طوال اليوم”. في جوهر الأمر، كان يشعر أنه محروم من اللعب، من التفكير المبدع، من اتخاذ المبادرة. ووجهته إلى طريقة تمكِّنه من أن يطلب مزيداً من الحرية من مديره. فعندما تتوجه بالطريقة الصحيحة للحديث مع رؤسائك، غالباً ما يبدون استعدادهم لتغيير طريقة عملهم، فلا شك أن تعظيم الأداء هو هدفهم أيضاً.
تعامل مع التحديات وتعلم منها سعياً للتطور
إذا وصلت إلى نقطة يقترن فيها التخيل بعملك، فمن الطبيعي أن ترغب في بذل مجهود أكبر. وفكرة أن بعض الأشخاص لديهم أخلاقيات عمل أفضل من غيرهم، نتيجة لتفوقهم الأخلاقي أو قوة طباعهم، هي فكرة ضلت المعنى السليم. فالسبب الحقيقي لاجتهاد الناس هو رغبتهم في ذلك، وعادةً لأنهم – عمداً أو دون عمد – اتَّبعوا الخطوات الثلاث في “دورة التميُّز”.
تتطلب الخطوة الرابعة العمل الشاق من أجل تحقيق هدف صعب المنال. وقد يتضمن هذا بعض العمل الشاق الممل، إلا أنك ستكون مستعداً لتحمُّل هذه المشقة إذا شعرت بما يربطك بالعمل، وإذا أدركت أنك أسهمت في صياغة المهام. وطريق التميُّز محفوف بالألم. ولكنه نوع مفيد من الألم الذي يصاحبه التوتر، كما أثبت العمل الذي قام به “إيريك كاندِل” – وهو قد شارك عالمين آخرين في جائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب في عام 2000 لاكتشاف ظاهرة المرونة المشبكية. وتوضيحاً لذلك، تخيَّل أنك تحاول أن تتذكر رقم هاتف. في البداية، يجب أن تكتبه على ورقة. وتقوم الخلايا العصبية المعنية بمعرفة ذلك الرقم بإطلاق ناقل عصبي اسمه “غلوتاميت”، كي تبدأ هذه العملية. إذا لم تتصل بهذا الرقم بعد هذه الخطوة، فلا شيء يتغير. ولكن إذا بذلت جهداً كي تتذكره، تتسع الشبكات وتستقر الوصلات بين الخلايا العصبية النشطة على نحو أكثر ثباتاً. وإذا أردنا استخدام المصطلح العلمي، فإننا نصفها بأنها لدنة (بلاستيكية). وعندما تجهد عقلك بهذه الطريقة، يلين لك ما كان صعباً، بفضل تقوية تلك المسارات العصبية. وكما يقول خبراء المخ والأعصاب: إن الأعصاب التي تتوهج معاً تقوى معاً. ولذلك، فإن الممارسة – وتعني في اصطلاح علم الأعصاب التوهج المتكرر للأعصاب – هي التي تحسِّن الأداء.
والعمل الشاق قد يدفعك أن تضرب مكتبك متذمراً، أو تنبذ المهمة الموكلة إليك. ولكن بعد الانتهاء منها، سيصبح مخك أقوى على التعامل معها، وستكون مسروراً لأنك تحملت هذه المشقة. ويعبِّر عن ذلك “جيمس لور”، وهو أحد قادة التفكير في مسألة ذروة الأداء، بقوله: “التوتر ليس العدو في حياتنا وإنما هو مفتاح النمو”.
وعلى الجانب المقابل، التوتر المضر لا يمكن تحمله بدون خسائر؛ فهو غير مخطَّط له ولا يمكن التحكم فيه، ويتجاوز قدرة النظام العاجز عن التكيَّف معه، ولا يمنح أي وقت للراحة والتعافي. كما أنه يضعف القوة الذهنية. وقد أثبت “آدم غالينسكي”، من كلية “كيلوغ” Kellogg School والباحث من هولندا، أن الشخص الذي يضعف إحساسه بالقوة والتحكم، تزداد وظائفه التنفيذية ضعفاً.
وعادةً ما يكون مصدر التوتر السام خارجياً – على سبيل المثال، من الطقس في الطبيعة، ومن الأمراض في الفيزيولوجيا البشرية، ومن الاقتصاد أو المدير السيء في مجال الأعمال. ولكنك قد تدفع نفسك دفعاً نحو ذلك في بعض الأحيان، سعياً للوصول إلى التميُّز. وهو ما يتعين أن تتجنبه لأن التوتر السام قاتل. فهو يقتل العمل الجيد، وخلايا المخ، وخلايا القلب، وفي نهاية المطاف، يقتل الشخص نفسه. وقد خلصت دراسة أُجريت في عام 2010 في هولندا إلى أن وجود نسب عالية من الكورتيزول في البول، وهو ما يسمى هرمون التوتر، يرفع احتمالات الوفاة من الأمراض الأوعية القلبية سبعة أضعاف، وذلك في عينة الدراسة التي شارك فيها 800 شخص.
وكي توجِّه نفسك التوجيه الصحيح، من الضروري أن تولي اهتمامك بالتوتر المفيد، في شكل التحديات التي يمكنك التغلب عليها، وأن تتجنب التوتر المضر. ولدىّ مريض كان يعمل مع فريق من واضعي البرمجيات على إعداد برمجية جديدة في تاريخ محدد. ومع اقتراب الموعد المحدد، بدأ التوتر السام ينشر سمومه. وأصيب أعضاء الفريق بالقلق والإحباط، مما دفعهم للعمل وقتاً أطول وبجهد أكبر ولكن بفعالية أقل، حتى أن أطلق مريضي صفيراً حاداً من فمه. فقال: “يا جماعة. دعونا نجتمع مجدداً وننتهي من هذه المهمة”. وعليه، بادروا بعقد اجتماع فوري، وحددوا خطواتهم القادمة، وأنهوا المشروع قبل الموعد المحدد. ما فعلوه أولاً هو خفض التوتر السام بالتواصل مع بعضهم بعضاً (من بين القواعد الأساسية التي أنادي بها ألا تقلق وحدك)، وتلاها صياغة خطة؛ ومن ثم استعادوا شعورهم بالقوة والسيطرة على الوضع.
تألق
بعدما تتعامل مع التحديات، فإنك تتقدم لتنتهي بالخطوة الأخيرة، وهي إقرارك لما حققته من إنجازات. فلطالما عرفنا أن احتياجنا للتقدير ضروري لتعظيم أدائنا. وعلى مستوى كيمياء الأعصاب، تقترن الإشادة عادةً بإفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالسرور والرضا العام. وهو السبب في الشعور الجسدي الإيجابي. وعلى المستوى الاجتماعي، فهو شعور يُرضي حاجة الإنسان التي يتفرد بها دون غيره من المخلوقات بأن يخدم الآخرين، وأن يكون له قيمة وأهمية. وهذه الحقائق مُثبَتة علمياً؛ أما الجديد في الأمر فهو استمرار انفصالنا عن الآخرين، مما يقلل من التقدير ويعزز ضرورته. فعندما تُنفَّذ مهام العمل بسرعة بالغة، وتتطلب مشاركة العديد من العناصر، يصعب على المديرين تخصيص أشخاص بعينهم بالإشادة، حينما يكونون في أشد الحاجة إلى سماعها. فعليك أن تتذكَّر هذا عندما تتعامل مع الزملاء. ولكن الأهم من ذلك أن تعبِّر بوضوح عندما لا تلقي أي تقدير من شركتك رغم ما تبذله من جهد في التعامل مع التحديات الصعبة ورغم ما تحققه من نمو في أدائك. فلك أن تطلب ما تستحقه. وإذا كانت ثقافة الجماعة التي تعمل معها تعاني بعلة مزمنة تعيقها عن الإشادة لمن يستحقها، فكِّر في البحث عن عمل آخر. لأن التقدير يتمم دورة التميُّز، مما يشجعك على بذل المزيد للوصول إلى قمة أدائك.
تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .